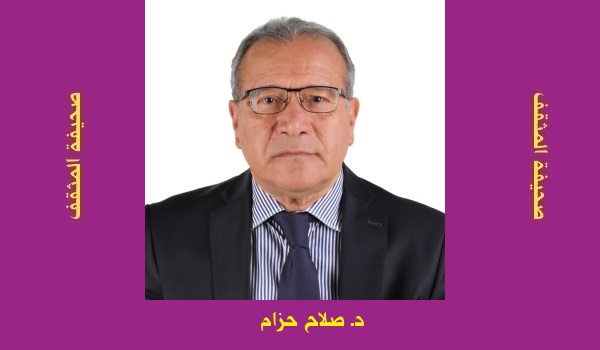قراءات نقدية
فالح الحمـراني أصداء روسية في رواية فؤاد التكرلي.. المسرات والأوجاع

اهتم الأدباء العرب بالأدب الروسي وتأثروا به منذ نهاية القرن التاسع عشر، واطلعوا عليه في الغالب من ترجماته الى اللغات الأوروبية. وانعكست أصداء القضايا الاجتماعية والعلاقات بين البشر، والتناقضات بين التراث والحديث والصراع بين الآباء والبنين، والأسئلة المتعلقة بمعنى الحياة وتنظيم العالم، والقضايا الميتافزيقية، على إبداع الأديب العربي وفكره. وما عدا الروائي السوداني الراحل الطيب صالح لم أقرأ لأحد من الأدباء العرب، من صرح بأن الأدب الروسي لا يعجبه. ودون شك فإن الأدب الروسي ترك ظلاله على أعمال رواد القصة العربية بما في ذلك محمود تيمور في مصر والريحاني وميخائيل نعيمة في لبنان وحنا مينا في سوريا والطاهر وطار في الجزائر ومحمود السيد في العراق وعلى ممثلي الأجيال التالية الذين أبدوا دائما إعجابهم به وبأفكاره وموضوعاته.
وفي هذا السياق استمدت القصة العراقية منذ نشوئها من الرواية الروسية التزامها بالهمّ الاجتماعي وطابعها الأيديولوجي المحض، وفي أحيان كثيرة على حساب المستوى الفني. ونجد بصمات الأدب الروسي واضحة أكثر في الأدب القصصي في خمسينات القرن الماضي في العراق، وحتى على روائيين من الرواد متميزين في الأدب العراقي، لا سيما عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وغائب طعمة فرمان. وعموما فإن عبد الملك نوري والتكرلي ظاهرة متفردة في تاريخ القصة العراقية، بل والعربية، ولم ينخرط القصاصان في التيار الأدبي العام الجارف الذي ساد في الخمسينيات والنصف الأول من الستينيات، والذي بالغ بإضفاء الطابع الأيديولوجي على الأدب، وسعى الأديبان التكرلي ونوري للبحث عن أدوات ومضامين جديدة للعمل الأدبي القصصي، فاهتم عبد الملك بالجوانب النفسية، فيما ركز التكرلي على المشاغل الوجودية للإنسان.
إن فؤاد التكرلي منح الحدث الاجتماعي في قصصه أبعادا أرحب، وتفادى حصرها بأطر موضوعة من خارج العمل الأدبي. وأدرك بصورة مبكرة إن تلك الأطر تظل حاجزا أمام انطلاقة العملية الإبداعية الفنية لجيل الخمسينيات ومنتصف الستينيات وحالت دون البحث عن آفاق جديدة. فتلك الأطر غدت بفعل عوامل خارج الأبداع تيارا لا فكاك منه، على الأقل بالنسبة لجيله. وعلى الرغم من إن الشكل الاجتماعي والأجواء البغدادية شكلت خلفية لأجواء قصص التكرلي، فإن مضامين أعماله والأسئلة التي طرحتها أحداث وشخوص قصصه، كانت ذات أبعاد فلسفية وأخلاقية، عن جوهر الوجود الإنساني، وكوامن النفس الإنسانية وضالتها، واستجابتها للظرف الإنساني الذي عايشته، وأصداء أخلاقية لمحيطها. ويلوح البعد الاجتماعي في أعمال التكرلي في غالب الأحيان، شكلا للعمل القصصي الروائي، لا غير. ويمكن للتحقق من ذلك أكثر بمقارنة الأعمال الروائية للتكرلي بأعمال واحد من أبناء جيله، الراحل غائب طعمة فرمان 1927- 1990)، الذي كان يؤكد دوماً اعتزازه وإعجابه بأدب التكرلي، وحرصه خلال وجوده في موسكو على إيصال أعماله الجديدة للتكرلي ليتعرف على رأيه فيها، وذلك يعود أيضا الى أن الرجلين كانا صديقي طفولة.
لقد ظلت الهموم الاجتماعية بحد ذاتها تمثل محورا لروايات غائب طعمة فرمان، الذي كان يبحث دائما عن مكوّنات الشخصية العراقية، ويسعى لاستعادة نكهة الأجواء البغدادية التي عفا عليها الزمن، ليس لغاية وإنما لحد ذاتها كأجواء، لذلك فإن غائبا كان مولعا بأسماء شوارع بغداد وأزقتها والأسواق والجسور القديمة وأرقام باصات مصلحة نقل الركاب (الاتوبيس)، وحرص حتى في روايته وقصصه القصيرة حتى التي جرت أحداثها خارج البلد على بعث المناخ لعراقي وشخوصه، دون التطرق بوضوح الى الهم الوجودي الشامل.
ويظهر المنحى الفلسفي والأخلاقي بشكل جلي في واحدة من روايات التكرلي التي كانت من بين آخر رواياته "المسرات والأوجاع". ويتناول التكرلي في روايته فترة تاريخية طويلة من حياة العراق، تمتد قرابة مئة عام، ويرسم طيفا واسعا من الشخوص المختلفة في مكوناتها النفسية وانتماءاتها، ولكن هناك شخصية" توفيق" التي تربط هذا الكم من الشخوص والأحداث. بيد أن السارد يتجاهل انعطافات التاريخ الكبيرة والكثير من تفاصيله التي تبدو مهمة، رغم إن تحولاته تكون أحيانا طاحونة قاتلة لسحق الأنسان وهو يمارس حياته اليومية، على خلفية الأحداث التي تموج بها البلد. أن " توفيق" (الشخصية الرئيسية في الرواية) يظل مراقبا للأحداث الكبيرة، التي تعاقبت على العراق دون أي تفاعل أو مشاركة فيها، روحيا أو عمليا، وليس لديه التزام عقائدي محدد، الأحداث بالنسبة له لا تعدو غير أنباء وسائل أعلام، ويلوح إن المتعة بالجنس والأكل واللهو بلعبة القمار، أو في سهرة مع صديق، أو مغامرة مع زوجة صديق أو قريب أو امرأة عابرة، بالنسبة له جوهر الحياة، وما يُغني معناها.
ومن الصعوبة العثور على جواب بسيط، عن ماذا أراد إن يقول الروائي في عمله الكبير والمهم "المسرات والأوجاع"، ولذا فعلينا إن نجد مفاتيح في داخل العمل الروائي نفسه، للكشف عن أسراره. ويبدو أن المتلقي يستطيع الإمساك بأحد المفاتيح التي تساعده على فهم جوانب كثيرة من رواية "المسرات والأوجاع" وشخصيتها الرئيسية بالتعرف على رواية "سانين" التي تأتي الشخصية الرئيسية في الرواية "توفيق" على ذكرها مرات عديدة، مع انه يتحدث عن روايات أخرى، ويقول توفيق ان "سانين" تركت أثرا عميقا في روحه، ويقرأها أول مرة وهو في آخر صف للمرحلة الثانوية، أي مرحلة تكوينه الفكري: ويروي السارد "في شهر حزيران، حين كانت تتجمع هموم الامتحان المقبل وبدايات الحر، قرأ، بالصدفة، رواية ضخمة مترجمة عن الأدب الروسي، وجد عنوانها مكتوبا بقلم الرصاص على صفحة البداية (سانيين أو ابن الطبيعة) ولم يعرف اسم مؤلفها أو مَن ترجمها بسبب تمزق غلافيها الخارجي والداخلي. استحوذت عليه النهار كله. أنهاها والليل في آواخره وأهله نيام والدار ساكنة. شعر، جالسا بذهول في فراشه، بأن أمرا ما عظيما ومرعبا، تَكَشَف له عبر هذه الصفحات التي تبعث على الجنون والهياج والتمرد والرغبة الصادقة بضرب الرأس بالحائط. كأن نارا مقدسة تناوشت روحه فألهبتها وأهاجت فيه العواطف، لم يعد يحتمل جدران غرفته..."(المسرات والأوجاع ص 28، دار المدى، الطبعة الأولى. 1998). ويعود توفيق الى رواية "سانين" في مرحلة نضوجه حيث يكتب في مذكراته عام 1975 حين يذكر انه قرأ "الغريب" لألبير كامو، التي لم تعجبه، ولكنه يقول إن هناك عنصرا يجمع بين "سانين" " الساكن في روحي" وبين ميرسو (بطل الغريب). ويضيف "غير ان الاول (سانين) أكثر حيوية وإنسانية وأقدر على الأقناع من الثاني" (ص120). ويعود "توفيق" لقراءة الرواية مرة جديدة عام 1977 ويكتب في دفتر مذكراته: "قرأت سانين مرة ثالثة بعد أن أخبرني عبد القادر (صديقه) انه جلّدها للمحافظة عليها فطلبتها منه فجلبها لي. حسدتُ سانين، كما هي عادتي كل مرة، حسدته لإدراكه ويقينه وسيطرته على ذاته وجرأته وصفاته الأخرى التي جعلت منه أنسانا عاديا وأسطوريا في نفس الوقت، ولكم تحسرت أن تنتهي الصفحة الأخيرة وان اضطر الى مفارقة هذا المخلوق وهو يقفز من القطار، تاركا هذا يمضي بدونه الى أفق مجهول"(173).
وتتحول سانين بذلك الى خلفية عريضة لرواية المسرات والأوجاع. إن تأكيد توفيق رواية سانين وعدم ذكر التكرلي اسم كاتب الرواية الروسي، ميخائيل ارتسيباشيف، ولا مترجمتها الأديب المصري المعروف إبراهيم المازني، ومروره بشكل عابر بحدثها الأخير فقط، ينطوي على أهمية بالنسبة للكشف عن أبعاد العمل الروائي لا سيما لأديب مجرب مثل فؤاد التكرلي، ولست اعرف هل إن أغفال تلك المعلومات يتعلق بلعبة روائية أيهاميه، للفصل بين سانين وتوفيق؟ فتوفيق يلوح كأنه " سانين" بمواصفات عراقية، أو انه وجه من وجوهه الشرقية، أو امتداد من امتداداته.
ورواية سانين من أعمال الأديب الروسي ميخائيل ارتسيباشيف (1878- 1927) ورأت النور لأول مرة عام 1907 وجذبت الأنظار لها، وبعثت الآمال به كروائي واعد، بعد ظهور قصته "موت لاندا" التي تناول بها شخصية كرست حياتها للبحث عن فكرة وانتهت بموت عبثي. وكتب في العامين 1905 و1906 قصصاً قصيرة عن الثورة الروسية الأولى (1905) التي خلقت هزيمتها مشاعر الإحباط لدى المثقفين (الانتلجينتسيا). وأصبح من تداعيات الهزيمة، الركض وراء المتع الجنسية التي تهاوت الى الانحطاط الأخلاقي، وانتشرت كالوباء ظواهر الانحلال والانحراف الجنسي. وعلى خلفية تلك الموجة ظهرت الرواية وعكست من جهة انتشار ذلك الوباء، ومن ناحية أخرى ساعدت على اتساعه. وحظيت الرواية بسرعة بنجاح لا حدود له، وتصدرت قوائم المبيعات وتألق نجم مؤلفها. وشتمها النقاد المحافظون بما ذلك ليف تولستوي، لكونها رواية لاأخلاقية وصبوا جام سخطهم عليها. واستقبلها المجددون بتحفظ. ولكن الرواية كانت حدثا مثيرا، وفرضت نفسها على الجميع، وكان لا بد من قراءتها. وبقيت " سانين" على مدى عدة سنوات، أنجيلا لكل تلميذ وتلميذة في روسيا. ومثلت الرواية بتناولها العلاقات الجنسية بشكل مفضوح بالنسبة لذلك الزمن، خروجا على تقاليد الأدب الروسي الذي ظل محتشما في تناوله الموضوع الجنسي. والرواية بأحداثها وشخوصها دعوة ليكون الأنسان معتدا بنفسه، وأن يهتدي بميوله ونزعاته. ويحصر ارتسيباشيف تلك الميول والنزعات بالغريزة الجنسية. وليس ثمة مكان للحب في فلسفته، فالحب برأيه، من اختلاق الفن والثقافة، فالرغبة، كما تؤكد أحداث الرواية، هي الدافع الحقيقي الوحيد في حياة الأنسان. وقامت الفلسفة الحياتية لبطل ارتسيباشيف (سانين) على الإيمان بالفردية الخالصة، وتأكيد "الحرية الذاتية"، والحياة الفردية الحرة، التي لا تحددها أية التزامات اجتماعية أو أخلاقية. وانحصر معنى الحياة بالنسبة له" بالشعور بالمسرات والأوجاع". وليس في وعي "سانين" افكار ذات بعد اجتماعي. وتلتف كلها على "محور" الوجود الفردي وحريته.
ويدرج عدد من مؤرخي الأدب الروسي ميخائيل ارتسيباشيف، الذي هاجر من روسيا بعد اندلاع الثورة البلشفية عام 1917، وأصبح واحداً من ألد أعدائها، في المدرسة "الطبيعية الجديدة"، التي تشكلت لمعارضة الأدب ذي المنحى الاجتماعي الذي مثله بسطوع حينذاك مكسيم غوركي والجماعة التي التفت حوله. إن أصداء "سانين" في رواية القاص العراقي الكبير فؤاد التكرلي، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تنقص من أهميتها ومكانتها في الأدب العراقي، والعربي عموما. وتظل المسرات والأوجاع عملا أدبيا أصيلا قائما بذاته. وكأي عمل أدبي أصيل، ستتعدد قراءاته والاجتهادات بتفسيره، والبحث عن مفاتيح لكنه اسراره.
***
د. فالح الحمـراني