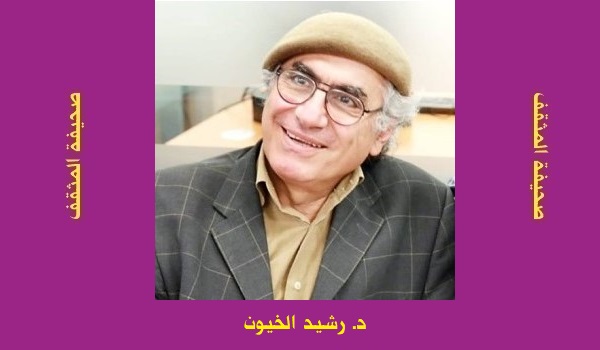قراءات نقدية
ضياء خضير: مقامات أبي جعفر الحديثي

أبو جعفر، حسّان الحديثي، صاحبُ هذه المقامات التي يسميها رحلات أدبية، أو (أدب رحلات)، لا يقصد بها الوصول إلى مدينة بعينها، مدينة قد تشبه مدينة )أين) الخيالية التي قضّى صديقنا ابنُ كركوك سركون بولص عمرَه القصير في البحث عنها دون أن يصل إليها. لأن ابنَ حديثة الذي يحمل في هاتفه وحقيبته خارطة الكرة الأرضية، يدور بها وحولها منذ عقود، كما تدور نواعير الفرات في مدينته الصغيرة، يريد أن يرتوي برؤية مدن العالم التي يذهب إليها للزيارة والتجارة، وبحثا عن السرّ المكنون في هذه المدينة أو تلك، دون أن يغادرها أو يغادر بعضها كللاً أو مللاً، ولا سأماً أو ضجراً، وإنما اتباعا لما كان يراه شاعر لبنان بشارة الخوري، الذي يقول:
يشربُ الكأس ذو الِحجا و ُيبِقّي
ِلغـٍد في قرار ِة الكأس شيّا
وأنا أسمي ما يكتبه الحديثي (مقامات)، وليس رحلات، لأن هناك صلة قربى أراها تشدُّ الرحلات إلى صورة المقامات القديمة لغةً ومصطلحا يجمع بين الإقامة والمقام، ولا تختلف إلا في اختلاف مقتضيات العصر والزمان.
ولست أدري لماذا يأتي إلى الذاكرة راويةُ أبي القاسم الحريري البصري الحارثُ بن همّام كلما قرأت مقامة أو رحلة من رحلات أبي جعفر الحديثي، المنسوب عندي إلى عالم الحداثة في المغامرة والسفر والتعامل مع تجارة الحاسوب وملحقاته، وليس إلى حديثة الأنبار وحدها؛ أهو ما يجمع بين هذه المقامات العصرية وتلك التي أنشأها الحريري في بصرة القرن الهجري الخامس من متعة القص والحكي وتحقيق الغاية البيانية والبلاغية، وما تنطوي عليه كلتاهما من جد القول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب والمشاهد ونوادرها؟! أم هو اسم الحارث بن همام، الذي نسب الحريري رواية هذه المقامات إليه، والذي يقول عنه ابنُ خلكان في وفيات الأعيان: إن الحريري قصد بهذا الاسم نفسَهُ، ونظر في ذلك إلى قول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): «كلكم حارث وكلكم همام» فالحارث: الكاسب، والهمام كثير الاهتمام بأموره، وما من شخص إلا وهو حارث وهمام. وليس مثل أبي جعفر حسّان الحديثي حارثٌ وهمام، جمع في حياته بين الحسنين، ونجح في المهمتين، مهمة القلم والتجارة، اللتين لا يربطهما ربما شيء بما اختص به بطلُ الحريري أبو زيد السروجي من حرفة الكدية والشطارة، مع أن بطل المقامة الهمام هذا، الذي يحاول بكل طريقة كسب حياته بطريف الكلام، للفت الاهتمام، هو غير الراوية الحارث بن همام، ومن يقف وراءه، واضعُ المقامات أبو القاسم الحريري نفسه، الذي يحدثنا مترجمو حياته أنه كان من ذوي الغنى والمال، ولا علاقة له بالحاجة وذلّ السؤال.
ولو أتيح لنا أن نقلب الأدوار التاريخية ونجعل الحديثي حسان يعيش في بصرة القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، الذي عاش فيه الحريري، لما وجد إذا أراد ممارسة الكتابة أو الرواية التي لا تخلو من متعة وغواية سبيلا إلى غير أبي زيد السروجي أو ما يشبهه ليجري الحوار معه، ويجعل مدار الحكاية حوله؛
ويمكننا كذلك أن نتخيل ما يفعله الحريري إذا وجد نفسه في بصرة القرن الخامس عشر الهجري - الحادي والعشرين الميلادي، فهو الآخر لا يكون حينئذٍ بعيدا عن صاحبنا الحديثي الذي تحولت راحلته في سيرها الهيذبى أو الخيزلى الصعب فيما يسميه (طريق القمر) إلى طائرة أو بساط ريح قادر على أن يحمله خلال يوم أو بعض يوم من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وبالعكس.
ومن يقرأ مقالة االحديثي أو مقامته البصرية الأولى بين مقالات الكتاب ومقاماته، ويرى إلى الحوار الذي يجري بينه وبين صائد السمك البصري الذي كان يرمي سنارته إلى مياه شط العرب ليطعم السمك الساهر في مياه تلك الضفة لا ليصيده، ويعبر عن ذاته الجريحة بعد فراق زوجته بالغناء الحزين، ثم يقرأ مقامة الحريري (الحرامية)، ويرى إلى ما فيها من حوار بين الحارث بن همام وأبي زيد السروجي الذي كان شحاذا أريبا أديبًا ألقى خطبة بليغة في مسجد بني حرام، فيتبعه راوية الحريري الحارث الهمام ليعرف جلية أمره ويقف على سره، كما وقف الحديثي على سر ذاك الفتى البصري، سينتفي ربما عنده الزمن ويدرك، كما أدركتُ، صلة القربي هذه في البناء العام للنصين، وغرابة اللقاء في محتواهما، والعبرة التي يمكن الخروج بها من مثل هذه الصلة بين الأدباء الرحالة الغرباء.
وكم يمتعني أن أقرأ مثل هذا الكلام يقدم له أبو جعفر الحديثي وهو يروي قصته مع ذلك الشاب البصري، ناسيا أني أقرأ لصديق من الأصدقاء أعرفه من هذا العصر، وليس للحريري أبي القاسم في ذلك العصر يرويه، وهو يقدم للقاء راويه في مقاماته مع بطله أبي زيد السروجي:
"كنت أقيم في فندق شيراتون المطّل على شط العرب وقد كانت إحدى أمتع الاوقات عندي هو التمشي ليلاً بمحاذاة الماء في المسافة الواقعة بين تمثال السيّاب شمالا ومطعم شط العرب جنوبا. وفي ليلة من الليالي المقمرة وقد تأخر الوقت وأفلتت عيني النعاس فخرجت من الفندق وقد خلا رصيف الشط من الناس إّلا من اثنين؛ السيّاب حارس المعاني وفتى أسمر اللون هاديء القسمات لم يتجاوز عمره العقدين والنصف يجلس وحيدا مع سنارته المنغمسة في الماء ويرسل صوته الشجي بطور ريفي حزين مترنماً حد البكاء ببعض أبيات عروة بن الورد.."
وأقرأ بعد ذلك أو قبله مقدمة الحريري في مقامته الحرامية الثامنة والأربعين بين مقاماته:
"روى الحارث بن همام عن أبي زيد السّروجيّ قال: ما زلت مذ رحلت عنسي، وارتحلت عن عرسي وغرسي، أحنّ إلى عيان البصرة، حنين المظلوم إلى النّصرة، لما أجمع عليه أرباب الدّراية، وأصحاب الرّواية؛ من خصائص معالمها، وعلمائها، ومآثر مشاهدها وشهدائها، وأسأل الله أن يوطئني ثراها، لأفوز بمراها، وأن يمطيني قراها، لأفتري قراها. فلمّا أحلّنيها الحظّ، وسرح لي فيها اللّحظ، رأيت بها ما يملأ العين قرّة، ويسلي عن الأوطان كلّ غريب، فغلّست في بعض الأيام، حين نصل خضاب الظّلام، وهتف أبو المنذر بالنّوّام لأخطو في خططها، وأقضي الوطر من توسّطها، فأدّاني الاختراق في مسالكها، والانصلات في سككها، إلى محلّة موسومة بالاحترام، منسوبة إلى بني حرام، ذات مساجد مشهودة، وحياض مورودة، ومبان وثيقة، ومغان أنيقة، وخصائص أثيرة، ومزايا كثيرة."
لأرى أن ما يهم الاطلاع عليه في النصين أكثر من غيره، ليس الموضوعَ المنسوب إلى كل راوية من راويتيهما، بل هو الطريقة والأسلوب، والروح المستكشفة والباحثة عن المطلوب.
وهو دائما غامضٌ غيرُ ظاهر، ولا ينبغي أن ننخدع فيه بالمظاهر.
ومدينة حديثة التي خرج منها حسان الحديثي، وهو لا يحمل في رأسه غير الطموح بالذهاب بعيدا عنها والعودة إليها، ولا يحمل في خرجه البدوي غير حفنة من قصائد شعرية علّمها إياها، أخوه الكبير، وزرع في نفسه من خلالها حب الشعر وعشق الأدب والتراث العربي منذ أيام الصبا الباكرة، يسوح في أروقة ماضيه ولغته كما يسوح في شوارع مدن العالم وأسواقها الغريبة، تظل بعيدة نائية، قد يجيب إذا سئل عنها وعن أهله فيها بما يشبه ما أجاب به أبو تمام حينما سئل مرة عن مدينته وأهله:
في الشام أهلي وبغدادُ الهوى
وأنا في الرقتين وفي الفسطاط إخواني
*
وما أظنُّ النوى ترضى بما فعلت
حتى تبلّغني أقصى خراسان
وخرسان البعيدة هذه التي لا ترضى النوى بما فعلت بالشاعر الكبير حتى وصول راحلته إليها، مدينة واقعة في أقصى الشمال الإيراني. وكأنما هي في نأيها وصعوبة الوصول إليها آنئذٍ الرمزُ القديم لمدينة (أين) الخيالية، أو شنجن الصينية التي لابدّ من التفكير بالضياع لدى التفكير في الذهاب إليها، كما يقول الحديثي، الذي يمزج في رحلاته القريبة والبعيدة، كما قلنا، بين الزيارة والتجارة. فهي مدينة مفقودة مع وجودها على الخريطة ما دامت غير قادرة على الإمساك بزائرها، ليقيم أو يعيش فيها أكثر مما يتطلبه الظرف والحاجة. مع أن البحث عنها يبقى هو الهاجس الخفي عنده، مثلما كان لسلفه ابنِ كركوك، ولكل الرحالة القدماء والمعاصرين، الذين ما فتئوا يرددون قولة ابن زريق البغدادي في غربته الغريبة:
ما آبَ من سفر إلا وأزعجه
رأيٌ إلى سفر بالعزم يُزْمِعُهُ
نعم، فهو مثل هؤلاء، لا يكاد يعود إلى مدينته ومستقره اللندني الأليف هذه الأيام وهذه السنوات إلا وأزعجه الحنين إلى مدنه الأخرى الموزعة على الخارطة في قارات العالم الخمس، بدءًا من مدينة القلب و(أم العراق) بغداد، التي يكتب في خاتمة رحلاته هذه الكلمات عنها:
"أعرف مدنَ الخيال كما أعرف مدن الواقع، غير أن بغداد هي المدينة التي تجمع الخيال بالواقع وسرُّها يكمن في كثرة المتكسرين على أعتابها، من العشاق حباً ومن الأوغاد عدوانا ً".
وانتهاءً بكل المدن التي زارها وسيزورها للسياحة والعمل، أو مجرد الفرجة والغزل.
وما يعشقه الحديثي في العادة ليس عماراتِ المدن وأحجارَها الإسمنتية الشاهقة، ولا مظاهر الحداثة فيها، لأنه من ذلك النوع من البشر الباحثين عن عراقة المدن وماضيها، لأننا والمدن، كما يقول "من أصل واحد كلانا من ماء عذب وطين لزب"!
وهو يجد نفسه "مسحوراً بحارات دمشق وأزقة بغداد وأحياء القاهرة وحجارة روما وبقايا أثينا، ولا أطيل المقام في سنغافورة وهونك كونك فالتأريخ مكتوب على حيطان المدن ورائحتُه مغموسة بتراب مماشيها وغبار أزقتها القديمة، ومدينة بلا نهٍر جارٍ وطين محروق وحجارة منحوتة، مدينة جامدةٌ وهياكل صامتة ومبان خرساء غريبة عنا نحن البشر".
وقبل أن يخرج المؤلف من بغداد ونخرج معه منها ومن العراق إلى مدن أخرى، لابد من التوقف معه عند بصرة السيّاب "مدينة النخل والمجاز" في الجنوب، وموصل أبي تمام أم الربيعين في الشمال. فهما عنده الطرفان للجسم الواحد، الذي تتوسطه مدينة القلب بغداد، يتردد بينهما ذهابا وإيابا كما يتردد النبض الخارج من شرايين القلب وأوردته.
وبعض الأوصاف التي يضفيها على مدينة مثل البصرة وهو يدخلها لا تختلف عن تلك التي اعتدنا أن نقرأها لدى الرحالة القدماء من الذين دخلوا المدينة قبله بقرون مثل ابن بطوطة..!
ولنقارن بين ما يقوله الحديثي عن المدينة هنا:
"هذه هي البصرة، ِسفرها ليس كالسفار، ولا شأنها كشأن باقي المدن والمصار، فهي ربيع دائم وكنز عائم، محفوفة بالخيرات من كل جانب فأرضها عطاء وأعلامها علماء، وأهلها وأن جارت عليهم الدهور والأزمنة، أهلُ جوٍد وكرٍم وسماحٍة وسخاء."
وما يقوله ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي في القرن الرابع عشر الميلادي عن المدينة نفسها:
"ومدينة البصرة إحدى أمهات العراق الشهيرة الذكر في الآفاق الفسيحة الأرجاء المونقة الأفناء، ذات البساتين الكثيرة والفواكه الأثيرة، توفر قسمها من النضارة والخصب... وأهل البصرة لهم مكارم أخلاق وإيناس للغريب وقيام بحقه، فلا يستوحش فيما بينهم غريب."
لنرى كيف أننا في مثل هذين النصين لا نحتاج إلى إجراء مناقلة زمنية نضع أحدهما مكان الآخر، لأنهما موحدان أو متشابهان فيما يقولان، كما لو كان كاتباهما واحدا لا اثنين.
والأمر ليس عائدا إلى نظر الأول الحديث إلى الثاني القديم، وإنما هي وحدة المشاعر والأحاسيس البشرية المدركة عند النظر إلى الموضوع الخاص بالمدينة العريقة وطبيعتها الجغرافية والزراعية، وتاريخها الثقافي والديني والعلمي المعروف لصاحبي النصين كليهما.
ولا يختلف الأمر في الموصل (مدينة الأنبياء) التي يقول لنا الحديثي في أول جملة تخطها يراعته عنها لدى دخوله إليها:
"غبْ عنها ما تشاء من الزمان ستجدها هي نفسها بتلك اللفة وتلقاها بكرمها الذي يلفت النتباه وقد حف أهلوها ضيوفها بكل سماحٍة يتسابقون فيسبقون أنفسهم لخدمة هذا ولراحة ذاك وكأنهم خلية نحل، ستجدها هي ذاتها بجسورها التي تربط ال ُحسنين واللثغتين، بدجلتها الذي يحكي لك حكايات التاريخ والعصور".
ومن مدنه العراقية الثلاث هذه، التي يحجُّ إليها ويستوفي فروضَ العودة إليها وتجديد العهد معها المرّةَ بعد المرة، ينطلق صاحبُنا إلى مدنه الأخرى الواقعة على الطريق إلى القمر.
هذه المدن الموزعة على الخريطة بين آسيا، وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، لا يكاد يستثني واحدة منها مهما بعدت ونأت دون أن يعقد العزم للذهاب إليها والوقوف على جلية الأمر فيها، ويسجل ملاحظاته عنها، إذا كان فيها من أسباب الجمال والإلفة ما يدعو النظر إليها للمعاينة والتثبت منها، مثل باريس مدينة النور، التي في كل ركن من أركانها "شعر وأدب وفي كل زاوية عاشق تعب ووراء كل عمود حبل حكاية يتأرجح بين حاضر الخير وماضي الشر بين واقع الترافة وغيب القهر".
وبراغ التي تشبه "اللحن الرقيق لقصيدة لم تُكتب بعدُ، وهي الخاطرةُ التي ما تزال تراود الخيال، واللوحةُ التي تحتاج الى الجرأة قبل الفرشاة والرسام".
وفلورنسا الإيطالية التي لا يملُّ المؤلفُ الرحالة من التجوال بين قصورها وكنائسها ومتاحفها ويرقب مندهشا أعمال فنانيها ويرى أن من الغريب "أن يضع الرسام حسابات رياضية دقيقة نحاول أن نفهمها الآن بصعوبة بالغة ونحن في عصر اختزلنا فيه علوم الفيزياء والرياضيات".
والمدهش أيضا أن "تضم تلك الرسوم والتصاميم فلسفة مخبوءة يعبر بها الفنان عن إنكاره او حبه او إيمانه أو رفضه لأشياء موجودة في لوحة أو منحوتة نتوهم حين نقف أمامها من ِمنا الجامد، ثم لننقلب حاسري الفكرة مكشوفي العيّ، كليلي العقل أمام عظمة الخلود وفلسفة الوجود".
ولا ننسى المدينة الإسبانية الجميلة أليكانتي التي لو كان للمدن وجوه، كما يقول، لأشرق وجه هذه المدينة لطفاً وجمالًا، ولو خلق الله للمدائن شفاهاً وألسنةً لتبسمت أليكانتي بوجوه الناس بل ولقالت شعراً عذباً يناسب روعتها وجمالها ويليق بحسنها وكمالها..!
وذلك لا يمنع من أن يرى في مدن أخرى مثل هونك كونك وتايبيه ما لا يسره ولا يرضيه، فالأولى المليئة بفنادقها الفاخرة وسياراتها الفارهة ومطاعمها الأنيقة ومراكز التسوق التي تضج بالحركة والضوء، تبقى عنده مدينة بائسة، "جعل منها الكونكريت أرضاً خالية من روح التاريخ مقطوعة النسب مع الماضي".
أما الثانية ف "جوّها رطب يكتم النفس وسماؤها معتمة تقبض الروح، وشعبها جامد وهواؤها فاسد وصباحها كئيب وليلها مريب والغريب فيها محضُ شقي غريب".
وهو في إدمانه على زيارة هذه المدن وتفحص قسمات وجوهها ووضع مبانيها وشوارعها وساكنيها والذين يتعامل معهم فيها، صار يرى أن "المدن كالنساء باختلاف السكنى والاطمئنان هذه تسكنك وتطمئن اليك، وأنت تسكن وتطمئن لتلك".. كما هو حاله مثلا مع زحلة اللبنانية التي سكنته، ولا أريد أن أختم كلامي عن الكتاب دون أن أضع هنا شيئا مما قاله فيها .
فهو، بحس الشاعر والأديب والرجل الأريب الذي يعشق الجمال مرتبطا بالتعبير عنه بالكلمات، لا يستطيع أن يرى وادي الجمال في بلدة مثلها دون أن يستذكر أحمد شوقي، وما قاله فيها:
شيّعتُ أحلامي بقلبٍ بــــــا ِك
ولممتُ من دربِ الملاحِ شباكي
*
ورجعتُ أدراج الشباب ووردِه
أمشي مكانهما على الاشواكِ
وهو يقول لنا إنه منذُ أن قرأ هذه الأبيات، ولثلاثة عقود مضت، وهو يتخيل زحلة ويرسم
لها صورا في عقله وقلبه، ويشعر أن أحمد شوقي قد أصابته نفثة من سحرها حين كتب لها هذه القصيدة الخالدة، "لكنه سحرٌ من نوع آخر يخترقُ حدود الزما ِن والمكان".
وربما جاز لنا القول بعد الفراغ من قراءة الكتاب إنه هو الآخر نوع من السحر الحلال، تعلق صورُه بالأفئدة والأسماع، ويلون بسحر أدبه المعدي كلّ الصفحات التي كتبت بها الرحلات بيد فنان صناع، اخترق حدود المألوف في إنشاء الكلمات، ورسم تلك اللوحات.
***
الدكتور ضياء خضير