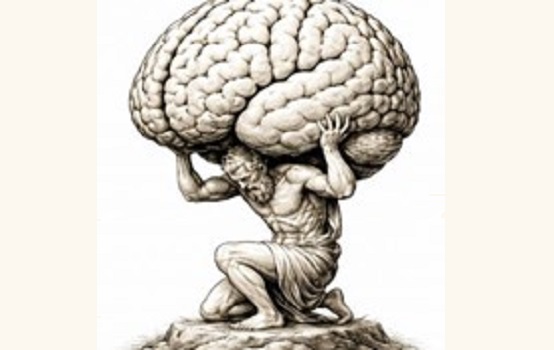قراءات نقدية
عبد الله الفيفي: أزمة النَّقد الأدبي والعلاقة بين الأديب والناقد

النقد الأدبي عِلم، أو يحاول أن يكون عِلمًا، ولم يَعُد اليوم انطباعًا أو تقريظًا. والنقد في العالم أجمع يفيد بعضه من بعض؛ فالحكمة تظلُّ ضالَّة الباحث، أنَّى وجدها التقطها، فهو أحقُّ بها وأهلها. ويجب أن يضيف الباحث ممَّا لدى الآخر إلى ما لديه؛ فليست هنالك أُمَّة مكتفية بذاتها، مستغنية عن الاقتراض والتعلُّم من غيرها. والأدب بدَوره يتطوَّر ككلِّ شيء، كما أنَّ العِلم والخبرة الإنسانيَّة يتطوَّران في كلِّ شيء، ولا تثريب على مَن يسعى لتطوير أدواته، بل التثريب على القابع عجزًا القانع بما لديه.
إن النقد الأدبي، إذن، دراسةٌ في مادة النصِّ، وجنسه، وسياقاته، وَفق معايير عِلميَّة. من حيث هو عِلمٌ كسائر العلوم، وحقلٌ تخصصي كسائر التخصُّصات، له قضاياه، ومشاغله، ومصطلحاته، وليس ميدانًا مشاعًا لعامَّة الشُّداة، والهُواة، والمتأدِّبين، والمثقَّفين. ومع هذا فثَمَّة اليوم من لا يحترم هذا الميدان، بل يخوض فيه بيديه ورجليه. وأضرب على هذا مثالًا نموذجيًّا على الارتجال والاستخفاف باسم الممارسة النقديَّة. فلقد نَبَتَ فيمن يشتغلون بالنقد من المعاصرين مَن لا يفرِّق، مثلًا، بين (القصيدة العموديَّة) وغير العموديَّة؛ فكُلُّ موزون لديه «عمود»؛ لأن صاحبنا يرى بأُمِّ عينية عموديَن لا عمودًا واحدًا، ماثلين في شطري البيت الشِّعري العَرَبي، وهو يظن هذا الشكل البَصَري سبب المصطلح! وكذا تسمع آخَر لا يفرِّق بين أشكال غير الموزون على البحور الخليليَّة، فكلُّ ذلك لديه «شِعرٌ حُرٌّ»، والسلام! وترى هذا يُنشَر في وسائل الإعلام، وربما في الكتب! وبهذا فالمفاهيم ضائعة والمصطلحات عائمة! والصحيح أن ليس الشِّعر العمودي ما كان موزونًا على البحور الخليليَّة فقط، بل يجب إلى ذلك أن تتبع القصيدة سنن القصيدة الجاهليَّة، كما أوضح هذا (أبو علي المرزوقي، -421هـ= 1030م) قبل ما يناهز ألف سنة، في مقدمة كتابه «شرح ديوان الحماسة». فأبان أن المصطلح يشمل احتذاء تقاليد القصيدة الجاهليَّة عمومًا، ممَّا حدَّده في سبعة أبواب: شَرف المعنى وصحَّته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، والتحام النَّظْم على وزنٍ ملائم، والتناسب في الاستعارة، ومشاكلة اللفظ للمعنى واقتضاؤهما للقافية. ولم يكن من معايير القصيدة العموديَّة الالتزام بالوزن والقافية أصلًا؛ من حيث كان ذلك مسلَّمًا، لا محلَّ خلافٍ بين المقلِّدين والمجدِّدين. ولقد كان هذا العمود التقليدي قد انكسر منذ (أبي تمام). أمَّا تسمية ما ليس موزونًا «شِعرًا حُرًّا»، فجهلٌ محض. ذلك أن مصطلح الشِّعر الحُر كان مصطلحًا عتيقًا، استُعمل ترجمةً لكلمة Free verse، خلال الأربعينيَّات والخمسينيَّات من القرن الماضي، ثمَّ عُدِل عنه إلى مصطلح شِعر التفعيلة؛ لأن الحُريَّة الموسيقيَّة في القصيدة العَرَبيَّة غير تامَّة، كما نبَّهت إلى هذا (نازك الملائكة)، منذ وقتٍ مبكر. إلَّا أنَّ ما يمكن أن يسمَّى الشِّعرَ الحُرَّ حقًّا هو ما أُسمِّيه (شِعر التفعيلات). وأعني بشِعر التفعيلات تلك القصيدة التي لا يُتقيَّد فيها بالتفعيلة الواحدة، بل ينداح الشاعر في موسيقى الشِّعر، ليبتدع أشكالًا تُمليها التجربةُ المتجدِّدةُ من نصٍّ إلى آخَر، فيمزج نظامًا تفعيليًّا بنظام. وأمَّا أن يأتي من يسمِّي (قصيدة النثر) شِعرًا حُرًّا، كما يُلحَظ في بعض المسابقات المعاصرة، التي يحكِّمها من ليسوا في عير النقد ولا في نفيره، فسَلَطَة اصطلاحيَّة طريفة، لا تستحقُّ التعليق! وقِس على هذا كثيرًا مما يُنشَر اليوم باسم النقد الأدبي.
غير أنَّ السؤال المتكرِّر: أليس للنقد دورٌ في تقييم النتاجات الإبداعيَّة الصادرة حديثا؟ والإجابة تتمثَّل في ضرورة التفريق بين «النقد العِلمي» و«النقد الصحفي». فالأوَّل ليس معنيًّا بمتابعة كلِّ جديدٍ من الإصدارات بالضرورة، إلَّا إذا كان لافتًا، ومضيفًا، ويستحقُّ التوقُّف. وإذا توقَّف أمام الجديد، توقَّف أمام الظواهر، لا أمام الأفراد، والعناوين. فكما أنَّ عِلم الطِّب، على سبيل النموذج، يدرس الظواهر المتعلِّقة بصحَّة الإنسان، لا فلانًا المريض أو فلانًا السليم، كذلك النقد الأدبي. وكذا في الدرس التطبيقي، لا يُعالج هذا العِلم أو ذاك الإشكالات الفرديَّة، إلَّا بوصفها شواهد على ظواهر. فيبقى الترويج للإصدارات الأدبيَّة، والكتابة عنها، بصفة عامَّة، دور الصحافة الأدبيَّة، بنقَّادها المعنيِّين بالتعريف بالجديد، وطرح بعض التقييم اليسير. أجل، النقد الأدبي هو مختبرٌ عِلميٌّ ومعرفيٌّ، لا شأن له بالترويج للكُتَّاب، ولا بالتعريف بالأسماء، اللَّهم إلَّا حين يُحقِّق أحدهم إنجازًا نوعيًّا، تضيف دراسته جديدًا في التبصُّر بمسائل النقد الأدبي.
صحيح أنَّ جماهير الناس لن يتقبَّلوا النقد الأكاديمي، ولن يستوعبوه، حتى لو أُتيحت له مساحات في وسائل الإعلام، فالإعلام العامُّ يتوجَّه غالبًا إلى شرائح وُسطى من المتلقِّين، لا للعلماء والأكاديميين. ومع هذا، حبَّذا لو عُنيت وسائل الإعلام الثقافي الجادِّ ببثِّ بعض المؤتمرات العِلميَّة، ونشر بعض النتاجات النقديَّة المتخصِّصة، للإسهام العِلمي المفيد لشريحة محدَّدة من ذوي الاختصاص والشغف بهذا التخصُّص، وتنوير غيرهم من المهتمِّين. غير أنَّ من المثاليَّة تصوُّر أن هذا سيكون باب جذبٍ واهتمامٍ للجماهير العريضة.
قد يتبادر التساؤل هنا : ما السبيل، إذن، إلى جعل النقد العِلمي مواكبًا للمتلقِّي العام، بحيث لا يفقد عِلميَّته ولا يخسر حضوره الجماهيري؟ وكي لا يقال إن النقَّاد قد فشلوا في الانفتاح على التجارب الإبداعيَّة الشابَّة، وابتعدوا عن قراءة المشهد الثقافي؟ ومع أن هذا حلمٌ جميلٌ، فإنه يلزم التفريق بين ثلاث وظائف: وظيفة العِلم، ووظيفة التعليم، ووظيفة الإعلام. فالعِلم، من حيث هو، ليست وظيفته التعليم المباشر، ولا الانفتاح على التجارب الشبابيَّة الإبداعيَّة، بل هذا دور التربية والتعليم. أمَّا قراءة المشهد الثقافي والإبداعي، فليست بوظيفة النقد الأكاديمي بالضرورة، لكنه دور الإعلام الثقافي. نعم، ينبغي للنقد الأكاديمي أن يتفاعل مع قضايا العصر والجماهير، وأن يلتفت إلى تجارب الشباب الإبداعيَّة الناضجة والمبشِّرة بمستقبل، وأن يرصد تحوُّلات المشهد الثقافي والإبداعي، فلا ينعزل عن الحراك من حوله، لكنه لا يصحَّ- في الآن نفسه- أن نحمِّل الناقد الأكاديمي وظائف قطاعات اجتماعيَّة وتعليميَّة وإعلاميَّة وثقافيَّة أخرى، وإلَّا كنا نخلط الأوراق، ونُماهي بين الاختصاصات.
وعلى الرغم مما يُفترَض في العِلم من حياد، ومن رصدٍ معرفيٍّ نزيهٍ عن الهوى والميل والأيديولوجيَّات، فأنت ترى أنَّ الناقد العَرَبيَّ كثيرًا ما ينتصر لفريقٍ أو توجُّه، ويصنِّف نفسه أو يُصنَّف إلى حساب نادٍ أو تيَّار، تمامًا كما يقع بين مشجعي كرة القدم، بضجيجهم وتدافعهم وفوضاهم. ويبدو أنَّه قد رسَّخ هذه الانحيازيَّة في مقاربة الأدب تحوُّل الطابع العشائري في المجتمع- مع الطابع «الشللي» أو «الثللي» في الساحة الأدبيَّة- إلى المجال النقدي، فأصبح لكلِّ تيَّارٍ نقَّادُه المحبُّون، المصفِّقون والمشجِّعون، ولكلِّ اتجاهٍ «كادره» المقرَّبون، من كَتَبَةٍ، وصحفيِّين، ودارسين، ونقَّاد. وهكذا، فإنَّ ما يمكن أن يُسمَّى النقد الأدبي العَرَبي قد لا يعدو في بعض نشاطه مبادراتٍ فرديَّةٍ مضطربة، أو مباريات كلاميَّة، يردُّ بعضها على بعض، تظهر نتاجاتها كنباتات موسميَّة بين حينٍ وآخر، في غير تنظيم، ولا تضافر، ولا مواكبة، ولا اطِّراد. ولا غرو، فإنَّ النقد الأدبيَّ هنا يبدو صورةً عن المجتمع نفسه، عبر موروثه وتحوُّلاته وتعثُّراته، كما يتجلَّى لنا خلال القرن الماضي وهذا القرن. ولعلَّه، كما أزعم، لمَّا يتبوَّأ بعد مكانةً ناضجة- بما تعنيه الكلمة من معنى- لا في تعامله مع المحلِّي ولا في تعامله مع الخارجي، ولا في تناوله للتراث، أو الراهن.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي