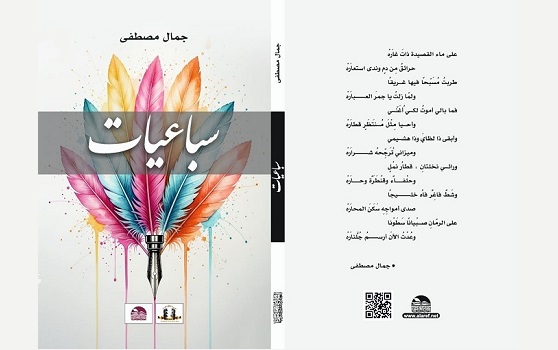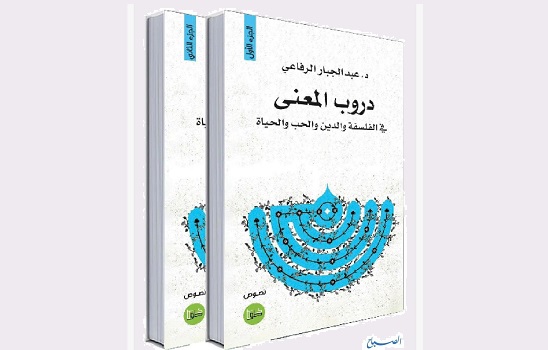قضايا
محمد سيف: الترجمة في فِعلِها التشويهي للمعرفة

مُذْ تشعّبت اللغات وتقاطعتْ مصالح الأقوام ما فتئت الحضارات تتكئ على الناقل الوسيط الذي تُجسّر به هُوّة المجهول مع الآخر، الترجمة، ومن غيرها؟! لا مَنْدوحة لنا من التأكيد على أهمية العمل الترجمي الذي ينطلق من مبدأ الاعتراف بالآخر، ويستهدف التعرُّف عليه، لتنتظم تقاطعا محوريا في المواسم الكبرى للتلاقح المعرفي، وهي سمة ملازمة ما بقيَ تعدد الحضارات بنسيجها الفُسيفسائي ثقافةً ولغةً وتموضعًا معرفيا وإنتاجا إنسانيا، فلها الفضل في مباغتة الزمن بقفزات عملاقة للأمام جرّاء الإفادة من معارف الآخرين، فالمعرفة الموضعية إقليميا - خصوصا في المناطق التي تخلّفت عن رَكْب التقدم العلمي - تتطلّب قرونا متطاولة لتصل إلى ما وصلت إليه قريناتها في الزمن!
وتبكيرًا لنقطة نظام، فإن هذا المقال لا ينتظم في نَسَق تدبيج القول في قيمة العمل الترجمي من حيث المبدأ، فهذا - فيما أرى - محلّ اتفاق، وإنما أحاول أن أُسقط البرقع عن الوجه المشوّه لحال الترجمة الراهن، وصورتها الواهنة الحالية، وأستنطق المسكوت عنه في الترجمة بما يكرّس انزياحها من الناقل المعرفي الوسيط إلى الفعل المشوّه لوجه الآخر واستجابتنا للمعرفة المبتورة المتلقّاة، وأردف ذلك بوَمَضات بما هي لَبِناتٌ مبدئية في سبيل إعادة المكانة اللائقة بها.
ولكي تكون توطئة متماسكة، دعوني أُعرّج ابتداءً على طبيعة اللغة على اعتبار أنها الحقل الذي تُعمِل فيه الترجمةُ محراثَها، كحركة بندول من اللغة المترجَم منها إلى اللغة المترجَم إليها، فاللغة هي كيان يتعالى من كونه مجرد قاموس لغوي، يضمُّ مفردات بين جنباته، إلى نسيجٍ متعدد المكوّنات تربط معيشة الناس ومصائرهم، وتعكس آلامهم وآمالهم على حدٍ سواء، فهي بحق - أي اللغة - تَناسُلٌ لتاريخ رقعة أرض بشتى مكوّناتها البشرية والمادية والمفاهيمية، وهي بهذا المفهوم في تعقيدها وحشيةٌ متعذرة على الترويض.
وبما هي كذلك فاللغة ليست مجرّد كلمات منبتة عن سياق معرفي-إنساني كامل، بل هي بنية رحبة تتعدى مجرد كونها قناة تواصلية إلى كونها أداة فاعلة لتَصوّر العالَم بل وقولبته، ينقل لنا داريوش في كتابه الهوية والوجود عن (Benjamin Lee Whorf) وهو عالم لسانيات أمريكي بارز، اشتهر بتطوير النظرية النسبية اللغوية المعروفة بـ (Sapir Whorf) وفحواها أنّ اللغة ليست انعكاسا للواقع، بل تُشكّله!: " تحكم أنماط تفكير الفرد قوانين تشكيلية عتيدة (...) كل لغة هي منظومة تشكيلية هائلة مختلفة عن غيرها، تنتظم فيها ثقافيا الأشكال والأصناف التي لا تكتفي بها الشخصية بأن تتواصل فحسب، بل تحلل كذلك الطبيعة (...) وتحدد قنوات تفكيرها وتُنشئُ مسكنَ وعيها".(1)
ولنيتشه استطرادٌ قَيّم في سياق القدرة المسحولِ حقُّها للغة على صياغة الواقع بمفاهيمه ونوعية تفاعلنا معها مِنْ ثَمَّ: "فحيثما تكون هناك قرابة لغوية، هناك بالذات، وبفضل فلسفة نحوية مشتركة - أعني بفضل سيادةٍ وسيطرةٍ لا شعورية للوظائف اللغوية المشتركة - لا بد أن تكون الأسس مهيّأة مسبقاً لتطورٍ وتعاقبٍ فلسفيّين متشابهين، في حين يبدو الطريق مسدودًا أمام أية إمكانية لتأويل آخر للعالم. وهناك احتمال كبير أن فلاسفة لغات أقاليم أورال ألْتاي حيث ظل مفهوم المسند إليه (الفاعل) في مستوى أدنى من التطور يمتلكون على الأرجح نظرة مختلفة للعالم، ولهم طرق أخرى في تأوّله غير تلك التي لدى الهندوجرمان والمسلمين؛ فالإكراه التي تمارسه وظائف نحوية بعينها هو في عمقه الأقصى إكراه تمارسه أحكام قيمية فيزيولوجية وشروط عرقيّة".(2)
ما أرمي إليه من هذا الإسهاب في البُعد الشمولي للغة هو أنه عندما نطلق مصطلح (ترجمة) فيجب ألّا يَقرّ في أذهاننا أن الترجمة هي محضُ بحثٍ عن معادل لفظي في اللغة المترجَم إليها للكلمات في اللغة المترجَم منها، بل الأمر يتعدى ذلك إلى تعيين المعادل الوظيفي لتلك المعاني في سياق ثقافة بمحدّداتها كافة، وإغفال ذلك يُظهر العمل الترجمي مادةً سطحية تشوّه أكثر مما تنقل!
نعم إنّ الترجمة قاصرة عن الوصول لحدّ مطابقة المعنى، ففي مقال سابق لي على هذه الصحيفة الغرّاء، بعنوان: كيف تشكّل اللغة أفكارنا وفقا لعلم الأعصاب اللغوي؟! أشرتُ إلى طبيعة الترجمة اللصيقة بها، والتي يصعُب استسهال انعكاساتها: "ولكن عندما نُنْعِم النظر فإنّ الترجمة لا يمكن أن تطوي مسافة اللغة؛ ولذا فالترجمة هي طبقة إضافية على اللغة الأصلية، وهي مسافة أخرى عن المعبَّر عنه من الفكرة الذهنية أو الشعور، وكلما كانت الترجمة عن لغة لا تنتمي لعائلة اللغات ذاتها كانت المسافة أكبر" ففي هذا النص أؤكد على أنّ الترجمة هي - ولا بُدّ - انزياحٌ ثانٍ للمعنى - بعد الانزياح الأول بين مسافة اللغة الملفوظة وبين الفكرة الذهنية - ضريبةً لانتقال الأفكار من لغة لأخرى، ولك أنْ تتخيل درجة تشوّه المعنى إنْ كانت اللغتان لا تنتميان للعائلة اللغوية ذاتية، ويزداد الأمر تعقيدا إنْ تعددت الوسائط الترجمية، كأنْ يُترجَم كتاب من الألمانية إلى الإنجليزية ثم من الإنجليزية إلى العربية! في انزياحٍ ثالث للمعنى، وهلمّ جرًا، فيتلقى القارئ العربي ترجمة شوهاء متعددة الأبعاد!
ولقد انتبه نيتشه لتلك الدقائق العصيّة على الترجمة، إذْ يقول: "إن أصعب ما يمكن ترجمته من لغة إلى أخرى هو النسق الذي يميز أسلوبها: وهو شيء له أساسه في الطبع الخاص بالعرق، أو بعبارة فيزيولوجية، في متوسط نسق (الأيْض) عند ذلك العرق. فهناك ترجمات حسنة النية تكاد تكون نسخًا مزورة، وابتذالا غير متعمّد للأصل، لا لشيء إلا لأن النسق الجسور والمرح، ذلك الذي يقفز فوق كل ما هو خطير في الأشياء والكلمات ويساعد على تخطّيه، قد تعذّر على الترجمة".(3) ولكن كلامنا في الحد الأدنى الذي لا بد من الأخذ به وهو استحضار النسق المعرفي العام للنص المترجم.
ومرة أخرى، الإشكال الذي نعانيه هو إشكال مفاهيمي لمفاهيم نلوكها ليل نهار، بدون أن نأخذها على محمل الجِدّ، فالترجمة - في مفهومها العريض - تأخذ عدة أبعاد، البُعد الأساسي وهو ترجمة النص، وهذا جليّ، ولكن ثمّة بُعد آخر أهم بمراحل، وهو بُعد تموضع المادة المعرفية المرشحة للترجمة في شبكة المعرفة أولويةً وأصالةً وعلاقة مع نظيراتها من المواد المبثوثة هنا وهناك، وخليقٌ بي أن أُفسح المجال لداريوش شايغان المفكر الإيراني-الفرنسي الذي سبِر التعدد الثقافي ويعي جيدا ما يتحدث عنه حين يتصل الأمر بالعمل الترجمي، إذْ يقول في كتابه النفيس، النفس المبتورة: "وبما أن الترجمات تجري، من جهة ثانية، بلا سياسة متماسكة، بلا رؤية شمولية، فإنها تقدم نفسها كأنها كتل من معارف متناغمة، يمكنها أن تسمح لنا بأن نعرف مدرسة فكرية إلى حد ما، لكنها تنتشر على شاكلة معارف متناثرة، غير مرتبطة بأي سياق خاص، تقوم بدلا من توجيه القارئ، في مجال متخصِّص، بتضليله وتشريده في متاهة العلوم الإنسانية، وهي تفتقر افتقارًا شديدًا إلى خارطة فلسفية تحدّد موقع التيارات الفكرية في إطار مناسب".(4)
إذن بُعد التموضع المعرفي مهم للغاية، فالترجمات العشوائية التي لا تلقي بالًا لأولوية متعلَّقات الأعمال الترجمية إنْ في الشبكة المعرفية العامة وإنْ في حقل خاص من الحقول، فإنّ نتاجها أقرب إلى خبط عشواء، وستهضم المجتمعات المتلقية مادةً منبتّة بِنَزَق عن شبكتها المعرفية، وغير موضوعية في النظرة الكلية، وأنه إذا ما قُصِرَت الترجمة على البُعد الأول - أي النصوص كيفما اتفق - فهو إذّاك عمل عبثي مؤذٍ معرفيا إن نظرنا إلى الصورة الإجمالية والمحصلة النهائية والمدى البعيد.
إنّ البُعد الثاني للعمل الترجمي يستلزم مَأْسَسَته - أي إنشاء مؤسسة تضطلع بمهام عمله - ليقوم بدوره المُلقى على عاتقه؛ من حيث إنها عملية واسعة تطلب تكاتف جهود أكْفاء من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، فالترجمات كالحقول المعرفية، تتطلّب تخصصا، وهذا وإنْ كان موجودا، فهو إما جهود تمشي على استحياء، وإما جهود غير ناظرة إلى جُملة الشبكة المعرفية المترامية الأطراف، والتي تتموضع فيها مادة العمل الأصلي قبل ترجمته - كما أسلفنا - إنّ إنشاء مركز للدراسات الترجمية بهذا المستوى من الالتفات الواعي سيخلق طفرة كبيرة في مجال تعرّفنا على الآخر كما هو إلى حد كبير، وكذلك عمق المعرفة الذي سنقف عليه من ناحية أخرى.
إنّ تعلّم اللغة الأخرى بما تحمله من عناصر ثقافية وتاريخية - بالتصور الذي بيّناه - هو الحل الأمثل لِلْمَتْح من معارف تلك اللغة، وتأتي الترجمة خيارا ثانيا، وخصوصا تلك المترجمة عبر وسيط ترجمي واحد، فللعربي الذي لا يحسن الفرنسية مثلا أن يقرأ كتابا مترجما من الفرنسية للعربية مباشرة وليس من الفرنسية للإنجليزية ثم للعربية، حيث تفقد المعرفة في طريق الترجمة المتعرج هذا جزءا من حمولتها الدلالية وتُشوَّه في كل منعطف لغوي! وهذا إنْ استطاع الفرد النفاذ إلى ترجمات مباشرة بطبيعة الحال، وإلا فليختر المشي على حقل الألغام إن شاء! وإن كان الفرد على دراية باللغة الإنجليزية ففي رأيي أن يقرأ العمل الترجمي من لغة أخرى للإنجليزية أولى من أن يقرأ المترجَم من تلك اللغة للعربية؛ نظرًا لكفاءة اللغة الإنجليزية معرفيا بسبب معجمها العلمي دائم التطوّر والمواكبة، وعلى كل حال فخيارات الفرد بدون تعلم اللغة المترجم منها هي خيارات شحيحة في عالمنا العربي، وعليه إن رغب في الْعَبّ من المعارف المتجاوزة زمن إقليمه أنْ يساير الحركة الترجمية العرجاء لمعارف الآخر بحذر شديد، ولْيتخيّر من بينها ما يسحبه للعمق والأسئلة الأولى، ولن يُعدم!
وخلاصة القول أنّ الترجمةَ - رغم طبيعتها القاصرة الملازمة لها كما فصّلناه آنفا - عملٌ معرفي يمثّل احتياجا لا يمكن القفز عليه، ويُزجَى شكرٌ كريم للقائمين عليه، إلا أنه في وضعه المتداعي حاليا هو ألصق بوَثباتٍ مرتجَلة منه بأن يصطفّ ضمن الأدوات المعرفية التي يمكن الرهان عليها، وحتى تنهض بواجبها المعرفي المنوط بها على أفضل وجه ممكن، يجب أن تحفّ بها عدة عوامل من المَأْسَسَة الواعية والتضلّع الثقافي - حدَّ التُّخمة - من اللغتين، المترجَم منها وإليها، وتحديد إطار فكري مدروس للمواد المترجَمة، وغيرها من العوامل التي تضمن أكبر قدر متاح ضمن الحدود البشرية من المصداقية والدقة ضمن خارطة دقيقة، وبغير ذلك فالترجمة فعل تشويهي لمعرفة الآخر؛ الأمر الذي يُلقي بظلاله البائسة على تفاعلنا مع معرفة شوهاء، إضافة إلى نوعية وحِدّة استجابتنا للآخر المتضاعفة عبر الزمن الذي يتجاوز الضعفاء!
***
محمـــد سيـــف – كاتب وباحث عُماني
........................
الهوامـــــــش
(1) الهُويّة والوجود - العقلانية التنويرية والموروث الديني، داريوش شايغان، ص29، دار الساقي، ط1، 2020.
(2) ما وراء الخير والشر، نيتشه، ص34-35، منشورات الجمل، ط1، 2018.
(3) ما وراء الخير والشر، نيتشه، ص47، منشورات الجمل، ط1، 2018.
(4) النفس المبتورة - هاجس الغرب في مجتمعاتنا، داريوش شايغان ص146، دار الساقي، ط2، 2018.