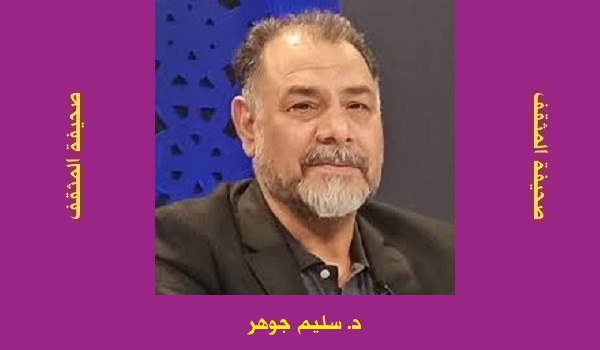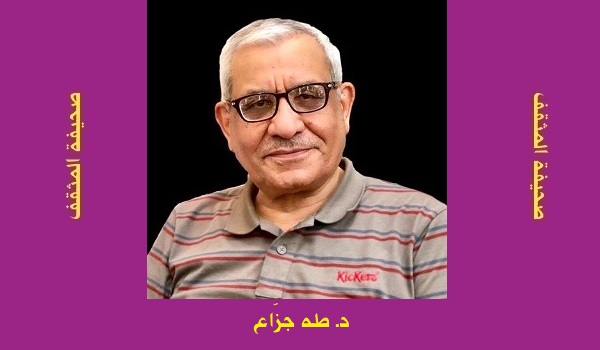قضايا
ثامر عباس: الحراك السياسي والانزياح الثقافي
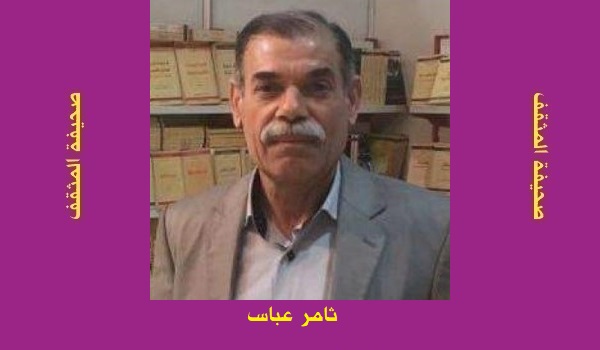
قراءة في سيرورات المدى (القصير) والمدى (الطويل)
من حسنات مدرسة الحوليات الفرنسية ذائعة الصيت، والتي استحالت لاحقا"الى مسمى آخر يدعى (التاريخ الجديد) على يد ثلة لامعة من مؤرخي تلك المدرسة العتيدة أمثال ؛ فرنان برودويل – تاريخ الحضارات، وجاك لوغوف - تاريخ القرون الوسطى، وميشيل فوفيل – تاريخ الأمد الطويل، وكريزيستوف بوميان - تاريخ البنى، وأنريه بورغيار - الانثروبولوجيا التاريخية، وفيليب إرياس – تاريخ الذهنيات، وجان – ماري بيسار – تاريخ الثقافة المادية، وجان لاكوتور – التاريخ الآني، وغي بوا – الماركسية والتاريخ الجديد، وجان كلود شميت – تاريخ المهمشين، وإفيلين باتلاجين – تاريخ المتخيل، وغيرهم . ليس فقط كونها أرخت سدولها على مجالات معرفية كانت غائبة أو مغيبة عن الحقل التاريخي، بحيث أضحى (التاريخ) بمثابة البؤرة التي تتقاطع داخلها غالبية العلوم الاجتماعية والإنسانية فحسب . وإنما أرست دعائم مقاربة جديدة لا تقتصر فقط على تحليل الظاهرة الاجتماعية المعنية من منظور منهجية واحدة، بقدر ما تضعها في بؤرة تقاطعات عديد من المنهجيات التي من شأنها (تعرية) الظاهرة المعنية من جميع الأغطية التي تحجب عن الباحث رؤية المصادر الخفية التي تكونت على أساسها، والكشف عن السياقات المهملة التي تمخضت عنها، وإماطة اللثام عن المئالات المتوقعة التي ستنتهي إليها .
ولعل من جملة الايجابيات والحسنات التي ابتدعتها هذه المدرسة العريقة في مجال تحليل السيرورات التاريخية المرتبطة بالظواهر الاجتماعية والإنسانية، هي اعتمادها عملية (التحقيب الافتراضي) لتلك السيرورات، وذلك بتقسيمها الى مديات زمنية مختلفة من حيث (السياقات) ومتعدد من حيث (الآماد) . بحيث لم تعد قراءة تاريخ الظاهرة المعنية منوطة بفترة زمنية يمكن الاستدلال عليها برقم زمني معين مثل (القرن الرابع عشر أو السادس عشر)، أو بتوصيف نوعي محدد (قديم – وسيط – حديث) كما كان يجري في المقاربات والقراءات التقليدية السابقة، وإنما بات التحقيب يتم على أساس ما تشتمل عليه الظاهرة قيد البحث أو الدراسة ذاتها من خصائص فريدة، فضلا"عن طبيعة ما تقيمه من علاقات، ومستوى ما يتخللها من تفاعلات مع بقية الظواهر الأخرى . وهو الأمر الذي أفضى الى أعادة النظر والتفكير بالكثير من المفاهيم والتصورات والاستنتاجات، التي سبق وإن جرى التواضع على معانيها والتوافق على دلالاتها بكيفيات لا تخلو من سلبيات (التفريط) في التقييم الموضوعي و(الإفراط) في التعميم الافتراضي .
وهكذا فقد أتاحت لنا هذه المنهجية المبتكرة مقاربات مركبة ومعمقة تستهدف ؛ الكيانات الجغرافية، والسرديات التاريخية، والبنى الاجتماعية، والأنساق الثقافية، والأعماق السيكولوجية، والشيفرات الرمزية، بصورة تختلف جذريا"عما كانت المنهجيات السابقة (التقليدية) تتبناه وتمارسه أثناء تحليل الظواهر وتفسير المعطيات . إذ لم يعد يكفي – بموجب هذه المنهجية - النظر الى الظواهر الاجتماعية أو الأحداث السياسية أو التحولات الثقافية أو الانزياحات القيمية، باعتبارهما حصيلة أوضاع وظروف الواقع (المعيش) وما يكتنفه من خلافات سياسية، وانقسامات اجتماعية، وصراعات إيديولوجية، وإشكاليات تاريخية فحسب . وإنما يستلزم التعاطي معها من منطلق كونهما نتاج خلفيات تاريخية متقادمة، ومرجعيات حضارية متراكمة، وتشكيلات اقتصادية متناضدة، وأصوليات سوسيولوجية متداخلة . كما أن هذه المنهجية استوجبت مراعاة الفوارق النوعية ليس فقط بين البنى والأنساق والأنماط ذات (الأمد القصير) أو (الأمد المتوسط) أو (الأمد الطويل) فحسب، بل وكذلك مراعاة الاختلافات النوعية بين تلك البنى والأنساق والأنماط على صعيد (التسارع) أو (التباطؤ) في الديناميات والجدليات التي تتحكم في إيقاعات تطورها أو نكوصها .
وبضوء هذه المنهجية التاريخية المثمرة، لم يعد صعبا"على الباحث تفسير ظاهرة (الركود) الثقافي و(الجمود) المعرفي التي لا تبرح تستوطن المجتمع العراقي لتفاقم من مشاكله المستعرة، وتراكم من إشكالياته المستعصية . هذا على الرغم من خضوعه لعقود من التغييرات السياسية، والتحولات الاجتماعية، والتبدلات الاقتصادية التي تمخضت عن / وترتبت على تلك المشاكل والإشكاليات، وهو الأمر الذي وصم جماعاته ومكوناته بالتخلف الاجتماعي المزمن والانحطاط الحضاري المتوطن . ذلك لأن من طبيعة العامل السياسي وقوعه ضمن إطار زمنية (الأمد القصير) المتسارعة نسبيا" في حراكها وتطورها، إذا ما قورنت بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تصنيفها ضمن إطار زمنية (الأمد المتوسط)، والتي عادة ما تعكس عناصرها حراكا"(أبطأ) في تكوين تشكيلاتها وبناء علاقاتها وتفعيل مؤثراتها، مما يمكن ملاحظته في إطار الزمنية الأولى (القصيرة المدى) المتسارعة من جهة، ولكنها، من جهة أخرى، تبدو – إذا ما قورنت بالعامل الثقافي الذي يصنف ضمن إطار زمنية (الأمد الطويل) – أسرع في حراك عناصرها وانتشار تأثيرها . أي بمعنى ان عمليات التغير والتطور المتوقع حصولها ضمن إطار العامل (الثقافي) لا يمكن ملاحظتها أو الإحساس بها إلاّ عبر آماد زمنية متطاولة ربما تمتد على مساحة (قرون) متعددة، أما بالنسبة لعمليات التغير والتطور التي يتوقع حصولها ضمن إطار العوامل (الاجتماعية والاقتصادية)، فالمرجح أنه يمكن ملاحظتها أو الإحساس بها خلال عدة (عقود) . هذا في حين يمكن رصد الأحداث (السياسية) وتشخيص الوقائع المرتبطة بها، عبر عدد من (السنين) التي تتراوح ما بين العقد أو العقدين على أكثر تقدير .
ومن هذا المنطلق، يتوجب على الكتاب والباحثين والأكاديميين فهم وإدراك حجم الصعوبات والمعوقات والتحديات التي سيكون عليهم مواجهتها والانغمار في أتونها، في حال حملتهم (وطنيتهم – عراقيتهم) على تبني خيارات التغيير السياسي والتطوير الاجتماعي والتنوير الثقافي، التي ينشدون حصولها لهذا المجتمع المفكك والمتهالك الذي مزقته الحروب وفرقته الصراعات وذررته الكراهيات .
***
ثامر عباس – باحث عراقي