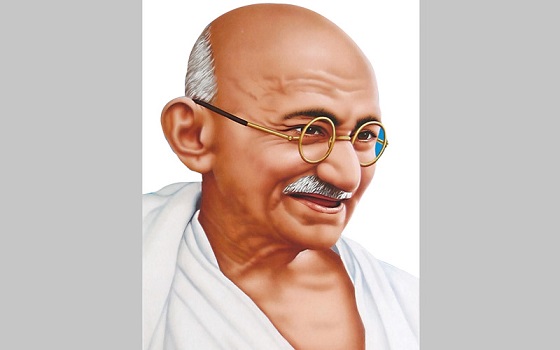قضايا
عبد الله الفيفي: الثقافة في السُّعوديَّة.. رُؤى مستقبليَّة (1-2)

إنَّ الأدب في المملكة العَرَبيَّة السُّعوديَّة هو امتدادٌ للتراث الأدبي العَرَبي الذي منبعه الجزيرة العَرَبيَّة. وقد نشأ في بداية العهد السُّعودي شِعرًا، وجاء وريث عصور انحدار العَرَبيَّة وآدابها في القرون الوسطى الإسلاميَّة؛ فكان عليه أن يتخلَّص تدريجيًّا من ذلك الإرث الثقيل. فاتجه إلى الإحياء، محاكيًا عصور العَرَبيَّة الزاهيَّة، منذ العصر الجاهلي إلى العباسي. وامتزج لدى بعض الشِّعراء نزوع الإحياء بتقاليد القصيدة البديعيَّة التي سادت خلال القرون الهجريَّة من السابع إلى الثاني عشر. على أنَّ منهم من طوَّر أسلوبه، ليرتقي من وهدة التراث بتقاليده إلى ضروب من الجِدَّة. لكنَّ الشاعر ظلَّ، في طَور ما يمكن أن يُسَمَّى مرحلة الإحياء، مقلِّدًا، لا أكثر، بلا مذهب اجتماعي ولا فني، يحذو حذو هذا الشاعر القديم تارةً وذلك تارة.
ثمَّ جعل الشِّعر يُراوح بين محيٍ لديباجة الشِّعر التقليديَّة، المتعلِّقة بمفهوم عمود الشِّعر، وآخَر حاول إدخال بعض قضايا العصر المستجدَّة. فكان من أعلام الطائفة الأولى: محمَّد بن عبدالله بن عثيمين، وأحمد بن إبراهيم الغزَّاوي، ومن الأخرى، أمثال: حمزة شحاتة، وحسين سرحان، وطاهر زمخشري، وحسين عرب، وخالد الفرج، وعبدالله بن خميس، ومحمَّد بن علي السنوسي. ويدخل في هذا التيار من حيث بناء القصيدة أولئك الشُّعراء المتأثِّرون بالشِّعر الحديث في مِصْر والشام والمهجر، ولا سيما بمدرسة أبولو في مِصْر، مثل: محمَّد حسن فقي، وعبدالله الفيصل، ومقبل العيسى، وأضرابهم.
ثمَّ جاءت موجة التجديد، وشِعر التفعيلة: محمَّد حسن عواد، وحسن عبدالله القرشي، ومن تلاهم حتى وقتنا الراهن.
على أنها بدت ملامح التطوُّر في قصيدة الحداثة خلال العِقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين واعدةً بآفاق مستقبليَّة أكثر نضجًا وتخلُّصًا من عثرات المراحل الانتقاليَّة التي مرَّت بها، إبَّان السبعينيَّات والثمَّانينيَّات من القرن الماضي. وبالرغم من أنَّ التحوُّلات النوعيَّة ظلَّت وئيدةً، فإنَّ الاستقراء يشير إلى أنَّ القصيدة الحديثة ما زالت في طريقها إلى عهدٍ جديد، يُنبئ عن انصهار التيارات في تيارٍ جديد، كنتُ قد أطلقتُ عليه (الحداثة الأصيلة، أو الأصالة الحداثيَّة).
-2-
أمَّا في ميدان النثر الأدبي، فمن الملامح اللَّافتة أنْ بدا أحيانًا ما يُسمَّى (القِصَّة القصيرة جِدًّا) (قصيدة نثرٍ في قِصَّة قصيرة جِدًّا)، أو( قِصَّة قصيرة جِدًّا في قصيدة نثرٍ)، في تزاوجٍ يجعل الفارق بين هذين النوعين شفَّافًا جِدًّا، حتى لا يكاد يميِّز القِصَّة القصيرة جِدًّا سِوَى التزامها حكائيَّة ما، في حين لا يلزم ذلك قصيدة النثر. فكما أن بعض الشِّعر لا يميِّزه عن النثر سوى الإيقاع- والإيقاع وحده ليس ما يمنح الشِّعر شِعريَّته الكاملة، وليس فقدانه هو ما يمنح النص نثريَّته بالضرورة، وإنما الإيقاع عنصر فارق للشِّعر- كذلك يلزم أن تكون الحكائيَّة عنصرًا مائزًا لكلِّ ما يندرج تحت اسم «قِصَّة»، طالتْ أم قصرت.
وكذلك بدا توالج الشِّعريِّ بالروائيِّ، لينشأ بينهما ما وَسَمْتُه في بعض دراساتي بمصطلح «القصيدة-الروايَّة». وإذا كان التداخل بين الشِّعريِّ والسرديِّ معدودًا في الكتابات المعاصرة من جملة التقنيات التعبيريَّة الحداثيَّة، أو ما بعد الحداثيَّة، فإنَّ لذلك أسبابًا شِعريَّة عَرَبيَّة تجعل العوامل مضاعفة في بروز هذه الظاهرة في السياق العربي. بيد أنَّ الأمر يزداد حِدَّةً إشكاليَّةً حين يكتب النصَّ السرديَّ شاعرٌ ذو تجربة لافتة، فيتمخَّض عمله عن شكلٍ كتابيٍّ ملتبس الهويَّة، يقع في منطقة برزخيَّة بين نوعين أدبيَّين (الشِّعر والروايَّة)، جديرةٍ بأن تُعطَى تسميتها المائزة، المتَّفقة مع طبيعتها الخاصَّة. ويأتي هذا الشكل الكتابي نتاجًا حداثيًّا، تنطمس فيه الفروق بين الأجناس الأدبيَّة، حيث بات الشِّعر يتقمَّص النثر، منذ: تي. إس. إليوت T. S. Eliot، وإي كامنجز Ee Cummings، كما يتقمَّص النثر الشِّعر، مثلما هي الحال عند: فرجينيا وولف Virginia Woolf، أو جيمس جويس James Joyce، أو نيكوس كازانتزاكي Nikos Kazantzaky. والروايات اليوم- كما يشير الشاعر المكسيكي (أوكتافيو باث Octavio Paz)- تنزع عمومًا إلى التحوُّل أكثر فأكثر إلى تشكيلات لفظيَّة، غير كثيرة الاختلاف عن بِنَى الشِّعر، كما تستعيد القصيدة لدَى بعض الشِّعراء النَّفَس الملحميَّ، فتقترب من الروايَّة.
وبهذا، فإذا كانت الروايَّة قد جاءت في العصر الحديث وريثة الملحمة الشِّعريَّة- التي كانت هي «القصيدة-الروايَّة»، في صيغتها العتيقة- فإن (القصيدة-الروايَّة) اليوم، في صيغتها الجديدة، تأتي بمثابة ارتدادٍ إلى نوعٍ من جنسٍ أدبيٍّ مهجور، هو الملحمة. غير أنَّ (القصيدة-الروايَّة) الجديدة، تتخلَّص من حِدَّة الحضور ذي الوجود الكامل لكلا الجنسين- الشِّعري والروائي- كي تُنشئ نمطًا جديدًا من التماهي بينهما، وإنْ كانت كفَّة الشِّعري فيها تميل إلى الرُّجحان. وهذا ما يدعو إلى تسميَّة النص بـ(قصيدة-روايَّة) لا بـ(روايَّة-قصيدة).
تلك ملامح عجلَى من مراحل تطوُّر الأدب السعودي حتى وقتنا الراهن.
-3-
على أنَّ الرؤية المستقبليَّة تحدو الأمل إلى تفعيل الثقافة- وفي جوهرها الأدب- لتأخذ دَورها الحضاري محلِّيًّا وعالميًّا؛ فليس من المقبول أن تكون المملكة العَرَبيَّة السُّعوديَّة، بتاريخها الضارب في الذاكرة الإنسانيَّة على هامش الثقافات، أو أن تتعامل مع الثقافة رديفةً لشؤون أخرى. وليست الثقافة بمهرجانات ملوَّنة، واحتفاليَّات يُدعَى لها الأصفياء، وليست بأضواء إعلاميَّة، وتوقيع كتب، وتغريدات «إكس»، وعلاقات عشائريَّة في زمن الثورة المعلوماتيَّة. إنَّها- كما ينبغي لها أن تكون- ثقافة الأرض التي تمثِّل أرض الإنسان الأوَّل، ثمَّ التي تمثِّل أرض العروبة والإسلام الأُولى، بآثارها، وتاريخها، وفنونها وآدابها، الجديرة بأن تكون في صدارة ثقافات العالم. ذلك أنها ثروةٌ أهم من النفط، حتى على المستوى الاقتصادي، بوصفها مادة الاقتصاد المعرفي الأُولى، ورافدة الاقتصاد العام. وكما أقول دائمًا: لقد آنَ التنقيب عن ثقافتنا وآثارنا وتقديمها إلى العالم، في القرن الحادي والعشرين، كما كان التنقيب عن الثروات المعدنيَّة في القرن الماضي. بل إنَّ ثروة المملكة في مجال الثقافة والآثار أهم من ثروتها النفطيَّة، وأبقى؛ فهي الماضي والحاضر والمستقبل. ومنذ إنشاء وزارة باسم (وزارة الثقافة)، واستقلالها عن (وزارة الإعلام)، استجابةً لمطالبات متكررة بذلك، والأمل معقود عليها لتحقيق الآمال الثقافيَّة التي أُنشئت من أجلها.
إنَّ الأدب- من حيث هو- قائم ونشط وفاعل، منذ نشوء المملكة. والأدباء الحقيقيُّون كثر. ذلك أن الجزيرة العربيَّة تاريخيًّا هي منبع اللُّغة العَرَبيَّة وآدابها، وهي في العصر الحديث حافلة بالشُّعراء والكتاب والمثقفين والمفكرين. ويأتي تفعيل هذه الواجهة الحضاريَّة الخصبة وتنظيمها، بوصفها رافدًا رئيسًا من روافد التنميَّة وبناء الإنسان، وهي من أهم محرِّكات التحول الوطني إلى المستقبل، وتحقيق رؤية 2030. ذلك أنَّ من ركائز القوَّة الأُولى في رؤيَّة المملكة 2030: الاهتمام بالعُمق العربي والإسلامي. ومن توجُّهات المحور الأوَّل في الرؤيَّة، الذي يدور حول حيويَّة المجتمع: دعم الثقافة، وبناء الشخصيَّة. وفي الأهداف الاستراتيجيَّة لهذا المحور يأتي تعزيز القِيَم الإسلاميَّة والهويَّة الوطنيَّة. وذلك من خلال المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، والعنايَّة باللُّغة العَرَبيَّة. ومن ضمن الأهداف الاستراتيجيَّة كذلك: تمكين حياة عامرة وصحيَّة، بوسائل منها: دعم الثقافة والترفيه، ومن ذلك تنميَّة المساهمة السُّعوديَّة في الفنون والثقافة. ومعلومٌ أنَّ الأدب يُعَدُّ القاسم المشترك الأعظم بين تلك الأهداف الاستراتيجيَّة لمحور حيويَّة المجتمع، بالنظر إلى موقعه الجوهري في بناء القِيَم والهويَّة، وكونه وعاء اللُّغة والتراث والثقافة، وهو فوق ذلك بمثابة الأب للفنون الأخرى، قديمًا وحديثًا. فمن نافلة القول أنَّ إيلاء الأدب ما يستحق من رعايَّة، ودعم الأدباء، وتنظيم شؤونهم من خلال جهاز مرجعي واحد، هو من آليَّات العمل الأساس لتحقيق برامج رؤية 2030.
غير أنَّ ثمَّة نقاط قصور، أراها ما زالت قائمة دون تحقيق الرؤيَّة الثقافيَّة. فبالرغم من أنَّ الأديب منذ ارتضى الأدبَ حرفةً، يدرك أنَّ «حرفة الأدب ستُدرِكه»، ولذا فما ينبغي أن يعوِّل في حِراكه الإنتاجي على آخَر، غير أنَّ هناك جوانب تنظيميَّة، وأبعادًا إنسانيَّة، يؤمَّل أن يكون للجهاز التنظيمي دورٌ مهمٌّ في رعايتها ودعمها وتنميتها.
ونفصِّل القول في مقال الأسبوع المقبل، بعون الله.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي