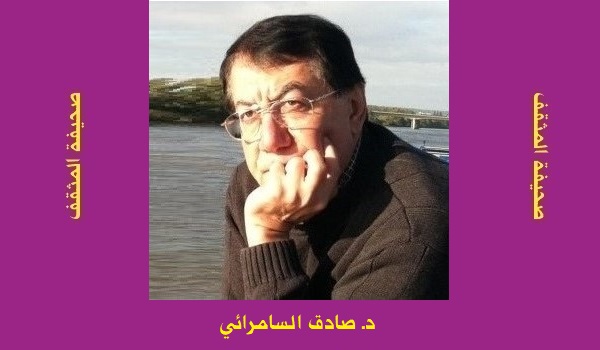شهادات ومذكرات
عبد السلام فاروق: مكتبات الراحلين.. قصص وحكايات تدمي القلوب!

ما إن يغمض كاتب عينيه للمرة الأخيرة حتى تبدأ رحلة العذاب لمكتبته التي كانت يوما ما قبلة للفكر ومعبدا للحرف. لا تنتظر الكتب طويلا حتى تساق كالغنائم إلى ساحة المزاد العلني أو تلقى في زوايا الإهمال كأوراق بالية. هنا في هذا المشهد المفارق تتحول المكتبة من "ميراث" إلى "متعة" بائسة تقاسمها الأرقام والهمهمات. الورثة لا يقرأون والزوجة لا تعرف الفرق بين "الأيام" لطه حسين و"كشكول" البقال. يكفي أن تلمح نظراتهم المتعجلة إلى تلك الجدران المليئة بالكتب لتفهم أنهم ينتظرون لحظة التخلص منها كأي كراكيب عفا عليها الزمن!
لا تلوموا الأبناء إن باعوا مكتبة والدهم بأقل من ثمن "آيفون" جديد. فجيل "الفيديوهات المضحكة" لا يرى في الكتب إلا حبرا على ورق أو ربما "ديكورا" قديما يصلح لتصوير السيلفي! إنهم أبناء "اللايكات" والشيرات" يبحثون عن المعرفة في 15 ثانية ويختزلون الحكمة في مقطع صوتي. الكتب عندهم كالمشي على الأقدام في زمن السيارات الطائرة: بطيئة مملة غير مجدية. وما العيب فيهم؟ العيب فيا نحن الذين لم نعلمهم أن الكتاب ليس مجرد حروف بل هو بصمة إنسان وروح معلقة بين السطور.
خردة ثقافية!
إذا كان بائعو الخردة يفرحون بشراء المكتبات فذلك لأنهم يدركون قيمتها أكثر من الورثة! هؤلاء الذين يهرولون لتحويل الكتب إلى "ورق مقوى" يباع بالكيلو. مشهد يختصر مأساة حضارية: أمة كانت توقر الحرف صارت تبيعه في سوق النخاسة. كل كتاب يرمى في سيارة الخردة هو إعلان عن انهيار سلم قيم بأكمله. فما قيمة شعب لا يحفظ تراثه الفكري؟ وما قيمة مدينة تتحول مكتباتها إلى "وليمة" للفئران والعث؟
أن تموت مرتين!
الألم الدامي الموجع ليس في موت الكاتب بل في موت مكتبته. فالكاتب قد يموت مرة لكن مكتبته تموت ألف مرة: حين تغلق الأدراج وتقطع الأغلفة وتسحق الهوامش التي كتبت بخط يده. إنها جريمة بحق الإنسانية أن تتحول مكتبة عاش صاحبها عمره يجمعها إلى "خردة". وكأننا ننزع من التاريخ صفحاته ونرميها في سلة المهملات. أليس هذا هو الموت الحقيقي للثقافة؟ أن تتحول الكتب إلى مجرد أرقام في فاتورة بيع!
مقترحات لإنقاذ ما تبقى!
1. "وصية المكتبة": أن يفرض القانون على الكتاب تضمين وصيتهم مصير مكتباتهم سواء بالتبرع لها لجامعات أو تحويلها إلى متاحف خاصة. فكما يورثون العقار يجب أن يورثون الفكر.
2. "بنك الكتب": مؤسسات ثقافية تتبنى شراء مكتبات الموتى وحفظها كتراث عام بدلا من تركها لعشوائية السوق.
3. التعليم قبل التوريث: تثقيف الأبناء بأهمية المكتبات في حياة آبائهم وتحويلها إلى جزء من الذاكرة العائلية لا مجرد رفوف.
4. مشروع "هذا الكتاب كان لـ…": توثيق ملكية الكتب بملصق صغير على الغلاف يحكي قصة لتحويلها من "شيء" إلى "سيرة".
قد نضحك ساخرين من جيل يلهو بالهواتف لكننا نحن من سمحنا بتحويل الكتب إلى جثث. الثقافة لا تموت حين يموت حاملوها بل تموت حين نرفض أن نكون جسرا بين الماضي والمستقبل. فليبدأ كل منا بإنقاذ كتاب واحد من سلة المهملات ولنعلم أبناءنا أن "الواي فاي" لا يغني عن مكتبة. لأن الأمم التي تبيع كتبها كالخردة تخبر التاريخ أنها استحالت خردة هي الأخرى.
لا عجب أن تتحول مكتبة الأمس إلى "مزاد اليوم" فالعصر الجديد لا يعرف الانتظار. جيل يعيش على "الديليفري" حتى في تلقيه للمعرفة: يريد كل شيء فورا مختصرا معلبا في رسالة صوتية أو منشور إنستجرام. الكتب الطويلة؟ إنها كالوجبة التي تحتاج ساعات للطهي بينما هم تعودوا على "البرجر" الثقافي: سريع لذيذ بلا عناء المضغ! لكنهم لا يدركون أنهم يتبنون "ثقافة الوجبات السريعة" التي تشبع الجوع العاجل وتجوع الروح على المدى البعيد.
المكتبات كالكهوف: لماذا يخافون من الظلام؟
الكتب مرايا تظهر للقارئ عوراته الفكرية وتشعره بضالته أمام تراكم الحضارات. لهذا يهرب الورثة منها كهارب من ظله! ليست المشكلة في أنهم لا يقرأون بل في أنهم يرفضون مواجهة أنفسهم. الهواتف النقالة تمنحهم الوهم بأنهم "أسياد الكون" بينما الكتب تذكرهم بأنهم مجرد نقطة في بحر الزمن. هل نلومهم إن فضلوا الهروب إلى الواقع الافتراضي حيث يمسكون بدفة المعرفة المزيفة بدلا من أن يبحروا بسفن الأجداد الهشة في محيطات الحكمة؟
في بعض البيوت تتحول المكتبات إلى ديكور يشار إليه بالبنان: "هذه الكتب كانت لوالدي العبقري!" لكن أحدا لا يجرؤ على فتحها كي لا يبعثر الغبار! إنها مهزلة أن تتحول المكتبة إلى "بورتريه" ورثوه مع الأثاث العتيق بينما جوهرها-كالأشباح-يطارد بالمكناس الكهربائية. هكذا تختزل الثقافة في صورة على الإنستجرام ويدفن الفكر تحت وطأة النظرات الإعجابية الزائفة.
الجهل وحده لا يكفي لقتل المكتبات بل اللامبالاة هي السلاح الأشد فتكا. فما يحدث ليس مجرد "بيع كتب" بل خيانة لعهد غير مكتوب بين الأجيال. الكاتب الذي جمع مكتبته حجرا حجرا كأنه يبني هيكلا لعبادة العقل يأتي من بعده من يهدمه بكل برود. والكارثة أن الورثة لا يشعرون بالذنب؛ لأن الجريمة تتم في وضح النهار وبموافقة المجتمع الصامت!
قد يقول البعض: "لماذا الندب على ما فات؟ لننشغل بإنقاذ ما تبقى!". لكن السؤال الجوهري: هل ما زال لدينا ما ينقذ؟
- لو كانت المكتبات تباع في المزادات فلنحولها إلى "مكتبات شوارع" كي يقرأها المارة كالمنشورات.
- لو كان الورثة جاهلين فلنفرض عليهم "ضريبة ثقافية" تحول قيمتها لشراء الكتب ونشرها في الأحياء الفقيرة.
- لو تحولت الكتب إلى خردة فلنصنع منها تماثيل في الساحات العامة كشواهد على زمن أحرقناه بأيدينا!
الثقافة ليست أوراقا بل نبض يسري بين السطور. والكتب لا تموت حين تحرق أو تباع بل تموت حين ننسى أننا لسنا أول من عاش ولا آخر من سيأتي. في كل كتاب ترمى سيرة إنسان وفي كل مكتبة تنهب تغرق جزيرة من ذاكرة البشرية. ربما يأتي يوم نبحث فيه عن كتاب ضائع فنكتشف أننا كنا نبحث عن جزء منا أهديناه لسيار الخردة!
قد ننجو من الجوع ومن الأوبئة ومن الحروب لكننا لن ننجو من جوع العقل. فالأمم التي تتنكر لكتبها كالابن العاق تحكم على نفسها بالانقراض الأخلاقي. فليكن "رداء الثقافة" الذي نورثه لأبنائنا أثقل من ذهب وأوسع من عقارات. لأن الحضارات لا تقاس بمساحة الأراضي بل بمساحة العقول التي تحفظها.
***
عبد السلام فاروق