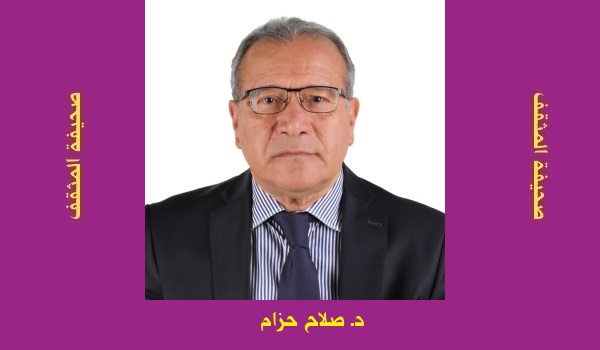أقلام فكرية
سلوى بنأحمد: الدّين بين الفلسفة والعلم.. رحلة التّوتر والتّكامل

منذ فجر الحضارة، شغل ثلاثيّة الدّين والفلسفة والعلم حيّزا مركزيّا في سعي الإنسان لفهم العالم والوجود، حيث تتقاطع هذه المجالات الثّلاثة في محاولتها للإجابة عن الأسئلة الكبرى المتعلّقة بالكون والحياة والمصير الإنساني، ومع ذلك، فقد شهدت هذه المجالات على مر العصور صراعات وتوتّرات، بالإضافة إلى فترات من التّكامل.
الدّين والفلسفة: البحث عن الحقيقة
إنّ نقطة التقاء الدّين والفلسفة هي السّعي نحو الحقيقة، وإن اختلفا في المنهج والأدوات، فالدّين يقدّم رؤية شاملة للكون والحياة، ويستند إلى الوحي والإيمان كأساس للمعرفة، بينما تعتمد الفلسفة على العقل والمنطق في استكشاف الوجود، وتسعى إلى فهم العالم من خلال التّفكير النّقدي والتّحليل.
يقول ابن رشد في كتابه فصل المقال "فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النّظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصّانع"1، وهذا يعكس وجهة نظر ترى أنّ الفلسفة يمكن أن تكون وسيلة لفهم الدّين وتعزيزه، وليس بالضرورة معارضته.
غير أنّ التّاريخ قد شهد صراعات بين الفلاسفة ورجال الدّين، والتّي غالبا ما كانت تنشأ بسبب اختلاف وجهات النّظر حول طبيعة الحقيقة ومصادر المعرفة، فقد اتّهم الفلاسفة بالإلحاد والزّندقة، بينما اتّهم رجال الدين بالجمود والتّعصب، لكن في المقابل كان هناك البعض من رجالات الفلسفة الذّين حاولوا التّوفيق بين الدّين والفلسفة، مثل ابن سينا وابن رشد، الذّين سعوا إلى إظهار أن العقل والإيمان يمكن أن يتعايشا ويتكاملا.
الدّين والعلم: من الصّراع إلى الحوار
العلاقة بين الدّين والعلم شهدت تحوّلات كبيرة في فترات كثيرة، من الصّراع إلى الحوار والتّكامل في العصور الوسطى، حيث كان العلم في كثير من الأحيان خاضعا لسلطة الكنيسة التّي اعتبرت أنّ المعرفة الدّينيّة هي المصدر الأساسي للحقيقة، وهو ما أدّى إلى قمع بعض الاكتشافات العلميّة التّي تعارضت مع العقيدة الدّينية، نذكر في السّياق الكنيسة الكاثوليكيّة في أوروبا وما كانت تتمتع به من سلطة كبيرة، وحيث أنّها كانت تعتبر الكتاب المقدّس المصدر النّهائي للمعرفة فإنّ أي اكتشافات علميّة تتعارض مع تفسير الكنيسة للكتاب المقدس هو هرطقة تُواجه بالقمع ومنه قضية غاليليو غاليلي الذّي أُجبر على التّراجع عن آرائه، وتمّ وضعه تحت الإقامة الجبريّة لأنّه دافع عن نظريّة مركزيّة الشّمس (أنّ الشّمس هي مركز الكون)، والتّي تعارضت مع وجهة نظر الكنيسة القائلة بأنّ الأرض هي مركز الكون2.
لقد كانت العديد من الاختصاصات تحت سلطة الكنيسة حتّى الطّب الذّي كان يُمارس غالبا من قبل رجال الدّين الذّين كانوا يعتقدون أنّ المرض هو عقاب من الله، وأنّ الشّفاء يمكن أن يتحقق من خلال الصّلاة والتّوبة، ومع تطوّر العلم، بدأ الأطبّاء في استخدام الملاحظة والتّجربة لفهم الأمراض وعلاجها.
في وقت ما أدّت نظريّة التّطور لداروين مثلا إلى جدل كبير بين العلم والدّين، وقد اعتقد البعض أنّ هذه النّظريّة تتعارض مع قصّة الخلق في الكتاب المقدّس، ومع ذلك، قبل بها العديد من العلماء ورجال الدّين، معتبرين أنّها طريقة لفهم كيفيّة خلق الكون.
ومع ظهور عصر النّهضة وعصر التّنوير، بدأ العلم في التّحرر من قيود الدّين، واكتسب استقلاليّته، بعد صراع عميق بين من يمثّل العلم ومن يمثّل الدّين، حيث اتّهم الطّرف الأوّل الدّين بالخرافة والجهل، واتهم الطّرف الثّاني العلم بالتّهديد للإيمان والأخلاق. لكن في العصر الحديث، بدأ الحوار بين العلم والدّين، حيث أدرك كل منهما أهميّة الآخر، فالعلم يوفر لنا فهما أفضل للعالم من حولنا، بينما يوفر الدّين لنا القيم والأخلاق التّي توجّه السّلوك، يقول أينشتاين "العلم بدون دين أعرج، والدّين بدون علم أعمى"3، وهذا يعكس وجهة نظر ترى أنّ العلم والدين يمكن أن يكمّلا بعضهما البعض، وأن كُلاّ منهما ضروري لفهم العالم والإنسان.
نقاط الالتقاء والاختلاف:
تتلاقى الفلسفة والدّين والعلم في السّعي نحو فهم العالم والإنسان، ولكنّها تختلفان في المنهج والأدوات، فالفلسفة تعتمد على العقل والمنطق، والدّين يعتمد على الوحي والإيمان، والعلم يعتمد على الملاحظة والتّجربة.
وعليه، تكمن نقاط الالتقاء في السّعي نحو الحقيقة، وطرح الأسئلة الكبرى حول الوجود والحياة والمصير الإنساني.
أمّا نقاط الاختلاف فتكمن في المنهج والأدوات، وفي طبيعة الحقيقة التّي يسعون إليها، فالفلسفة تسعى إلى الحقيقة من خلال التّفكير النّقدي والتّحليل، والدّين يسعى إلى الحقيقة من خلال الإيمان والوحي، والعلم يسعى إلى الحقيقة من خلال الملاحظة والتّجربة.
وبناء على ما سبق، العلاقة بين الدّين والفلسفة والعلم معقّدة ومتشابكة، وتشهد على الدّوام تحوّلات وتطوّرات، فالدّين والفلسفة والعلم ثلاثة مسارات مختلفة في سعي الإنسان لفهم العالم والوجود، وعلى الرغم من التّوترات والصّراعات التّي شهدتها هذه المجالات عبر التّاريخ، إلاّ أنّها يمكن أن تتعاون وتتكامل، وأن تساهم في إثراء المعرفة الإنسانيّة وتعزيز الوعي بالذّات والعالم.
***
د. سلوى بنأحمد - باحثة في علم الكلام وقضايا الإرهاب والتّطرّف / جامعة الزّيتونة - تونس
........................
1- القرطبي، ابن رشد، فصل المقال، تح محمّد عمارة، دار المعارف، ط2/ دت، ص22.
2- مينوا، جورج، الكنيسة والعلم، دار الأهالي، دمشق، ط1/ 2005، ص 547.
3- صديقي، عبد اللطيف، المسألة الدينية عند آينتشاين، منشورات الاختلاف منشورات ضفاف، ص 19.