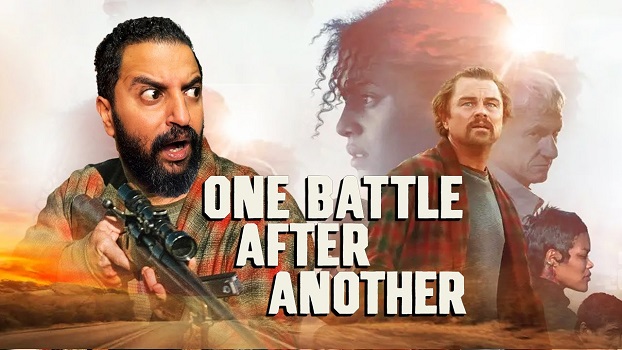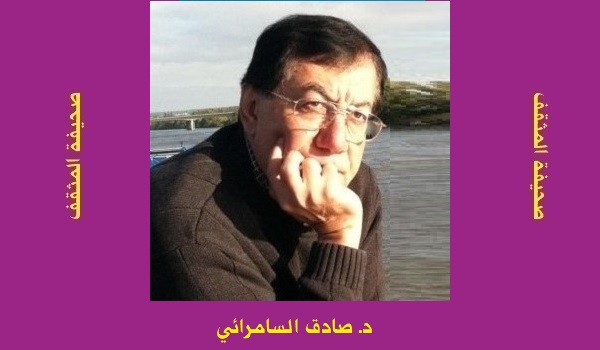قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: تجليات الجسد والروح.. قراءة هيرمينوطيقية رمزية

في البنية النفسية والرمزية لقصيدة "نشيد الخيول" للشاعرة ناديا نواصر
تعتبر قصيدة نشيد الخيول من النصوص التي تتلبّس بشعرية الكشف والوله والاحتراق الداخلي، وتستدعي قراءة نقدية تتجاوز المستوى الحسي إلى الأبعاد الرمزية والنفسية والإيروسية والروحية.
تمثّل قصيدة نشيد الخيول التي مطلعها «جئتك في المساء المكتظ بغربتي» تجربةً شعريةً تتجاوز حدود البوح العاطفي إلى تخوم الكشف الوجودي والوجداني، حيث تمتزج في نسيجها اللغة بالوجدان، والعاطفة بالرمز، والرغبة بالمعنى. إنها قصيدةٌ تكتبُ الذاتُ فيها حضورها عبر غيابها، وتبحث عن خلاصها في الآخر بوصفه مرآةً للكينونة لا مجرّد موضوعٍ للحب أو الشهوة.
في هذا النص، تتجلّى الأنثى في صورة كونية تتماسّ مع عناصر الخلق الأولى: الماء والنار والضوء والرماد، لتصبح العلاقة بين الأنا والآخر فعلاً من أفعال التكوّن والانبعاث. فـ"المساء المكتظ بالغربة" ليس ظرفاً زمانيّاً بل حالة وجودية تضع الذات في مواجهة عزلتها، والرحلة نحو "الصدر المؤثّث بالنشيد الحر" ليست لقاءً حسّيّاً، بل عودةٌ رمزية إلى المأوى الأول، إلى الطمأنينة الكونية التي تنبثق من رحم العشق والمعنى.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، تُقرأ القصيدة من خلال منظورٍ هيرمينوطيقي يستنطق أفقها التأويلي، ومنهجٍ رمزيٍّ ودلالي يفكّك بنيتها الصورية والمعجمية، وتحليلٍ بنيوي لغويّ يبيّن كيف تعمل اللغة على إنتاج الرغبة والمعنى، إضافةً إلى مقاربةٍ نفسية ترصد الدوافع الداخلية والانفعالات الكامنة في نسيجها.
تسعى هذه القراءة إذًا إلى الكشف عن البنية العميقة للنصّ، حيث تمتزج الشهوة بالروح، واللغة بالانفعال، والمعنى بالغياب، في نصٍّ شعريٍّ يجعل من العشق وسيلةً لتجاوز الغربة، ومن الكلمة أفقاً للخلاص.
القصيدة "نشيد الخيول" “جئتك في المساء المكتظ بغربتي” هي نصّ شفيف مشحون بالتوتّر العاطفي والإيروتيكي المكبوت، تنبض بين سطورها رغبة وجودية لا تُختزل في نداء الجسد، بل تمتد إلى التحام الكينونة بالكينونة، كما لو أنّ اللقاء بين "الأنا" و"الآخر" هو محاولة للخلاص من التيه، من الغربة، ومن العطش الميتافيزيقي للدفء.
1. البنية النفسية للنص:
القصيدة تُبنى على محورين متقابلين:
١- الاغتراب والانكسار: “المساء المكتظ بغربتي”، “طائر ضيّع بوصلة العمر”، “عارية القلب”.
٢- الانجذاب والانبعاث: “أغواني الصوت الهارب من أقاصي المجرة”، “نبع العطش المستميت على جسد الحكايا”، “حيث أينع النرجس واستيقظت أنثى الماء والنار”.
هذا التوازي يُظهر شخصية الشاعرة الجزائرية ناديا نواصر وهي في حالة مخاضٍ شعوريّ بين العطش الروحي والشهوة الكونية، بين الانكسار والرغبة في الاتحاد. إنها لا تبحث عن جسدٍ آخر، بل عن مأوى روحيّ يشبه الصدر المؤثث بالنشيد الحر؛ مأوى للكينونة الضائعة في زحمة الغربة.
2. الدافع الإيروتيكي – الرمزي:
الحضور الإيروتيكي هنا ليس مباشراً أو حسياً، بل يتخفّى في استعارات الماء والنار والليل والمساء.
حين تقول الشاعرة نواصر:
“استيقظت أنثى الماء والنار”
فهي لا تتحدث عن أنوثة الجسد، بل عن أنوثة الوجود؛ عن الطاقة الأولى للخلق التي تتفجّر في لحظة عشق كونيّ.
والماء هنا رمز للحياة والانسياب والحنين، بينما النار رمز للرغبة والإشراق والانصهار.
وفي اتحادهما تنبثق “أنثى الوجود” التي هي الذات وقد بلغت ذروة انصهارها بالعشق — أي اللحظة التي يلتقي فيها الجمال بالإيروس بالروح.
هذا ما يجعل النص مندرجاً تحت ما يُسمّى في النقد الحديث بالإيروس الجمالي، حيث تتحوّل الرغبة إلى طاقة خَلقٍ وإبداع، لا إلى غريزةٍ فحسب.
3. اللغة الشعرية والتوتر الدلالي:
القصيدة تقوم على لغة مُفعمة بالتوهّج والالتباس الجميل، إذ تمزج بين النور والعتمة، الماء والنار، الوله والعقل، في نسيجٍ لغويّ يقترب من اللغة الصوفية في صعودها التدريجي من الحس إلى المعنى.
فعبارة “الروح الولهى – الصبر المنتحر – الرماد المستيقظ من نار الغوايات” تمثّل مستويات النفس في علاقتها بالرغبة: من اللهفة إلى الاحتراق إلى التطهّر.
4. الدافع الداخلي: الرغبة في الاتحاد والتحرّر.
من المنظور النفسي، النص يكشف عن حالة اغتراب وجودي وعطش أنثويّ للانصهار. المتحدثة تحمل وعياً مأزوماً بالعزلة، فـ"المساء المكتظ بغربتها" هو مساء الذات، بينما "الصدر المؤثث بالنشيد الحر" هو رمزية الوطن العاطفي، ذلك الذي تُستعاد فيه الأنثى إلى كمالها.
اللقاء مع الآخر ليس لقاءً عاطفياً، بل هو خلاصٌ من تمزّق الذات، فالـ"أنا" تمشي إلى "الآخر" بلا موعد، بلا طرقٍ على الأبواب، لأن الرغبة أقوى من التعقّل، ولأن الغواية هنا هي طريق الكشف والخلق في آن واحد.
- خلاصة الرؤية:
القصيدة ليست مجرّد نص حبّ، بل رحلة وجودية – روحية – إيروسية في آن، تسعى فيها الذات إلى تجاوز غربتها عبر فعل العشق الذي يتجاوز الجسد إلى التوحّد الروحي والكياني.
إنها قصيدة عن الأنثى التي تصنع من رغبتها صلاة، ومن عطشها نبعاً للخلق، وعن الشهوة التي تُروّض لتغدو شهوة النور والمعنى لا شهوة الجسد فحسب.
المنهج الهيرمينوطيقي — تفسير النصّ في أفق المعنى:
المنهج الهيرمينوطيقي يفتح الباب أمام قراءة النص بوصفه حلقة في دائرة فهم قوامها: القارئ — النص — السياق (التاريخيّ-الذاتيّ). هنا:
سياق المتكلم/المخاطَب: المتحدثة تأتي من حالة اغتراب؛ المساء المكتظ بغربةٍ يحدد نبرة النصّ؛ المخاطَب يبدو كمنفى/مأوى/ملكوتٍ يتوق إليه الفاعل.
دائرة الفهم: كل صورة في القصيدة تُعيد تفسير الصور السابقة: مثلاً صورة «طائر ضيّع بوصلة العمر» تُفسَّر لاحقًا عبر رموز الماء والنار والصدر المؤثث، فتتحوّل إلى رمز لحالة التجوال الوجودي وليس مجرد فقدان اتجاه فيزيائي.
الأفق المُؤوَّل: القصيدة تقرأ كقِصةِ رجوعٍ/انصهارٍ؛ لا كحدثٍ معزول. الهيرمينوطيق يسمح باعتبار كلِّ تكرار لفظي/صوري (المساء، الروح، النار) حلقةً في سلسلة كشف متصاعدة تقود إلى ذروة الانصهار («أنثى الماء والنار»).
النتيجة: النص تكوينيّ؛ فهمُ المقاطعِ يَتأتى حين نعيد ربطها بدينامية البحث عن مأوى وجداني، وليس بتحليل كل بيتٍ منفردًا.
المنهج الرمزي والدلالي — قراءة الرموز الكبرى والصغرى:
القصيدة غنية برموزٍ تعمل في مستويات متعدِّدة:
١- المساء/الغربة: رمز للحالة الوجودية والليل الداخلي، ليس فقط ظرفًا زمانيًّا.
٢- الطائر/البوصلة: الطائر رمز للذات التائهة — البوصلة رمز البحث عن معنى/وجهة.
٣- الماء والنار: ثنائية كلاسيكية للحياة والرغبة؛ الماء يرمز للانسياب والحنان والخصب، النار ترمز للشوق والاشتغال والانصهار المتحرّك. اتحاد «أنثى الماء والنار» يدلّ على لقاء قطبيّين ينتجان حالة مولدة (خلق أو ولادة شعرية وأنثوية).
٤- الرماد/الصبر المنتحر: الرماد يدل على آثار الاحتراق، لكنه «مستيقظ» هنا، أي أن احتراق الغواية لا يموت بل يعبّر، والصبر المنتحر يعكس تناقضاً: الصبر الذي بلغ حد الانهيار، لكنه يولّد وعياً جديداً.
٥- الصدر المؤثث بالنشيد الحر والنرجس: الصدر كمأوى/حقل إبداع؛ النرجس رمزُ الجمال والتجدّد، ما يمنح اللقاء بعدًا مولدًا جمالياً.
- دلاليًا، الرموز لا تعمل منفصلة بل كخريطةٍ معنوية: كل رمز يوجّه القارئ نحو تجربةٍ نفسيّة/وجودية واحدة: رغبة الانصهار والتحوّل.
- البُنية اللغوية والأسلوبية — كيف تُبنى اللغة لتوليد المعنى:
تحليل البُنية يبيّن كيف تُوظّف الوسائل اللغوية الإيقاع والدلالة:
١- التراكيب الذاتية والمواضع الشِّعريّة: تكرار «جئتك» في افتتاح النصّ يمنح الحدث طابعًا إلحاحيًا؛ التتابع بين الجمل القصيرة والشرطية يخلق إيقاعًا تامورياً (تدرّجًا من الارتباك إلى اليقين).
٢- التركيب الاستعاري: النص يعتمد بكثافة على الكثيف الاستعاري (الطائر، البوصلة، الرماد، الصهيل) ما يحوّل المشهد من سردية إلى رؤيا.
٣- التناصّ الصوتي والإيقاعي: استخدام صورٍ صوتية مثل «يهذي.. وتحمله للنجم ناياتي» يخلق موسيقى داخلية؛ توظيف اقتطاعات صوتية (وقفات، نقطتين، تشطير) يعزز حالة الاضطراب والاشتعال.
٤- الضدان البنيوية: القصيدة تشتغل بصيغة التضاد (غربة/مأوى، رماد/نار، صبر/انتحار)، ما يتيح طاقة ثنائية تُحرك المعنى نحو ذروة التلاشي/البعث.
٥- الضمائر والدلالة التواصُلية: الضمير «أنا» المتحرك نحو «أنتَ/أنتِ» يجعل الخطاب حميميًّا وخطابيًّا في آن؛ المخاطب يجمع بين كينونة نفسية ومقدسٍ رمزي.
البنية اللغوية إذن ليست زينة بل أداة تصعيد دلالي: كلّ بناء يُحشد لإنتاج إحساس الاندفاع والرغبة والتطهير.
- الحسّ النفسي — الاندفاعات، الدفاعات والدوافع الداخلية:
من منظور نفسيّ موجز:
١- الدافع المركزي: رغبة في الاتحاد/الانتماء ومعالجة اغتراب وجودي؛ لقاء الآخر يمثل حلًّا رمزيًا للانقسام الداخلي.
٢- انفعالات مختلطة: نصٌّ تجمع فيه «الذعر» (الطائر الضائع، الارتباك في الطريق) و«التوق» (العطش المستميت، النشيد الحر). هذا التباين يشير إلى فاعل نفسي يعاني توتّرًا داخليًا بين الخوف والرغبة.
٣- آليات دفاعية: استعمال الصور الاستعارية والتكثيف الشعري وظيفة دفاعية — تَحويل الشهوة الخامّ إلى تجلٍّ ميتافيزيقيّ (سحبها من مستوى الجسد إلى مستوى الرمز) يسمح بالتحكم في القلق والعار المحتملين.
٤- رمزية الانتحار/الصبر: عبارة «الصبر المنتحر» تدلّ على استنفاد قدرة التحمل، ولكنها أيضًا فعل تحوّل: الموت الرمزي لصبرٍ قديم يُعيد إنتاج طاقة شعرية/عاطفية جديدة.
٥- الهوية المؤقتة: حيوية الصور تدلّ على شخصية تبحث عن ذاتٍ متجددة؛ اللقاء ليس مجرد مُتعة بل إعادة بناء للذات المشتتة.
- التقاء المناهج — تركيب قراءة مُشتركة:
حين نجمع ما سبق: الهيرمينوطيق يشرح حركة الفهم وتدرّج الكشف، الرمزي يوضح طبقات الإحالة، التحليل البنيوي يبيّن آليات اللغة، والتحليل النفسي يكشف عن دوافع الانفعال. معًا، تعطي هذه المناهج صورة متكاملة للنص:
القصيدة نص كشف/ولادة، حيث تتحوّل الغربة إلى مسار يثمر لقاءً يُعيد للذات وحدةً وكيانًا.
الشهوة ليست نزوة عابرة، بل قوة خلّاقة تُعيد تشكيل اللغة نفسها.
بناء الصورة اللغوية والرمزية يسمح بتحويل العاطفة إلى تجربة جمالية تُقنع القارئ بأن الشوق هنا مقدّس وخلقٌ شعريّ.
- خاتمة:
القصيدة تُعدُّ نموذجاً ناجحاً لشعر الوجد المعاصر الذي يدمج الإيروس بالجمال والروح. باستخدام أدوات الهيرمينوطيق والرمزية والدلالات البنيوية والتحليل النفسي، نقرأ النص كرحلة تصاعدية: من تيه الغربة إلى شعور الانعتاق/الاتحاد، عبر لغةٍ مُصقولةٍ تجمع بين الصيحة والرقة، بين الصمت والنشيد. هي قصيدة عن الاشتغال الشعري نفسه: كيف تصنع الرغبة نصًّا، وكيف يتحوّل الاحتراق إلى نورٍ يولد غدًا.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
.....................
نشيد الخيول
بقلم: نادية نواصر
جئتك في المساء المكتظ بغربتي
طائرا ضيع بوصلة العمر
في عيني شرود
وعلى كتفي نقر الوهن
عارية القلب
حافية الوجدان
في البدء أربكني الطريق
وعند السطر الأول من الخفق زلزلني المقال
أغواني الصوت الهارب من أقاصي المجرة
هزتني أغاني البحر
وماتبقى من صهيل المساء
كفه الأمان
والصهد المنبثق من يقطين الروح
نبع العطش المستميت
على جسد الحكايا
جئتك من حيث كان المفترق
والكامن الحارق
الرماد المستيقظ من نار الغوايات
الروح الولهى
الصبر المنتحر
على هيبة الجبل الوارف
أيها الموسوم بما رامه المجاز قل لي كيق مشيت إلي؟
وكيف مشيت إليك بلا سابق موعد؟
لا احتمال للحكمة
غير هذا الجنون
بعثر مدائني
وانهار العقل
بلا سابق طرق على بوابة الروح الموصدة
إني في مدار الحيرة
من أمر الروح
فابسط ذراعك كي أمضي إلى الصدر المؤثث بالنشيد الحر
حيث أينع النرجس
واستيقظت أنثى الماء والنار
وامتزج الممكن بالمستحيل
واختلطت اليابسة بالماء
واخرجت تربة الروح أثقالها
وتاه بنا الدرب إلى ما تعذر على الصحو
اعتقاله
جئتك في المساء الشهي
حيث ألقيت علي القبض
أيها الصقر قل لي
من القاتل ومن القتيل؟