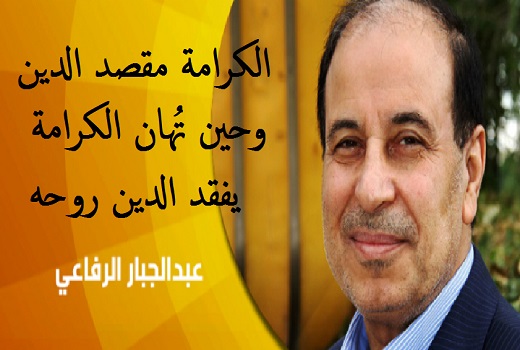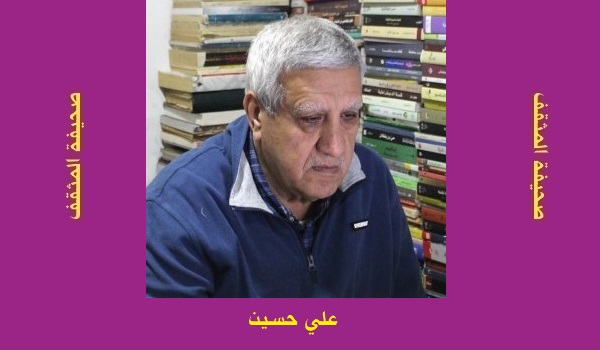أقلام فكرية
ابراهيم طلبه سلكها: أهمية الفلسفة فى تعزيز الأداء الفعال للموظفين فى الوظائف العامة

مقدمة: في ظلّ التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتسارعة، تواجه الوظائف العامة تحدياتٍ متزايدة تتعلّق بمستوى النزاهة، والالتزام بالقيم الأخلاقية، وتحقيق الصالح العام. فمع ازدياد الاعتماد على المؤسسات الحكومية لتنظيم شؤون الحياة العامة وتقديم الخدمات الأساسية، تتجلّى أحيانًا مظاهر الفساد الإداري وتعارض المصالح وضعف الأداء الوظيفي، الأمر الذي يُضعف الثقة بين المواطن والدولة، ويؤثر سلبًا في فعالية الخدمات العامة. ومن هنا تنبع مشكلة البحث، والمتمثلة في غياب إطارٍ فلسفي شامل يربط بين أخلاقيات المهنة والقيم الإنسانية من جهة، وبين الضوابط القانونية والإدارية التي تحكم سلوك الموظف العام من جهة أخرى.
وتتطلب معالجة هذه المشكلة دراسة العلاقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق المؤسسية، وتحليل الأسس الفلسفية التي تحدد مفاهيم الواجب والمسؤولية والعدالة والشفافية في ممارسة الوظائف العامة. كما يقتضي الأمر التعرف على القيم المهنية الأساسية، مثل الصدق والنزاهة والكفاءة والخدمة العامة، وبيان كيفية ترجمتها إلى ممارساتٍ عملية ضمن بيئةٍ وظيفية تتسم بالتعقيد والمساءلة.
تكمن أهمية البحث في سعيه إلى تقديم رؤيةٍ متكاملة لفلسفة أخلاقيات المهنة في الوظائف العامة، تجمع بين التحليل الفلسفي العميق والتطبيق العملي، وتوفر إطارًا نظريًا يمكن من خلاله تطوير سلوك الموظف العام وتعزيز النزاهة والمسؤولية في القطاع الحكومي. كما يسهم البحث في بناء قاعدة معرفية تساعد على صياغة السياسات العامة ووضع الأطر التنظيمية التي تراعي البعد الأخلاقي والإنساني في العمل الإداري، بما يحقق الصالح العام ويرسّخ الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة.
أما منهج البحث، فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المفاهيم الفلسفية والقيم الأخلاقية المرتبطة بالوظائف العامة، إلى جانب المنهج الفلسفي النقدي لتحليل الأفكار والتصورات المتصلة بأخلاقيات المهنة عبر تاريخ الفكر الغربي والحديث، بالاستناد إلى المراجع النظرية والفلسفية، ودراسة النماذج التطبيقية للوظيفة العامة في السياق المعاصر. كما تم توظيف المنهج المقارن لمقارنة المبادئ والقيم الأخلاقية في الفلسفة الكلاسيكية والمعاصرة، وربطها بالممارسات الواقعية في الخدمة العامة، بهدف تقديم توصياتٍ عملية لتطوير أخلاقيات الوظائف العامة.
وانطلاقًا من ذلك، يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1- ما الأسس الفلسفية التي تحدد أخلاقيات المهنة في الوظائف العامة؟
2- كيف يمكن ترجمة القيم الأخلاقية إلى ممارساتٍ عملية في الإدارة العامة؟
3- ما الفرق بين الوظيفة العامة كمهنةٍ والوظيفة العامة كرسالةٍ أخلاقية؟
4- كيف يمكن بناء ميثاقٍ فلسفي لأخلاقيات المهنة يوازن بين المسؤولية الفردية والمؤسسية؟
تمثل هذه التساؤلات محورًا أساسيًا لفهم طبيعة الوظائف العامة، وتطوير إطارٍ أخلاقي وعملي يرسخ قيم النزاهة والكفاءة والعدالة، ويعزز الالتزام بالقيم العليا في العمل الإداري.
المحور الأول: مفهوم أخلاقيات المهنة بين الفلسفة والتطبيق
لقد لوحِظ السلوك الأخلاقي الإنساني منذ أقدم العصور المسجَّلة، وتشير الدراسات الأنثروبولوجية والأثرية إلى أن جميع القبائل البدائية امتلكت قواعد محددة وواضحة للسلوك. ويفترض كريستوفر بوهِم (Christopher Boehm) أن التطور التدريجي في بنية الأخلاق وتعقيدها على امتداد مسار تطوّر الإنسان العاقل كان نتيجة لازدياد الحاجة إلى تجنّب النزاعات والإصابات مع الانتقال إلى بيئة السافانا المفتوحة، وتزامن ذلك مع تطوّر استخدام الأدوات الحجرية كأسلحة. وعلى الرغم مما تتّسم به الأخلاق الإنسانية من تعقيد ورُقيّ يفوق ما لدى سائر الكائنات، فإنها في جوهرها ظاهرة طبيعية نشأت للحدّ من النزعة الفردية المفرطة وتعزيز روح التعاون بين البشر. أما الأخلاق الجماعية، فتنشأ من المفاهيم والمعتقدات المشتركة، وغالبًا ما يجري تقنينها لتنظيم السلوك داخل الثقافة أو الجماعة الاجتماعية.(1)
وإذا كان هذا التطوّر الطبيعي قد وضع الأساس الأولي للقواعد الأخلاقية، فإن انتقال الإنسان إلى أنماط اجتماعية أكثر تعقيدًا مهّد لمرحلة جديدة في التفكير الأخلاقي، وهي المرحلة التي برزت بوضوح في اليونان القديمة.
كانت اليونان القديمة مهد الأخلاق الفلسفية الغربية، إذ تعود أصول المبادئ الأخلاقية فيها إلى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وقد أصبحت أسماء مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو رموزًا خالدة في تاريخ الفكر الإنساني. فقد انتقلت اليونان من كونها مجموعة من القبائل المتناحرة إلى مجتمع من الناس يعيشون في دولة المدينة، حيث بدأ الأفراد يقضون أوقاتهم في التأمل في مفاهيم مثل السعادة، والحياة الفاضلة، وقيمة التنظيم الاجتماعي. لقد غدت المبادئ والممارسات الأخلاقية بمثابة الإسمنت الذي يربط المجتمع ويمنحه تماسكه، بحيث يتمكّن المواطنون من السعي وراء رغباتهم وتحقيق أهدافهم ضمن إطار من التوازن والاحترام المتبادل. ويشير جرايلنج (Grayling) إلى أن:
«الآداب هي جوهر الأخلاق الحقيقية؛ فهي التي تُهذّب العلاقات الاجتماعية، وتُضفي على التفاعل الإنساني مسحة من اللطف والرقي، وتخفّف من حدّة الصراع. فبدونها يستحيل قيام المجتمع ذاته أو ضبطه. والإجابة عن سؤال: كيف يمكن لمجتمع معقّد وتعددي أن يتعامل مع ضغوط الاختلاف والتنافس الداخلي؟ يجب أن تضع التهذيب واللياقة في مركزها، إذ لا شيء آخر — ولا حتى الأداة الحادة المتمثلة في القانون — يمكنه أن يحقق ذلك بالكفاءة نفسها».(٢)
ومن الطبيعي بعد هذا التحوّل الفلسفي أن تتكامل الصورة التاريخية للأخلاق، بحيث تتّضح الصلة بين نشأتها الطبيعية الأولى وبين تطورها النظري، وهو ما يقود مباشرة إلى إدراك الوظيفة الاجتماعية التي أدّتها القواعد الأخلاقية في تنظيم الحياة البشرية عبر العصور.
ومن ثمّ، فمنذ اللحظات الأولى لتكوّن البنية الاجتماعية في المجتمعات البدائية، مرورًا بوضع القوانين الأولى التي نظّمت الحياة في المدن، وصولًا إلى انبثاق الفلسفة الأكاديمية في مراحلها المبكرة، بلغ الإنسان طورًا أدرك فيه أن المجتمع لا يقوم إلا على قواعد للسلوك تُجسّد القيم المشتركة، وتُعبَّر عنها بطرائق بسيطة ومباشرة في صورة آداب عامة وسلوك قويم، لتكون الإطار الذي تنتظم في نطاقه «الحياة الفاضلة» التي يتحقق بها خير الفرد وصلاح الجماعة معًا.(٣)
وعلى هذا الأساس، يصبح واضحًا أن المفاهيم الحديثة للمهنيّة والأخلاق المهنية ليست معزولة عن هذا الامتداد التاريخي، بل هي تطوّر طبيعي لمبدأ قديم مفاده أن السلوك المنظم هو شرط لاستقامة المجتمع وتحقيق الصالح العام.
1- تعريف المهنة من منظور فلسفي
عند البحث عن تعريفٍ لمفهوم «المهنة»، يُمكن العثور – في الغالب – على أربعة اتجاهات رئيسة في تحديدها. فالاتجاه الأول يرى أن السمة المميِّزة للمهنة هي نزعة ذهنية أو موقف نفسي، إذ إن الدافع الإيثاري قادر على أن يرقى بأي نداءٍ شريف إلى مصافّ المهن. أما الاتجاه الثاني فيعتبر المهنة نوعًا من العمل يتطلّب مهارةً خاصة تقوم على مستوى عالٍ من النشاط الفكري. ويذهب الاتجاه الثالث إلى أن المهنة مرتبة اجتماعية متميّزة، مثل مهنة القضاء أو المحاماة أو رجال الدين. بينما يؤكد الاتجاه الرابع أن أي عمل لا يُعدّ مهنةً حقيقية ما لم تتأسس فيه علاقة سرّية قوامها الثقة بين العميل ووكيله، كما هو الحال في العلاقة بين المريض وطبيبه، أو بين المتقاضي ومحاميه.(٤) وهنا يمكن ملاحظة أن الثقة المتبادلة بين الأطراف تعتبر جزءًا من التطور الأخلاقي الذي ناقشناه في الفقرات السابقة، إذ تشكّل أحد أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والممارسة المهنية المسؤولة.
ومن خلال هذه الاتجاهات يمكن القول إن المهنة ليست مفهومًا أحادي البعد، بل تتأسس على تداخلٍ بين البعد الأخلاقي والاجتماعي والمعرفي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تتبّع التعريفات الحديثة للمهنة كما وردت في القواميس والمراجع الفكرية المعاصرة.
ولا يُعَدّ أيٌّ من هذه التعريفات كافيًا بمفرده، غير أنّها جميعًا، إذا نُظِر إليها مجتمعةً — كما أرجل الطاولة — تُشكّل أساسًا متينًا تستند إليه المهنة وتستمدّ منه توازنها واستقرارها. ومع ذلك، يمكن صياغة عددٍ من التعريفات التي تُسهم في تحديد مفهوم المهنة بدقّة أكبر. يُوضّح قاموس أوكسفورد الإنجليزي (٢٠١٤) أن المهنة تشمل العمل أو الوظيفة، سواء أكانت مسارًا مهنيًا أم دعوةً رسالية، وتقوم على عناصر أساسية هي: المعرفة، والتطبيق، والتدريب، والمؤهلات الرسمية، مع الإشارة إلى أن العنصرين الأخيرين يُعدّان أمرين مألوفين، لكن غير جوهريين. أما قاموس ميريام- ويبستر (٢٠١٤) فيعرّف المهنة بأنها «دعوة أو رسالة تتطلّب معرفة متخصّصة، وغالبًا إعدادًا أكاديميًا طويلًا ومكثّفًا».(٥) ويُظهر هذا أن المهنة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة أخلاقية واجتماعية تتطلب مستوى عالٍ من المعرفة والتدريب.
وإذا كانت القواميس الحديثة قد ركّزت على الجانب المعرفي والرسالي للمهنة، فإن بعض المفكرين المعاصرين قد وسّعوا هذا الإطار ليشمل بعدها الخدمي والاجتماعي، كما نجد عند سيدني وبياتريس ويب، اللذين شدّدا على أن المهنة لا تُمارس من أجل الربح، بل من أجل خدمة الآخرين في ضوء رسالة أخلاقية واضحة. فقد قدَّم مؤسِّسا مدرسة لندن للاقتصاد، سيدني (Sidney) وبياتريس ويب (Beatrice Webb)، تعريفًا للمهنة يُعدّ معاصرًا لتعريف فلكسنر، إذ اعتبرا أن المهنة هي: «دعوة تقوم على تدريبٍ تعليميٍّ متخصّص، غايتها تقديم النصح والخدمة الموضوعية للآخرين مقابل عِوَضٍ مباشرٍ ومحدّد، من غير توقّعٍ لأي مكسبٍ تجاريٍّ آخر».(٦) ويؤكد هذا التعريف على الطابع الخدمي للأخلاق المهنية، وهو امتداد طبيعي للفلسفة الأخلاقية التي ناقشناها في اليونان القديمة، حيث تم وضع المبادئ التنظيمية للمجتمع.
وفي الاتجاه ذاته، يضيف العالِم القانوني الأمريكي روزكو باوند (Roscoe Pound) بُعدًا جديدًا يربط بين الممارسة المهنية والالتزام بالخدمة العامة، مؤكدًا أن القيمة الأخلاقية للمهنة لا تنفصل عن قيمتها العلمية أو التقنية. فهو يرى أن المهنة هي: «جماعة تمارس فنًّا علميًّا بوصفه نداءً مشتركًا، في روحٍ من الخدمة العامة — وهي ليست أقلَّ خدمةً عامةً لمجرد أنها قد تكون في الوقت ذاته وسيلةً للعيش».(٧) ويؤكد هذا التعريف أن الالتزام الأخلاقي لا يقل أهمية عن الخبرة العلمية أو التقنية، وأن الخدمة العامة جزء لا يتجزأ من الهوية المهنية.
ومع تطوّر الفكر المهني في القرن العشرين، أخذ التعريف يزداد دقةً وشمولًا، كما في طرح كروس (Cruess) وآخرين (٢٠٠٤) الذين أبرزوا فكرة «العقد الاجتماعي» بين المهنة والمجتمع، باعتبارها الأساس الأخلاقي الذي يُبرّر استقلال المهنة وامتيازها بالثقة والتنظيم الذاتي. فقد عرّف كروس وآخرون المهنة بأنها: «عملٌ يقوم جوهره على إتقان مجموعة معقّدة من المعارف والمهارات. وهي رسالة تُوظَّف فيها المعرفة في أحد فروع العلم أو الفنون المشتقة منه لخدمة الآخرين. ويُقيَّم أعضاؤها وفق مواثيق أخلاقية يُعلِنون من خلالها التزامهم بالكفاءة، والنزاهة، والأخلاق، والإيثار، والسعي إلى تحقيق الخير العام ضمن مجالهم. وتشكل هذه الالتزامات الأساسَ لعقدٍ اجتماعيٍّ بين المهنة والمجتمع، يمنح المهنة احتكارَ استخدام معرفتها المتخصّصة، وحقَّ الاستقلالية الواسعة في الممارسة، وامتيازَ التنظيم الذاتي. وتبقى المهنة، ومن ينتمون إليها، مسؤولين أمام من يخدمونهم وأمام المجتمع بأسره».(٨)
ويُعمّق إليوت فريدسون (Eliot Freidson) هذا التصوّر من خلال تحليله للمهنة بوصفها بنيةً مؤسسية تستمد شرعيتها من الثقة العامة، ومن افتراضٍ جوهريٍّ بأن العاملين فيها يغلّبون الصالح العام على المصلحة الذاتية، ويمارسون الرقابة الذاتية بوصفها ضمانةً أخلاقية للمجتمع. فهو يرى أن المهنة «ممارسةٌ يشغلها أفراد يتمتّعون بامتيازاتٍ خاصة، من قبيل الترخيص الحصري، وهي امتيازاتٌ مبرَّرة بعدة افتراضات؛ أولها أن ممارستها تتطلّب تدريبًا فكريًا عميقًا وقدرةً على إصدار أحكامٍ معقّدة؛ وثانيها أن العملاء عاجزون عن تقييم جودة الخدمة تقييـمًا كافيًا، الأمر الذي يقتضي منهم الثقة بمن يستشيرونهم؛ وثالثها أن هذه الثقة تقوم على افتراضٍ بأن المصلحة الذاتية للممارس متوازنة — بل خاضعة — لالتزامه بخدمة مصلحة العميل والصالح العام؛ وأخيرًا أن المهنة تُنظِّم نفسها ذاتيًا، أي إنها مؤسَّسة على نحوٍ يضمن للمجتمع وللقضاء معًا أن أعضاءها أكفاء، وأمناء في ثقة عملائهم، ومتجاوزون لمصالحهم الشخصية».(٩)
ولتحديد السمات التي تجعل من أي ممارسة «مهنة» بالمعنى الدقيق، صاغ فريدسون وأرجيريس وشون (Argyris & Schön، ١٩٧٤) مجموعةً من الخصائص التي تُميّز العمل المهني عن غيره من صور الكسب أو الحرفة، ويمكن إجمالها في عشر خصائص رئيسة:
١- تدريبٌ متخصص طويل الأمد يقوم على منظومة من المعارف المجرّدة.
2- توجّهٌ خدمي يقوم على تقديم النفع للآخرين.
٣- أيديولوجيا مهنية تستند إلى عقيدة أو إيمان أصيل يعبّر عنه أعضاء المهنة.
4- منظومة أخلاقية مُلزمة لجميع الممارسين.
٥- جسم معرفي خاص يميّز أعضاء المهنة عن سواهم.
٦- مجموعة مهارات تقنية تشكّل الجانب العملي للممارسة المهنية.
7- نقابة أو هيئة مهنية تضمّ أولئك الذين يملكون حقّ ممارسة المهنة.
٨- سلطة تُمنَح من المجتمع في صورة ترخيص أو اعتماد رسمي.
٩- بيئة معترف بها تُمارَس فيها المهنة على نحوٍ رسمي ومنظّم.
١٠- نظرية في المنافع الاجتماعية تُستمدّ من الأيديولوجيا التي تقوم عليها المهنة.(١٠)
وقد لاقت هذه الخصائص صدى واسعًا في المؤسسات المهنية الحديثة، إذ تبنّاها عددٌ من المجالس والمنظمات التي تسعى إلى وضع معايير موحدة للمهن، مثل المجلس الأسترالي للمهن الذي قدّم تعريفًا مؤسسيًا أكثر شمولًا للمهنة. فقد عرّف المجلس الأسترالي للمهن المهنة على النحو الآتي: «المهنة هي جماعة منظَّمة من الأفراد يلتزمون بالمعايير الأخلاقية، ويقدّمون أنفسهم — ويُعترف بهم من قبل الجمهور — بوصفهم أشخاصًا يمتلكون معرفةً ومهاراتٍ متخصّصة ضمن مجالٍ علمي معترف به على نطاقٍ واسع، مشتقٍّ من البحث والتعليم والتدريب على مستوى عالٍ، وهم مستعدّون لتوظيف هذه المعرفة وممارسة تلك المهارات بما يخدم مصلحة الآخرين. ومن جوهر تعريف المهنة وجودُ مدوّنةٍ أخلاقية تحكم أنشطة كل مهنة، وتتطلّب من أعضائها سلوكًا وممارساتٍ تتجاوز الالتزامات الأخلاقية الفردية. فهي تُحدِّد وتُفرض من خلالها معاييرُ عاليةٌ للسلوك، سواء في تقديم الخدمات للجمهور أو في التعامل بين الزملاء المهنيين. وغالبًا ما تُطبَّق هذه المدوّنات من قِبَل المهنة نفسها، ويحظى بها المجتمع اعترافًا وقبولًا».(١١)
وإلى جانب هذا التصور المؤسسي، قدّم عدد من الباحثين تعريفات تكميلية تُبرز الجوانب التنظيمية والعملية في الممارسة المهنية، كما فعل بهرمان (Behrman, J) الذي ركّز على التعليم النظامي، والرقابة الذاتية، والالتزام بخدمة المجتمع. فقد رأى أن للمهنة خصائص أساسية أخرى، من أهمها: وجود مجال محدّد بوضوح من الخبرة، واشتراط مرحلة من التعليم أو التدريب النظامي قبل الانضمام إلى المهنة، مع قصر العضوية على المؤهَّلين وفق معايير دقيقة. وتشمل المهنة كذلك آليات للفحص والترخيص، والتزامًا بخدمة المجتمع يستند إلى توجّهٍ خدميٍّ يُقدَّم على السعي إلى الكسب المادي. كما تتضمن ممارسة العمل نشاطًا تطوّعيًا (pro bono) ورسومًا متباينة تراعي قدرة المستفيدين على الدفع، إلى جانب نظامٍ تنظيميٍّ ذاتي يقوم على مدوّنة أخلاقية تُلزم الأعضاء بمستويات عالية من الكفاءة، وتوفّر آليات للرقابة الذاتية تفرض العقوبات المناسبة في حالات سوء السلوك أو الإهمال.(١٢)
وتتفق رؤية «الجمعية الأمريكية لإداريي شؤون الأفراد» (ASPA) مع هذه الاتجاهات، غير أنها تُحدّد المهنة من زاوية عملية تنظيمية، فتجعل من التعليم النظامي، والجمعية المهنية، ومدوّنة السلوك الأخلاقي ركائز لا غنى عنها لأي ممارسة مهنية حقيقية. فهي ترى أن المهنة الحقيقية يجب أن تتّسم بالخصائص الخمس الآتية:
1- أن تكون ممارسةً بدوامٍ كامل؛
2- أن تكون هناك مدارس ومناهج تعليمية مخصّصة لتدريس المبادئ الأساسية للمهنة، وأن يتوافر جسم معرفي مشترك ومحدّد؛
3- أن تمتلك المهنة جمعية مهنية وطنية؛
4- أن يكون لها برنامج اعتماد مهني معتمد ومعروف؛
٥- وأن تتبنّى مدوّنة أخلاقية تُنظّم سلوك الممارسين وتوجّههم.(١٣)
ويُعدّ المجال الطبي نموذجًا متميّزًا لتجسيد هذه القيم في الممارسة الواقعية، إذ تتكامل فيه الكفاءة مع الإيثار والاستقلالية والمسؤولية الاجتماعية. ويذكر كروس وآخرون (1997) أن المهنيين في المجال الطبي يتميّزون بالسمات الآتية:
١- الكفاءة: القدرة على إتقان المعارف والمهارات المرتبطة بالممارسة الطبية والمحافظة على حداثتها؛
٢- الالتزام: الشعور بالواجب والدافع الداخلي للعمل بما يحقق أفضل مصلحة للمريض؛
٣- الاستقلالية: الحرية في اتخاذ القرارات المستقلة بما يخدم مصلحة المرضى والصالح العام للمجتمع؛
٤- الإيثار: الإخلاص غير الأناني في رعاية الآخرين، وتقديم احتياجات المريض على المصلحة الشخصية؛
٥- النزاهة والصدق: التمسك الثابت بمدوّنة القيم الأخلاقية، والتحلي بالاستقامة ومقاومة الفساد؛
٦- الأخلاق والمبادئ: السعي إلى الخير العام، والالتزام بالمُثُل العليا للسلوك الإنساني القويم في التعامل مع المرضى والزملاء والمجتمع؛
٧- التنظيم الذاتي: امتلاك امتياز وضع المعايير المهنية، وتحمل المسؤولية عن الأفعال والسلوكيات في الممارسة الطبية؛
٨- المسؤولية تجاه المجتمع: الالتزام بتسخير الخبرة والمعرفة لخدمة المجتمع، وتحمل المساءلة أمامه عن الأفعال الفردية أو المهنية ذات الصلة بالخير العام؛
٩- المسؤولية تجاه المهنة: الالتزام بصون نزاهة المهنة والحفاظ على طابعها الأخلاقي والتعاوني، وتحمل المسؤولية عن السلوك المهني أمام الزملاء؛
١٠- العمل الجماعي: القدرة على تقدير خبرات الآخرين واحترامها، والتعاون معهم بما يخدم المصلحة الفضلى للمريض. (14)
ومن هذا العرض تتضح الصلة الوثيقة بين المهنة والصفات التي يتحلّى بها من يمارسها، الأمر الذي يقود إلى التساؤل الجوهري: من هو المهني؟ وما المقصود بالفلسفة المهنية؟
ويُعرَّف المهني بأنه عضوٌ في مهنةٍ ما، يتميّز بامتلاكه مجموعةً من الصفات التي تُجسِّد جوهر الممارسة المهنية الرفيعة، وتتمثل في الآتي:
1- امتلاك المعرفة والمهارات الخاصة بمجال المهنة.
2- الالتزام المستمر بتطوير الذات علميًّا ومهاريًّا.
3- اتّباع نزعةٍ خدمية في أداء العمل تهدف إلى نفع الآخرين.
4- الاعتزاز بالمهنة والشعور بالانتماء إليها.
5- إقامة علاقةٍ ميثاقية قائمة على الثقة والالتزام تجاه العملاء.
6- الإبداع والابتكار في الأداء والممارسة المهنية.
7- التحلّي بالضمير المهني والجدارة بالثقة.
8- تحمّل المسؤولية الكاملة عن العمل ونتائجه.
9- اتخاذ القرارات الأخلاقية السليمة في المواقف المهنية.
10- امتلاك روح القيادة والقدرة على توجيه الآخرين مهنيًّا وأخلاقيًّا.(١٥)
وإذا كان تعريف «المهني» يُبرز البعد الشخصي في ممارسة المهنة، فإن «الفلسفة المهنية» تمثّل الإطار الفكري الذي يوجّه هذا السلوك، ويُحدّد العلاقة بين المعرفة والأخلاق والسياسة المهنية، بما يضمن اتساق الممارسة مع القيم العليا للمجتمع. فهي مجموعة من المعتقدات والمواقف تجاه الحياة تُوجِّه سلوك الأفراد الذين يمارسون مهنةً معينة، ويمكن النظر إليها بوصفها نتاجَ تفاعلٍ بين ثلاثة عناصر مترابطة، هي: معايير الممارسة المهنية، والمبادئ الأخلاقية، والسياسة المهنية التي تتضمّن عقائد المهنة. تشكل معايير الممارسة الإطار الذي يُنظّم من خلاله المهنيون أداءهم لأعمالهم، بينما تُقدِّم الأخلاق المبادئ المقبولة التي تُميِّز بين الصواب والخطأ كما يفهمها ويقبلها أعضاء المهنة، وتوضّح كيفية تطبيق هذه المبادئ في تعامل المهنة مع المجتمع وفي خدمتها له.(١٦)
2- مفهوم "الأخلاق المهنية":
وإذا كانت المهنة تقوم على منظومة من المعارف والمهارات والسلوكيات التي تخدم الصالح العام وتعبّر عن رسالة اجتماعية، فإن الأخلاق المهنية تمثّل الجانب المعياري الذي يوجّه هذه الممارسة، ويضمن اتساقها مع المبادئ الإنسانية العليا. ويأتي مفهوم "الأخلاق المهنية" ليكمل هذه الصورة، إذ إن الأخلاق هي مجموعة من المبادئ التي وُضعت للصالح العام، صاغها الحكماء استنادًا إلى خبراتهم وحكمتهم. وقد خضعت هذه المبادئ عبر العصور لعمليات تنقيح وتعديل وتطوير، لتتوافق مع خصوصية الأقاليم، وطبيعة الحُكّام أو السلالات الحاكمة، ومع التطورات التي شهدها العلم والتكنولوجيا، وتغيّر الأزمنة والظروف.
وتهتم الأخلاق المهنية بتطبيق المبادئ والممارسات الأخلاقية على واقع العمل والمهنة، فتتناول أسئلة من قبيل:
(أ) ما الذي ينبغي أو لا ينبغي فعله في موقفٍ معيَّن؟
(ب) ما الصواب أو الخطأ في طريقة التعامل مع موقفٍ ما؟
(ج) ما الخير أو الشر في الأشخاص أو السياسات أو المبادئ المتصلة بذلك الموقف؟ (١٧)
ومن المهم التمييز بين الأخلاق العملية (السلوك العملي) (Morality) وعلم الأخلاق (الدراسة النظرية) (Ethics)، إذ تختلف الأولى عن الثانية في أن الأولى تُعنى بما يفعله الإنسان فعليًا في حياته اليومية، بينما تهتم الثانية بتحليل وتفسير وتقييم تلك الأفعال من منظورٍ فلسفي معياري.ويمكن ابراز ذلك كما يلى: (١٨)
تُسهم دراسة الأخلاق في التعرّف إلى معتقدات الناس وقيمهم ومبادئهم الأخلاقية، وفي تعلّم ما هو خير أو شرّ فيها، ثم ممارستها على نحوٍ يعزّز رفاه الإنسان وسعادته. كما تنطوي على البحث في الأوضاع القائمة، وتكوين الأحكام، ومعالجة الإشكالات الأخلاقية. وإلى جانب ذلك، تُعلِّمنا الأخلاق كيف نحيا وكيف نتعامل مع القضايا المختلفة من منظور الواجبات والحقوق والمسؤوليات والالتزامات. (١٩)
ومن هذا المنطلق، يتّضح لنا بجلاء مدى أهمية الأخلاق بوجهٍ عام، ودورها في تأطير السلوك الإنساني وتوجيهه نحو التطبيق العملي في الحياة المهنية. فالأخلاق المهنية والقيم الإنسانية تُعَدّان من أكثر الموضوعات اتصالًا بواقعنا المعاصر المفعم بالصراعات والضغوط التي تشهدها المهن المختلفة، حيث يُطالَب الفرد بأداء واجباتٍ متعدّدة في اتجاهاتٍ متنوّعة. ومن المؤكّد أن دراسة هذا الموضوع دراسةً منهجية تسهم في تنمية قدرات الفرد وصقل حُسن حكمه، وفي تهذيب سلوكه وقراراته وأفعاله أثناء قيامه بواجباته تجاه أسرته ومؤسسته ومجتمعه. (٢٠)
وبناءً على ما تقدّم، تهدف دراسة الأخلاق المهنية والقيم الإنسانية إلى ما يلي:
(أ) فهم القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تُوجِّه الممارسة المهنية؛
(ب) معالجة القضايا الأخلاقية التي تنشأ داخل المهنة؛
(ج) تبرير الأحكام الأخلاقية المرتبطة بالممارسة المهنية. (٢١)
ويمكن النظر إلى الأخلاق المهنية بوصفها فرعًا من الأخلاقيات التطبيقية يهدف إلى تحديد العمل المهني، وتوضيحه، وانتقاده، وفهم القيم النموذجية المرتبطة به. وتتميّز المهن، من الناحية الاجتماعية، بخبرة أعضائها القائمة على أسسٍ علمية، وبمثُلهم الأعلى في الخدمة، وهو ما ينطبق على ما يُعرف بالمهن الكلاسيكية. ويمكن فهم هذا المثل الأعلى للخدمة من خلال القيم التي تحدّد أهداف العمل المهني؛ فعلى سبيل المثال، يتمثّل الهدف الأساسي للطبيب في تعزيز الصحة. فكلّ مهنةٍ كلاسيكيةٍ لها مثلها الأعلى في الخدمة، المرتبط بالقيمة النموذجية لعمل أعضائها. (٢٢)
ومن منظور فلسفي أعمق، يمكن القول إنّ العمل المهني يُجسّد الحقوق والواجبات الخاصة بكل مهنة، كما يتطلّب توافر الفضيلة الشخصية لدى الممارس ذاته. ويمكن تناول أخلاقيات الهندسة، على سبيل المثال، من خلال الإشارة إلى النظام التكنولوجي، الذي يتميّز باستقلالية قيمه، وبمفهومي وجوب التكنولوجيا وحتميّتها. ومن خلال هذه المفاهيم يمكن تحليل سياق تعليم المهندسين، وعملهم، وأهدافهم، ونقدها. وترى النظرة التقليدية أنّ قيم الهندسة تتمثّل في سلامة الجمهور وصحّته ورفاهيته، غير أنّه يمكن — من منظورٍ نقدي — الطعن في هذا التصوّر. وتختلف مهنة الهندسة عن المهن الكلاسيكية في بعض الجوانب الجوهرية، حيث يلعب مفهوم الولاءات المزدوجة دورًا محوريًا في هذا الاختلاف. (٢٣)
وبذلك يمكن القول إنّ الأخلاق المهنية تتجلّى في ثلاثة أشكال رئيسة:
أولًا، تُفهم الأخلاق المهنية بوصفها مجموعة من القيم والمعايير التي تُوجّه عمليًا القرارات عند اتخاذها من قبل المهنيين، وبذلك تكون محدِّدًا للفعل بدرجات متفاوتة من الوضوح والوعي، ويُعزى تناول هذا الجانب من الأخلاق المهنية إلى علم النفس الاجتماعي.
ثانيًا، تُدرَك الأخلاق المهنية باعتبارها منظومة مثالية من القيم، تهدف إلى توضيح أفضل عالم ممكن تمارس فيه المهنة دورها على نحوٍ مثالي. وقد وضعت مختلف المهن في الوقت الحاضر مدوّنات سلوك تعبّر عن أفضل القيم والسلوكيات والنتائج المرجوّة. ويمكن وصف هذا النمط من الأخلاق المهنية بأنه تعبيري واستعراضي، ومن ثمّ يمكن دراسته من خلال أدوات البلاغة. غير أنّ هذا الافتراض يحتاج إلى توضيح، إذ لا ينبغي فهم مصطلح البلاغة بمعناه السلبي، بل بوصفه وسيلة لإعلان وتجسيد النوايا الحسنة التي يُفترض أن تميّز المهنة.
ثالثًا، تُعدّ الأخلاق المهنية فرعًا فلسفيًا نقديًا ينتمي إلى ميدان الأخلاق التطبيقية، حيث تُطبّق المناهج الفلسفية العامة على القرارات المهنية والتخطيط والعمل بغية تقييمها ونقدها وتطويرها. وتعتمد هذه المقالة النهج الفلسفي في دراسة الأخلاق المهنية. (٢٤)
ومن ثمّ، يمكن تمييز عدة اتجاهات رئيسة في ميدان الأخلاق المهنية الفلسفية:
أولًا، يُعرف الاتجاه الأول باسم «أخلاق المعضلات» (Quandary Ethics)، وهو مصطلح استخدمه للمرة الأولى — على ما يبدو — الفيلسوف إي. بينكوفز (E. Pincoffs). وعند تطبيق هذا المنظور على الأخلاق المهنية، تُدرَس الحياة المهنية من خلال مشكلاتها الدرامية ومعضلاتها الأخلاقية. فمثلًا، قد يجد محامي الدفاع نفسه ممثلًا لشخص خطر يعلم أن تبرئته قد تسبّب ضررًا جسيمًا للمجتمع. فهل يلتزم بالدفاع عنه رغم ذلك؟ إنّ حقّ الإنسان في الدفاع عن نفسه حقٌّ أساسي، لكنه لا يمكن ممارسته دون مساعدة مختص قانوني، وهو ما يجعل هذه الحالة نموذجًا لمعضلة أخلاقية في مجال القانون.
ثانيًا، يتناول اتجاه آخر تحليل المفاهيم الأساسية للعمل المهني والمهنية بوجه عام، وذلك عبر التحليل الفلسفي المفاهيمي. ويرى كثير من الفلاسفة أنّ هذا هو النهج الفلسفي الرئيس في دراسة الأخلاق المهنية، لما يتّسم به من شرعية منهجية وفائدة تحليلية. ومن أبرز المفاهيم التي تخضع لهذا التحليل مفهوما الاستقلالية (Autonomy) والسلطة (Authority)، بوصفهما من المفاهيم النموذجية في بنية الحياة المهنية.
ثالثًا، يركّز الاتجاه الفلسفي الأخير على العالم التاريخي للحياة المهنية، باعتباره الإطار الذي تتشكّل فيه جميع الأنشطة المهنية. وقد كان ميشيل فوكو (Foucault) من الروّاد في هذا النهج، الذي يُعَدّ — في كثير من الجوانب — الأكثر خصوبة وإنتاجًا؛ لأنه يتيح تكوين صورة شاملة عن الحياة المهنية، ويسمح بوضع الاتجاهات الأخرى في سياقٍ فلسفي وتاريخي متكامل. (٢٥)
٣- العلاقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق المؤسسية:
وبعد تناول الأسس النظرية والفلسفية للأخلاق المهنية، تنتقل الدراسة إلى مستوى أكثر تطبيقًا، يتمثل في العلاقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق المؤسسية، إذ لا يمكن فهم السلوك الأخلاقي المهني بمعزلٍ عن البيئة التنظيمية التي يعمل فيها الفرد. فكما أنّ الأخلاق المهنية تعبّر عن التزام الفرد بقيم عامة تحكم ممارسته، فإن المؤسسات بدورها تمتلك منظومات قيمية تحدّد الإطار العام للسلوك داخلها.
وتُكمِّل هذه الرؤية أهمية الأخلاق الفردية بمفهوم الأخلاق المؤسسية، إذ تُعَدّ القيم الأساس الجوهري للسلوك الأخلاقي، ويمكن تقييمها على مستويين: الفردي والتنظيمي. ويُطلق على التوافق بين قيم الفرد وقيم المؤسسة مصطلح «الانسجام بين الفرد والمنظمة» أو «التوافق القيمي»، وهو ما يشكّل محور العلاقة الأخلاقية بين الفرد ومؤسسته.
وفي هذا السياق، أجرت ليدتكا (Liedtka) في أطروحتها مقابلات مع عدد من المديرين في منظمتين، وطلبت منهم تحديد كلٍّ من قيمهم الشخصية وقيم مؤسساتهم التنظيمية، ثم شرح كيفية توظيفهم لهذه القيم في حلّ المعضلات الأخلاقية التي واجهوها. واستخدمت الباحثة مصطلح «التوافق القيمي» للدلالة على مدى الاتساق الداخلي الذي أبداه المشاركون في توصيف منظوماتهم القيمية الشخصية، وكذلك مدى إدراكهم لقيم مؤسساتهم بوصفها منظومات متسقة داخليًا أيضًا.
وقد ركّزت ليدتكا في دراستها على حلّ صراعات القيم، سواء أكانت صراعات داخلية يعيشها المدير ذاته، أم صراعات خارجية بينه وبين المؤسسة. وتبيّن من نتائج الدراسة أن المديرين ذوي التوافق القيمي العالي كانوا أكثر قدرة على حلّ النزاعات الأخلاقية على مستوى أخلاقي أرفع مقارنةً بأولئك الذين عبّروا عن توافق أقل أو قيم أقل اتساقًا داخليًا. كما لاحظت الباحثة أن المؤسسات، من منظور هؤلاء المديرين أنفسهم، تُظهر أنساقًا قيمية تتفاوت في درجة الاتساق الداخلي. فقد كان المديرون العاملون في مؤسسات ذات منظومات قيمية عالية الاتساق أكثر ميلًا إلى اتخاذ قرارات أخلاقية متقدّمة مقارنةً بنظرائهم في مؤسسات أقلّ اتساقًا قيميًا. (٢٦)
وفي مقالٍ لاحق مستمدٍّ من أطروحتها، أكدت ليدتكا أن النظام القيمي للمؤسسة يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الإطار الذي تُعرض عليه المعضلات الأخلاقية التي يواجهها المديرون. وقد قارنت بين مؤسستين: إحداهما تتسم بـ «نظام قيمي غني ومتعدد الأبعاد»، والأخرى وصفتها بأنها «نفعية بحتة».
وقد قامت ليدتكا بتحليل مصادر متعددة لصراع القيم، شملت ما يلي:
1- الصراع داخل منظومة القيم الخاصة بالمؤسسة،
2- الصراع داخل منظومة القيم الخاصة بالفرد،
3- الصراع بين قيم الفرد وقيم المؤسسة،
4- وأخيرًا الصراع المزدوج الذي ينشأ داخل القيم الفردية والتنظيمية وبينهما معًا. (٢٧)
واستخدمت ليدتكا مصطلح «التوافق القيمي» للإشارة إلى الانسجام الداخلي للقيم داخل المؤسسة، وكذلك إلى الاتساق الداخلي للقيم التي يتبنّاها الفرد. وكان من أبرز ما طرحته في حجّتها أنّه كلما ارتفع مستوى التوافق القيمي داخل المؤسسة، ازدادت قدرة قيمها على التأثير في استجابات الأفراد تجاه المعضلات الأخلاقية. وبالمثل، كلما اتسقت قيم الفرد داخليًا بدرجة أكبر، ازدادت قوة تأثيرها في تشكيل استجاباته لتلك المعضلات ذاتها. وبعبارة أخرى، حين تكون قيم المؤسسة متناقضة أو غير محدَّدة بوضوح، أو حين تكون قيم الفرد متضاربة أو غامضة، فإن هذه القيم تفقد فعاليتها النسبيّة في توجيه عملية اتخاذ القرار الأخلاقي. (٢٨)
كما استخدم بوسنر وشميت (Posner & Schmidt) أيضًا مفهوم التوافق القيمي لقياس مدى ما تتّسم به القيم من انسجام سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات — وفقًا لتقارير الأفراد أنفسهم — غير أنهما لم يركّزا على العلاقة بين قيم الأفراد وقيم مؤسساتهم. وقد خلص الباحثان إلى أنّ التوافق القيمي لدى الأفراد والتوافق القيمي لدى المؤسسات يرتبطان ارتباطًا إيجابيًا بعملية اتخاذ القرار الأخلاقي، غير أنّ التأثير الأبرز كان للتوافق القيمي على المستوى الفردي. أما أدكنز (Adkins) وآخرون، فقد درسوا التوافق القيمي بين الزملاء في بيئة العمل، وخلصوا إلى أنّ النتائج الإيجابية في العمل — مثل الرضا الوظيفي والالتزام بالحضور — كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتوافق القيمي، ولا سيّما بين الموظفين ذوي الرتب الأدنى، وفي الوظائف التي تتطلّب تعاونًا مباشرًا بين الأفراد. (٢٩)
ويشير كوينزي وشمينكه (Kuenzi & Schminke) في مراجعتهما للأدبيات الخاصة بمناخ العمل التنظيمي إلى أنّ هناك تعددًا كبيرًا في التعريفات وتداخلًا ملحوظًا بين العديد من المفاهيم ذات الصلة، مثل: المناخ التنظيمي، ومناخ العمل، والمناخ النفسي، والسياق التنظيمي. وقد حاولا التمييز بين المناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية، مشيرين إلى أنّ الأول يتعلّق أكثر بـ «كيفية إنجاز الأمور»، في حين ترتبط الثانية بـ «الافتراضات الكامنة» أو «المستوى الأعلى من التجريد».
ويُعدّ هذا التمييز ذا أهمية خاصة في دراسة مناخ الأخلاق داخل المنظمات، إذ يركّز هذا الحقل بدوره على «كيفية إنجاز الأمور» في سياق اتخاذ القرارات الأخلاقية، بخلاف مفهوم الثقافة الأخلاقية الذي يرتبط بالافتراضات العميقة التي تحكم السلوك. وتكتمل الصورة عند النظر إلى الأخلاقيات الفردية والمؤسسية معًا، حيث أشار أحد الاتجاهات المؤثرة في هذا المجال — كما طرحه فيكتور وكالن (Victor & Cullen) — إلى أنّ المنظمات يمكن أن تُظهر أبعادًا أخلاقية تماثل مراحل النمو الأخلاقي التي اقترحها كولبرج (Kohlberg) لتطور الأخلاق عند الأفراد.
كما أشارت دراسات متعدّدة إلى وجود علاقة وثيقة بين الأخلاقيات الفردية والمناخ التنظيمي، حيث أظهرت النتائج أنّ الأفراد يفضّلون مستويات أعلى من التوافق بينهما، وأنّ هذا التوافق يرتبط إيجابيًا بارتفاع مستويات الرضا الوظيفي والالتزام بالعمل، وبانخفاض نية ترك الوظيفة. (٣٠)
المحور الثاني: الأسس الفلسفية لأخلاقيات الوظيفة العامة
١- الفضيلة العملية عند أرسطو في سياق العمل العام
تُعَدّ الفلسفة الأخلاقية لأرسطو، كما عرضها في كتابه الأخلاق النيقوماخية، من أبرز النظريات التي أولت عناية خاصة بمفهومي الفضيلة والفهم الأخلاقي بوصفهما الأساس الجوهري للحياة المُرضية والمثالية. وتتناول هذه الدراسة تصوّر أرسطو للفضيلة والمعرفة الأخلاقية، وتبحث في العلاقة التفاعلية بينهما ضمن الإطار الكلي لنظريته الأخلاقية. (٣١)
وتؤسس هذه الرؤية لفهم الدور المركزي الذي تؤديه الفضيلة والمعرفة الأخلاقية في تحقيق الحياة المزدهرة، وهو ما يقودنا مباشرة إلى شرح مفهوم السعادة (اليوذيمونيا) باعتباره الهدف الأسمى للفكر الأرسطي. ويرتكز هذا الفكر على أن السعادة تمثّل اكتمال الازدهار الإنساني، ولا تتحقق إلا من خلال تنمية الخصال الفاضلة في النفس البشرية. فالفضيلة، في نظر أرسطو، ليست مجرد التزام بالقوانين أو اتباعٍ للمبادئ، بل هي ثمرة تكوين العادات الفاضلة واكتساب الحكمة العملية عبر الخبرة والتأمل. أما المعرفة الأخلاقية، فهي إدراك المبادئ التي توجه السلوك القويم، والقدرة على تطبيقها في المواقف العملية المحددة. ومن هنا يتضح أن تحقيق السعادة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة الفضائل، وهو ما يمهد للانتقال إلى تعريف الفضيلة وأنواعها.
تُعرِّف فلسفة أرسطو الفضيلة بأنها حالة من التميّز والصلاح الأخلاقي، وهي هيئة راسخة في النفس تمكّن الإنسان من التصرّف وفقًا للعقل وتحقيق أقصى قدراته بوصفه كائنًا عاقلًا. وتتضمّن الفضيلة، عنده، ميلاً ثابتًا لاختيار الوسط بين الإفراط والتفريط في الأفعال والانفعالات، ويوجَّه هذا الاختيار بواسطة الحكمة العملية (الفرونيسيس). أما الوسط أو ما يُعرف بـ«الوسط الذهبي»، فليس قاعدة جامدة، بل يتغيّر تبعًا للظروف والملابسات الخاصة بكل موقف. ويقسّم أرسطو الفضائل إلى نوعين رئيسيين:
1- الفضائل العقلية، مثل الحكمة والفهم، وتنشأ من التعلّم والبحث العقلي.
2- الفضائل الأخلاقية، مثل الشجاعة والاعتدال والعدالة، وتُكتسَب من خلال الممارسة العملية المستمرة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية. (٣٢)
ويرتبط الفهم النظري للفضيلة بتطبيقها العملي في حياة الفرد، وهو ما يقود إلى الحديث عن تدرّج الفهم الأخلاقي بين الأشخاص المختلفين. فوفقًا لأرسطو، يشترك الفاضل والمعتدل (المالك لزمام نفسه – إنكراتيك) وغير المعتدل (العاجز عن ضبط نفسه – أكراتيك) في امتلاك معرفة بالخير، لأن العقل الإنساني موجَّه من حيث المبدأ نحو الصواب. ومع ذلك، فإن المعرفة الأخلاقية التي يمتلكها الإنسان الفاضل أكمل وأرقى، لأن من يعجز عن ضبط نفسه يفشل في ترجمة معرفته إلى فعل، فيظل فهمه الأخلاقي ناقصًا. وهكذا يعكس التدرّج بين الشخصيات الثلاث درجات متفاوتة من الفهم الأخلاقي والمعرفة العملية بالخير. (٣٣)
ويتبيّن من ذلك أن تحقيق السعادة عند أرسطو يرتبط بممارسة الفضيلة في أبعادها النظرية والعملية معًا، مما يكشف عن الطابع الاجتماعي والسياسي للأخلاق في فلسفته. فالسعادة، في تصوره، لا تُنال إلا عبر الاعتياد والممارسة العملية، إذ تمتزج الفضيلة في جوهرها بين البعد المعرفي الذي يهتم بإدراك الخير، والبعد الأخلاقي الذي يتمثل في ممارسة هذا الخير واقعًا. وتقوم الأخلاق الأرسطية، في جوهرها، على تنمية العادات الفاضلة والسعي المستمر نحو التميّز والاعتدال، فيتحقق الاتساق الداخلي والاستقامة الأخلاقية. (٣٤)
وترتبط الفضائل الأخلاقية (Moral Virtues) بالصفات الشخصية وأنماط السلوك التي توجه أفعال الإنسان في المواقف الاجتماعية والأخلاقية. وتُكتسب هذه الفضائل من خلال الممارسة الواعية والتعوّد التدريجي على السلوك القويم، وهي تقوم على تحقيق توازن منسجم بين طرفي الإفراط والتفريط في مختلف الميول والانفعالات. ومن أبرز أمثلتها:
- الشجاعة: الوسط بين الجبن (نقص) والتهور (إفراط).
- الاعتدال: الوسط بين الإفراط في المتع (إسراف) والبلادة أو انعدام الإحساس (نقص).
- الكرم: الوسط بين التبذير (إفراط) والبخل (نقص).
- العدالة: الوسط بين الظلم أو التقصير (نقص) والإفراط في التعويض أو تجاوز الحدّ (إفراط). (٣٥)
وتوضّح هذه الأمثلة كيف يمكن للفرد أن يُجسّد التحليل النظري للفضيلة في سلوكه العملي اليومي، لتتحقق بذلك وحدة النظر والفعل. ومن ثمّ، فإن الفضيلة عند أرسطو لا تنحصر في المجال الفردي، بل تمتد إلى الحياة الاجتماعية والسياسية، إذ يرى أن الغاية القصوى من الوجود الإنساني هي الازدهار الإنساني الذي يتحقق من خلال المشاركة في الحياة العامة وممارسة الفضائل في المجال السياسي. فالفضيلة ليست مجرد خلق فردي، بل هي ممارسة مدنية تشارك في تحقيق الصالح العام. (٣٦)
ومن هذا المنطلق، لا يفصل أرسطو بين الحكمة العملية (الفرونيسيس) والحرفة (التكني) أو العلم (الإبيستيمي)، لاسيما عند تأسيسه لنظريته السياسية. فكما يرى بعض الباحثين، ومنهم راشيل بارني، فإن أرسطو يصوغ مفهوم الفضيلة في إطار الحرفة، أي بوصفها مهارة تُمارس وتتقن بالتجربة والخبرة. وقد ارتبط هذا التصور في أصله بالسفسطائيين الذين زعموا أنهم قادرون على تعليم الفضيلة السياسية بوصفها فنًا يمكن اكتسابه. (٣٧)
وفي الكتاب السادس من الأخلاق النيقوماخية، يميّز أرسطو بين الحكمة العملية والحرفة. فهو يُعرّف الحِرَف بأنها «حالة عقلية تشمل العقل الصحيح وتتعلق بالإنتاج»، بينما الحكمة العملية تتعلق بالفعل الذي غايته الخير ذاته. ويصف الشخص الحكيم عمليًا بأنه «قادر على المداولة الدقيقة حول الأمور التي هي خير ونفع له»، لا في شأنٍ جزئي كالصحة أو القوة، بل في ما يعزّز الحياة الجيدة عمومًا. وهنا يتضح أن الحكمة العملية، بخلاف الحرفة، تنتمي إلى مجال الفعل لا الإنتاج، لأنها تسعى إلى الفعل الجيد ذاته. (٣٨)
وبوجهٍ عام، تُعرَّف الحرفة بأنها «تنظيم وتوحيد للممارسة يؤدي إلى القدرة على تقديم تفسيرات وفهمٍ منظّم»، وهي بذلك تقلّل من الصدفة وعدم اليقين في الحياة الاجتماعية. ويستخدم أرسطو هذا المفهوم في تطوير نظريته السياسية التي تقوم على معرفةٍ منهجية بكيفية تحقيق الغايات المرغوبة. ومن هنا يؤكد أن «الإنتاج ينتهي إلى شيءٍ آخر غير ذاته، أما الفعل فلا، لأن غايته هي الفعل الجيد ذاته»، وأن «العلم السياسي والحكمة العملية هما نفس الحالة». (٣٩)
وهكذا يتضح أن الفضيلة العملية والحكمة العملية ليستا مجرد معرفة نظرية، بل مهارة مكتسبة تتجسد بالفعل الواعي في الحياة العامة، سواء في السياسة أو في المجال الاجتماعي، حيث يتحقق التوازن بين النظرية والممارسة، وبين المعرفة والفعل، في صورة وحدة أخلاقية متكاملة تمثل جوهر الفكر الأرسطي في الأخلاق والسياسة.
٢- الواجب عند كانط ومفهوم المسؤولية الأخلاقية:
تنصّ إحدى الركائز المركزية في فلسفة كانط الأخلاقية على أنّه لكي يكون للفعل قيمةٌ أخلاقية، فلا بدّ له من أن يكون مطابقًا للواجب فحسب، بل يجب أيضًا أن يُؤدَّى بدافع الواجب. وتُطرح هنا مسألة ما إذا كان الفعل بدافع الواجب نفسه واجبًا أخلاقيًا، أي ما إذا كان كانط يرى أنّ علينا واجبًا في أن نؤدي أفعالنا بدافع الواجب ذاته. وقد ذهب عددٌ من العلماء البارزين، ومنهم هنري أليسون، وهـ. ج. باتون، وروبرت پپين، وو. د. روس، إلى أنّ كانط يرى بالفعل وجود مثل هذا الواجب (٤٠).
يُفهم دافع الواجب تقليديًا على أنه دافع أوّلي، حيث تُستخدم صفة الأوّلي لتمييز الدوافع الأوّلية عن الثانوية. وتتميّز الدوافع الأوّلية بثلاث خصائص أساسية:
١. الدوافع الأوّلية تعبّر عن نوع الاعتبارات التي يستند إليها الفاعل نفسه عادةً لتفسير سبب قيامه بالفعل الذي أتى به.
٢. الدوافع الأوّلية تمتلك قوة تحفيزية فعلية؛ فهي تُسهم في التسبّب بالفعل وتُقدّم «الدافع الرئيس للفعل، أي ما يُحرّك المرء إلى العمل».
٣. الدوافع الأوّلية هي من نوع الاعتبارات التي تظهر عادةً ضمن عملية التأمل أو المداولة العقلية، وتشكل جزءًا من أساس الاختيار لدى الفاعل؛ فهي تعبّر عن «الاهتمام أو القصد الذي حدّد سلوكه كما فعل»، أي «الدافع الذي تصرّف على أساسه» (٤١).
وفيما يخصّ تقسيم الواجبات، يُلاحظ آلن و. وود في كتابه "الأخلاق الكانطية" أنّ التقسيم الجوهري للواجبات عند إيمانويل كانط يقوم على التمييز بين الواجبات القانونية (الحقوقية) والواجبات الأخلاقية. ويشكّل هذا التقسيم الأساس البنيوي لكتاب "ميتافيزيقا الأخلاق" ، الذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مذهب الحق ومذهب الفضيلة، وهو ما يسميه كانط بـ«الأخلاق».
ويمثل هذان المجالان إطارين تشريعيين متميّزين، لكلٍّ منهما مبدؤه الأساسي الخاص، ويعبّران عن القيمة الجوهرية للإنسان بطرقٍ مختلفة. يُقدّم مذهب الحق الأساس للدولة السياسية وتشريعاتها الخارجية، ويتضمّن الواجبات الحقوقية التي تُكوِّن بنية قانونية عقلانية، كثيرٌ منها قابلٌ للتطبيق القسري من خلال القوانين المدنية أو الجنائية. ومع ذلك، لا يصنّف كانط جميع الواجبات الحقوقية بوصفها قابلةً للإكراه؛ إذ يرى أنّ بعضها، مثل واجبات العدالة المستندة إلى الإنصاف، غير قابلٍ للإنفاذ القسري.
ويوضّح وود أنّ سوء الفهم لمفهوم «الحق» عند كانط يحدث حين يُختزل إلى مجرّد فلسفة قانونٍ أو سياسة دولة، بينما ينبغي فهمه باعتباره نسقًا من القواعد الأخلاقية العقلانية الهادفة إلى ضمان معاملة الإنسانية كغايةٍ في ذاتها، من خلال صون الحرية الخارجية للأشخاص وفقًا لقوانين كلية.
أمّا مجال الأخلاق، فيتناول الواجبات التي تحثّ الإنسان على معاملة الإنسانية — في ذاته وفي الآخرين — كغايةٍ في ذاتها بطرقٍ تتجاوز مجرد حماية الحرية الخارجية. وتتحقّق هذه الواجبات من خلال الانضباط الذاتي العقلاني الذي يهدف إلى تهذيب الطبيعة الإنسانية وتعزيز ازدهارها (٤٢).
وعلى خلاف الواجبات الحقوقية، لا يجوز فرض الواجبات الأخلاقية بالإكراه الخارجي، لأنّ ذلك يُخلّ بالاستقلال الذاتي للفرد وينتهك حقوقه. لذا، يجب أن تُؤدَّى الواجبات الأخلاقية بدافع الشعور الداخلي بالواجب والالتزام العقلي الأخلاقي. ويرى كانط أنّ جميع الواجبات الحقوقية هي أيضًا واجبات أخلاقية بمعناها الأوسع، لأنّ احترام القانون وحقوق الآخرين ينبع من القيمة الجوهرية للإنسانية ذاتها. ومن ثمّ، يجب أداء الواجبات الحقوقية لا لمجرّد الالتزام القانوني، بل بدافع الاحترام الأخلاقي للواجب (٤٣).
وفي نطاق الواجبات الأخلاقية، يُفرّق كانط بين الواجبات تجاه الذات والواجبات تجاه الآخرين، وتنقسم كل فئة بدورها إلى نوعين:
١. واجبات تامة: إلزامية تمامًا، وانتهاكها يستوجب اللوم الأخلاقي.
٢. واجبات غير تامة: غير إلزامية على نحو صارم، لكنها تُعدّ فاضلة ومستحقة للثناء الأخلاقي.
وفي كتابه "المبادئ الأساسية لمتافيزيقا الأخلاق" ، يصرّح كانط بأنّ الواجب هو ضرورة الفعل انطلاقًا من الاحترام للقانون الأخلاقي. ويرى أنّ القيمة الأخلاقية للفعل لا تكمن في النتائج التي يحققها، ولا في أيّ مبدأٍ يستمدّ دافعه من التوقعات المرتبطة بالعواقب، فآثار مثل الرضا الشخصي أو حتى سعادة الآخرين لا تُكوِّن في ذاتها قيمةً أخلاقية. بل إنّ الخير الأسمى — أو ما يسمّيه كانط الخير الأعلى غير المشروط — يكمن في المفهوم ذاته للقانون الأخلاقي، وهو ما لا يقدر على تصوّره إلا الكائنات العاقلة. لذلك، لا تكون للفعل قيمةٌ أخلاقية إلا عندما تكون الإرادة محدَّدة بالقانون ذاته، لا بأيّ نتائج متوقعة عنه (٤٤) وتنقسم الواجبات عند كانط كما يلي:
١. الواجبات الضرورية نحو الذات:
يؤكّد كانط أن الإنسان ليس مجرّد شيء يُستعمل كوسيلة، بل يجب دائمًا أن يُعامَل كغاية في ذاته. ويوضّح هذه الفكرة من خلال مثال الانتحار؛ إذ يرى أنّ من يُفكّر في إنهاء حياته هربًا من الألم إنما يستخدم نفسه كوسيلة لتجنّب المعاناة، وهو ما يتعارض مع المبدأ الأخلاقي القائل بوجوب معاملة الإنسانية كغاية لا كوسيلة. ومن ثمّ، لا يجوز أخلاقيًا للإنسان أن يتخلّص من ذاته بالتشويه أو التدمير الذاتي.
٢. الواجبات الضرورية نحو الآخرين:
فيما يتعلّق بالآخرين، يشرح كانط أنّ تقديم وعدٍ خادعٍ لشخصٍ ما هو نوع من معاملة ذلك الشخص كوسيلة فحسب لتحقيق غايةٍ خاصة، فالمخدوع لا يمكنه أن يوافق عقلانيًا على أن يُستغل بهذه الطريقة، وبالتالي يُخفق الفاعل الأخلاقي في احترام الآخر كغاية في ذاته. إنّ انتهاك حقوق الآخرين على هذا النحو يُعدّ إخفاقًا في الاعتراف بطبيعتهم العاقلة وكرامتهم الجوهرية.
٣. الواجبات الجديرة بالاستحقاق نحو الذات:
يرى كانط أنّه لا يكفي مجرد الامتناع عن انتهاك مبدأ الإنسانية كغاية في ذاتها، بل يجب كذلك العمل على تعزيز هذا المبدأ. فالإنسان يمتلك استعداداتٍ طبيعية نحو التطوّر الأخلاقي والفكري، وإهمال هذه الاستعدادات لا يُعتبر خرقًا مباشرًا للواجب، لكنه يُقصّر في تحقيق الغاية الأخلاقية الكاملة للإنسانية.
٤. الواجبات الجديرة بالاستحقاق نحو الآخرين:
يعتقد كانط أنّ الإنسانية يمكن أن تستمر من حيث المبدأ حتى لو لم يسعَ الأفراد إلى تعزيز سعادة الآخرين، إلا أنّ ذلك يعكس التزامًا سلبيًا فحسب بمبدأ الإنسانية. أما الالتزام الإيجابي فيقتضي أن يسعى الإنسان بقدر الإمكان إلى دعم الغايات المشروعة للآخرين. إنّ المبدأ القائل بوجوب معاملة الإنسانية كغاية في ذاتها لا يُستمد من التجربة، بل من العقل الخالص، وهو يعمل كقانونٍ أخلاقي موضوعي يضع حدودًا للأهداف الذاتية، ويدعم التشريع العملي الكوني.
٥. الضرورة العملية للعمل من منطلق الواجب:
يؤكد كانط أن ضرورة العمل من منطلق الواجب لا تنشأ عن المشاعر الذاتية أو الميول الشخصية، بل عن العلاقة العقلانية بين الفاعلين الأخلاقيين. ويجب اعتبار الإرادة العقلانية إرادة تشريعٍ ذاتي، تُلزم نفسها بالقوانين الكونية احترامًا للقانون الأخلاقي. ويتضمّن مفهوم الواجب ليس فقط الامتثال الموضوعي للقانون (الشرعية)، وإنما أيضًا الالتزام الذاتي بالقانون كدافع (الأخلاق). فالأفعال التي تُؤدّى من منطلق الواجب، لا لمجرّد الامتثال له، هي التي تمتلك قيمةً أخلاقية حقيقية.
وقد تُوصَف الأفعال التي تُنجَز بتضحياتٍ كبيرة باسم الواجب بأنها نبيلة أو سامية، غير أنّ هذا الوصف لا يصحّ إلا إذا نشأت عن شعورٍ حقيقي بالالتزام الأخلاقي، لا عن العاطفة. ويؤكد كانط أنّ كرامة الواجب مستقلة عن الإشباع الشخصي، مشددًا على أنّ الحياة الأخلاقية يجب أن تُحكم بالتشريع الذاتي العقلاني. فأيّ محاولة لدمج الواجب الأخلاقي مع السعي وراء الإشباع الشخصي تُقوِّض في النهاية الحياة الأخلاقية ذاتها (٤٥).
في ضوء هذا التحليل، يمكن القول إنّ انتشار الجريمة في المجتمع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفشل في العمل من منطلق الواجب، وهو، في نظر كانط، المعيار الوحيد للقيمة الأخلاقية. ومن ثمّ، فإنّ الوقاية من الجريمة لا تقوم على مجرد الامتثال للقوانين أو الأعراف الاجتماعية، بل على الأفعال التي تُؤدَّى بدافع الواجب الخالص.
ويتعين على القادة السياسيين، على وجه الخصوص، أن يدركوا أنّ مناصبهم ليست وسائل لتحقيق المكاسب الشخصية، بل هي مسؤوليات أخلاقية تُسهم في خدمة الصالح العام. وتؤدّي نزاهتهم الأخلاقية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الثقة العامة وترسيخ النظام المجتمعي.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون ضباط الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، بصفتهم كائناتٍ عقلانية، موجهين دومًا بالقانون الأخلاقي، وأن يستخدموا قدراتهم في جمع المعلومات والوقاية من الجريمة والكشف عنها في إطار منضبط بالعقل العملي. كما ينبغي أن يعمل المخبرون الذين يساهمون في هذه العمليات من منطلق الواجب الخالص، مختارين الخير بفضل إرادتهم العقلانية. وينبغي أن تتوافق أفعالهم مع قواعد يمكن تعميمها عالميًا، انسجامًا مع المبدأ الأخلاقي المطلق الذي صاغه كانط (٤٦).
ويجب أن تكون الإرادة، بوصفها قدرةً عقلانيةً تشريعيةً، هي القوة الموجِّهة لضباط الشرطة، تبعدهم عن المصالح الذاتية وتدفعهم نحو الواجب الأساسي المتمثل في الوقاية من الجريمة وخدمة العدالة. وعندما يلتزم العاملون في هذه المؤسسات بالمبدأ العقلاني للواجب، فإنهم لا يؤدّون التزاماتهم المهنية فحسب، بل يُسهمون أيضًا في تعزيز النسيج الأخلاقي للأمة.
وعلاوة على ذلك، فإنّ الانضباط الأخلاقي داخل أجهزة الشرطة والاستخبارات يُعدّ شرطًا ضروريًا لمكافحة الفساد وسائر الجرائم التي تهدّد الاستقرار الوطني. إنّ الحالة الأخلاقية الراهنة للأمة يمكن معالجتها بفاعلية من خلال عقيدة الواجب عند كانط، إذ تُعيد الاعتبار لمفهوم الاحترام العقلي للقانون الأخلاقي بوصفه أساس السلوك الإنساني الراشد. وفي النهاية، يجب أن يكون السعي نحو الأفعال النبيلة والمحمودة أخلاقيًا مستندًا لا إلى الدوافع العاطفية، بل إلى الاحترام العقلاني للواجب وحده. وعلى كل مواطنٍ أن يُدرك أنّ الفعل الأخلاقي الحقّ إنما ينبع من الواجب وحده، تأكيدًا لكرامة الكائنات العاقلة ورفعًا للقانون الأخلاقي بوصفه قوة تشريعية كونية شاملة (٤٧).
3- العدالة والمسئولية الاجتماعية عند جون رولز وهبرماس
يرى جون رولز أن أسمى مثال يمكن أن تسعى إليه الإنسانية هو العدالة، وهي تقتضي النظر إلى الإنسان بوصفه غايةً في ذاته لا وسيلةً لغيره. ورغم إقراره بأهمية مفاهيم مثل الاستقرار والإنتاج والكفاءة في المجتمع، فإن رولز يؤكد أن التركيز على العدالة، وعلى العلاقة بين المؤسسات والأسباب العادلة، يفوق كل تلك الاعتبارات أهمية. فوفقًا له، إن تحديد القيم التي تختارها البنى الاجتماعية المختلفة، وتوزيع الخيرات الأساسية بين أفراد المجتمع تبعًا لهذه القيم، هو ما يُشكّل العدالة.
ويرى رولز أن العدالة هي تقليد أخلاقي يتناول مسألة التوزيع المنصف للحاجات بين أفراد الجماعة. فالمجتمع، في نظره، يتكوّن من أفراد يعملون معًا لتكوينه، ويخضع كل عضو في المجتمع المنظم للمبادئ الأخلاقية نفسها، ويدرك أن المؤسسات الاجتماعية الكبرى عادةً ما تتمسك بهذه المبادئ. ويعتقد رولز أن العامل الأهم في إقامة العدالة هو البنية الأساسية للمجتمع، أي الكيفية التي تتفاعل بها مؤسساته الكبرى — كالأسرة والنظام السياسي والنظام الاقتصادي — لتؤثر في الفرص المتاحة للأفراد في حياتهم (٤٨).
ومن ثَمّ، تُصاغ مبادئ العدالة لتنظيم الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. فالعدالة الاجتماعية تفرض التزامات تبعية على الأفراد: فإذا وُجدت مؤسسات عادلة، وجب عليهم الالتزام بقواعدها؛ وإن لم توجد، وجب عليهم السعي لإقامة مؤسسات عادلة، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا ومن دون أن يفرض عبئًا مفرطًا على الفرد الساعي. ومن هنا، رأى رولز أن العدالة هي الإنصاف، لأن أي مجموعة من المبادئ التي يتفق عليها الجميع لا بد أن تكون منصفة للجميع أيضًا، إذ لا أحد سيقبل بها لو كانت جائرة عليه (٤٩).
تُعَدّ العدالة، وفقًا لجون رولز، الفضيلة الأساسية للمؤسسات الاجتماعية، والأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي. ويرى رولز أن جميع القرارات التشريعية والسياسية يجب أن تبقى ضمن الحدود التي تضعها قواعد العدالة. ويؤكد أن المجال الرئيس الذي تعمل فيه العدالة هو توزيع الخيرات، إذ يرى أن «الخيرات» هي ما يمتلكه الإنسان بعقله وإرادته، وتشمل كل ما يطمح إليه من الثروة والمكانة الاجتماعية والفرص والمواهب والاستقلال والاحترام الذاتي.
ويُعدّ رولز أبرز ممثلي الأخلاق التعاقدية المعاصرة، إذ «بحث في كيفية بناء النظام السياسي والمؤسسات على وفق مبادئ العدالة، التي اعتبرها في الأصل قيمةً أخلاقية». كما اختار رولز جانب الإيثار على حساب الأنانية، لأن مبدأه — بحسب هوفر، وهنت، وأوكهولم — يقوم على «عدم الانحياز في جانب الإيثار، إذ تُعتبر خيرية كل إنسان مساوية لغيره»، وهو المبدأ الذي طوّره رولز في كتابه نظرية في العدالة، حيث دافع عن فكرة أن العدالة هي الحقيقة (٥٠).
تندرج الأخلاق التعاقدية المعاصرة في إطار فئتين رئيسيتين. ورغم أن كلا الاتجاهين يتبنى الرؤية الكلاسيكية التي تقرّ بأن جميع البشر خُلقوا متساوين، فإنهما يتفقان أيضًا على أنه إذا اتُّفق على مبادئ معينة من الجميع، فلا يجوز التضحية بمصلحة أحد لصالح آخر. وتنطلق هذه الفكرة من أن مبادئ العدالة يجب أن تُبنى على عقدٍ افتراضي، غير أن الاتجاهين يختلفان في تفسيرهما لطبيعة المساواة الفطرية بين البشر.
فالتيار الأول، المستند إلى هوبز، يفسّر المساواة الطبيعية بأنها تفاوت في القوة الجسدية، ويرى أن هذا التفاوت يقود إلى إدراكٍ مشترك بضرورة اعتماد قواعد تحفظ حقوق الجميع. وقد تبنّى هذا التفسير فلاسفةٌ مثل ديفيد جوطييه وراسل، وهو يتعارض مع المفهوم التقليدي للعقد الاجتماعي الذي يرى أن البشر متساوون أخلاقيًا بطبيعتهم، وأن أهدافهم تخضع لاعتبارات موضوعية ومشتركة.
أما جون رولز، فهو من أنصار النظرية التعاقدية الأخلاقية التي يستند فيها إلى التصور الكانطي للمساواة الأخلاقية، لا إلى التصور الهوبزي (٥١).
يُحدِّد جون رولز مفهومين أساسيين للعدالة، يُشكِّلان جوهر نظريته في العدالة باعتبارها إنصافًا:
١- لكل فرد حقٌّ متساوٍ في أوسع نطاق ممكن من الحريات الأساسية، على أن تكون هذه الحريات متوافقة مع الحريات المماثلة للآخرين.
٢- يجب تنظيم أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وفق مبدأين فرعيين:
(أ) مبدأ الإنصاف في الحماية، بحيث تُوجَّه التفاوتات لخدمة مصلحة الأقل حظًّا في المجتمع بأكبر قدر ممكن.
(ب) مبدأ تكافؤ الفرص العادل، بحيث تُتاح المناصب والوظائف والمراكز للجميع على قدم المساواة.
ويُطلق رولز على هذه المبادئ أسماء محددة:
الأول هو مبدأ الحرية،
والثاني هو مبدأ الاختلاف،
والثالث هو مبدأ تكافؤ الفرص العادل.
ويُبيّن رولز أن هناك ترتيبًا هرميًا صارمًا بين هذه المبادئ، إذ إن المبدأ الأول، أي مبدأ الحرية، يتقدّم على المبدأ الثاني في الأهمية، كما أن البند (ب) من المبدأ الثاني — أي تكافؤ الفرص — يتقدّم على البند (أ)، وهو مبدأ الاختلاف. وهذا يعني أن تحقيق تكافؤ الفرص شرطٌ سابق لتحقيق العدالة في توزيع الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد رولز أن الالتزام بالمبدأ الأول ضروري لتأسيس البنية الاجتماعية والأفعال العادلة؛ إذ لا يمكن تطبيق المبدأ الثاني دون ضمان الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها المبدأ الأول. ومع ذلك، يسمح المبدأ الثاني بتنظيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ما دامت تلك التنظيمات تُسهم في تحسين أوضاع الفئات الأقل حظًّا في المجتمع (٥٢).
قدّم جون رولز أيضًا مفهوم واجب المساعدة (Duty of Assistance)، الذي يرى من خلاله أنّ الدول المتقدمة تتحمّل التزامًا أخلاقيًا تجاه الدول النامية أو المجتمعات المثقلة بالأعباء، يتمثل في مساعدتها على بناء مؤسسات عادلة وكافية من دون فرض قيمٍ أو نماذج محددة عليها، وذلك تمكينًا لها من بلوغ استقلالٍ مؤسسيٍّ حقيقي يضمن العدالة والرفاه لمواطنيها.
وفي المقابل، يتعيّن على الدول المتلقّية للمساعدة أن تُظهر التزامًا جادًّا بتطوير مؤسساتٍ تتوافق مع المبادئ الأساسية للعدالة. ومن خلال طرحه لمفاهيم مثل مجتمع الشعوب وواجب المساعدة، وضع رولز إطارًا نظريًا يوازن بين العدالة والسيادة والتضامن الدولي، ويهدف إلى بناء مجتمعٍ دولي أكثر عدالةً وانسجامًا من دون إغفال التنوّع الثقافي والسياسي بين الأمم.
وفي السياق المعاصر، أصبحت مفاهيم مثل التوافق المتداخل والعقل العمومي ذات أهمية خاصة في صياغة سياساتٍ شاملةٍ قائمةٍ على الحوار والتفاهم. أما على المستوى العالمي، فإن مبدأ واجب المساعدة يشكّل الأساس لتصميم سياسات المساعدات الدولية التي تركز ليس فقط على الرفاه الاقتصادي، بل أيضًا على بناء مؤسسات عادلة ومستدامة (٥٣).
تُعدّ العدالة الهدف الرئيس للنظام القانوني والسياسات العامة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق المساواة والتوزيع العادل في ظل ديناميات المجتمع. وفي سياق القانون الحديث، يتمثل التحدي الأساسي في ضمان أن يكون القانون ليس مجرد أداة لتنظيم العلاقات الاجتماعية فحسب، بل قادرًا أيضًا على التكيف مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتطورة. وأحد المناهج الفلسفية التي يمكن استخدامها لمواجهة هذا التحدي هو كتاب "نظرية العدالة" لجون رولز، الذي قدّم من خلاله مفهوم العدالة باعتبارها عدالة إنصاف، وهو ما يوفر إطارًا مفاهيميًا لتقييم الهياكل الاجتماعية والمؤسسات القانونية استنادًا إلى العدالة التوزيعية. (٥٤)
وفي عالم الأعمال، وخصوصًا في عملية دمج الشركات والاستحواذ عليها، تُعتبر العدالة أحد العناصر الحاسمة، إذ تهدف عملية الدمج والاستحواذ غالبًا إلى خلق قيمة مضافة، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الحصة السوقية، أو تحقيق وفورات في التكاليف. ومع ذلك، تثير هذه العملية تحديات تتعلق بتوزيع المنافع والأعباء بين المساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وفي سياق الشركات الحديثة، أصبحت مبادئ رولز ذات صلة خاصة، ولا سيما في عملية دمج الشركات بعد الاستحواذ، التي غالبًا ما تؤثر على حقوق ومصالح المساهمين الأقلية. كما أن مبدأ رولز في العدالة التوزيعية ذو أهمية لضمان توزيع المنافع الناتجة عن إجراءات الشركات بطريقة متناسبة وعادلة. (٥٥)
ويرى جون رولز في نظريته الشهيرة "نظرية العدالة" أن الإنسان كائن أخلاقي يسعى إلى بناء مشروع حياته ضمن نظام من التعاون الاجتماعي العادل. ومن ثمّ، فإن المجتمع العادل هو الذي يوفّر للأفراد ما يُسميه «السلع الأساسية»، التي تشمل الحريات والفرص والدخل والثروة والاحترام الذاتي. (٥٦) ويُعدّ الاحترام الذاتي حجر الأساس في هذه السلع، لأنه يُعبّر عن شعور الفرد بقيمته كمواطن متكافئ داخل المجتمع. فالعمل أو المهنة التي يختارها الإنسان ليست مجرّد وسيلة للعيش، بل هي مجال لتحقيق الكرامة والمشاركة في الحياة العامة. لذلك يجب أن تكفل العدالة توزيع الفرص المهنية توزيعًا متكافئًا حتى لا تُهدر كرامة الإنسان أو يُقصى من دائرة التعاون الاجتماعي. (٥٧)
ولم يتناول رولز البطالة القسرية مباشرة، لكنه أشار إلى أن النظام الاقتصادي العادل ينبغي أن يضمن تكافؤ الفرص ويُحقق المنفعة المشتركة. فحرمان الأفراد من العمل لا يعني فقط حرمانهم من الدخل، بل من المشاركة الفعلية في الحياة العامة. ولهذا يرى عدد من الباحثين المعاصرين أن منسوب العدالة في المجتمع يُقاس بقدر ما يُوفّر من فرص عمل حقيقية لكل من يرغب في العمل. (٥٨) وتذهب بعض الدراسات إلى ضرورة إدراج مبدأ التوظيف الكامل ضمن قائمة السلع الأساسية التي يفاضل فيها الأفراد في «الموقف الأصلي»، بحيث لا يكون العمل حقًّا اختياريًا، بل مكوّنًا جوهريًا من العدالة الاجتماعية. (٥٩)
وقد أشار رولز في موضع من كتاباته إلى أن الدولة يمكن أن تؤدي دور «صاحب العمل الأخير» لضمان عدم وجود بطالة قسرية. (٦٠) إلا أن هذه الفكرة لم تُدمج رسميًا في بنية نظريته، وهو ما دفع بعض الباحثين — مثل باربرا فريد — إلى القول إن «الرد الرولزي على الليبرتارية يمثل فصلاً غير مكتوب من نظرية العدالة». (٦١) فلو تم إدراج العمل ضمن السلع الأساسية، لأصبحت العدالة ملزمة بتوفير نظام اقتصادي يضمن التوظيف الكامل لكل المواطنين القادرين والراغبين في العمل. وهذه الإضافة ستمنح النظرية بُعدًا مؤسسيًا جديدًا يربط بين العدالة الاجتماعية وسياسات التشغيل، وهي خطوة نحو دمج فلسفة رولز مع الاقتصاد العملي وقانون العمل. (٦٢)
أما يورجن هبرماس فيُعدّ أحد أبرز المفكرين الألمان في القرن العشرين، وقد قدم إسهامات مهمة في الفلسفة الاجتماعية والسياسية. وتتركز أعماله على الفعل التواصلي (Communicative Action) كأساس لفهم العدالة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الحديثة. (٦٣) ويرى هبرماس أن العدالة لا تُفهم فقط عبر توزيع الموارد، بل من خلال عملية تواصلية تشاركية تُفضي إلى توافقات معقولة بين الأفراد. ففي كتابه "نظرية الفعل التواصلي"، يشير إلى أن العدالة تتحقق عندما يتفق الأفراد على قواعد سلوكية تُحترم عالميًا وتُستند إلى التفاهم المتبادل. (٦٤)
ويربط هبرماس المسؤولية الاجتماعية بالحياة المشتركة، التي تُشكّل السياق الثقافي والاجتماعي للأفراد، إذ يتحمل الأفراد مسؤولية تجاه بعضهم البعض عبر التفاعل التواصلي الذي يؤدي إلى فهم مشترك وتوافقات أخلاقية. (٦٥) وتقوم نظرية الفعل التواصلي عنده أساسًا على تمييزٍ بين مفهومين للعقلانية يوجِّهان المعرفة ويحددان كيفية توجيه الفعل:
أولًا: العقلانية المعرفية–الأداتية، وهي التي تقوم على توجيه الفعل نحو تحقيق أهداف خاصة يحددها الفاعل مسبقًا، وتنقسم هذه الأفعال إلى نوعين:
١. الفعل الأداتي: عندما يكون الهدف هو التأثير الفعّال في حالة من حالات الواقع (كما في العمل والإنتاج).
٢. الفعل الاستراتيجي: عندما يسعى الفاعل إلى التأثير في قرارات الآخرين لتحقيق غاياته الخاصة (كما في علاقات السيطرة أو الهيمنة).
ثانيًا: العقلانية التواصلية، التي تقوم على أفعال موجَّهة نحو التفاهم المتبادل، أي تلك التي تهدف إلى تحقيق اتفاق بين الذوات المتخاطبة من أجل توحيد تفسيراتهم للعالم وتناغم رؤاهم المشتركة حوله. (٦٦)
ووفقًا لهبرماس، ترتبط عملية الشرعية بتقييمات ادعاءات الصلاحية مثل الصحة، والعدالة، والكفاية، والصدق، وقابلية الفهم المدمجة ضمن عملية الاتصال نفسها. ويشير هذا إلى مفهوم "الفعل التواصلي"، الذي يرى هبرماس أنه محوري في عملية الشرعية. فالفعل التواصلي يرتبط بكيفية تقييم الأفراد لشرعية الأفعال الكلامية باعتبارها مسألة تشكيل مواقفهم الأخلاقية، وكذلك المجتمع الأوسع الذي ينتمون إليه. وتشمل هذه التقييمات تطوير "الكفاءة التواصليّة" كأساس للتعلم الأخلاقي، ولقدرة الأفراد على التوسط بين الاهتمامات الجوهرية والداخلية في أحكامهم حول ادعاءات الصلاحية. (٦٧)
ويُبرز هبرماس مركزية الحركات الاجتماعية في عملية الشرعية، إذ يرى أن الحركات الاجتماعية: «تحاول طرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره، وتحديد طرق جديدة لمعالجة المشكلات، واقتراح حلول ممكنة، وتوفير معلومات جديدة، وتفسير القيم بشكل مختلف، وتحفيز الأسباب الصالحة وانتقاد الأسباب السيئة». ويجادل هبرماس بأن صراع الشرعية الذي تسهم فيه الحركات الاجتماعية يُخاض عبر الفعل التواصلي في المجال العام. كما يرى أن: «التأثير المحوَّل إلى قوة تواصليّة يُشرّع القرارات السياسية». (٦٨)
٤- البعد الإنساني في الوظيفة العامة بين العقلانية والمنفعة:
إن استخدام مبدأ العقلانية في علم الاقتصاد يسبق ظهور النفعية التي كثيرًا ما يُخلَط بينهما. ففي حديث آدم سميث عن تقسيم العمل، يصف قبيلة من الصيادين يكون أحد أفرادها ماهرًا على نحوٍ خاص في صناعة الأقواس والسهام. يقول سميث: «كان هذا الرجل كثيرًا ما يُبادِل ما يصنعه من أقواس وسهامٍ بلحوم الغزلان أو الماشية مع رفاقه، ثم أدرك في نهاية الأمر أنه يستطيع بهذه الطريقة أن يحصل على كميةٍ أكبر من الغزلان والماشية مما لو خرج بنفسه إلى الحقول للصيد. ومن منطلق عنايته بمصلحته الخاصة، أصبحت صناعة الأقواس والسهام عمله الرئيسى». غير أن الانتقال من الحدس إلى التحليل يتطلّب فهمًا دقيقًا لما يعنيه «الاهتمام بالمصلحة الخاصة»، وهو ما أصبح مصدرًا لنقاشٍ لا ينتهي بين علماء الاجتماع والاقتصاد القائمين على نموذج الفاعل العقلاني. (٦٩)
ويُستمد مفهوم العقلانية القائمة على تعظيم المنفعة من النفعية التي وضع أسسها بنتام وجون ستيوارت مل، إذ يقول بنتام: «لقد وضعت الطبيعةُ البشرَ تحت سيادة سيّدين اثنين: الألم واللذة. فهما وحدهما من يُحدّدان ما ينبغي علينا فعله، كما يُحدّدان ما سنفعله بالفعل...». ورغم أنّ عددًا من المفكّرين — مثل جيفنز ومنجر وفالراس — قد جرّبوا مقاربات نفعية في التحليل الاقتصادي، فإنّ المنفعة لم تبدأ في احتلال موقعها المحوري في التحليل الاقتصادي إلا في سبعينيات القرن التاسع عشر بفضل أعمال هؤلاء الثلاثة. فقد كانت المنفعة لديهم اختصارًا نظريًّا لمفهوم القيمة، وهو ما جعلهم لا يُولون اهتمامًا كبيرًا لمسائل مثل قابليّة قياس المنفعة أو إمكان المقارنة بين منافع الأفراد. (٧٠)
ومن هذا التطور النظري، برزت الافتراضات المكوِّنة للمفهوم النيوكلاسيكي للسلوك العقلاني للفاعل الاقتصادي، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
١- الفاعل الاقتصادي يختار من مجموعة مغلقة من البدائل المعطاة والمعلومة مسبقًا (المجموعة المسموح بها).
٢- يمتلك الفاعل جميع المعلومات ذات الصلة بكل بديل من البدائل المتاحة.
٣- تكون تفضيلات الفاعل محددة خارجيًا، وهي كاملة وانتقالية ومستقرة.
٤- تكون دالة المنفعة الخاصة بالفاعل محددة بوضوح، وتعكس بالأساس تفضيلاته.
٥- يسعى الفاعل إلى تعظيم المنفعة المتوقعة وتقليل التكاليف في ظلّ قيودٍ معيّنة (كما لو كان يحلّ مسألة رياضية للبحث عن القيمة القصوى المقيّدة لدالة المنفعة المتوقعة ضمن المجموعة المسموح بها).
٦- لا يتأثر اختيار الفاعل الاقتصادي بطريقة عرض المشكلة أو صياغتها (بما في ذلك التحيّزات أو الخرافات أو غيرها من المؤثرات).
٧- مبدأ الفردانية المنهجية: الفرد هو الوحدة الوحيدة لاتخاذ القرار.
٨- مبدأ الوضعية المنهجية: إن قدرة النموذج على إنتاج تنبؤات دقيقة هي المعيار الوحيد لصحته. (٧١)
والافتراض الرئيس في هذا النموذج هو أن الفاعل الاقتصادي يتخذ قراراته وهو على علمٍ تام بجميع البدائل الممكنة، ويدرك حدود قدراته، ويسعى — في ضوء تلك الحدود — إلى اختيار أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافه.
أما الشروط المسبقة لاتخاذ القرار في نظرية المنفعة المتوقعة، فيمكن تلخيصها على النحو الآتي:
١- تحديد دالة المنفعة الكلية للفاعل الاقتصادي الذي يتخذ القرار تحديدًا صحيحًا.
٢- إمكانية التعبير عن مستوى المنفعة الكلية في المواقف أو الحالات المستقبلية أيضًا.
٣- معرفة الفاعل للتوزيع الذاتي (الذاتي التقدير) لاحتمالات نتائج كل بديل من البدائل الممكنة.
٤- اتخاذ القرار ضمن مجموعة مغلقة من البدائل المعطاة والمعروفة.
والغاية من الاختيار هي تعظيم القيم المتوقعة لدالة المنفعة الكلية المحددة. (٧٢)
كما أن النموذج البشري الذي هيمن على التوجه التقليدي الجديد في الاقتصاد يتألف من افتراضين جوهريين منفصلين: العقلانية والمصلحة الذاتية. يُفترض أن الفاعلين يتصرفون بعقلانية في سبيل تحقيق ما يرغبون في تحقيقه، وأن ما يرغبون في تحقيقه يُفترض أن يُحدّد بمصطلحات رفاههم الشخصي. من الناحية التقنية، تم تحديد هذا المفهوم للسلوك العقلاني والمصلحة الذاتية باعتباره افتراضًا بأن الفاعلين يعظمون دالة المنفعة مع مراعاة القيود التي يواجهونها. في هذا البناء، يتم تحديد عنصر العقلانية في النموذج الاقتصادي للإنسان من خلال افتراض التعظيم، بينما يتم تحديد عنصر المصلحة الذاتية من خلال المكونات المدرجة في دوال المنفعة. في الواقع، يُختزل الفاعلون الذين يشغلون النماذج الاقتصادية القياسية أساسًا إلى تلك الدوال. وبمجرد تحديدها للفاعلين، لا يحتاج الاقتصادي المحلل إلى معرفة المزيد عنهم من أجل التنبؤ بما سيختارونه، بالنظر إلى خيارات الاختيار والقيود التي يواجهونها. (٧٣)
أما المبادئ الأخلاقية ومعايير العدالة والإنصاف، فعادةً ما تتعلق بالأفعال نفسها لا بالنتائج. فهي تمثل قواعد للسلوك توجب على الأفراد التصرف بعدل ونزاهة وأخلاقية، مثل عدم السرقة، وعدم الكذب، والوفاء بالوعود. وهذه المبادئ تركز أكثر على الطريقة التي يسعى بها الشخص لتحقيق ما يريد، وليس فقط على ما يريد تحقيقه. وإذا كان لمفهوم "التفضيل الأخلاقي" أن يكون له معنى، فهذا يعني تفضيل التصرف وفقًا للقواعد الأخلاقية. وبمعنى آخر، فإن التفضيلات الأخلاقية هي تفضيلات على الأفعال نفسها، وليس على النتائج التي قد تنتج عنها. (٧٤)
ويمكن حساب التعاطف بسهولة ضمن إطار الاختيار العقلاني، ببساطة عن طريق توسيع مفهوم المصلحة الذاتية. «إن كون المرء مهتمًا بمصلحته لا يتطلب أن يكون أنانيًا بأي شكل، إذ يمكن للمرء أن يشعر بالمتعة والألم نتيجة التعاطف مع الآخرين، وهذه المتع والآلام هي جوهرًا ملك له». وليس فقط أن الاهتمام بالآخرين يمكن استيعابه بسهولة ضمن دالة المنفعة للأشخاص المعنيين، بل إن الاهتمام بأي نوع من الأهداف أو القيم التي قد يُفترض أن يسعى الشخص لتحقيقها يمكن أن يُؤخذ في الحسبان ضمن إطار الاختيار العقلاني، إذا عُرّف «الاختيار العقلاني» بالحد الأدنى باعتباره تعظيم مقياس قابل للتحديد. (٧٥)
إنّ ما يميز السلوك البشري في الواقع هو أن الناس يتصرفون كأتباعٍ للقواعد، لا كمنظِّمين لتحقيق الأهداف وفقًا لما تفترضه نظرية الاختيار العقلاني المعيارية. وهو ما يمكّنهم من تحقيق العديد من المنافع المتبادلة الناتجة عن التعاون، تلك التي تبدو مستحيلة المنال بالنسبة للفاعلين الاستراتيجيين الذين يسعون إلى أقصى درجات التعظيم العقلاني لمنافعهم. فالمواقف القائمة على التبعية المتبادلة في القرارات، كما يُمثَّل لها نموذجيًا في «لعبة السجين»، هي النوع الدقيق من الحالات التي لطالما أدّت فيها القواعد الأخلاقية للسلوك دورًا أساسيًا. فالمواقف المشابهة للّعبة السجينة تتكرر كثيرًا في حياتنا اليومية، وبعض القواعد التقليدية للسلوك الحسن تتخذ شكل الدعوة إلى تعليق الحسابات القائمة على العقلانية الفردية.
فالسلوك القائم على اتباع القواعد يرتبط بتفضيلاتٍ تتعلق بالأفعال ذاتها، لا بالتفضيلات العادية المرتبطة بالنتائج. وتقترب هذه المسألة من الفكرة العامة لآدم سميث، ومفادها أنّ العديد من الأنماط السلوكية يمكن تفسيرها على نحوٍ أفضل إذا فهمنا موقف الناس من الأفعال ذاتها، لا من تقييمهم للنتائج النهائية. وبالمثل، منح إيمانويل كانط مكانةً مركزية في الأخلاق الاجتماعية لمفهومه عن «الأمر المطلق». ومع أن تركيز كلٍّ من سميث وكانط هو معياريّ أكثر منه وصفيّ، فإن تحليلهما مرتبط ارتباطًا وثيقًا، إذ كلاهما رأى أنّ السلوك الفعلي للبشر يقوم جزئيًا على معايير أخلاقية. وقد تضمّنت تحليلاتهما السلوكية النظر إلى عملية الاختيار الواقعية من خلال مجموعة القواعد، لا فقط من خلال تفضيلٍ شاملٍ يأخذ كلّ شيء في الحسبان. (٧٦)
5- البعد الأخلاقي في ممارسة الوظائف العامة:
نسعى هنا إلى توضيح دور الأخلاق في الخدمة العامة بوصفها جزءًا من مفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك من منظور الإدارة العامة، بهدف تحديد القيم الأخلاقية التي تُتَّخذ كإرشادات معيارية، ويلتزم القائمون على الإدارة الحكومية بها من أجل تحقيق الصالح العام. إنّ الأخلاق في ممارسة الإدارة العامة يجب أن تمثّل الضوابط والمعايير التي تنظّم أنماط السلوك المؤسسي، إذ تُعَدّ المنظمات العامة مؤسساتٍ تتعامل مباشرة مع المجتمع، ولذلك ينبغي أن يتحلّى القائمون على الشأن العام فيها بالمواقف والسلوكيات التي تعكس النموذج الأخلاقي القويم. (٧٧)
وفي التطبيق العملي، إذا تمكّن المسؤولون الإداريون من تطبيق القيم والمبادئ الكامنة في أخلاقيات الإدارة العامة، أمكن لأعمالهم أن تسير بسلاسة، وأن تُسهم في تحقيق الحوكمة الرشيدة، كما يسهم ذلك في تشكيل شخصية الأفراد بحيث يتّصفون بالانضباط، واللباقة، والمسؤولية، والمهنية العالية. فالأخلاق تُعَدّ أحد العوامل الأساسية التي تحدد نجاح أهداف أنشطة منظمات الإدارة العامة، وبالتالي دعم تحقيق التحوّل نحو الحوكمة الرشيدة. (٧٨)
ومن هذا المنطلق، فإنّ المؤسسات، بوصفها فاعلين في الإدارة العامة، تسعى إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة، ومن ثَمَّ ينبغي عليها أن تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق القيم الأخلاقية للإدارة العامة، لأنّ هذه القيم ترتبط بجميع مراحل العملية الإدارية العامة، بدءًا من صياغة السياسات مرورًا بتنفيذها ووصولًا إلى تقييمها بهدف تقديم خدمات عامة جيدة ومتكاملة. ومن الضروري العمل على رفع جودة الخدمات العامة المقدَّمة للمجتمع، وهو ما يستلزم تحسين نظام الخدمة العامة ذاته لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين. إنّ التنفيذ الفعّال والكفء للخدمات العامة يُعدّ واجبًا أساسيًا على المسؤولين القائمين على الشأن العام، من أجل ضمان حقوق المواطنين في الحصول على مختلف أشكال الخدمات العامة، سواء كانت سلعًا أو خدمات، على أن يتم ذلك وفقًا للأنظمة والقوانين السارية، وبما يتوافق مع حاجات المجتمع ومصالحه العامة. وتتطلّب الحوكمة الرشيدة أن تُعطى الأولوية للقيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه السلوك الإداري لتحقيق أفضل أداء ممكن في الخدمة العامة. (٧٩)
لقد أصبح الموظفون العموميون أكثر وعيًا أخلاقيًا مما كانوا عليه في السابق، خصوصًا في مجالات مثل مكافحة التمييز، والتنمر الإداري، وتلقّي الهدايا، والمحسوبية السياسية، والشفافية، والمساءلة. وخلال العقود الأخيرة، خصّصت الدول الأعضاء في المنظمات الدولية موارد كبيرة لوضع معايير أخلاقية واضحة. وتتفق جميع الدول الأعضاء على أنّ الأخلاقيات العامة تمثّل عنصرًا أساسيًا لعدة أسباب:
١- المؤسسات العامة تحمي الدول من التهديدات الخارجية والداخلية.
٢- الحكومات تستخدم وسائل – كالقوة أو التهديد بها – تؤثر في مصير الجميع.
٣- تتدخل السلطات العامة وبعض فئات الموظفين العموميين (مثل القضاة ورجال الشرطة والعسكريين) في الحقوق الشخصية للأفراد.
٤- يوفر الموظفون العموميون سلعًا وخدماتٍ ذات قيمة كبيرة للمواطنين، مثل الرعاية الصحية وفرص العمل.
٥- يشرف الموظفون العموميون على الأموال العامة التي يمنحها البرلمان المنتخب من قبل المواطنين، ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية في أوقات القيود المالية، إذ تتحمّل الخدمة العامة مسؤولية إدارة تلك الأموال بكفاءة وفاعلية ونزاهة. (٨٠)
ومن ثمّ، فإنّ الموظفين العموميين والمؤسسات العامة يمتلكون تأثيرًا كبيرًا في رفاهية المجتمعات، ولهذا السبب ينبغي أن تُوجَّه أعمالهم وفقًا لقواعد وسياسات تمنعهم من التصرف بطرق غير أخلاقية. وقد سادت لفترةٍ طويلةٍ آراء مفادها أن الموظفين المدنيين مرتبطون بسلطة الدولة ولا يمكن مقارنتهم بغيرهم من الموظفين العموميين أو العاملين في القطاع الخاص، إذ مُنحوا صفةً قانونيةً عامة – على الأقل في معظم الدول – من أجل ربطهم بالدولة وبسيادة القانون، لا بمصالح الأفراد. ويعود أصل هذه الصفة القانونية العامة إلى الثورة الفرنسية التي هدفت إلى إقامة وضمان مجتمع ديمقراطي يستند إلى مبادئ الثورة.
وفي ألمانيا، استُلهم إدخال هذه الصفة القانونية العامة من الفيلسوف فريدريك هيجل، إذ تصوّر الموظف المدني والدولة ككيانٍ واحد أشبه بـ«الوحش ليفياثان» الذي يقف فوق المجتمع والمواطنين، وكان دوره الرئيس يتمثل في حماية المجتمع من خلال فرض القوانين لتحقيق العدالة وموازنة المصالح الأنانية المتعارضة داخل المجتمع. أما التعريف الأكثر تأثيرًا للبيروقراطية فيعود إلى ماكس فيبر، الذي قدّمه في محاضرته الشهيرة «السياسة بوصفها حرفة» عام ١٩١٩، حيث عرّف دور الموظفين العموميين على النحو التالي:
«يتجلّى شرف الموظف المدني في قدرته على تنفيذ أوامر السلطات العليا بضمير حيّ، تمامًا كما لو أن هذه الأوامر تتفق مع قناعته الشخصية. وينطبق ذلك حتى لو بدا له أن الأمر خاطئ، وإذا ما أصرت السلطة على تنفيذه رغم اعتراض الموظف. فبدون هذا الانضباط الأخلاقي وهذا التفاني الذاتي بأسمى معانيه، سينهار الجهاز الإداري بأكمله». (٨١)
اليوم، يتزايد الوعي بأن العمل في المجال العام أصبح أكثر تعقيدًا، ولم يعد محكومًا بمبدأ العقلانية كما تنبأ به فيبر. ففي الواقع، يرى الخبراء المعاصرون أن الموظفين المدنيين لا ينبغي النظر إليهم كعجلات في آلة ضخمة، إذ أصبح العمل في القطاع العام أكثر طابعًا فرديًا، ومحملًا بالقيم، وعاطفيًا، وتعدديًا، وغير متوقع أكثر من أي وقت مضى. فعلى سبيل المثال، يمتلك الموظفون العموميون المعاصرون قدرةً أكبر على اتخاذ القرارات الفردية مما كان يتوقعه فيبر. وقد أوضح العديد من الباحثين أن التمسك المفرط بالقواعد يمكن أن يكون مشكلة في حد ذاته. ومع ذلك، لا تزال سيادة القانون والقانون الإداري تشكلان المبادئ الجوهرية لجميع الأنظمة الإدارية في أوروبا. ومن المثير للدهشة أن النقاشات حول أهمية القانون، وخاصة القانون الإداري، والمبادئ الإدارية، لم تحظَ بدور رئيسي خلال الفترة الذهبية للإدارة العامة الجديدة، وربما يعود ذلك إلى أن القانون الإداري كان يُنظر إليه غالبًا كقيد يعرقل الخيارات السياسية وإصلاح السياسات، كما اعتُبر الإفراط في استخدامه سببًا في ضعف كفاءة القطاع العام. ونتيجة لذلك، وُصِف السلوك الإداري التقليدي بأنه جامد، ومقيّد بالقواعد، ومركزي، ومهووس بتحديد كيفية إنجاز الأمور، أي أنه يركّز على تنظيم الإجراءات والتحكم في المدخلات، بينما يتجاهل النتائج النهائية تمامًا. وهكذا، أصبحت نظريات الإدارة العامة الجديدة مهيمنة على النقاشات الاقتصادية والسياسية والتنظيمية. (٨٢)
إنّ النقاشات حول الأخلاق والنزاهة تمتلك تاريخًا طويلًا داخل شبكة الإدارة العامة الأوروبية. ففي عام ٢٠٠٤، قامت الرئاسة الأيرلندية والهولندية للاتحاد الأوروبي بتكليف دراستين حول الأخلاق والنزاهة في دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، تلاها في عام ٢٠٠٦ عمل الرئاسة الفنلندية على متابعة هذا الموضوع. وفي عام ٢٠٠٧، كلّفت المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة تجريبية حول تنظيم تضارب المصالح لدى شاغلي المناصب العامة في دول الاتحاد الأوروبي، بدعم من شبكة الإدارة العامة الأوروبية. كما دعمت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي عام ٢٠٠٨ دراسةً حول النجاحات والإخفاقات في مجال إدارة الموارد البشرية، تضمنت فصلًا خاصًا عن الأخلاق والثقة العامة، وأعقبتها في عام ٢٠٠٩ دراسة حول تعزيز الثقة في الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الأوروبي غير الرسمي الخاص بالإدارات العامة المركزية. (٨٣)
نظرًا لأن مهنة التدريس تُعدّ من أسمى المهن في هذا العالم، فإنه ينبغي، من أجل بناء مهنة تعليمية قوية وفعّالة، أن يتحلى المعلم بالالتزام تجاه طلابه، وأن يضمن تحقيقهم للتعلّم المنشود. وكما هو الحال في سائر المهن الرفيعة، توجد معايير أخلاقية ضرورية لمهنة التعليم أيضًا. فوظيفة المعلم في العصر الحاضر تختلف كثيرًا عن وظيفة المعلمين في العصور القديمة الذين كانوا يعيشون حياة بسيطة ويولون أهمية كبرى لمستوى الممارسة الرفيع والتفكير السليم. أما اليوم، فيُتوقَّع من المعلمين أداء أدوار متعددة ومتنوعة لجعل المدرسة مؤسسة فعّالة ومنتجة. ولتحقيق هذه الأدوار، يحتاج المعلمون المعاصرون إلى قدر عالٍ من المهارة والكفاءة والتأهيل لتلبية متطلبات العصر الراهن، لذا ينبغي للمعلم أن يطوّر قدراته في جميع مجالات مهنته، سواء على مستوى التعلم المهني أو في خضمّ طموحاته الحياتية كافة. (٨٤)
وبما أنّ مهنة التدريس تُعدّ من أنبل المهن، فإن بناء مهنة تعليمية قوية وفعّالة يستلزم التزام المعلم تجاه طلابه وضمان تحصيلهم العلمي. وكما هو الحال في سائر المهن المرموقة، هناك قواعد وأنظمة ومعايير أخلاقية تحكم كل مهنة، سواء كانت مفروضة ذاتيًا أم من قِبل جهات مختصة. وعلى هذا النحو، تقوم مهنة التعليم على مجموعة من المعايير الأخلاقية الأساسية، وهي كما يلي:
1- الرعاية: تشمل التعاطف مع المهنة، والاهتمام بالتدريس، والبصيرة اللازمة لتطوير قدرات الطلاب. يجب على المعلمين التعبير عن التزامهم المهني تجاه طلابهم بالسعي لرفاههم وضمان تعلّمهم، من خلال أساليب التأثير الإيجابي، والقدرة المهنية، والتعاطف الإنساني في الممارسة التربوية.
2- الاحترام: يشمل شعور المعلم الداخلي بالقيمة والتقدير، الضروري لتحقيق المعايير الأخلاقية المرتبطة بالتقدير والكرامة الإنسانية، ويسهم في الحفاظ على التوازن العاطفي وتعزيز النمو المعرفي المستمر.
3- النزاهة: تقوم على الصدق، الأمانة، الشعور بالمسؤولية، والممارسات الأخلاقية السليمة، وهي عناصر جوهرية للحفاظ على النزاهة المهنية.
4- المساءلة: تهدف إلى توجيه السلوك المهني نحو الالتزام بالقيم، ومعالجة الانحرافات الأخلاقية أو التهاون في الالتزام بالمعايير المهنية.
5- الرضا الذاتي: يُعدّ شرطًا ضروريًا لحياة سعيدة وناجحة، إذ يعكس شعور المعلم بالرضا الداخلي المبني على الكرامة والاحترام الذاتي، ويُمكّنه من إسعاد الآخرين بفعالية.
6- الثقة: تعتبر الثقة أساس العلاقة بين المعلم وطلابه، وكذلك مع الزملاء وأولياء الأمور، وتشمل قيم العدالة، الانفتاح، والصدق.
7- توجيه السلوك والتصرف: يُسهم مستوى الأخلاق المهنية لدى المعلم في غرس القيم الأخلاقية في طلابه وتنمية شخصياتهم المتكاملة.
8- الشخصية المتوازنة: يُتوقع من المعلمين إظهار سلوك قويم يُعتبر نموذجًا يُحتذى به للمعلمين الآخرين والطلاب، ما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع بأكمله.
9- أن يكون المعلم قدوة: يميل الطلاب إلى تقليد سلوك معلميهم وأعمالهم الحسنة، لذا فإن المعلم الذي يتصرف بطريقة إيجابية ومُلهمة يُحفّز طلابه على تبني نفس السلوكيات.
1- - تطوير المجتمع: يتفاعل المجتمع مع العملية التعليمية، لذلك فإن بناء مجتمع أخلاقي يتطلب معلمين قادرين على غرس المبادئ والقيم الأخلاقية في نفوس الطلاب، لمواجهة التدهور القيمي الراهن.
11- الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية: تُعد القواعد والمبادئ الأخلاقية ضرورية لتوجيه الرؤية والمسار المهني في أي مهنة، ويجب أن تُبنى هذه القواعد على أساس مفهوم الأخلاق المهنية لضمان تحقيق أهداف التعليم على جميع المستويات. (٨٥)
المحور الثالث: الوظيفة العامة كواجب أخلاقي
1- الالتزام بالقوانين والقيم العامة:
وفقًا لمجلس كيبيك، إحدى المقاطعات الكندية، عند النظر في تنظيم أي مهنة والإشراف عليها من قبل هيئة مهنية، يجب أخذ عدة جوانب في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الحاجة للتنظيم قائمة. هذه الجوانب تتعلق بطبيعة الأنشطة المهنية وخصائص الأفراد الذين يمارسونها، وتشمل ما يلي:
١- المعرفة المطلوبة لممارسة المهنة: مدى تعقيد المعلومات والخبرات الضرورية لممارسة الأنشطة المهنية بشكل كفء وفعّال.
٢- درجة الاستقلالية للممارسين: مدى قدرة الممارسين على اتخاذ قرارات مهنية مستقلة، والصعوبة التي قد يواجهها الأشخاص غير المؤهلين أو غير المدربين في تقييم هذه الأنشطة.
٣- الطابع الشخصي للعلاقات المهنية: الطبيعة التفاعلية بين الممارسين والأشخاص الذين يلجأون إلى خدماتهم، مع الأخذ في الاعتبار الثقة الخاصة التي يجب أن يضعها العملاء في الممارسين.
٤- خطورة الضرر المحتمل: مدى تأثير الإهمال أو نقص الكفاءة على الأفراد الذين يتلقون الخدمات، ومدى أهمية الإشراف لضمان حماية المستفيدين.
٥- الطبيعة السرية للمعلومات: نوعية وحساسية المعلومات التي يطلع عليها الممارسون أثناء ممارسة مهنتهم، والتي تتطلب الحفاظ على السرية المهنية. (٨٦)
تُظهر هذه المعايير مدى الترابط بين الجانب المهني والأخلاقي، إذ تمثّل الأخلاق عنصرًا حاضرًا في كل نشاط إنساني منظم. فالأخلاق موجودة في كل مكان، ولا تقتصر أهميتها على تزايد توقعات الجمهور بشأن جودة الخدمات العامة أو مصداقية الموظفين العموميين، بل تمتد إلى قضايا حديثة تشمل المسؤولية الاجتماعية للشركات العالمية، ورواتب كبار المديرين التنفيذيين، والفوائد الطبية للهندسة الوراثية، وقضايا القتل الرحيم، وأخلاقيات الاستثمار الأخضر، والتأثيرات الاجتماعية والثقافية للإعلام الجديد، والمسؤولية عن تغيّر المناخ، ومتطلبات الغذاء الصحي، وسياسات مكافحة التدخين، ومبادئ الشفافية والمساءلة، وغيرها من الموضوعات التي تعكس أهمية القيم والمبادئ في الحياة العامة. وفي مجال أخلاقيات الخدمة العامة، أصبح تحقيق روح الصدق والشفافية بمثابة "الكأس المقدسة" التي يسعى الجميع إلى بلوغها. كما يقوم مفهوما الحوكمة الرشيدة والأخلاق على فرضية أنه يمكن تحديد معنى "الإدارة الجيدة" والسلوك الأخلاقي، ويتطلّب ذلك نقاشًا حول القيم والمبادئ وما ينبغي تحقيقه ولماذا. (٨٧)
وفي هذا السياق، لا يزال مفهوم الأخلاق والسلوك الأخلاقي متأثرًا بتمييز أرسطو بين الفضائل والرذائل؛ فالفضائل تمثل الجوانب الإيجابية للسلوك الإنساني، والرذائل تمثل الجوانب السلبية منه. وتعرّف الفضيلة بأنها سلوك يعكس معيارًا أخلاقيًا رفيعًا ونمطًا من التفكير والسلوك المبني على أسس أخلاقية سامية. واليوم، تكاد لا توجد منظمة عامة تعمل دون مبادئ دستورية ومدونات أخلاقية تحدّد مجموعة الفضائل والمبادئ التي ينبغي على الموظفين العموميين الالتزام بها. وقد عرّف أرسطو الفضيلة في كتابه الأخلاق النيقوماخية بأنها نقطة الوسط بين الإفراط والتفريط في صفة معينة؛ فالشجاعة هي الحدّ الوسط بين الجبن والتهوّر، والتسامح هو التوازن بين ضيق الأفق والمبالغة في القبول، بينما الرذائل هي النقيض المباشر للفضائل. (٨٨)
وفيما بعد، شكّك الفيلسوف كانط في جدوى هذا التمييز البسيط بين الفضائل الحسنة والرذائل السيئة، مؤكدًا أن معظم الفضائل والرذائل تتسم بالغموض والالتباس، ويجب الحكم عليها ضمن سياق محدّد، وبالنظر إلى ما إذا كانت تخدم مبدأً أخلاقيًا أم لا. وفي كتابه ميتافيزيقا الأخلاق، ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: "لا يمكن تصوّر أي شيء في العالم، أو حتى خارجه، يمكن أن يُسمّى خيرًا على وجه الإطلاق، سوى الإرادة الخيّرة." ومع ذلك، يستمر العديد من المفكرين اليوم في إعادة اكتشاف أهمية الأخلاق القائمة على الفضيلة، مستلهمين قول أرسطو: "فالفضائل لا تنشأ فينا لا بطبيعتنا ولا بخلاف طبيعتنا، بل نحن مهيّأون بطبيعتنا لتقبّلها، وتُستكمَل فينا بالممارسة. فالأشياء التي ينبغي أن نتعلّمها قبل أن نفعلها، لا نتعلّمها إلا بفعلها." وعليه، فإن تعلم الفضائل قد يكون صعبًا في البداية، لكنه يصبح أسهل مع مرور الوقت من خلال الممارسة المستمرة حتى يتحوّل إلى عادة راسخة. (٨٩)
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن لكل عصر مجموعة من الكلمات التي تجسّد رؤيته للعالم وتشكل نقاطًا مرجعية يمكن قياس كل شيء آخر في ضوئها. ففي العصور القديمة كانت الكلمات المفتاحية هي الفضائل مثل العدالة والشجاعة، وفي العصور الوسطى كانت القيم الدينية مثل الإيمان والنعمة والإله، أما في القرن الثامن عشر فقد هيمنت مفاهيم عقلانية مثل العقل والطبيعة والحقوق، بينما أصبحت اليوم هذه المفاهيم تتجسد في كلمات أكثر تعقيدًا مثل الكفاءة، والاستحقاق، والمساءلة، والمرونة، والحكم الرشيد. وبالمثل، تغيّر معنى قيم الخدمة العامة مثل الحياد، والاستقرار، والتدرج الهرمي، والسرية، والولاء، بما يعكس التحولات الاجتماعية والثقافية في العصر الحاضر. وفي الحقيقة، القيم لا تزول، بل تتغير، ولا يوجد تصور ثابت أو فهم موحّد للأخلاق العامة. واليوم، أصبح الناس أكثر تطلبًا ونقدًا تجاه القادة والسلطات، وأيضًا أكثر وعيًا بتطلعاتهم الحياتية، بينما تتزايد الشكوك حول وجود قيم عالمية ثابتة، بحيث يُطبق المواطنون معايير أكثر صرامة على أنفسهم وعلى تصوراتهم للدين والإيمان والحظ وتحقيق الذات. (٩٠)
2- الطاعة الإدارية والضمير الأخلاقي:
تُعَدّ الطاعة عنصرًا أساسيًّا في بنية الحياة الاجتماعية، ولا يمكن الإشارة إلى ما هو أعمق منها في هذا الصدد، فوجود نظام من السلطة شرطٌ لازم لكل حياة جماعية، ولا يُستثنى من ذلك سوى الإنسان الذي يعيش في عزلة تامة، إذ هو وحده الذي لا يُضطر إلى الاستجابة — سواء بالتحدّي أو بالخضوع — لأوامر الآخرين. وبالنسبة لكثير من الناس، تُعَدّ الطاعة نزعةً سلوكيةً متجذّرة بعمق، بل هي دافع قويّ أحيانًا يتغلب على ما يتلقاه الفرد من تربية أخلاقية وتعاطف وسلوك قويم.
إنّ المعضلة الكامنة في الخضوع للسلطة قديمة قِدَم قصة إبراهيم، كما أنّ السؤال عمّا إذا كان نيبغي للمرء أن يُطيع حين تتعارض الأوامر مع صوت الضمير قد نوقش في فلسفة أفلاطون، وجُسّد في مأساة أنتيجونه، إحدى أعظم المسرحيات التراجيدية في الأدب الإغريقي التي كتبها سوفوكليس (Sophocles) في القرن الخامس قبل الميلاد، وتعرّض له الفلاسفة بالتحليل في كل عصر تقريبًا. ويرى الفلاسفة المحافظون أنّ العصيان يُهدّد نسيج المجتمع ذاته، في حين يؤكد الإنسانيون على أولوية الضمير الفردي. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للجوانب القانونية والفلسفية للطاعة، فإنها تقول القليل عن سلوك معظم الناس في المواقف الملموسة. (٩١)
ومن أبرز المشكلات الأخلاقية المتكرّرة في تاريخ الإنسانية مسألة الطاعة للسلطة، فالطاعة عنصرٌ ضروري لبقاء المجتمعات؛ إذ يجب على المواطنين طاعة القوانين، وعلى الجنود تنفيذ الأوامر، وعلى العمّال الامتثال لتوجيهات رؤسائهم. أمّا العصيان فيهدّد البنية السلطوية التي يقوم عليها تماسك المجتمعات. غير أنّ الطاعة نفسها محفوفة بالالتباس والمآزق الأخلاقية، فعندما يتعارض صوت الضمير مع صوت السلطة، أيهما ينبغي أن يوجّه سلوكنا؟
كممرّضة، هل تلتزمين بأمر الطبيب بأن تكذبي على المريضة بشأن حالتها؟ كممثل لمصرف، هل ينفذ موظف أوامر مديره بحجز مزرعة أفلست بسبب ظروف جوية خارجة عن إرادة صاحبها؟ وكجندي في خضم المعركة، هل يطيع أوامر قائده بإطلاق النار على نساء وأطفال أبرياء؟ إنّ الوجه المظلم للطاعة يكمن في أنّها قد تُخفي وراءها الضمير الأخلاقي للفرد، وتتحوّل إلى الدعامة التي تستند إليها شبكات كاملة من القهر والسيطرة والقتل — كما حدث في ألمانيا النازية. (٩٢)
ومن هنا، يظلّ الضمير أداةً أخلاقية نافعة، إذ يقدّم إرشادًا سريعًا للفعل في المواقف التي يعجز فيها الفاعل عن التفكّر أو المداولة الواعية. وفوق ذلك، يمكن للضمير أن ينبّهنا إلى وجود قيمة أخلاقية مهدَّدة أو موضوعة على المحك، مما يحفّز مزيدًا من التأمل حين تسمح الظروف بذلك. وعليه، عند اتخاذ القرار بشأن كيفية التصرف، ينبغي للفاعل دائمًا أن ينظر في أوامر ضميره ويوازنها على نحو صحيح قبل الإقدام على الفعل.ويمكن تمييز ثلاثة مجالات مترابطة لحرية الضمير:
1- حرية تبنّي المرء لآرائه الأخلاقية الخاصة.
٢- حرية التعبير عن ضميره.
3- حرية التصرف وفقًا لضميره. (٩٣)
3- مفهوم الأمانة والنزاهة والمسؤولية:
تتعلق هذه المفاهيم (الأمانة – النزاهة – المسؤولية) بالصدق، لذا يجب أن نتّخذ من الصدق، كما يُستعمل في الحياة اليومية، استعارةً ونقطة انطلاق. فنحن نتوقّع من الآخرين أن يكونوا منفتحين إزاء ما يفكّرون فيه وما يفعلونه، وألّا يُخفوا عنا أمورًا ينبغي أن نعرفها؛ ومن ثمّ يبدو أنّ الانفتاح أحد أوجه الصدق. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون الناس منفتحين إزاء أي شيء يفكرون فيه أو يفعلونه فحسب، بل يجب أن تكون أفكارهم وأفعالهم صادقة كذلك. وثالثًا، عادةً لا نعدّ الآخرين صادقين إلا بشرط ألا يخدعونا أو يُلحقوا بنا ضررًا؛ أي أن يكونوا مستقيمين في أفعالهم. وباختصار، يبدو أنّ الصدق يتكوّن من ثلاثة عناصر أساسية: الانفتاح، وصدق القول (قول الحقيقة)، والإنصاف. (٩٤)
وتُعنى هذه العناصر الثلاثة، بالنسبة إلى العلماء والباحثين، بضرورة الشفافية المبدئية في كل ما يقومون به وكل ما يتوصلون إليه خلال البحث العلمي. ويمكن التمييز هنا بين انفتاح العملية (أي وضوح الخطوات والمنهجيات المتّبعة) وانفتاح النتائج (أي إعلان ما تم التوصّل إليه من بيانات واستنتاجات). أما الصدق فهو جوهر العمل العلمي، لأنّ البحث عن الحقيقة يُعدّ من الاهتمامات الأساسية للعلم، ويعني التمسّك بالحقائق في الأفعال والأقوال على حد سواء. وهنا يمكن التمييز بين البحث عن الحقيقة وقول الحقيقة بوصفهما جانبين متكاملين من الصدق. أما الإنصاف، فيعني منح كل ذي حقّ حقّه، وألا يتصرّف الباحثون على نحوٍ يُلحق الضرر بأصحاب المصلحة في البحث أو ينتقص من مكانتهم. (٩٥)
ووفقًا لقاموس ويبستر، يُعرَّف الصدق بأنه التحلّي بالإنصاف والحق، وأن يكون الإنسان خاليًا من الخداع، صادقًا وأصيلًا وحقيقيًّا. ويشمل ذلك تجنّب التلاعب أو إصدار بيانات أو أفعال مضللة يقصد منها الخداع. فالصدق ليس مجرد قول الحقيقة، بل هو التحلّي بروح الصدق، أي النية الكامنة وراء الحقيقة ذاتها. إنه أكثر من مجرد مطابقة القول للواقع؛ إذ يرتبط بالدوافع والمقاصد. فعندما نحلف اليمين نقول: «أقول الحق، والحق كله، ولا شيء غير الحق». ويُعدّ الصدق، على الأرجح، أعظم القيم الإنسانية جميعًا، إذ يمنحنا فوائد شخصية عظيمة ومكاسب مجتمعية ووطنية أكبر. فهو يُقيم أساسًا متينًا للفرد والمجتمع، إذ لا يمكن فصل الحقيقة عن الصدق، لأنّ الحقيقة هي المضمون الجوهري للصدق. ومجتمعنا اليوم يتوق إلى رؤية قادة ومسؤولين يتحلّون بالصدق، لأن الصدق هو دائمًا الفعل الصائب. (٩٦)
أما النزاهة، فتشير إلى الاتساق بين الأفعال والقيم والمبادئ والأساليب، وإلى التوافق بين التوقّعات والنتائج. وفي السياق الأخلاقي، تُعدّ النزاهة صفة جوهرية تتجلّى في الفهم الفطري للصدق والإخلاص في دوافع الإنسان لأفعاله. وتستخدم الشركات والمؤسسات هذا المفهوم للدلالة على السلوك المؤسسي المسؤول المتوافق مع القواعد الأخلاقية المتعارف عليها. وبصورة أكثر تحديدًا، تُلزم الشركة نفسها بالنزاهة باعتبارها التزامًا ذاتيًا يوجّه أنشطتها وقراراتها وإجراءاتها، بحيث تُراعى القيم الأخلاقية الأساسية في جميع ممارساتها.
وتنبثق الالتزامات الأخلاقية لهذا المعيار الأدنى من الامتثال للقوانين السارية، أي أنّ النزاهة تتضمّن الخضوع الصريح للتشريعات واللوائح. لكنها في الوقت ذاته تشمل أيضًا القيم والمعايير الأساسية المعترف بها عالميًا، والتي تتجاوز حدود التشريعات الوطنية، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والمعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وإرشادات المسؤولية الاجتماعية، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من المواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة. (٩٧)
ويُستخدم مصطلح النزاهة المؤسسية (Corporate Integrity) للدلالة على مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تضمن أن تعمل المؤسسة وفق القيم الأخلاقية والقوانين والمعايير المهنية المعترف بها. ويهدف دليل الممارسات المؤسسية إلى توضيح السياسات والإجراءات التي تعزز النزاهة في بيئة العمل، وتشمل عادةً ما يلي:
1- الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية والدولية.
2- الشفافية في اتخاذ القرارات والإفصاح عن المعلومات.
3- المساءلة في جميع المستويات الإدارية.
4- منع تضارب المصالح والتعامل معه عند حدوثه.
5- احترام حقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية العادلة.
6- مكافحة الفساد والرشوة بجميع أشكالها.
7- تشجيع ثقافة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلّغين.
٨- الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في ممارسات العمل. (٩٨)
وباختصار، تمثّل النزاهة المؤسسية الإطار الأخلاقي الذي يوجّه الشركة نحو تحقيق أهدافها بطريقة مسؤولة، شفافة، ومتسقة مع القيم الإنسانية العامة.
المحور الرابع: التحديات الأخلاقية في الواقع الإداري
1- الفساد الإداري وتعارض المصلحة:
وبالانتقال إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه النزاهة المؤسسية، يأتي الفساد بوصفه نقيضًا مباشرًا للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المؤسسات. فكلمة "الفساد" مشتقة من الكلمة اللاتينية corruptus، التي تعني "الفاسد". وفي السياق القانوني، يشير هذا المصطلح إلى إساءة استخدام المنصب الموثوق به في أحد فروع السلطة (التنفيذية، التشريعية، القضائية) أو في المنظمات السياسية أو غيرها، بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة للفرد أو للآخرين. ويُعدّ الفساد الإداري أحد أكثر أشكال الفساد شيوعًا في مختلف فروع الحكومة، وهو نوع من الفساد يحدث في معظم المؤسسات، وبخاصة مؤسسات الدولة، حيث يواجهه الأفراد والشركات وغيرها من الكيانات أثناء تعاملاتها. وغالبًا ما يُفهم مصطلح الفساد الإداري على أنه يتجسد أساسًا في رشوة الموظفين الأدنى رتبة بهدف التهرب من الالتزامات أو "تجاوز الدور" لإنجاز بعض المعاملات (٩٩).
ومن ناحية أخرى، يُعرَّف الفساد الإداري أحيانًا بشكل واسع جدًا، مما يؤدي إلى الخلط بينه وبين الفساد السياسي أو إلى اعتبار هذين الشكلين من الفساد مظهرًا واحدًا موحدًا. إلا أنّ مفهوم الفساد الإداري أوسع بلا شك، فهو لا يقتصر على الموظفين ذوي الرتب الدنيا، كما لا يقتصر على الرشوة التقليدية، إذ تشمل مظاهره أيضًا أشكالًا أخرى من القبول أو التسهيل أو منح الامتيازات غير المستحقة. ويُبرز الفساد الإداري جانبين أساسيين من الفساد:
١- الرشوة (أو أي شكل آخر من المنفعة غير المبرَّرة) لتقديم خدمات قانونية، حيث يقع الفساد لجعل الأعمال تسير بسلاسة أو لتسريع الإجراءات وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يحدث انتهاك خطير للقانون، بل يُعاد توظيفه بطريقة غير طبيعية وإن كانت الإجراءات ظاهريًا قانونية.
٢- الرشوة (أو أي شكل آخر من المنفعة غير المبرَّرة) لتقديم خدمات أو أفعال غير قانونية تنطوي على انتهاك للوائح والقوانين (١٠٠).
ويرى فيلب (Philip) أنّ حالة الفساد تتحقّق عندما تتوافر الشروط الأربعة التالية:
1- قيام موظف عام (أ) بفعلٍ لتحقيق مصلحة شخصية،
٢- انتهاكه بذلك قواعد الوظيفة العامة،
3- إلحاق الضرر بالمصلحة العامة (ب)،
٤- استفادة طرف ثالث (ج) من هذا الفعل، ومكافأة الموظف (أ) لقاء تمكينه من الحصول على سلع أو خدمات لم يكن ليتمكن من الحصول عليها بطريقة أخرى (١٠١).
ويضيف فيلب أنّ الفعل يُعدّ فاسدًا بشكل مؤكد عندما تجتمع هذه المعايير الأربعة كلها في واقعة واحدة، غير أنّ العديد من حالات الفساد لا تتضمن سوى ثلاثة معايير منها. ويمكن الإشارة إلى أنّ الموظف العام لا يضرّ بالمصلحة العامة فحسب، بل قد يُلحق الأذى أيضًا بطرفٍ رابع (د)، مثل شخصٍ يُستبعد من صفقةٍ تجارية أو يُحرم من استخدام خدماتٍ أو الحصول على سلعٍ تمكّن منها شخص آخر (ج) بوسائل غير مشروعة. فالفساد يُعدّ مرادفًا للرشوة، ويرتبط أساسًا بالمخالفات أو الأفعال غير القانونية في القطاع العام. لذلك يرى داردن (Darden) أنّ مصطلح "الفساد" ينبغي أن يُحصر في الممارسات السيئة للموظفين العموميين التي تنحرف عن التسلسل القيادي أو تُضعف نزاهته، وبالتالي تُقوّض القواعد القانونية التي تحكم عمل المنظمة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف شخصية (وخاصة المكاسب الذاتية) (١٠٢).
ومع ذلك، فإنّ الفساد مفهوم أوسع بكثير، إذ يشمل أيضًا الأفعال المثيرة للجدل أخلاقيًا أو المنحرفة، والتي قد لا تُعدّ جرائم قانونية لكنها تستحق الإدانة على الأقل، بالإضافة إلى انتهاك المعايير الأخلاقية والسلوكية في كلٍّ من القطاعين العام والخاص. ويأخذ الفساد الإداري، ارتباطًا بالفساد السياسي، أشكالًا متعددة، ولا يكون من الطبيعي أن تكون كلّ أنماط الممارسات الفاسدة متساوية الأثر في الأداء الاقتصادي. وتشير الدراسات التجريبية الحديثة إلى أنّ كثيرًا من الدول شهدت تراجعًا في النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة للفساد، بينما حققت دول أخرى نموًا اقتصاديًا مرتفعًا في بعض الحالات على الرغم من وجود الفساد. ويُعزى ذلك إلى مدى تنسيق الموظفين – مرتكبي الممارسات الفاسدة – لسلوكهم. ففي غياب شبكة فساد منظمة، يجمع كل موظف الرشاوى لحسابه الخاص دون الاكتراث بتأثيرها على الأداء العام، أما عند وجود شبكة فساد منظمة، فإنّ الجهاز البيروقراطي يقلل من القيمة الإجمالية للرشوة، ما يؤدي إلى انخفاض المدفوعات غير المشروعة وزيادة الابتكار، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويُستخدم في هذا السياق التعبير الإنجليزي "تزييت العجلات" (to oil the wheels)، في إشارة إلى الرشوة التي تُقدَّم لتسهيل الإجراءات أو تسريع المعاملات (١٠٣).
ويتضح من تحليل هذه العوامل أنّ الفساد الإداري لا ينشأ بمعزل عن البنية السياسية والمؤسسية والاقتصادية للدولة، بل يتغذّى على اختلالات متشابكة في النظام الإداري والسياسي والأخلاقي، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
١- الخلل في القيادة السياسية والحوكمة العليا: يبدأ الفساد من القمة، حين تتحول مواقع صنع القرار إلى أدوات لمصالح شخصية أو حزبية، ويُستغل النفوذ لتوجيه المشاريع الحكومية أو منح العقود لتحقيق مكاسب خاصة. وتنتج هذه الممارسات ثقافة مؤسسية تُشرعن الفساد من الأعلى إلى الأسفل، فتفقد الإدارة العامة مصداقيتها.
٢- غياب استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد: يُظهر تضارب السياسات الحكومية ضعف الإرادة السياسية في المواجهة، إذ تعمل بعض الهيئات على تطبيق معايير النزاهة، بينما تُضعف هيئات أخرى هذه الجهود عبر تشريعات متساهلة أو تبريرات اقتصادية، مما يؤدي إلى ازدواجية تنظيمية تقلّص فعالية أي إصلاح.
٣- ضعف منظومة المساءلة والشفافية: تؤدي قلة الإبلاغ عن الفساد وقصور الملاحقة القضائية إلى توليد بيئة آمنة للفساد، حيث يشعر الفاعلون بانعدام الخطر من العقاب. كما أن غياب السجلات الوطنية للإدانات وعدم نشر البيانات الخاصة بالقضايا يسهم في طمس الأدلة وغياب الرادع العام.
٤- الضغوط الاقتصادية وضعف الحوافز الأخلاقية: تؤدي الأجور المنخفضة وغياب الحوافز المهنية وتردّي بيئة العمل إلى جعل الموظف أكثر قابلية للانحراف الأخلاقي، خصوصًا عندما يرى نماذج فاسدة في المستويات العليا لا تُحاسَب. وبالتالي، يتحول الفساد إلى وسيلة للبقاء الاقتصادي لدى الأفراد، وليس مجرد انحراف فردي.
٥- الثغرات الإدارية والمؤسسية في إدارة المشاريع العامة: في ظل غياب آليات رقابة فعّالة على مشاريع البنية التحتية، تتزايد احتمالات الرشوة والاحتيال أثناء التخطيط أو الترسية أو التنفيذ. كما أنّ نقص البيانات الدقيقة حول الأسعار المقارنة والتكلفة الحقيقية للمشاريع يصعّب تقييم النزاهة الاقتصادية للصفقات الحكومية.
٦- ضعف تكامل المعلومات والحوكمة الرقمية: يشير نقص البيانات الوطنية حول البنى التحتية والمشروعات العامة إلى هشاشة نظم المعلومات الإدارية، وهو ما يتيح للمسؤولين التلاعب بالمشاريع أو تمرير قرارات غير مبرّرة بحجة نقص البيانات أو تعقيد الإجراءات.
٧- العدوى الهيكلية للفساد: ينتشر الفساد عبر آلية "القدوة السلبية"، إذ تُظهر الممارسات العليا في النظام الإداري أنّ النفوذ يحمي صاحبه من العقوبة، مما يدفع المستويات الأدنى إلى محاكاة السلوك نفسه. وهكذا يتحول الفساد إلى نمط إداري مستقر وهيكلي يصعب اجتثاثه دون إصلاح شامل (١٠٤).
الفساد الإداري ليس مجرد انحراف فردي عن القواعد، بل هو تعبير عن خلل متجذر في منظومة القيم والإدارة معًا. فعندما تتراجع العدالة المؤسسية والشفافية وتغيب المحاسبة، يتحوّل القانون نفسه إلى أداة للمناورة بدلًا من أن يكون أداةً للضبط، ويصبح الفساد وسيلة خفية لإعادة توزيع السلطة والثروة داخل الجهاز الإداري.
وقد تطوّرت دراسة الفساد منذ تسعينيات القرن العشرين لتصبح حقلًا علميًا متعدد التخصصات، نال اعترافًا متزايدًا باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق الحوكمة الرشيدة. وتظهر الآثار السلبية للفساد بشكل خاص في مجالات الإدارة العامة والسياسات والحوكمة، حيث يُعدّ ممارسة السلطة بعدالة وشفافية أمرًا حيويًا لضمان عمل الأنظمة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وفي عام ٢٠٠٣، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، والتي تُعدّ الأداة الدولية الرئيسية في هذا المجال. وتتضمن الاتفاقية العديد من الأحكام التي تؤكد أهمية إنشاء مؤسسات لمكافحة الفساد كوسائل فعّالة لتحقيق هذا الهدف. ومنذ ذلك الحين، أنشأت العديد من الدول الأعضاء في الاتفاقية مؤسسات مختلفة تحت مسميات متعددة لمكافحة الفساد. ومن منظور القانون الدولي، يزداد الاعتراف بأنّ التصدي للفساد يتطلب جهدًا جماعيًا من الدول، مستندًا إلى إطار قانوني قوي يتجاوز الحدود الوطنية (١٠٥).
وتُعدّ المعايير الأخلاقية أساسية في الممارسات الإدارية العامة واليومية، إذ إن النغمة الأخلاقية السائدة داخل المؤسسة تؤثر مباشرة على كفاءتها وفعاليتها، وعلى عمليات اتخاذ القرار، ودرجة التزام الموظفين ورضاهم الوظيفي، وكذلك على مستويات الضغوط النفسية ودوران العمالة. إن جعل الممارسات الأخلاقية أولوية لا يقتصر على العمل بنزاهة أو الحفاظ على المصداقية، بل هو أيضًا وسيلة لتحقيق الكفاءة المثلى في أداء المؤسسات العامة. والمؤسسات العامة الناجحة عادةً ما تتميّز بمعايير أخلاقية عالية، سواء في علاقاتها الخارجية مع أصحاب المصلحة أو في علاقاتها الداخلية بين الموظفين. وفي مختلف الدول الأوروبية، تختلف الأنظمة والثقافات السياسية تبعًا لعدة عوامل، مثل قوة البرلمان وحقوقه في الرقابة، ودرجة اختراق الأحزاب السياسية للأجهزة البيروقراطية، وحرية الصحافة، وحجم الإدارات العامة، وتصميم الهياكل التنظيمية وأنظمة الموارد البشرية، وغيرها من العوامل (١٠٦)
2- اللامبالاة والمسؤولية الجزئية:
يتبيّن مما سبق أنّ الفساد الإداري ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج تفاعل معقّد بين خلل القيم الأخلاقية وضعف القيادة المؤسسية وغياب المساءلة الفعالة، وهو ما يُنتج بيئة عمل تتآكل فيها روح الالتزام والضمير المهني. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ أحد المظاهر الخطيرة التي تُسهم في ترسيخ هذا الواقع هو تفشّي اللامبالاة والمسؤولية الجزئية داخل المؤسسات العامة والخاصة على السواء.
تُعدّ اللامبالاة في بيئة العمل من أخطر الظواهر التي تهدد الأداء المؤسسي وجودة القيادة، إذ لا تعبّر فقط عن ضعف الالتزام أو فتور الدافع، بل تكشف عن حالة أعمق من الانفصال الأخلاقي والوجداني عن الهدف المهني، مما يؤدي تدريجيًا إلى تفكك روح الفريق وتراجع معايير التميّز.
في هذا السياق، يقدّم جو روبرت ثورنتون (Joe Robert Thornton) معالجة دقيقة لهذه الظاهرة في كتابه المهم «أعماق الركاكة: القضاء على اللامبالاة» الصادر عام ٢٠٢١، حيث يربط بين مفهومي الركاكة (Mediocrity) واللامبالاة (Indifference) باعتبارهما علتين مركزيتين لانهيار فعالية القيادة وانطفاء روح المبادرة في المؤسسات. ويرى ثورنتون أن نقيض التميّز في العمل ليس الفشل كما يُظن، بل هو الركاكة، أي أداء الحد الأدنى الذي يضمن البقاء دون طموح أو إبداع. ويؤكد أن الركاكة ليست دائمًا نتيجة لضعف الكفاءة الفردية، بل غالبًا ما تكون نتاج قيادة غير فعّالة تفتقر إلى الرؤية والحافز (١٠٧).
ثم ينتقل إلى ما يعتبره الخطر الأكبر: اللامبالاة، التي يعرفها بأنها القدرة الأخلاقية والإنسانية على التغاضي عن الخطأ أو التقصير أو الظلم دون اتخاذ موقف، والاكتفاء بالصمت والرضا عن الوضع القائم. وهذه الحالة، كما يوضح، تشكّل بيئة خصبة لترسيخ الفساد الإداري وتآكل قيم العدالة والمساءلة داخل العمل (١٠٨).
ويشير ثورنتون أيضًا إلى أنّ القيادة اللامبالية تُعدّ أحد أخطر أشكال الفشل المؤسسي، فهي ليست بالضرورة قيادة ظالمة أو قاسية، بل قيادة غافلة تكتفي بفعل ما يكفي للبقاء دون السعي إلى التغيير أو التحسين. ويسميها "القيادة التي تفعل فقط ما يكفي لتستمر"، والتي تنشر عدوى اللامبالاة في جميع مستويات العمل، حيث يفقد الموظفون الشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الجودة والخدمة العامة (١٠٩).
ويطرح ثورنتون مجموعة من المبادئ العملية لمواجهة ظاهرة اللامبالاة في بيئة العمل، من أبرزها:
١- إحياء الشعور الأخلاقي في العمل، من خلال ربط الأداء اليومي بالقيم الإنسانية والمجتمعية.
٢- تحفيز الشجاعة القيادية في مواجهة التقصير، بدلًا من سياسة "النظر إلى الجانب الآخر".
٣- بناء ثقافة المساءلة، حيث يُكافأ الالتزام الحقيقي وتُدان اللامبالاة.
٤- تحويل السلبية إلى دافع إيجابي للتغيير عبر الحوار والمشاركة (١١٠).
ويؤكد ثورنتون في خلاصة تحليله أنّ اللامبالاة ليست مجرد سلوك وظيفي، بل مشكلة ثقافية شاملة تمتد إلى المجتمع بأسره. فهي تنشأ عندما تفقد الجماعات والمؤسسات حسّها الأخلاقي الجمعي، فتفقد القدرة على الغضب من الخطأ أو الدفاع عن الصواب. ويرى أن المجتمعات التي تتسامح مع اللامبالاة "تتآكل من الداخل قبل أن تنهار من الخارج" (١١١).
ويخلص جو روبرت ثورنتون إلى أن اللامبالاة هي نقيض الحياة المهنية والأخلاقية، وأن مكافحتها تبدأ من إعادة إحياء الضمير القيادي في المؤسسات. فالعمل، في جوهره، ليس مجرد وسيلة للرزق، بل فضاء أخلاقي تُختبر فيه قيم الإنسان واستعداده لتحمّل المسؤولية تجاه الآخرين والمجتمع.
3- أخلاقيات التعامل مع المواطنين والزملاء والرؤساء:
وإذا كانت اللامبالاة تمثّل تهديدًا داخليًا لقيم الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة، فإنّ الأخلاقيات المهنية تمثل الوجه المقابل الذي يضبط العلاقات ويعيد بناء الثقة بين العاملين والمجتمع. ومن هنا تبرز أهمية أخلاقيات التعامل مع المواطنين والزملاء والرؤساء بوصفها الإطار السلوكي الذي يضمن انسجام الأداء الإداري مع المبادئ الإنسانية والقيم العامة.
لقد عُرفت مواثيق الأخلاقيات منذ زمن بعيد، ومن بين أقدمها وأكثرها شهرةً قسم أبقراط الذي وُضع في القرن الخامس قبل الميلاد، ولا يزال حتى اليوم يؤدي دورًا بارزًا في مهنة الرعاية الصحية. ومن الشائع أيضًا أن تمتلك المهن الأخرى مواثيق أخلاقية خاصة بها، إذ يُعد الالتزام بميثاقٍ أخلاقي وسلوكي أحد السمات الجوهرية التي تُميّز المهنة عن غيرها من الأنشطة. ورغم انتشار مواثيق الأخلاقيات في المهن التقليدية، إلا أنّ ظهورها داخل المؤسسات غير المهنية يعد ظاهرة حديثة نسبيًا. ويُعزى هذا الانتشار المتزايد إلى عوامل عدة، منها نمو حجم المؤسسات، وارتفاع توقعات المجتمع من أدائها، إضافةً إلى الطابع العالمي المتزايد لأنشطتها، ما ساهم مجتمعةً في انتشار واسع لمواثيق الأخلاقيات عبر مختلف المؤسسات (١١٢).
وتشمل فروع الأخلاقيات التطبيقية: الأخلاقيات التجارية، الأخلاقيات البيولوجية، الأخلاقيات المهنية، الأخلاقيات الاجتماعية، أخلاقيات التكنولوجيا، أخلاقيات المعلومات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتكتسب هذه الفروع أهمية كبيرة في مجال الاتصال في البحث والممارسة، لعدة أسباب تتعلق أساسًا بطبيعة الاتصال ذاته والقضايا المرتبطة به، مثل تكنولوجيا الاتصال والوساطة، بالإضافة إلى القضايا التي يتعامل معها الاتصال، بما في ذلك وساطة الرسائل. ويؤثر هذا في طبيعة ما يُنقل، وكيفية نقله، ومن يقوم بالنقل، ومن هم المستلمون—سواء كانوا المقصودين أو غير المقصودين (١١٣).
وقد أصبح الاتصال بين الأفراد ذا أهمية متزايدة، لا سيما في ظل العولمة، حيث يُعد الاتصال الشخصي ضرورةً للبقاء على تواصل مع الآخرين، بما في ذلك الأحبة والمجتمع الأوسع. عبر التاريخ، كان الانتماء إلى المجتمع وقبول الفرد فيه أمرًا بالغ الأهمية للبشر، وقد اكتسب هذا الأمر أهميةً أكبر مع التطور التقني وابتكارات الاتصال الحديثة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاتصال اللاسلكي والإنترنت غير المحدود، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وصولًا إلى الهواتف الذكية الحديثة.
ولا يقتصر البقاء على تواصل على تبادل الرسائل فحسب، بل يشمل أيضًا مراعاة طبيعة العلاقات مع من نتواصل معهم. فإرسال الرسائل يتيح تلبية الحاجة الإنسانية للانتماء، ويسهم في التخفيف من الشعور بالوحدة، ويعزز رفاهية الفرد من خلال تعزيز شعوره بالاستقلالية والرضا عن ذاته. وهكذا، أضاف القرن الحادي والعشرون بُعدًا جديدًا للاتصال بين الأفراد، لا سيما لدى الأجيال الشابة، من خلال وسائل الإعلام الرقمية الجديدة التي أصبحت جزءًا لا غنى عنه من حياتهم (١١٤).
ويُعدّ مجال الأخلاق، أو الفلسفة الأخلاقية، أي الدراسة الأكاديمية للمبادئ والقواعد الأخلاقية، مجالًا مستمرًا طوال تاريخ البشرية. وكما هو الحال مع أي مجال مرتبط بالفلسفة، لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم "الأخلاق"، إلا أنّ الفهم العام يمكن تبسيطه باعتبار الأخلاق دراسةً لما هو "حسن وقبيح". وأكثر صلةً بالخطابات المجتمعية المعاصرة هو الفهم السلوكي للأخلاق والممارسة الأخلاقية.
وعند العودة إلى الفهم الأساسي للأخلاق على المستوى السلوكي، يمكن الإشارة إلى "القاعدة الذهبية": «في كل شيء، عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك». ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار قاعدة عامة للسلوك الأخلاقي توجيه الفرد لسلوكه بما يتوافق مع الطريقة التي يحب أن يُعامل بها. وعلى الصعيد المهني والأكاديمي، قد يكون التفكير في القضايا الأخلاقية، وتفسيرها، والالتزام بالمعايير الأخلاقية أكثر تعقيدًا مما يبدو، ما يجعل من الضروري للأفراد العاملين في مجالات الاتصال أن يفهموا طبيعة الأخلاق، وكيفية تطبيقها في سياقات محددة، والتعرف على أوجه التشابه والفروق بين هذه السياقات (١١٥).
وقد وضع سقراط ثلاثة ركائز أساسية للحوار: العقل، الضمير، والفعل الأخلاقي. وبعد محاكمته بتهمة التجديف وإفساد شباب أثينا، أُدين سقراط أمام هيئة من أقرانه وحُكم عليه بالموت، كما روى أفلاطون هذه الواقعة في محاورة الدفاع (Apology). وفي بداية محاورة كريتو، نكتشف أن صديقه المقرّب كريتو جاء إليه في السجن عارضًا عليه فرصة الهرب والنفي إلى خارج أثينا، مطمئنًا إياه إلى سهولة العملية وعدم تعريض أي طرف لمخاطرة. وبعدما كان سقراط قد رفض هذا العرض سابقًا، يقدّم كريتو هذه المرة سلسلةً من الحجج لإقناع سقراط بالموافقة على الهرب.
وفي رده على كريتو، يقدّم سقراط ملاحظات واضحة حول طريقة تعامله مع العرض، تكشف عن طبيعة مشروعه الفلسفي، أي مشروع الأخلاق العملية، حيث:
1- يؤكد أنه لن يسمح لأي محاولة تستهدف التأثير في عواطفه بأن تُؤثّر على حكمه، فهو بحاجة إلى صفاء الذهن وهدوء النفس، ولن يُصغي إلا إلى حجّة قائمة على الوقائع وتبدو الأفضل بعد التأمل.
2- على الرغم من ترحيبه بالحوار، فإنه يرفض أن يُقاد بآراء الآخرين، ويؤكد على اتباع ضميره الشخصي وحده.
3- يصرّ على أنه ما إن يتبيّن له ما هو الصواب أو الأفضل، فعليه أن يفعله دون تردّد، مختتمًا مبدأه باتفاقه مع كريتو على أنّ "الأمر المهم حقًا ليس أن نعيش، بل أن نعيش عيشًا حسنًا"، أي أن نحيا حياة شريفة وعادلة (١١٦).
4- نحو فلسفة عملية لأخلاقيات الوظيفة العامة:
في ضوء ما تقدّم من الحديث عن الأخلاق المهنية، تتجلّى الحاجة إلى بناء فلسفة عملية تُوجِّه أخلاقيات الوظيفة العامة نحو غاية عليا، هي تحقيق المصلحة العامة وصيانة كرامة الإنسان داخل بيئة العمل. ويبرز ذلك بوضوح في ميدان الخدمة العامة، حيث يُنتظر من الموظف العام أن يكون نموذجًا للالتزام والمسؤولية والقدوة في السلوك. فلكي تكون الخدمة العامة فعّالة وتتمتع بالاحترام والثقة، لا بد أن يلتزم العاملون فيها بمجموعة من السلوكيات والمعايير الأخلاقية التي تضمن الانضباط المهني، وتحفظ للمؤسسات هيبتها وفاعليتها. ومن أبرز هذه المعايير ما يلي:
1- احترام جميع حقوق الإنسان والتعامل بروح من اللياقة والاحترام مع الجميع.
2- أداء العمل بجدٍّ وانضباط، مع الالتزام بالمواعيد ومعايير الجودة في الإنجاز.
3- تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء لتحقيق أهداف المؤسسة.
4- السعي إلى التميز في تقديم الخدمة، والتطوير المستمر للأداء لتحقيق نتائج ملموسة.
5- ممارسة المسؤولية وحسن الإدارة، بما يشمل التنظيم الفعّال للموارد واتخاذ القرارات الرشيدة.
6- تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مستويات العمل، لضمان الثقة والمصداقية.
7- أداء الواجبات بنزاهة واستقامة، وتجنّب أي سلوك قد يضر بالمصلحة العامة.
8- الحفاظ على الحياد السياسي، وعدم السماح للتوجهات السياسية الشخصية بالتأثير على الأداء المهني أو القرارات الإدارية (١١٧).
تتواصل هنا الرؤية المتكاملة لفلسفة أخلاقيات الوظيفة العامة، حيث يتعمق التحليل من مستوى السلوكيات المهنية إلى مستوى القيم الجوهرية التي تُشكّل الأساس الأخلاقي للسلوك العام. فبعد أن تناولنا في المحور السابق المبادئ التي تضمن فعالية الخدمة العامة وثقة المجتمع بها، ننتقل الآن إلى فلسفة القيم المهنية التي تمثل الركيزة الأخلاقية لكل ممارسة في ميدان الخدمة العامة.
المحور الخامس: فلسفة القيم المهنية في الخدمة العامة
1- الصدق، العدالة، الكفاءة، الشفافية، الخدمة العامة:
تتأسس هذه الفلسفة على منظومة من القيم المركزية مثل الصدق، العدالة، الكفاءة، الشفافية، والخدمة العامة. فالقيم ليست مجرد مبادئ نظرية، بل هي موجهات عملية تضمن أن تكون المهنة أداة لخدمة الإنسان والمجتمع، لا وسيلة لمصلحة شخصية أو غاية نفعية ضيقة.
ومن ثم، تبرز الكفاءة والمهارة كشرطين أساسيين لأداء الأعمال والوظائف المختلفة بكفاءة ومسؤولية. وتُعدّ هذه المعايير المشتركة العناصر الجوهرية في تعريف الشخص "المحترف" أو ذي الكفاءة العالية، وهو الذي:
1- يتقن منظومة معقّدة من المعارف والمهارات تُستخدم في خدمة الآخرين، أي أنه بلغ مستوى متقدّمًا من الكفاءة في مجاله ويحافظ عليه باستمرار.
2- يُظهر قدرًا من المساءلة تجاه الجمهور والمهنة على حدٍّ سواء، ملتزمًا بمقاييس الأداء المهنية مثل التعليم المستمر الفعّال والحد الأدنى من معايير الكفاءة والأخلاق. وفي هذا السياق، قد تتولى الدولة ضمان الكفاءة من خلال تكليف أعضاء مهنيين بإجراء اختبارات ومنح تراخيص علنية للناجحين، أو قد تمنح المؤسسات المهنية حرية إصدار اعتمادها الخاص، ومع ذلك تبقى المهنة مسؤولة عن جدارة وثقة ممارسيها أمام المجتمع.
3- يخضع لميثاق أخلاقي يوجّه سلوكه المهني وينظّم ممارساته.
4- يُظهر التزامًا بالكفاءة والنزاهة والاستقامة الأخلاقية، ويحافظ على الطابع الأخلاقي والتعاوني للمهنة، ويتحمّل المسؤولية تجاهها عن كل سلوكه. كما يتصف بروح الإيثار، مقدمًا مصلحة الآخرين والصالح العام على مصالحه الذاتية.
5- يمارس استقلالية في الحكم والممارسة المهنية، ويتحمّل المسؤولية المترتبة على امتيازه في التنظيم الذاتي، وغالبًا ما ينضمّ إلى مؤسسات مهنية تُعنى بحماية استقلال المهنة من خلال أنظمة الاعتماد والترخيص والتصديق المهني.
6- يُظهر روحًا مهنية متجذّرة في الانتماء إلى جماعة تشترك في مثلٍ عليا مشتركة تضع الخدمة فوق المكسب، والإتقان فوق الكثرة، والتعبير الذاتي فوق الدوافع المادية، والولاء فوق المصلحة الفردية. ويعبّر هذا الالتزام عن مساهمة المهني في تطوير المهنة والنهوض بجماعته المهنية من خلال عمله ومشاركته الفعّالة في تعزيز قيمها وممارساتها (١١٨).
2- التوفيق بين الواجب الشخصي والمصلحة العامة:
يُعد هذا المحور امتدادًا طبيعيًا لما سبقه من بحثٍ في فلسفة القيم المهنية، حيث ينتقل من تحديد القيم العامة مثل الصدق والعدالة والكفاءة إلى تناول إشكالية التوفيق بين الواجب الشخصي والمصلحة العامة، وهي من أعقد المسائل الأخلاقية في ميادين العمل المهني، ولا سيّما في القطاعات الحساسة كالرعاية الصحية.
يتطلب هذا التوازن تحقيق الانسجام بين المهنية والالتزام الأخلاقي في جميع المهن، ويظهر هذا بوضوح في المجال الصحي، حيث تتقاطع القيم الإنسانية مع الضغوط الاقتصادية والتقنية.
أولاً، يشهد العالم اليوم تحولًا متزايدًا في الرعاية الصحية نحو منطق السوق؛ إذ صار المرضى يُعاملون كمستهلكين والعاملون في المجال الطبي كمزودين للخدمة، في إطار يخضع لمبدأ “ليحذر المشتري” (caveat emptor) الذي يُفترض أنه يحمي الجميع. غير أنّ هذا التحول أوجد ضغوطًا جديدة على الخريجين الطبيين الذين يرزحون تحت وطأة الديون الناتجة عن تكاليف التعليم المرتفعة، فيسعون لزيادة دخلهم ولو على حساب البعد الإنساني للمهنة، مما يُهدد بتحويل الرعاية إلى سلعة لا رسالة. ومع انتشار الإنترنت وتنامي معرفة المرضى، باتوا أكثر تشككًا في كفاية العلاج أو النصيحة الطبية، ومع تطور التكنولوجيا الطبية تزايدت مطالبهم بالعلاج، الأمر الذي أفرز تحديات أخلاقية جديدة في موازنة الواجب المهني مع الاعتبارات الاقتصادية (١١٩).
ثانيًا، رغم هذه التحولات، ثمة مكاسب أخلاقية مهمة، أبرزها تراجع نموذج “الأبوة الطبية” الذي كان يقوم على خضوع المريض الكامل لسلطة الطبيب، ليحلّ محله نموذج المشاركة واتخاذ القرار المشترك. غير أنّ هذا المكسب ترافق مع خطر تآكل المهنية، إذ صار بعض الأطباء يمارسون الطب بوصفه نشاطًا تجاريًا قائمًا على تلبية الطلب مقابل العائد المالي، بينما يسعى الأطباء الملتزمون بالضمير المهني إلى التوفيق بين رغبات المرضى ومسؤولياتهم تجاه الصالح العام وحماية الموارد الصحية (١٢٠).
ومن ثمّ، فإن المهنية لا تتحقق إلا عبر التأمل الذاتي والإصلاح المؤسسي. فلا بد أولًا من إصلاح بيئة العمل الطبي بما يضمن إزالة الحوافز المنحرفة التي تشجع السلوك غير الأخلاقي، كالإفراط في وصف الأدوية أو الفحوص غير الضرورية بهدف الربح. وثانيًا، تعتمد المهنية على القدوة والنموذج العملي، إذ لا تكفي المعرفة النظرية ما لم يجد المتدرب أمامه أمثلة حيّة تجسد الالتزام والضمير (١٢١).
في الإطار الفلسفي، ترتبط المهنية بـ أخلاقيات الفضيلة، أي بنمط الشخصية الذي يجمع بين المعرفة والعادات الأخلاقية الراسخة، أو ما يسميه أرسطو “عادات القلب”. فالمهنية ليست دهاءً تقنيًا، بل التزامًا وجدانيًا مستمرًا تجاه الإنسان. لذلك، فإن بقاء المهنة وازدهارها يعتمد على نظام صحي عادل يضمن تكافؤ الفرص وعلى وجود قدوات ملهمة تغرس في الأجيال الجديدة روح المسؤولية والفضيلة (١٢٢).
وتتسع دائرة الالتزام الأخلاقي لتشمل الاحتياجات الإنسانية العامة كما يصنفها ماسلو، بدءًا من:
1- الاحتياجات الفسيولوجية كالطعام والمأوى والراحة،
2- - مرورًا باحتياجات الأمان والحماية،
3- فالاحتياجات الاجتماعية من انتماء ومودة وقبول،
4- ثم احتياجات الأنا كالاحترام والثقة بالنفس،
5- وصولًا إلى احتياجات تحقيق الذات، أي السعي إلى تحقيق أفضل ما في الإنسان من قدرات (١٢٣).
وفي هذا الإطار، يتجلى الدور الأخلاقي للدين في ترسيخ القيم التي تحفظ توازن الفرد والمجتمع. فالأديان تحثّ على الخير وتنهى عن الكبائر، وتؤكد قاعدة أخلاقية كونية هي «عامل الآخرين كما تحب أن يُعاملوك»، أو كما عبّر جوستينيان: «أن نعيش بصدق، وألا نؤذي أحدًا، وأن نُعطي كل إنسان حقه». ويشير ليونارد سويدلر (Leonard Swidler) إلى ثلاث نتائج لهذه القاعدة:
1- معاملة البشر كغايات لا كوسائل،
2- حماية الضعفاء والعاجزين،
3- معاملة الكائنات غير البشرية باحترام لأنها جزء من خلق الله (١٢٤).
وتُبرز هذه المبادئ أساس العلاقة بين المسؤول العام والبيئة المحيطة؛ إذ يتجسد الواجب الأخلاقي في خدمة الإنسان أولًا، وضمان أمنه وسلامته ثانيًا، وصون البيئة الطبيعية ثالثًا. كما تستدعي الحاجة إلى الدين في المجتمع أن يحترم المسؤول العام حرية المعتقد ويتبنى سياسة التسامح الديني، مع التزامه بمبادئ أخلاقية عامة مستمدة من التعاليم الدينية لتكون دليلًا لسلوكه المهني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحاجة الدينية تُعد من الاحتياجات الاجتماعية في المستوى الثاني من هرم ماسلو (١٢٥).
3- الوعي الأخلاقي كأساس للإصلاح الإداري:
يمثل هذا العنصر استكمالًا منطقيًا لما سبقه من حديثٍ عن التوفيق بين الواجب الشخصي والمصلحة العامة، إذ ينتقل إلى تناول الوعي الأخلاقي بوصفه الركيزة الأساسية لأي إصلاح إداري فعّال، وشرطًا لاستمرار القيم المهنية في الخدمة العامة.
في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة، باتت أخلاقيات موظفي الخدمة العامة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، نتيجة لتعدد القيم وتضاربها في البيئات الحديثة. فالأخلاق الكلاسيكية التي كانت تقوم على الانضباط، والإخلاص، والولاء، والالتزام المؤسسي، تواجه اليوم تحديات جديدة تتطلب من الموظف العمومي إعادة النظر في علاقته بالقيم التقليدية، واستيعاب منظومة أوسع من المبادئ التي تعكس التنوع والتعدد في القيم المعاصرة.
وقد تناول ماكس فيبر في عمله الشهير «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (19- 4) نموذجًا للمجتمعات التي جعلت من العمل قيمة أخلاقية مطلقة، فصار الإنسان يعمل لا لمجرد الكسب، بل لأن العمل ذاته يُعد غاية أخلاقية. وهكذا، أصبح العمل هو الإطار الذي تُعرض فيه الفضائل العملية مثل الاجتهاد، والانضباط، والمسؤولية. أما في عصرنا الحاضر، فقد تحوّل هذا الفهم إلى نظرةٍ مهنية أكثر براغماتية، إذ يرى كثير من موظفي الخدمة العامة وظائفهم كمسارات مهنية لا كدعوات أخلاقية أو رسالات معنوية. ومع ذلك، يظل للعمل مكانته المركزية، إذ أُضيفت إليه قيم حديثة مثل الأداء الفردي، والتعلم المستمر، وتطوير الكفاءات، وهي تحولات إيجابية تعبّر عن نضج الوعي المهني واتساع مفهوم الخدمة العامة (١٢٦).
وترافق هذا التحول مع تغيّر نموذج العمل المؤسسي ذاته؛ فبعد أن كان العمل بدوام كامل والوظيفة المستقرة حتى التقاعد هما القاعدة، صارت الحدود بين الحياة المهنية والخاصة أكثر مرونة، وظهرت أنماط جديدة من العمل الجزئي والزمن المرن. ولم تعد ساعات العمل مفهومًا جامدًا، إذ أصبح الوصول إلى الموظف ممكنًا في كل وقت عبر الوسائل الرقمية. ورغم هذه التغيّرات، لا يزال العمل الجادّ يُنظر إليه كفضيلة أخلاقية، حتى مع تزايد الضغط المهني وامتداد ساعات العمل في معظم القطاعات العامة (١٢٧).
أما من حيث تطوير المهارات والتعلّم مدى الحياة، فقد تغيّرت النظرة جذريًا؛ إذ لم يعد الموظف خبيرًا تقليديًا يعتمد على شهادة جامعية فحسب، بل أصبح مطالبًا بتجديد معارفه وصقل كفاءاته بصورة مستمرة. إنّ هذا التسارع في وتيرة التطوير الذاتي يعكس روح الأخلاق الحديثة في العمل، القائمة على المرونة والمسؤولية الفردية، والتي حلّت محل الأخلاقيات الجامدة التي كانت تهيمن في الماضي.
كذلك، صارت الخدمة العامة أكثر انفتاحًا على الثقافات التنظيمية والقيم الوافدة من القطاعين الخاص والمجتمع المدني، دون أن تفقد جوهرها القيمي الأصيل المتمثل في الاستقلالية، والاستحقاق، والاحترافية، والإنصاف، والمسؤولية. ومن ثمّ، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديد القيم الأخلاقية المشتركة التي تجمع القطاع العام بسواه، حفاظًا على وحدة المعايير واستمرار الثقة المجتمعية في المؤسسات العامة (١٢٨).
ومع بروز التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية، برزت تحديات جديدة تتصل بالاستخدام الأخلاقي للمعلومة. إذ باتت المدونات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الحكومية، أدواتٍ رئيسية في التواصل مع الجمهور وصياغة السياسات، لكنها في الوقت نفسه فتحت المجال أمام مخاطر الخلط بين الرأي الشخصي والموقف المؤسسي، وبين التواصل المهني والاستخدام الحزبي أو الترويجي للمعلومات. كما أتاحت هذه الوسائل للعاملين في الخدمة العامة فضاءً واسعًا للتعبير عن الذات خارج إطار العمل الرسمي، وهو ما يثير إشكالات تتعلق بحدود الحرية والمسؤولية المهنية.
ومن هنا، فإن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالاتصال العام أصبحت أكثر تعقيدًا، تتطلب من الإدارات الحكومية صياغة أطر واضحة للسلوك الرقمي والمسؤولية الاتصالية، بما يضمن الحفاظ على الثقة العامة وحماية الحياد المؤسسي، ويحول دون استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية أو سياسية (١٢٩).
المحور السادس: بناء ميثاق فلسفي لأخلاقيات الوظائف العامة
لقد أظهرت التحولات في أخلاقيات العمل العام أنَّ الإصلاح الإداري لا يتحقق بمجرد تطوير الأنظمة أو تحديث الإجراءات، بل يقوم أساسًا على الوعي الأخلاقي لدى العاملين في الخدمة العامة. ومن ثمّ، يصبح بناء هذا الوعي شرطًا ضروريًا لأي إصلاح إداري فعّال. فكلّ إصلاح يفتقر إلى الأساس الأخلاقي مصيره الفشل، لأن الأخلاق هي التي تمنح الفعل الإداري معناه الإنساني، وتحدّد مساره الصحيح في ضوء قيم العدالة والمسؤولية والنزاهة.
وفي هذا السياق، يتعيّن أن يُستكمَل الوعي الأخلاقي ببناء إطارٍ فلسفيٍّ مؤسَّسٍ لأخلاقيات الوظائف العامة، يقوم على التخطيط الواعي والتنظيم الرشيد. فمن خلال السير في مسار تطوّرهم ونموّهم العقلي، أدرك الإنسان تدريجيًا ضرورة التخطيط في الحياة، وبدأ ينظر إليه بوصفه أداةً تخدم إدارة النظم الاجتماعية وقيادتها. وفي عصرنا الحالي، أصبحت المنظمات والمؤسسات الإدارية بالغة التعقيد إلى حدٍّ يجعلها غير قادرة على البقاء دون تخطيطٍ تفصيلي. ويتطلّب التخطيط الوعي بالفرص والتهديدات المستقبلية، والتنبؤ بكيفية التعامل معها. ويُعدّ التخطيط – الذي يُنجز دائمًا في الإدارة قبل عملية التنظيم – عمليةً تشمل تحديد الرؤية والرسالة والأهداف، وتقدير الموارد والافتراضات البيئية، فضلًا عن وضع السياسات والإجراءات والأساليب. وتُعَدّ السياسات والإجراءات أدواتٍ لتنفيذ الرؤية التنظيمية، سواء أكانت مكتوبةً ومُعلَنة رسميًا أم ضمنيةً يتعرّف عليها المديرون والموظفون تدريجيًا مع مرور الوقت؛ ومن ثمّ، فإن غياب السياسات الموثّقة أو المكتوبة لبعض المهام لا يعني بالضرورة غياب السياسة الخاصة بها. كما تحتاج الحكومات إلى صياغة السياسات وتنفيذها تنفيذًا فعّالًا من أجل الاضطلاع بواجباتها، وتُعرف هذه السياسات عادةً باسم السياسات العامة، وإذا تم تنفيذها بشكل سليم فإنها ترفع مستوى الرفاهية والرضا العام للمواطنين، وتُسهم في تعزيز قوة الدولة (١٣٠).
إن تنفيذ السياسات يعني فعليًا تحويل الالتزامات إلى أفعال. ومن المؤكد أن فشل تنفيذ السياسات لا يعود دائمًا إلى ضعف الحكومة أو المؤسسات المنفذة، بل قد يكون نتيجة للخلل في مرحلة صياغة السياسات ذاتها. وتحدث مشكلات التنفيذ عندما لا تتحقق النتائج المرجوّة أو المصالح المطلوبة، وهذه المشكلات ليست حكرًا على الدول النامية؛ فحيثما تُفتقد العوامل الأساسية والحيوية لتنفيذ السياسات العامة – سواء في الدول النامية أو المتقدمة – تظهر صعوبات في التنفيذ. وقد أشارت دراسات متعدّدة إلى عدد من العوائق التي تؤدي إلى عدم تنفيذ السياسات أو تنفيذها بشكل غير مكتمل؛ غير أن ما هو مؤكّد هو أن السياسات لا تُنفَّذ إلا بواسطة الأفراد العاملين داخل المنظمات. لذلك، وبجانب العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونقائص عملية صياغة السياسات، لا يمكن تجاهل دور الموارد البشرية في المنظمات. وخاصةً مع التوسع المتزايد للمنظمات وتعقّد بيئاتها، أصبح دور الموارد البشرية في تنفيذ السياسات وتحقيق النجاح أكثر أهميةً وحسمًا.
وتتجلّى هنا أهمية حوكمة الشركات بوصفها الإطار التنظيمي الذي يُدار من خلاله العمل المؤسسي، إذ تشير إلى «النظام الذي تُدار وتُوجَّه من خلاله الشركات». ويُعدّ أحد أهداف حوكمة الشركات إنشاء مجموعة من الآليات الداخلية التي تضمن اتخاذ قرارات إدارية سليمة، مع مراعاة حقوق ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة، إضافةً إلى الأعراف والمعايير الأخلاقية التي تلتزم بها الشركة. وقد جرى الاعتراف بأهمية خلق مناخ أخلاقي إيجابي والحفاظ عليه بوصفه جانبًا أساسيًا من جوانب حوكمة الشركات، إذ يُسهم في تقليل التكاليف المترتبة على وسائل الرقابة الاجتماعية الرسمية الأكثر تدخلًا وربما الأقل فاعلية، وكذلك في الحدّ من الخسائر الناجمة عن تضرر السمعة وانخفاض قيمة الأصول عند انكشاف مخالفات أخلاقية. كما أن الإخفاق في الحفاظ على ثقافة أخلاقية مناسبة، وفي تقديم نماذج سلوكية أخلاقية للموظفين، يمكن أن يُكبِّد الشركة خسائر جسيمة (١٣١).
ويكون المناخ الأخلاقي أكثر فاعلية عندما يكون أعضاء المنظمة مدفوعين داخليًا للتصرف بشكل أخلاقي. وبما أن فاعلية حوكمة الشركات تتعزّز من خلال التوافق بين الأخلاقيات التنظيمية والأخلاقيات الفردية، فإن فهم العوامل التي تُنتج هذا التوافق يُعدّ أمرًا مهمًا. ونظرًا لأن متغيرات المستوى التنظيمي ومتغيرات المستوى الفردي كليهما تؤثر في عملية اتخاذ القرار الأخلاقي، فإن نتائج البحوث التي تركز على أحد المستويين دون الآخر يجب أن تُستكمل بدراسات تتناول النوعين معًا (١٣٢).
إنّ بناء ميثاق فلسفي لأخلاقيات الوظائف العامة لا يكتمل من دون تحديد الأساس القيمي الذي يوجّه السلوك الإنساني داخل المؤسسات، وهو ما يجعل المسؤولية الأخلاقية محورًا جوهريًا في هذا البناء. فالأخلاق لا تُفهم هنا باعتبارها مجرد مجموعة من القواعد السلوكية، بل بوصفها منظومة من الفضائل الإنسانية التي تمنح الفعل الإداري روحه ومعناه.
١- المسؤولية الأخلاقية (أخلاقيات الفضيلة في السياق المعاصر):
تُعَدّ أخلاقيات الفضيلة إطارًا أخلاقيًا يركّز على تنمية الطابع الأخلاقي والفضائل بوصفها الأساس للحكم الأخلاقي والسلوك القويم. وقد جرى توظيف هذا الإطار في عصورنا الحديثة في مجالات متعددة مثل الأعمال، والرعاية الصحية، والسياسة، والتكنولوجيا. وفيما يلي عرض موجز لتجليات أخلاقيات الفضيلة في هذه المجالات:
١- أخلاقيات الأعمال:
في مجال الأعمال، تركز أخلاقيات الفضيلة على تنمية القيادة الأخلاقية وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على القيم والمبادئ الأخلاقية. ويُطلب من القادة أن يتحلّوا بصفات مثل الصدق، والنزاهة، والعدالة، والتعاطف، لما لهذه الفضائل من أثر في اتخاذ القرارات وبناء الثقة مع الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة. وتُعدّ الشركة التي تتبنى هذا النهج الأخلاقي هي تلك التي تُوازن بين الربحية من جهة، ورفاه الموظفين، والاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى.
2- أخلاقيات الرعاية الصحية:
تلعب أخلاقيات الفضيلة دورًا محوريًا في توجيه سلوك العاملين في القطاع الصحي. إذ يُشجَّع الأطباء والممرضون على تنمية فضائل مثل الرحمة، والتعاطف، والنزاهة، واحترام استقلالية المريض. ويُبرز هذا النهج أهمية العلاقة الإنسانية القائمة على الثقة والرعاية بين مقدم الخدمة والمريض، بوصفها شرطًا جوهريًا لتقديم علاج أخلاقي وفعّال.
3- الأخلاقيات السياسية:
تُقدّم أخلاقيات الفضيلة منظورًا مميزًا للقيادة السياسية ولعملية الحكم، من خلال إبراز فضائل مثل العدالة، والصدق، والحكمة العملية، والشجاعة. ويُحثّ السياسيون على تقديم الصالح العام على المصلحة الشخصية، وعلى التزام النزاهة الأخلاقية في أداء مسؤولياتهم تجاه الشعب. ويركّز هذا المنهج على أهمية الطابع الأخلاقي للسياسي ودوره في توجيه القرارات والسياسات العامة.
4- الأخلاقيات التكنولوجية:
مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، أصبحت أخلاقيات الفضيلة ذات أهمية متزايدة في معالجة القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والخصوصية، وأمن البيانات، والرفاه الرقمي. ويدعو الفلاسفة إلى تطوير التكنولوجيا واستخدامها بطريقة تعزز الكرامة الإنسانية والسلوك الأخلاقي. ويُشجَّع المصممون والمبرمجون على التفكير في العواقب الأخلاقية لابتكاراتهم، والسعي لدمج قيم مثل الشفافية، والمسؤولية، واحترام الإنسان في منتجاتهم التقنية (١٣٣).
وفي الظروف المعاصرة، تُعدّ أخلاقيات الفضيلة منهجًا شاملًا يتمحور حول الطابع الأخلاقي للفرد في عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية. فهي تركّز على تنمية الفضائل الأخلاقية وتكوين العادات السلوكية الفاضلة التي تُوجّه الأفراد والمؤسسات نحو حياة الخير والازدهار المجتمعي. ومع ذلك، من الضروري الإقرار بأن تطبيق أخلاقيات الفضيلة قد يواجه تحديات معقدة وعوامل دقيقة تتطلّب حوارًا مستمرًا وتأملًا عميقًا من أجل التعامل السليم مع القضايا الأخلاقية المعاصرة (١٣٤).
وفي ضوء ما تقدّم عن أخلاقيات الفضيلة بوصفها الإطار القيمي للمسؤولية الأخلاقية، يبرز العقل العملي باعتباره الأداة التي تُترجِم القيم إلى أفعال، والفضائل إلى ممارسات مهنية ملموسة. فالأخلاق ليست مجرد مبادئ نظرية، بل مهارة مكتسبة تُمارَس ضمن سياق عملي واقعي يقتضي حكمًا رشيدًا وقدرة على الموازنة بين القيم المتعارضة. ومن ثمّ، فإنّ الفضيلة لا تكتمل إلا حين تتجلّى في العمل الحِرفي أو المهني المتقن الذي يجمع بين الكفاءة التقنية والحكمة الأخلاقية.
٢- العقل العملي والمهارة:
في وقتنا الحالي، عندما نلتقي بما يُسمّى «السبّاكين المحترفين» أو «مندوبي التأمين على الحياة المحترفين» وغيرهم ممن يدّعون الاحتراف، يصبح من الصعب تحديد معنى كلمة "محترف" بدقة. عمومًا، يقدم العديد من الباحثين والكتّاب ثلاثة تعريفات بسيطة لهذا المفهوم:
1- ما يتعلق بعمل يتطلب تعليمًا أو تدريبًا أو مهارة خاصة.
2- ما يُنجز أو يُقدَّم من قِبل شخص يعمل في مهنة محددة.
٣- ما يُمارس مقابل أجر في مجال رياضي أو نشاط معين (١٣٥).
وباختصار، يُعرف المحترف بأنه الشخص الذي يلتزم بالمعايير التقنية والأخلاقية لمهنته. غير أن مجرد الإعلان عن الذات بوصفها "محترفة" دون تقديم أداء فعلي متميّز يؤدي إلى تغير نظرة الجمهور وتآكل الثقة الممنوحة عادة لهذه الفئة المهنية. لقد كان جوهر الأخلاق في مجال الرعاية الصحية دائمًا وضع مصلحة المريض أو الصالح العام في المقام الأول، بينما وضعت الأخلاق في عالم الأعمال تاريخيًا تحقيق الربح في المرتبة الأولى. وحتى الملاحظات العابرة تكشف عن محاولات لتبرير دمج أخلاقيات الرعاية الصحية مع أخلاقيات الأعمال، أي السعي للتوفيق بين منطق المنفعة العامة ومنطق الربح الخاص (١٣٦).
وبعد تناول دور العقل العملي في توجيه السلوك المهني الفردي، تتسع دائرة النقاش لتشمل المستوى المؤسسي، حيث تصبح العدالة المؤسسية شرطًا أساسيًا لترسيخ الأخلاق في بيئة العمل وضمان اتساق القيم بين الفرد والمنظمة.
٣- العدالة المؤسسية:
في الغالب، يفضّل أصحاب العمل توظيف الأشخاص الذين يتحلّون بأخلاقيات مهنية راسخة، كما يميلون إلى الاحتفاظ بهم وترقيتهم. وتشير الدراسات إلى أن الأخلاقيات المهنية تُعدّ عنصرًا أساسيًا في عالم الأعمال. يرى هويفيك أن على المديرين التعامل مع ازدواجية الولاء لدى الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم أعضاءً في المهنة وفي المنظمة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن بناء قاعدة أخلاقية مستدامة أمر حاسم لاتخاذ قرارات تجارية رشيدة في المستقبل.
وقد وجد سروكا أن الشركات العاملة في مجالات الأدوية والتبغ والكحول في بولندا وجمهورية التشيك تُضمّن مبادئ الأخلاقيات في أنشطتها التشغيلية، معتبرةً الأخلاق عنصرًا جوهريًا في نجاح الشركات الحديثة وربحيتها. كما لاحظ أن معظم مديري المشاريع والمهندسين المعماريين والمقاولين في قطاع البناء يلتزمون بميثاق مهني للأخلاقيات، ويعتبرون الممارسة الأخلاقية السليمة هدفًا تنظيميًا رئيسيًا.
ويشير شفاب إلى أن الالتزام بالأخلاق قد يكون مكلفًا أحيانًا، إلا أن الحاجة إلى وجود قوانين وأنظمة واسعة النطاق لضبط السلوك تدلّ على أن السعي نحو الالتزام بالأخلاق يظلّ جديرًا بالاهتمام. وفي هذا السياق، يقدّم موراهان توجيهات للشباب المهنيين لمساعدتهم على تطوير عادات سلوكية أخلاقية مثالية، والتعامل مع السلوك غير الأخلاقي عند مواجهته في بيئة العمل. ويُعدّ الفهم العميق لمفاهيم الأخلاق وتبعات السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال أمرًا ضروريًا للمهنيين الشباب في أماكن العمل الحديثة.
كما أشار مارجيريتا وبراكّيني إلى أن المؤسسات يمكنها تحقيق بيئة عمل أخلاقية متوازنة بين رأس المال ورفاه العاملين من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمنهج يتمحور حول الإنسان، حيث تعمل خطوط التجميع في هذا السياق على أساس تفاعل اجتماعي- تقني يجمع بين التكنولوجيا والعاملين (١٣٧).
إنّ منطق العدالة المؤسسية يقود بطبيعته إلى البحث في الأسس الفلسفية للقوانين التي تنظم العمل، إذ لا يمكن ترسيخ الممارسات الأخلاقية داخل المؤسسات من دون إطار قانوني يستند إلى قيم فلسفية واضحة. فالقانون، في هذا السياق، لا يعبّر فقط عن قواعد إلزامية للسلوك، بل عن تصوّر معياري للعدالة يحدّد علاقة الفرد بالمجتمع ويضمن كرامته داخل بيئة العمل.
٤- الأسس الفلسفية لقانون العمل:
تُعدّ الأسس الفلسفية لقانون العمل مجالًا ناشئًا ضمن البحث الأكاديمي. فقد تناولت بعض الدراسات المنعزلة، التي انخرطت في الفكر الفلسفي، جوانب متفرّقة من قانون العمل، مثل الفصل من العمل، والحدّ الأدنى القانوني للأجور، وحرية تكوين الجمعيات، والاعتراف بالنقابات العمالية لأغراض المفاوضة الجماعية، وحقّ العمل. وتهدف هذه الدراسات إلى بلورة منظور فلسفي شامل يغطي موضوع قانون العمل برمّته، إذ يقوم جوهر هذا المنظور على تحليل الأفكار والقيم والمبادئ الأخلاقية والسياسية التي تشكّل أساس التصورات المتعلقة بأغراض ونطاق هذا الفرع القانوني. ويشتمل ذلك على إضاءة هذه الأفكار والقيم والمبادئ التأسيسية وتحليلها نقديًا من حيث معناها وتطبيقها وترابطها، والكشف عن المبادئ والمثل الأخلاقية التي تمثّل الأساس أو الافتراضات التي تستند إليها الرؤى المختلفة حول أهداف قانون العمل وغاياته، ما يمنح فرصة لبناء رؤية فلسفية واسعة النطاق ومتعدّدة الاتجاهات حول أسس هذا القانون (١٣٨).
ينطوي قانون العمل على مجموعة واسعة من المفاهيم غير المحددة، والتي غالبًا ما تكون موضع نزاع. ويتجلى ذلك عند دراسة حقوق العمل المصنّفة كحقوق إنسان، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان بشكل عام. على سبيل المثال، الحق في العمل؛ إذ تنص المادة "24" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "يحق لكل شخص العمل، والاختيار الحر للعمل، وظروف عمل عادلة ومناسبة، والحماية من البطالة." فهل يعني هذا أن لكل شخص الحق في العمل الذي يختاره؟ أم أن لكل شخص الحق في العمل غير الاستغلالي؟ وقد حاولت بعض الدراسات استكشاف معنى هذا الحق، أحيانًا بالاستعانة بأفكار فلسفية مثل تحقيق الذات من خلال العمل. كما نوقشت قضية الحق في الراحة والفراغ، بما في ذلك العطلات المدفوعة، حيث يرى بعض الباحثين أنه لا ينتمي إلى قائمة حقوق الإنسان، بينما يعتقد آخرون أن إنكار هذا الحق يشكّل انتهاكًا لكرامة الإنسان (١٣٩).
أما الحق في "الأجر العادل والمناسب"، فقد ورد في المادة "33" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يحق لكل من يعمل الحصول على أجر عادل ومناسب يضمن له ولأسرته حياة كريمة، ويُستكمل، إذا لزم الأمر، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية." فكيف نفهم مفهوم الأجر العادل والمناسب هذا؟ هل يعني فقط أن يتقاضى العمال الأجر السائد في السوق مقابل عملهم؟ أم أن الإشارة إلى "حياة كريمة" توجب أن يحصلوا على أجر معيشي يغطي الحد الأدنى للاحتياجات، حتى لو تجاوز الأجر السائد في السوق للوظيفة؟ أم أن المبدأ يقتصر على أن تكمل الدولة الدخل المكتسب عندما ينخفض عن خط الفقر للأسرة؟ كان فريدريك إنجلز يرى أن المطالبة بأجر عادل ليست سوى هراء، وأنها لا تعدو كونها أجر فقر يحدده السوق. ومع ذلك، يمكن إعطاء معنى أكثر تحديدًا ومبدئيًا لفكرة الأجر العادل، من خلال تطوير مفهوم متماسك يميز بين الأجر العادل والاستغلال، وهو ما يثير بالضرورة نقاشًا حول تعريف الاستغلال نفسه (١٤٠).
ومن هذا المنطلق، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات العملية التي تُسهم في تعزيز الممارسات المهنية وتطويرها، من أبرزها:
١- تعزيز برامج التعليم والتدريب المستمر لضمان اطلاع المهنيين الدائم على أحدث المعارف والتقنيات في مجالاتهم.
٢- إرساء معايير واضحة للكفاءة والأخلاق المهنية، والعمل على تحديثها بانتظام بما يتوافق مع التطورات العلمية والمجتمعية.
٣- تفعيل آليات الترخيص والاعتماد المهني لضمان جودة الأداء ومصداقية الممارسين أمام الجمهور.
٤- تشجيع البحث العلمي والتعاون المهني بوصفهما وسيلتين لتطوير المهنة وإغناء المعرفة المشتركة.
٥- ترسيخ روح الخدمة العامة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها جوهر الاحتراف وأساس الثقة بين المهنة والمجتمع.
٦- دعم الهيئات المهنية والمؤسسات التنظيمية للقيام بدورها في الإشراف والمساءلة، ونشر ثقافة النزاهة والالتزام.
٧- تعزيز الوعي المهني لدى الممارسين الجدد بما يتعلق بقيم المهنة وأخلاقياتها وأهميتها في خدمة الصالح العام (١٤١).
تمثل هذه التوصيات إطارًا توجيهيًا يهدف إلى تطوير بيئة مهنية تقوم على الكفاءة والنزاهة والتعلم المستمر، بما يضمن تقدّم المهنة وتعزيز دورها المؤثر في المجتمع. وإنّ تطوير الممارسات المهنية وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكفاءة والنزاهة لا يكتمل من دون بنية مؤسسية تضمن المشاركة والمساءلة، إذ تمثل هذه الأخيرة الركيزة الأساسية لاستدامة الأخلاق في العمل العام. فالأخلاق لا تُترجم إلى سلوك واقعي إلا حين توجد منظومة تُمكّن من محاسبة المسؤولين ومشاركة المواطنين في مراقبة أداء المؤسسات.
٥- المشاركة والمساءلة:
يُعَدّ إنشاء سلطة قضائية مستقلة، تتمتّع بمؤسسات فعّالة للمساءلة مثل نظام التدقيق الداخلي، ولجان التحقيق، ومؤسسة أمين المظالم، من العوامل الأساسية لتهيئة بيئة مواتية لقطاع عام أخلاقي. وتشمل الاستقلالية في هذا السياق أن يخضع رؤساء هذه المؤسسات لإجراءات تعيين وعزل خاصة، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية، وأن تتمتّع إدارتها للموارد البشرية والمالية بدرجة كافية من الاستقلال.
ومع ذلك، تشير الأدبيات إلى نقطة ضعف رئيسية في عمل هذه المؤسسات، تتمثّل في تركيزها المفرط على التدقيق المالي وتقييم الأداء، مقارنة بالاهتمام المحدود بدورها في التحقيق في انتهاكات النزاهة. ومن بين المتطلبات الأساسية التي يجب أن يضمّها الإطار القانوني في هذا المجال ما يلي:
1- سلطة قضائية مستقلة وفعّالة؛
2- نيابة عامة مستقلة؛
3- هيئات رقابة وتنفيذ فعّالة، مثل الشرطة؛
4- آليات سليمة لتلقّي الشكاوى وسبل الطعن (١٤٢).
٦- تفعيل الأخلاق في السياسات العامة من منظور فلسفي
في عالمنا المعقّد والمتشابك اليوم، لا يمكن المبالغة في أهمية الأخلاقيات المهنية، فهي تُعدّ الأساس الذي يوجّه المهنيين للتصرّف بمسؤولية وأمانة، بما يخدم مصالح عملائهم والجمهور على حدّ سواء. كما تشكّل هذه الأخلاقيات قاعدة لبيئة مهنية وإدارية سليمة تقوم على الثقة، ما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل. وتظلّ الأخلاقيات المهنية ذات أهمية جوهرية في عصرنا الحالي للأسباب التالية:
١- الثقة والمصداقية: تساهم الأخلاقيات المهنية في بناء الثقة بين المهنيين وعملائهم أو الجمهور، والحفاظ عليها. فعندما يثق الناس بأن المهنيين يتصرفون بنزاهة وكفاءة، يكونون أكثر استعدادًا للتعامل معهم في الخدمات أو المعاملات المهنية.
٢- حماية المصلحة العامة: تؤثر العديد من المهن مباشرةً في رفاه الأفراد وسلامة المجتمع. وتُسهم المعايير الأخلاقية في حماية المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال، يلتزم الأطباء بالمعايير الأخلاقية لضمان سلامة المرضى، كما يتعين على المهندسين الالتزام بالإرشادات الأخلاقية لضمان أمان البنية التحتية.
٣- المساءلة: توفّر الأخلاقيات المهنية إطارًا يُلزم المهنيين بالمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، ما يضمن محاسبتهم على أي سوء سلوك أو إهمال، ويعزّز الانضباط والالتزام في العمل المهني.
٤- تجنّب تضارب المصالح: تُوجّه المبادئ الأخلاقية المهنيين في إدارة تضارب المصالح والإفصاح عنها، وهو أمر بالغ الأهمية في المهن التي قد تؤدي فيها المصالح الشخصية إلى الإخلال بواجب المهني تجاه عملائه أو الصالح العام.
٥- الامتثال القانوني والتنظيمي: يساعد الالتزام بالأخلاقيات المهنية المهنيين على الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، ما يقلّل من خطر التعرض للمساءلة القانونية أو التأديبية.
٦- السمعة المهنية: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية ضروري لبناء سمعة مهنية طيبة والحفاظ عليها، إذ إن السمعة المتضرّرة قد تخلّف آثارًا طويلة الأمد على فرص العمل والثقة المهنية.
٧- القدرة على التكيّف مع المتغيرات: مع تطوّر المجتمع وتقدّم التكنولوجيا، تظهر قضايا أخلاقية جديدة. وتوفّر الأخلاقيات المهنية إطارًا لمعالجة هذه المسائل بمرونة مع الحفاظ على المبادئ الجوهرية.
٨- المسؤولية الاجتماعية: تؤثر المهن في المجتمع والبيئة على نطاق واسع، وتسهم الاعتبارات الأخلاقية في مساعدة المهنيين على اتخاذ قرارات تراعي الصالح الاجتماعي والبيئي العام.
٩- الإشباع الشخصي والرفاه: يحقّق الالتزام بالأخلاقيات المهنية شعورًا بالرضا والمعنى، إذ يجد المهني في سلوكه الأخلاقي مصدرًا للرضا الذاتي والمساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع (١٤٣).
القيم هي المعتقدات الضمنية التي تشكّل الأساس للسلوك الأخلاقي، أي للممارسات التي يُنظر إليها في المجتمع على أنها تصرفات صحيحة وسليمة. ومن هذا المنطلق، ينبغي إدراك الأهمية الجوهرية للقيم التالية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، إذ تمثل الركيزة الأساسية لأخلاقيات المهنة وممارستها بمسؤولية ونزاهة:
١- جودة الحياة: أن يشعر الأفراد بالرضا عن تجاربهم الحياتية.
٢- الصحة، والقدرات الإنسانية، والتمكين، والنمو، والتميّز: أن يتمتع الأفراد بالصحة والوعي بقدراتهم الكامنة، وأن يسعوا إلى تحقيقها وتفعيلها في حياتهم الفردية والجماعية.
٣- الحرية والمسؤولية: أن يتمتع الأفراد بالحرية في الاختيار، مقترنة بالمسؤولية في ممارسة هذه الحرية.
٤- العدالة: أن يعيش الأفراد في مجتمع تتحقق فيه نتائج عادلة وصحيحة للجميع دون تمييز.
٥- الكرامة والنزاهة والحقوق الأساسية: الاعتراف بالقيمة الجوهرية والكرامة الإنسانية والحقوق الأصيلة لكل فرد ومؤسسة ومجتمع.
٦- روح التعاون والمصلحة المشتركة: أن يعمل الأفراد بروح المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع العام.
٧- الأصالة والانفتاح في العلاقات: التحلّي بالصدق والشفافية في التعامل الإنساني.
٨- الفاعلية والكفاءة والاتساق: السعي لتحقيق أفضل النتائج بأقل الموارد، ضمن تناغم بين الأهداف الفردية والعامة.
٩- النظرة الشمولية والنظامية: فهم السلوك الإنساني في إطار النظم الكلية المتداخلة، وتقدير المصالح المتنوعة للأطراف المختلفة بإنصاف.
١٠- المشاركة الديمقراطية واتخاذ القرار الجماعي: تشجيع المشاركة الواسعة في إدارة شؤون المجتمع واتخاذ القرارات على نحوٍ يضمن العدالة والتمثيل المتوازن (١٤٤).
لذلك، يجب الالتزام بما يلي:
أ- احترام حقوق الإنسان والتعامل بلُطفٍ ولباقة:
1- الحقوق الديمقراطية: يحق لموظف الخدمة العامة أن يكون عضوًا في أي حزب سياسي، وأن يُدلي بصوته وفقًا لمعتقداته، سواء في الانتخابات الحزبية أو العامة.
٢- الدين: يجوز لموظف الخدمة العامة الانتماء لأي طائفة دينية، شريطة ألا يخالف القوانين النافذة. ومع ذلك، وبما أن الحكومة لا تتبنّى دينًا رسميًا، يُمنع الترويج للمعتقدات الدينية داخل مكاتب الخدمة العامة.
٣- عدم التمييز: يجب على موظف الخدمة العامة عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة تجاه أي فرد من الجمهور أو زميل في العمل، على أساس النوع، أو القبيلة، أو الدين، أو الجنسية، أو الأصل العرقي، أو الحالة الاجتماعية، أو الإعاقة.
٤- اللباقة في التعامل: ينبغي على موظف الخدمة العامة التعامل بلباقة واحترام مع الرؤساء والزملاء، ومع جميع المواطنين، وخصوصًا العملاء المتلقين للخدمة. وإذا طُلِب منه توضيح مسألة أو تقديم توجيه يتعلق بالقوانين أو اللوائح أو الإجراءات، فعليه أن يفعل ذلك بوضوح وسرعة.
٥- احترام الآخرين وخصوصيتهم: يجب على موظف الخدمة العامة احترام حقوق زملائه وصون خصوصيتهم، لا سيما عند التعامل مع المعلومات الشخصية أو الحساسة.(145)
٦- التحرش الجنسي: يجب على موظف الخدمة العامة الامتناع عن إقامة أي علاقات جنسية داخل مكان العمل، وتجنّب جميع أشكال السلوك التي قد تُعدّ تحرشًا جنسيًا.(146)
ب- الانضباط والاجتهاد:
لضمان أداء فعّال، يجب على الموظف العام أداء واجباته باجتهاد وانضباط عالٍ، واستثمار وقته ومهاراته وخبراته لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن المتوقع من الموظفين العموميين الالتزام بما يلي:
الانضباط:
١- الالتزام بالقانون، وعدم السماح لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو جنسية أو مصالح شخصية أو علاقات خاصة بالتأثير على القرارات.
2- طاعة التعليمات القانونية وتنفيذها بدقة.
٣- أداء المهام المكلّف بها بكفاءة. وإذا رأى الموظف أنه يُطلب منه أداء عمل غير لائق، فعليه إبلاغ رؤسائه بالأمر وفق الإجراءات المعتمدة.
4- الاستعداد للعمل في أي موقع يُكلّف به.
5- الامتناع عن أي سلوك قد يضعف أدائه الوظيفي.
٦- الالتزام بالمواعيد فيما يخص الحضور إلى العمل أو الاجتماعات الرسمية، وعدم التغيب عن العمل دون إذن أو سبب وجيه.
7- تجنّب استخدام الألفاظ الجارحة أو المسيئة في بيئة العمل.
٨- إنجاز المهام الموكلة ضمن المدة الزمنية المحددة وبالمستوى المطلوب من الجودة.(147)
المظهر العام والنظافة الشخصية:
يجب على الموظف الحفاظ على نظافته الشخصية وارتداء لباسٍ لائق ومحترم يتوافق مع الأعراف المعمول بها في مكان العمل، وفق ما تحدده النشرات والتعليمات الإدارية الخاصة بالموظفين.
الحياة الخاصة:
يتعيّن على الموظف، أثناء تواجده خارج مقر العمل، التصرف في حياته الخاصة بما لا يؤثر سلبًا على أدائه الوظيفي أو يضر بسمعة الخدمة العامة. لذا يُحظر عليه الإفراط في تعاطي الخمور أو استخدام المواد المخدّرة، أو القيام بأي سلوك يُعد غير مقبول اجتماعيًا أو مهنيًا.
السرية والخصوصية:
يجب على الموظف العام عدم إفشاء أي معلومات سرّية أو رسمية اطلع عليها أثناء أداء مهامه، إلا بعد الحصول على الإذن اللازم. كما يُطلب الحفاظ على سرية المعلومات الرسمية حتى بعد مغادرة الخدمة العامة.
الإفصاح عن المعلومات:
١- لا يجوز للموظف العام استخدام أي وثيقة رسمية أو نسخها (سواء كانت رسالة أو مستندًا أو معلومات تم الحصول عليها أثناء أداء المهام) لأغراض شخصية.
٢- لا يجوز للموظفين العموميين التواصل مع وسائل الإعلام بشأن القضايا المتعلقة بالعمل أو سياسات الدولة الرسمية دون إذن مسبق.
٣- تُنشر المعلومات الرسمية لوسائل الإعلام فقط من قبل الموظفين المخوّلين بذلك، ووفق الإجراءات المعتمدة.(148)
ج- تضارب المصالح والنزاهة الشخصية
يُعدّ تجنّب تضارب المصالح من الركائز الجوهرية في بناء الثقة العامة والمحافظة على نزاهة الخدمة العامة. ويتطلّب ذلك من الموظف العام أن يتصرّف دائمًا بما يضمن المصلحة العامة، دون أن يسمح لأي مصالح شخصية أو مالية أو عائلية بأن تؤثّر على قراراته أو أدائه المهني. ويُعدّ تضارب المصالح قائمًا عندما تتداخل المصلحة الخاصة للموظف مع واجباته الرسمية بما قد يؤثر على حياده أو يُضعف من ثقة الجمهور في عدالة القرار.
ومن أبرز القواعد الواجبة في هذا الصدد:
١- على الموظف العام الإفصاح عن أي مصلحة مالية أو تجارية أو ارتباط عائلي قد يُحتمل أن يؤثر على نزاهة قراراته.
٢- يُمنع على الموظف قبول أي هدايا أو مكافآت أو امتيازات أو تبرعات أو خدمات من أي جهة قد تكون لها مصلحة في قراراته أو تعاملاته الرسمية.
٣- يُحظر استخدام المعلومات أو الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أطراف خارجية.
٤- يتوجّب على الموظف الامتناع عن المشاركة في أي قرار أو معاملة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
٥- في حال وجود شك في تضارب المصالح، يجب على الموظف إحالة المسألة إلى جهة الإشراف أو لجنة الأخلاقيات للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
إن الالتزام بهذه القواعد لا يحمي فقط سمعة الموظف ونزاهته الشخصية، بل يعزّز كذلك ثقة المواطنين في حياد المؤسسات العامة وعدالة أدائها.(149)
ج- العمل الجماعي
وإدراكًا لأهمية التعاون في تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الخدمة العامة، يسعى موظفو الخدمة العامة إلى ترسيخ روح العمل الجماعي من خلال تقديم الدعم والمساندة لزملائهم كلما دعت الحاجة. فالعمل الجماعي لا يتحقق إلا في ظلّ بيئة يسودها الاحترام المتبادل، والتنسيق الفعّال، والإدراك المشترك للأهداف العامة. ويُحقَّق العمل الجماعي عندما يلتزم الموظفون بما يلي:
1- تقديم تعليمات واضحة وغير مشوّهة.
٢- إعطاء الاهتمام الواجب والاعتبار المناسب للآراء الرسمية المقدمة من الزملاء أو المرؤوسين.
٣- التأكد من أن المرؤوسين يفهمون بوضوح نطاق عملهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم.
٤- منح التقدير للموظف صاحب الأداء المتميز وعدم السعي لأخذ الفضل الشخصي على حسابه.
٥- تجنّب الأفعال أو الكلمات الخبيثة التي تهدف إلى السخرية من المرؤوسين أو الرؤساء.
٦- تقديم تقارير عن المرؤوسين بعدل وموضوعية وبدون أي خوف أو تحيّز.(149)
د- السعي نحو التميّز في الخدمة
ولأن الخدمة العامة تمثل واجهة الدولة ومظهر التزامها تجاه مواطنيها، فإنها تتطلّب من موظفيها السعي الدائم نحو التميّز في الأداء، والإخلاص في تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة والمهنية. ومن ثم، يجب على موظفي الخدمة العامة الالتزام بما يلي:
1- السعي لتحقيق أعلى معايير الأداء.
٢- إذا كان الموظف عضوًا في هيئة مهنية (مثل الأطباء، المعلمون، الصيادلة، المهندسون، المحامون، إلخ)، فعليه الالتزام بمدوّنة السلوك المهني الخاصة بتلك الهيئة.
٣- السعي لاكتساب المعرفة والمهارات الجديدة بشكل مستمر واستخدامها بفعالية في أداء المهام.
٤- إدراك الحاجة إلى التدريب والسعي للحصول على الدورات التدريبية المناسبة لتعزيز الكفاءة.(15- )
إن هذه المبادئ لا تقتصر على تنظيم سلوك الموظف داخل بيئة العمل فحسب، بل تمتد لتشكّل إطارًا عامًا لترسيخ المسؤولية المؤسسية وحسن الإدارة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المستويات. فالسعي نحو النزاهة والتميّز في الخدمة العامة لا ينفصل عن أداء الواجبات بروح العدالة والحياد السياسي، وبما يضمن ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحقيق المصلحة العامة في أسمى صورها.
المحور السابع: الفلسفة بوصفها مهنة، وبوصفها رسالة
1- هل الفلسفة مهنة أم تخصص؟
لم تكن الفلسفة، في نشأتها الأولى، مهنةً بالمعنى الأكاديمي أو الوظيفي الحديث، بل كانت سعيًا حرًّا نحو الحكمة، يزاوله المفكرون خارج جدران المؤسسات. فالفيلسوف لم يكن دائمًا أستاذًا جامعيًا أو صاحب كرسي أكاديمي، بل كان مفكرًا حرًّا يتحرك بين مجالات العلم والأدب والسياسة والدين.
وقد شهد التاريخ الحديث للفكر الغربي أمثلة بارزة على فلاسفة لم يتخذوا الفلسفة مهنة رسمية، بل عاشوا فلسفتهم ضمن مهن أخرى أو خارج الإطار المؤسسي تمامًا. فـ ديكارت درس القانون وخدم في الجيش قبل أن يتفرغ للتأمل العقلي، وسبينوزا رفض المناصب الأكاديمية ليكسب رزقه من صقل العدسات، وجون لوك عمل طبيبًا ومستشارًا سياسيًا، وبركلي وريد كانا رجلَي دين قبل أن يصيرا فلاسفة، وهيوم اشتغل موظفًا ومربّيًا ثم دبلوماسيًا، وجون ستيوارت ميل كان إداريًا في شركة الهند الشرقية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان، ونيتشه درّس فقه اللغة لا الفلسفة، وفريجه كان رياضيًا قبل أن يؤسس المنطق الحديث، أما بيرس فاشتغل بالعلوم التطبيقية في هيئة المسح الساحلي الأمريكية.لقد كان الفلاسفة هؤلاء يزاولون الفكر كحياة لا كمهنة، ويبرهنون أن الفلسفة ليست مقصورة على قاعات الجامعات، بل هي أسلوب وجود وبحث عن الحقيقة.(151)
أما في العصر الحديث، فقد اتخذت الفلسفة شكلًا مهنيًا مؤسسيًا واضحًا، فأغلب من يُسمَّون "فلاسفة" اليوم هم أساتذة جامعيون أو باحثون أكاديميون يتقاضون رواتبهم لقاء التدريس والبحث. ولم يَعُد من الشائع أن نجد فلاسفة يعيشون خارج الإطار الأكاديمي إلا في حالات نادرة، مثل روجر سكروتن الذي انسحب من الجامعة ليعمل مستقلًا في مراكز الأبحاث والاستشارات الفكرية. وهكذا أصبحت الفلسفة، في الغالب، مهنة أكاديمية أكثر منها نداءً فكريًا أو رسالة وجودية.(152)
2- التمييز بين الفلسفة بوصفها مهنة والفلسفة بوصفها رسالة:
تُشير سوزان هاك (Susan Haack) إلى هذا التحول الجوهري في طبيعة الفلسفة من كونها رسالة إنسانية إلى كونها مهنة أكاديمية، محاولةً أن تميّز بين الموقفين تمييزًا دقيقًا. تقول هاك:
"يتحدد موضوعي في هذا المقام في الفرق بين الفلسفة بوصفها مهنة أكاديمية، والفلسفة بوصفها نداءً أو دعوةً أو رسالة، لا بمعناها الديني، بل بالمعنى الذي نصف به مهنة التمريض مثلًا على أنها رسالة. وهذا التمييز يتجاوز الفارق التقليدي بين المحترف والهاوي، فصاحب الرسالة الفلسفية يواصل التفلسف حتى لو لم يُدفع له أجر لقاء ذلك..."(153)
فالفلسفة، بهذا المعنى، ليست مجرد حرفة فكرية أو نشاط بحثي يُكافأ عليه ماديًا، بل هي استجابة داخلية لنداء الحقيقة. والهاك هنا لا تحتقر "الهاوي"، بل تعيد الاعتبار لفكرة التفلسف الحر الذي لا يُحدَّد بالعائد المهني، بل بالإخلاص للحقيقة والسعي وراء الفهم الأعمق. ومن أبرز من جسّد هذا النموذج، كما تقول، تشارلز ساندرز بيرس، الذي واصل إنتاجه الفلسفي الكبير رغم فقره وتهميشه الأكاديمي.
غير أن هاك تلفت النظر إلى أن الفيلسوف قد يكون، في حالات نادرة، جامعًا بين الأمرين: أن يكون الفلسفة بالنسبة إليه مهنةً ورسالةً في آنٍ واحد. غير أن هذا الوضع يولّد، كما تقول، توترًا بين قيمٍ متعارضة؛ فالتقدّم الفلسفي الحقيقي يتطلب شجاعة فكرية وصبرًا وجوديًا على الخطأ والصواب، بينما النجاح المهني الأكاديمي يعتمد على الامتثال للمعايير المؤسسية والقياسات الشكلية للإنجاز. تقول هاك:
"الطموح الجوهري للفيلسوف هو اقتحام حصن المعرفة، أو على الأقل أن يكون أحد الجثث التي تتسلّق فوقها الأجيال اللاحقة في طريقها إلى الحقيقة... أما النجاح في المهنة الأكاديمية فله طموحات أخرى مختلفة تمامًا."(154)
إن الفيلسوف المهني قد ينجح في حقل التدريس والنشر والترقي الوظيفي، لكنه ليس بالضرورة ساعيًا وراء الحقيقة بالمعنى العميق الذي قصدته الفلسفة الكلاسيكية. أما من يرى الفلسفة رسالةً، فهو يخاطر أحيانًا بأن يُهمَّش أو يُخطئ الطريق، لكنه يظل أمينًا لجوهر التفلسف بوصفه بحثًا وجوديًا لا وظيفةً مؤسسية.
وتوضح هاك أن هذا التمييز لا يعني أن أصحاب الرسالة أكثر نفعًا للفكر من أصحاب المهنة، ولا العكس، إذ قد يُنتج الفيلسوف الأكاديمي فكرةً عظيمة بفضل انضباطه المنهجي، في حين قد يضيع الفيلسوف الحر في متاهة التأملات غير المثمرة. تقول:"حتى أكثر الفلاسفة إخلاصًا قد يُضيعون وقتهم في طرقٍ مسدودة، في حين قد يُصيب أكثر المحترفين برودًا فكرةً بالغة الأهمية."(155)
غير أن المعنى الأعمق الذي تقترحه هاك هو أن قيم التفلسف الأصيلة — البحث عن الحقيقة، الصدق الفكري، الجرأة في التساؤل — قد تُصاب بالوهن حين تُختزل الفلسفة إلى مجرد مهنة أكاديمية. فـ"الطبيعة الفلسفية"، كما قال أفلاطون، قابلة للفساد إذا وجدت نفسها في بيئة رديئة، أي في بيئة لا تكرّم الحقيقة لذاتها، بل للمنافع والمكانة.
خاتمة
خلال هذا البحث، تمّ استكشاف فلسفة أخلاقيات المهنة في الوظائف العامة من خلال تحليل الأسس الفلسفية، والقيم المهنية، والواجبات الأخلاقية، والعلاقات بين الفرد والمؤسسة، وذلك بهدف تقديم رؤية شاملة تربط النظرية الفلسفية بالتطبيق العملي في السياق الإداري المعاصر. وقد أظهرت الدراسة أن الوظيفة العامة ليست مجرد وظيفة تنظيمية أو دور بيروقراطي، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب النزاهة، والعدالة، والكفاءة، والشفافية، والالتزام بالقيم التي تضمن حماية الصالح العام.
وأظهرت الفصول المختلفة أن أخلاقيات المهنة ترتكز على ثلاثة مستويات مترابطة: الأخلاق الفردية للموظف، والأخلاق المؤسسية للهيئة العامة، والقيم المجتمعية التي تحكم التفاعل بينهما. كما بيّن البحث أن الفلاسفة الكلاسيكيين والمعاصرِين قدّموا نماذج مهمة لفهم الواجب، والفضيلة العملية، والمسؤولية الاجتماعية، والتي يمكن توظيفها لتوجيه سلوك الموظف العام وتحقيق بيئة عمل مهنية أخلاقية ومتوازنة.
من خلال دراسة القيم المهنية الأساسية مثل الصدق، والأمانة، والعدالة، والخدمة العامة، وتفعيل العقل العملي، والمسؤولية، والمساءلة، تبيّن أن بناء ميثاق فلسفي لأخلاقيات الوظائف العامة يُعتبر خطوة ضرورية لضمان استمرار النزاهة، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. كما أوضحت الدراسة أن الفلسفة بوصفها رسالة تتجاوز كونها مجرد مهنة، فهي تحفّز الموظف على التعامل مع عمله بروح المسؤولية العميقة والالتزام الأخلاقي المستمر، بما يجعل الوظيفة العامة أداة لتحقيق الخير العام وليس مجرد وسيلة للتقاضي أو السلطة.
وفي ضوء ما سبق، يمكن الاستنتاج بأن تعزيز أخلاقيات المهنة في الوظائف العامة يتطلب دمج القيم الفلسفية مع السياسات والإجراءات العملية، وتدريب الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية، وبناء نظم مؤسسية داعمة للمساءلة والشفافية، وتشجيع ثقافة العمل الجماعي والسعي نحو التميز. وتشكّل هذه العناصر معًا أساسًا لإرساء بيئة إدارية متوازنة، تسهم في خدمة المجتمع بفعالية، وتضمن حماية الحقوق والمصالح العامة، وتحقق الغاية الجوهرية للوظيفة العامة كرسالة أخلاقية وإنسانية.
***
دكتور ابراهيم طلبه سلكها – أستاذ فلسفة
2- 25
......................
الهوامش
1. Candidate Guide. CCAANNDDIIDDAATTEE GGUUIIDDEE: Professional Ethics, p. 13.
2. Ibid., p. 14.
3. Ibid., p. 15.
4. Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. “What Does It Mean to Be a ‘Professional’ ... and What Does It Mean to Be an Ergonomics Professional?” FPE Position Paper: Professionalism, June 2- , 2- - 6, p. 5.
5. Tapper, Alan, and Stephan Millett. 2- 15. “Revisiting the Concept of a Profession.” Research in Ethical Issues in Organizations 13: 1–18. Emerald Group Publishing Limited, p. 3.
6. Ibid., pp. 4–5.
7. Ibid., p. 5.
8. Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. Op. cit., p. 3.
9. Tapper, Alan, and Stephan Millett. Op. cit., p. 3.
1- Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. Op. cit., p. 4.
11. Australian Council of Professions. 2- - 3. “What is a Profession,” [email protected]. Accessed 14/1- /2- 25.
12. Tapper, Alan, and Stephan Millett. Op. cit., p. 7.
13. Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. “What Does It Mean to Be a ‘Professional’ ... and What Does It Mean to Be an Ergonomics Professional?” FPE Position Paper: Professionalism, June 2- , 2- - 6, p. 1.
14. Ibid., p. 3.
15. Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. “What Does It Mean to Be a ‘Professional’ ... and What Does It Mean to Be an Ergonomics Professional?” FPE Position Paper: Professionalism, June 2- , 2- - 6, p. 4.
16. Joel F. Montezinos. “On a Professional Philosophy of Polygraph,” Polygraph 45, no. 1 (2- 16), pp. 44–46.
17. Naagarazan, R. S. Professional Ethics and Human Values. New Delhi: New Age International Publishers, 2- - 6, p. 1.
18. Ibid., p. 2.
19. Ibid., p. 5.
20 . Ibid., Preface.
21. Ibid., 1.
22. Airaksinen, Timo. The Philosophy of Professional Ethics. In Institutional Issues Involving Ethics and Justice, Vol. I. The Philosophy of Professional Ethics, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), p. 1.
23. Lo- Cit.
24. Lo- Cit.
25. Ibid., p. 2.
26. Elango, B., et al. “Organizational Ethics, Individual Ethics, and Ethical Intentions in International Decision- Making.” Journal of Business Ethics 97, no. 4 (2- 1- ): 543–561. https://doi.org/1- .1- - 7/s1- 551- - 1- - - 524- z, p. 543.
27. Ibid., p. 454.
28. Lo- Cit.
29. Ibid., pp. 454–455.
3- . Ibid., p. 455.
31. “An Ethical Study.” International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) 12, no. 4 (April 2- 24). https://www.ijcrt.org, p. 17- .
32. Lo- Cit.
33. Ibid., pp. 17- –171.
34. Ibid., p. 172.
35. Ibid., pp. 172–173.
36. Halper, Edward. “Aristotle’s Political Virtues.” In Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, vol. 3, 154–161. The Paideia Archive, 1998. https://doi.org/1- .584- /wcp2- - paideia1998356.
37. Inamura, K. (2- 23). “Aristotle's political theory as a craft and science in Politics 4–6.” Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, 39(3), 553–575. https://doi.org/1- .1163/2- 512996- 1234- 381, p. 4.
38. Lo- Cit.
39. Lo- Cit.
4- . Walschots, Michael. “Kant and the Duty to Act from Duty.” History of Philosophy Quarterly 39, no. 1 (2- 22): 59–75. https://doi.org/1- .54- 6/21521- 26.39.1.- 4, p. 1.
41. Isserow, Jessica (2- 22). “Doubts about Duty as a Secondary Motive.” Philosophy and Phenomenological Research, 1- 5 (2): 276–298. https://doi.org/1- .1111/phpr.12821, p. 3.
42. Kasony, Amos Julius, and Thomas Marwa Monchena. “Ethics of Duty and Crime Prevention: Practical Applications of Kantian Philosophy in Tanzania.” International Journal of Social Science and Human Research 8, no. 7 (July 2- 25): [pages if available]. ISSN (print): 2644- - 679. ISSN (online): 2644- - 695, p. 55- 6.
43. Lo- Cit.
44. Lo- Cit.
45. Ibid., p. 55- 7.
46. Lo- Cit.
47. Lo- Cit.
48. Orji, Chidi Paul. "The Ethical Principles of John Rawls as a Tool for Social Justice and Peace in Contemporary Society." Socialscientia Journal 1- , no. 1 (March 2- 25). ISSN 2636- 5979, p. 64.
49. Lo- Cit.
5- . Ibid., p. 65.
51. Lo- Cit.
52. Ibid., p. 7- .
53. Putri, Audrey Adyuta, and Elisatris Gultom. “John Rawls' Theory of Justice in the Perspective of Shareholder Rights Protection.” Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4, no. 1 (January 2- 25), p. 295.
54. Ibid., p. 289.
55. Lo- Cit.
56. John Rawls. A Theory of Justice, Revised Edition. Harvard University Press, 1999, p. 54.
57. Rawls. A Theory of Justice, Revised Edition. Harvard University Press, 1999, pp. 384–386.
58. Udell, L. “Rawls, Libertarianism, and the Employment Problem.” Philosophy & Public Affairs, Vol. 43, No. 2, 2- 15, p. 173.
59. Ibid., pp. 176–178.
6- . Rawls. Justice as Fairness: A Restatement. Harvard University Press, 2- - 1, p. 13- .
61. Barbara Fried. “The Unwritten Theory of Justice.” Philosophy & Public Affairs, Vol. 41, No. 1, 2- 13, p. 46.
62. Ibid., pp. 47–49.
63. Habermas, J. The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press, 1984, p. 45.
64. Ibid., p. 95.
65. Ibid., pp. 13- –132.
66. Deflem, Mathieu. “Law in Habermas’s Theory of Communicative Action.” Vniversitas, no. 116, July–Dec. 2- - 8, pp. 267–285. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, p. 17- .
67. Desmond, E. 2- 18. "Critical Theory and Communicative Action: The Challenge of Legitimation in a World at Risk." In Social Theory and Asian Dialogues: Cultivating Planetary Conversations, edited by A. K. Giri, 399–422. Singapore: Palgrave Macmillan, p. 8.
68. Ibid., p. 12.
69. Lawrence E. Blume and David Easley. Rationality, June 2- - 7, p. 1.
7- . Ibid., pp. 1–2.
71. Alexandr Soukup et al. “The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory.” Modern Applied Science; Vol. 9, No. 3; 2- 15, p. 2.
72. Ibid., p. 3.
73. Vanberg, Viktor J. 2- - 6. Rationality, Rule- Following and Emotions: On the Economics of Moral Preferences. Papers on Economics and Evolution, No. - 621. Jena: Max Planck Institute of Economics, pp. 1–2.
74. Ibid., p. 5.
75. Ibid., p. 9.
76. Ibid., p. 11.
77. Sudrajat, A. R. (2- 23, January). “Implementation of Ethics in Public Services Towards Good Governance in the Perspective of Public Administration.” Journal of Social Science, 4(1), 4- –44, p. 4- .
78. Ibid., p. 41.
79. Lo- Cit.
8- . Christoph Demmke & SNE Timo Moilanen. “Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration: Evaluating Reform Outcomes in the Context of the Financial Crisis.” European Institute of Public Administration, December 2- 11, p. 5.
81. Ibid., pp. 5–6.
82. Ibid., pp. 6–7.
83. Ibid., p. 1- .
84. Kumar, Anil. "Importance of Professional Ethics for a Teacher." International Journal of Literacy and Education 2, no. 1 (2- 22): 158–161, p. 158.
85. Ibid., pp. 158–159.
86. Victoria, Artur. "Characteristics of a Profession." July 2- 18. https://doi.org/1- .1314- /RG.2.2.36676.32643, p. 1.
87. Christoph Demmke & SNE Timo Moilanen. Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration: Evaluating Reform Outcomes in the Context of the Financial Crisis. European Institute of Public Administration, December 2- 11, p. 23.
88. Lo- Cit.
89. Ibid., pp. 23–24.
9- . Ibid., p. 27.
91. Milgram, Stanley. “The Perils of Obedience.” Harper’s Magazine 248, no. 1483 (December 1973): 62–77. Abridged and adapted from Obedience to Authority by Stanley Milgram. Copyright 1974 by Stanley Milgram, p. 64.
92. Freeman, R. Edward, and Andrew C. Wicks. A Note on Obedience to Authority. Darden Case No. UVA- E- - - 7- . Charlottesville, VA: University of Virginia Darden School of Business, 2- - 8, p. 3.
93. Brassfield, Elizabeth R. Conscience and Its Role in Moral Life. Chapel Hill, 2- 2- , p. iii.
94. Piet J. M. Verschuren. “The Meaning of Honesty for Research.” Quality & Quantity 37, no. 3 (2- - 3): 257–276. https://doi.org/1- .1- 23/A:1- 2447291- 729, p. 33.
95. Ibid., pp. 33–34.
96. La Red Business Network. The Management Principle of Honesty. Revised July 2- 13. https://lared.org/PDF/ENG/Honesty, p. 1.
97. UN Global Compact Network Germany and Alliance for Integrity. Corporate Integrity: Catalogue of Practices. Berlin: UN Global Compact Network Germany, 2- 2- . https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/AfIn_Corporate_Integrity.pdf, p. 6.
98. Ibid., p. 11.
99. Šumah, Štefan, et al. “Administrative Corruption.” American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 4, no. 12: 143–149. e- ISSN 2378- 7- 3X, p. 143.
1- - . Lo- Cit.
1- 1. Šumah, Štefan, et al. “Administrative Corruption.” American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 4, no. 12: 143–149. e- ISSN 2378- 7- 3X, p. 143.
1- 2. Ibid., p. 144.
1- 3. Lo- Cit.
1- 4. Lo- Cit.
1- 5. Ibid., p. 147.
1- 6. Ruhollah Akrami and Mehrad Momen. “Combating Corruption in Public Administration, Policy and Governance: a Perspective on Iranian Law.” Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume 1, Issue 2, 2- 23, p. 227.
See Also:
- Christoph Demmke & SNE Timo Moilanen. Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration: Evaluating Reform Outcomes in the Context of the Financial Crisis. European Institute of Public Administration, December 2- 11, p. 41.
1- 7. Thornton, Joe Robert. The Depths of Mediocrity: Eliminating Indifference. Joe Robert Thornton Publishing, 2- 21, p. 12.
1- 8. Ibid., p. 115.
1- 9. Ibid., p. 122.
11- . Ibid., pp. 45–47.
111. Ibid., p. 63.
112. Rossouw, Deon, and Leon van Vuuren. Codes of Ethics Handbook. Pretoria: The Ethics Institute, 2- 2- , p. 2.
113. Rebekah Rousi and Ville Vakkuri. Introduction to Ethics in the Age of Digital Communication. 2- 23, p. 4.
114. Jorge Ferreira. Interpersonal Relationships in the Contemporary 21st Century Society. London, United Kingdom, p. 1.
115. Rebekah Rousi and Ville Vakkuri. Introduction to Ethics in the Age of Digital Communication. 2- 23, p. 1.
116. The United Republic of Tanzania. Code of Ethics and Conduct for the Public Service. Dar es Salaam: The Public Service Office, Government of the United Republic of Tanzania, [n.d.], p. 4.
117. Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. “What Does It Mean to Be a ‘Professional’ ... and What Does It Mean to Be an Ergonomics Professional?” FPE Position Paper: Professionalism, June 2- , 2- - 6, p. 1.
118. Alastair Vincent Campbell and A/Prof Anita Ho. The Philosophy of Professionalism and Professional Ethics. CMEP — 15th Anniversary, SMA News June 2- 15, p. 24.
119. Ibid., p. 25.
12- . Loc- Cit.
121. Loc- Cit.
122. Gildenhuys, J. S. H. The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach, an Introduction for Undergraduate Students. Stellenbosch: Sun Press, a division of African Sun Media, 2- - 4, pp. 57–58.
123. Ibid., pp. 67–68.
124. Ibid., p. 68.
125. Christoph Demmke & SNE Timo Moilanen. Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration: Evaluating Reform Outcomes in the Context of the Financial Crisis. European Institute of Public Administration, December 2- 11, p. 39.
126. Loc- Cit.
127. Loc- Cit.
128. Ibid., p. 4- .
129. Pourkiani, Masoud. “Evaluation of Professional Ethics Relations and the Level of Implementation of the Policies of the Organization of Natural Resources, Forests, Ranges and Watershed Management of the Country.” Ethics & Society: International Journal of Ethics & Society 4, no. 4 (2- 23): 45–52, pp. 44–45.
13- . Elango, B., et al. “Organizational Ethics, Individual Ethics, and Ethical Intentions in International Decision- Making.” Journal of Business Ethics 97, no. 4 (2- 1- ): 543–561. https://doi.org/1- .1- - 7/s1- 551- - 1- - - 524- z, p. 543.
131. Lo- Cit.
132. “An Ethical Study.” International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) 12, no. 4 (April 2- 24). https://www.ijcrt.org, pp. 174–175.
133. Ibid., p. 175.
134. Charles, M. Arockia, and Dr. Imkumnaro. “Ethics in Professional Life: Implications for Learning, Teaching and Studying.” Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) 9, no. 9 (September 2- 22). https://www.jetir.org, pp. 133–134.
135. Ibid., p. 134.
136. Chen, Che- Fei. “Importance of Professional Ethics for Learning.” International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB) 2, no. 2 (2- 24). ISSN 2987- 1972, p. 3725.
137. Philosophical Foundations of Labour Law, edited by Hugh Collins, Gillian Lester, and Virginia Mantouvalou. Oxford University Press, 2- 18, p. 1.
138. Ibid., p. 21.
139. Ibid., p. 12.
14- . Rice, Valerie J., and Jerry R. Duncan. Op. Cit., p. 8.
141. Christoph Demmke & SNE Timo Moilanen. Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration: Evaluating Reform Outcomes in the Context of the Financial Crisis. European Institute of Public Administration, December 2- 11, pp. 41–42.
142. Chen, Che- Fei. “Importance of Professional Ethics for Learning.” International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB) 2, no. 2 (2- 24). ISSN 2987- 1972, pp. 3724–3725.
143. Candidate Guide. CCAANNDDIIDDAATTEE GGUUIIDDEE: Professional Ethics, p. 12.
144. The United Republic of Tanzania. Code of Ethics and Conduct for the Public Service. Dar es Salaam: The Public Service Office, Government of the United Republic of Tanzania, [n.d.], pp. 4–5.
145. Loc- Cit.
146. Ibid., pp. 6–7.
147. Ibid., p. 7.
148. Ibid., pp. 8–9.
149. Ibid., p. 9.
15- . Loc- Cit
151. Susan Haack. "Philosophy as a Profession, and as a Calling." Syzetesis 8 (2- 21): 33–51, pp. 34–36.
152. Ibid., pp. 36–37.
153. Ibid., p. 38.
154. Lo- Cit.
155. Ibid., pp. 38–39.