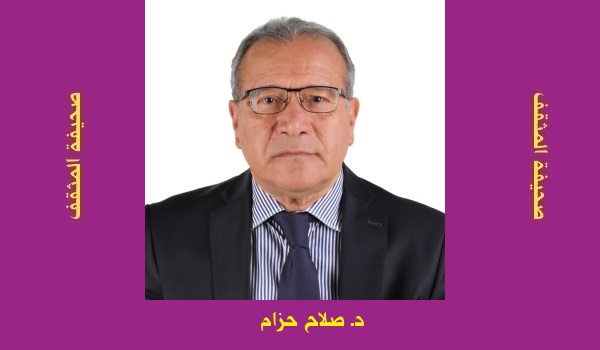قراءات نقدية
عبد الله الفيفي: وقائع المتنبِّي في شُرَّاح شِعره!

حدَّثَنا (ذو القُروح) في المساق السابق عن بيت (المتنبِّي):
أَلُوْمُ بِهِ مَنْ لامَني في وِدادِهِ
وحُقَّ لِخَيْرِ الخَلْقِ مِن خَيْرِهِ الوُدُّ
وكيف أنَّ (ابن جِنِّي) جاء شارحًا، فقال: «أي: هو خَير الخَلْق وأنا كذلك! وحقيقٌ أهل الخَير أنْ يودَّ بعضهم بعضًا، فحقيق عليَّ، إذن، أن أودَّه!» فردَّ كلامَه (ابنُ معقل) قائلًا: «أقول: إنَّه يُحتمل أن يكون «من خَيره» راجعًا إلى آباء الممدوح، كأنَّه قال: هو خَير الخَلْق من خَير الخَلْق، وهذا الأقرب والأشبه بغرضه؛ لأنَّ وصفه نفسه بأنَّه خَير الناس من أقصى الرَّقاعة، وأقبح الشَّناعة!»(1) وقال ذو القُروح: إنَّه على طرافة شرح ابن جِنِّي- ولا يَبعد أن يكون ما ذكرَ هو مقصود الشاعر بالفعل، ولعلَّ ابن جِنِّي أعلم بمقاصد المتنبِّي من غيره- فإنَّ معناه حسب شرح ابن معقل لا يخلو من الشناعة أيضًا! وذلك بعد أن ذكرَ أنَّ (أبا الطَّيِّب) كان يَصِل من سُخف المديح ما لا يَصِل إليه عابدٌ خانعٌ مع ربِّه، بالرغم من ادِّعائه الكرامة والاعتزاز بالذات. قال: ويبدو هذا التعالي لديه تظاهرًا نفسيًّا يُخفي نقيضه، أو قُل: إنه ضربٌ من التعويض النَّفسي. قلتُ:
ـ وما المستغرب في تأليه (المتنبِّي) بعض ممدوحيه، وهو القائل عن بعضهم:
وإِذا مُدِحتَ فَلا لِتَكْسَبَ رِفعَـةً ::: لِلشَّاكِرينَ عَلـى الإِلَـــهِ ثَـنــاءُ
ـ قطعتْ جهيزة قول كلِّ خطيب، ببيته هذا! والبيت من قصيدة مديح في (هارون بن عبد العزيز الأوراجي)، الكاتب، وكان صوفيَّ المذهب.
ـ إذا كان هذا في مديح كاتبٍ صوفيٍّ، فماذا تُراه قائلًا عمَّن فوقه منزلة؟!
ـ وأعود إلى القول: إنَّ ابن معقل كثيرًا ما يخطِّئ ابنَ جنِّي ويبدو هو الخاطئ. ومن ذلك ما ذكره في بيتنا الشاهد؛ فما علاقة آباء الممدوح بسياق البيت؟ وإنَّما كان (المتنبِّي) يشير إلى وِداده هو للممدوح: «ألومُ به مَنْ لَامَني في وِدادِهِ.» فلمَّا لامَه اللائمون على وِداده إيَّاه، أجابهم بأنَّ الطيور على أشكالها تقع: «وحُقَّ لِخَيْرِ الخَلْقِ من خَيْرِهِ الوُدُّ.» أمَّا ما أشار إليه (ابن معقل)، فتكلُّفٌ محض. وأمَّا حكاية الرَّقاعة والشَّناعة، إنْ صحَّت، فله أن يقذف بها أبا الطَّيِّب كما شاء، ولا حاجة به إلى تحريف معانيه لتبرئته من الرَّقاعة والشَّناعة! وليس المعنى بغريبٍ على أبي الطَّيِّب في فخره بذاته، ووقوفه أحيانًا نِدًّا لممدوحيه، في انفصام شخصيَّته التي لازمت خِطابة الشِّعري: بين الخنوع والكبرياء. لكأنَّ ابن معقل ما كان يعرف طبيعة المتنبِّي تلك! والحقُّ أنَّه إنَّما كان يوقِع ابنَ معقل في مثل هذا حُبُّ المِراء، ونزوعُه إلى التنقُّص من شُرَّاح شِعر المتنبِّي، وإظهار أنَّه يفهم شِعره خيرًا منهم. وقد كان هذا يحمله أحيانًا على الذهاب إلى معانٍ بعيدة، كما رأينا في البيت السابق، وأحيانًا إلى معانٍ أقلَّ شِعريَّة وبلاغيَّة. مثال هذه الحالة الأخيرة أنَّه توقَّف أيضًا عند قول أبي الطَّيِّب، من داليَّةٍ أخرى:
ومِنِّي استَفادَ النَّاسُ كُلَّ فَضِيلةٍ ::: فَجازوا بِتَركِ الذَّمِّ إِنْ لَم يَكُنْ حَمْدُ
فعاب على (ابن جنِّي) شرحه البيت؛ لأنَّه قال: «قوله: «فجازوا»، كما تقول: هذا الدِّرهمُ يجوزُ على خُبْث نَقده؛ أي: يُتَسَمَّح به، أي: فغايتُهم أن لا يُذَمُّوا، وأمَّا أن يُحمَدوا، فلا.» فانتكس (ابنُ معقل) بمعنى البيت، قائلًا: «وأقول: إنَّه قد عابوا عليه هذا التفسير، وقيل: كيف يزعم أنَّه قد أحكمَ سماع شِعر أبي الطَّيِّب منه، وقراءته عليه، ويقول هذا القول؟ وإنَّما قوله: «فجازوا» أمرٌ من المجازاة، لا من الجواز، أي: «فجازوا» على ما استفدتم منِّي من الغرائب بترك الذَّمِّ لي إنْ لم يكن منكم حَمْد.»(2)
ـ فأيُّ المعنيين الآن أبلغ؟
ـ هنا السؤال! أيُّهما أبلغ: أن يطلب الشاعر من النَّاس أن يتركوا ذَمَّه، إنْ لم يحمدوه؟ وأنَّى للمحسود أن يطلب من حاسده ترك ذَمِّه أصلًا، فضلًا عن احتمال الحمد؟! أهذا أبلغ، أم أن يصوِّر ما اكتسبوه من غرائب- [وظاهرٌ هنا أنَّ الرواية التي يعتمد عليها (ابن معقل) في شرحه بلفظ «كل غريبة» لا «كل فضيلة»]- إنَّما اكتسبوها منه هو، لتَستُرهم من الذَّمِّ، وأمَّا الحَمْد فهيهات؛ فهو بعيدٌ عن «شواربهم»؟
ـ لا شكَّ عندك أنَّ فهم (ابن جنِّي) لمراد الشاعر هنا أَوْجَه، وأبلغ، وأشبه بمذهب (أبي الطَّيِّب) في الشِّعر والفخر، مما فهمه (ابن معقل)، أو قُل: مما حاول فهمه، لتخطيء ابن جنِّي؟
ـ لا شك! حتى لقد جعل (ابن معقل) الشاعرَ ملتفتًا إلى التسوُّل لدَى حاسدِيه ليكفُّوا عنه ذَمَّهم! وما كان هذا ممَّا يليق بالمتنبِّي الالتفات إليه، ولا حتى بمَن دون المتنبِّي، في تكبُّره وتعاليه. وإنَّما «جازوا» فعلٌ ماضٍ، معطوفٌ على الفعل الماضي في صدر البيت، بلا التفات: «استفادَ الناس... فجازوا...». تساوقًا مع قوله قبل هذا البيت مباشرةً:
يَرومونَ شأوي في الكَلامِ وإنَّما ::: يُحاكي الفَتَى فيما خَلا المَنطِقَ القِردُ
فَهُمْ في جُموعٍ لا يَراها ابنُ دَأْيَةٍ ::: وهُمْ في ضَجيجٍ لا يُحِسُّ بِها الخُـلْدُ
فهم من الحقارة كالقرود، والقِرد قد يحاكي الفتَى لكنَّه لا يبلغ شأوه، وهم من الخفاء بحيث لا يراهم حتى الغُراب (ابن دَأْيَة)، على حِدَّة بَصَره، ولا يسمعهم حتى (الخُلْد)، نوع من الفئران، على رهافة سمعه. وهكذا كان المتنبِّي يُوقِع شُرَّاحه في حبائل القراءات المحتملة، ليسهروا جرَّاها ويختصموا؛ بمثل استعماله كلمة «جازوا» هاهنا، التي يُمكِن أن تُقرَأ على وجهَيها، مع ما بين القراءتين من بَون في الدلالة والتصوير والشِّعريَّة.
ـ غير أنَّه يبدو أنَّه كان بين شُرَّاح شِعر (أبي الطَّيِّب) من المماحكات، كما كان بين شُرَّاح شِعر (أبي تمَّام)؛ فظلَّ ذلك يحمل أحدهم على تنقُّص الآخَر، وإظهار أنَّه أكثر منه فهمًا للشِّعر ودِقَّة.
ـ ومِن ثَمَّ كانوا يصنعون من حَبَّة بيتٍ شِعريٍّ سطحيٍّ قُبَّةً هائلةً، يستعرضون تحتها عضلاتهم في الحفر اللُّغوي، والتشقيق الفارغ، والمصارعة الحُرَّة شرحًا وتشريحًا.(3) وستلحظ أنَّ هؤلاء الشُّراح يقعون في معرَّة (وحدة البيت)، فلا ينظرون إلى البيت في سياقه من الأبيات غالبًا، بل يدندنون على البيت الواحد، وكأن لا علاقة له بما قبله وما بعده؛ فترى منهم في ذلك العجب العجاب من المعاني التي يتوهَّمون منها ما قد لا يتوهَّمه إلَّا من ليس في وعيه!
ـ مثال ذلك؟
ـ خُذ مثلًا توقُّفهم الطويل العريض والمعقَّد أمام بيت المتنبِّي الواضح:
إِنَّ المُعينَ عَلى الصَّبابَةِ بِالأَسَى ::: أَولَــى بِرَحمَــةِ رَبِّهـا وإِخـائِهِ
وقد جاء قبله:
مـا الخِـلُّ إِلَّا مَـن أَوَدُّ بِقَلْبِـهِ ::: وأَرَى بِطَرْفٍ لا يَرَى بِسِوائِهِ(4)
فالبيت، حين يُربَط بسياقه، أوضح من أن يحتاج إلى شرحٍ أصلًا. يقول الشاعر: إنَّما خِلُّه من النَّاس ذلك الذي يتفاعل معه، ويشاركه همومه وأحزانه، وكأنَّه يحمل قَلْبه وطَرْفه، فيودُّ ما يَودُّه، ويرى ما يرى. ومن ثَمَّ بنى على هذا بيته التالي، الذي عَدَّه الشُّرَّاح مُشْكِلًا، وما هو بمُشْكِل؛ ليقول: إنَّ أَولى الناس برحمة العاشق، أو رَبِّ الصَّبابة، وبإخائه، ذلك الخِلُّ الذي يُعين على هموم الصَّبابة، ويُشرِك رَبَّها حُزنَه بحُزنه، متعاطفًا معه، مستشعِرًا حاله، لا ذلك الذي يلومه، ويبكِّته، وكأنَّه قد ارتكب جُرمًا، فضلًا عن الآخَر الذي يعمل بالوشاية ضِدَّه. والأسَى إزاء مأساة الإنسان فيه عَونٌ له من الناحية النفسيَّة، والبكاء لبكائه محمود، بعكس جُمود العَين. ألا ترى إلى كلام (عبدالقاهر الجرجاني)(5) في بيت (العبَّاس بن الأحنف):
سأَطلبُ بُعْدَ الدَّارِ عنكُمْ لِتَقْربوا ::: وتَسْكُبُ عينايَ الدُّموعَ لتَجمُدا
لمَّا قال: «لا ترَى أحدًا يذكرُ عينَه بالجمودِ إلاَّ وهُوَ يشكوها ويذمُّها وينسبها إلى البُخْل، ويَعُدُّ امتناعها من البكاءِ تَرْكًا لمعونةِ صاحِبها على ما بهِ من الهمِّ، ألا ترى إلى قوله:
ألا إِنَّ عَينًا لم تَجُدْ يومَ واسِطٍ ::: عليكَ بجاري دمعِها لَـجَمُوْدُ
فأتَى بالجمودِ تأكيدًا لنفي الجُودِ، ومُحالٌ أن يَجْعَلها لا تَجودُ بالبكاءِ وليس هناك التماسُ بكاءٍ... وعلى ذلك قولُ أهل اللُّغةِ: «عَينٌ جَمُودٌ، لا ماءَ فيها، وسَنةٌ جمادٌ، لا مطرَ فيها، وناقةٌ جمادٌ، لا لَبَن فيها«، وكما لا تُجْعَلُ السَّنةُ والناقةُ جمادًا إلَّا على مَعْنى أنَّ السَّنةَ بخيلةٌ بالقَطْر، والناقةَ لا تَسْخُو بالدَّرِّ، كذلك حُكْمُ العَينِ لا تُجْعَل »جَمُودًا« إِلَّا وهناكَ ما يَقْتضي إرادةَ البُكاءِ منها، وما يَجْعَلُها إِذا بكَتْ مُحْسِنةً موصوفَةً بأنْ قَدْ جادَتْ وسَخَتْ، وإِذا لم تَبْكِ، مسِيئةً موصوفةً بأنْ قد ضَنَّتْ وبَخِلَتْ... وجملةُ الأمرِ أَنَّا لا نعلمُ أحدًا جعلَ جُمود العَين دليلَ سرورٍ وأمارةَ غِبْطةٍ، وكنايةً عن أنَّ الحالَ حالُ فرحٍ.»
ـ وإذا كان هذا شأن العَين حين تخذل صاحبها عن البكاء في ظَرفٍ يستدعيه، فكذلك شأن خليله حين لا يتفاعل معه بالأسَى والبكاء.
ـ نعم، وإنْ كان المتنبِّي لا يقصد- كما توقَّفتْ عنده عقول الشُّرَّاح؛ فقالوا: إنَّ الأسَى إنَّما يزيد الأسَى ولا يُعين عليه- أنْ يقف خِلُّه ليبكي لبكائه فحسب، بل يقصد أيضًا أن يتمثَّل أساهُ موقفًا نبيلًا، يَظهر، في الأقل، في الكفِّ عن اللَّوم، مع الإشفاق عليه ممَّا هو فيه.
وهكذا ستجد هؤلاء الشُّرَّاح يُشرِّقون ويُغرِّبون، متوقِّفين مع كُلِّ كلمة، مبتوتة عن سياقها من النص، مأخوذة بدلالتها المعجميَّة العقيم، لا بدلالتها الشِّعريَّة.(6)
[وللحديث بقية].
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
.........................
(1) ابن معقل، (2003)، المآخِذ على شُرَّاح ديوان أبي الطيِّب المتنبي، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميَّة)، 1: 76- 77.
(2) م.ن، 1: 79.
(3) يُنظَر في هذا: ابن المستوفي، (1989)، النِّظام في شرح شِعر المتنبِّي وأبي تمَّام، دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمان، (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام).
(4) بسِوائه بمعنى: بسِواه، أي بغَيره. لكن من التحكُّم غير المفهوم فَتْحُ اللُّغويِّين السِّين في (سِوَى) عند مدِّ مقصورها، فتجد الكلمة قد كُتِبت: (بسَوائه)، مع أنَّ المعنى يصبح هنا بلا معنى! إلَّا في ديوان (المتنبِّي) بتصحيح (عبدالوهاب عزام)، حيث تجد: «بسِوائه»، بكسر السِّين، وهكذا ينبغي أن تكون! فإنْ قيل: «هكذا نطقت العَرَب»، قلنا: هاتوا التسجيل الصوتيَّ لعَرَبيٍّ سَوِيِّ العقل واللِّسان، يقول: «بِسِوَى»، فإذا مَدَّ الكلمة قال: «بِسَوَاء»! لا يُقبل هنا التسجيل عن اللُّثْغ أو المعاتيه!
(5) (1984)، دلائل الإعجاز، قرأه وعلَّق عليه: أبو فهر محمود محمَّد شاكر، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، 269- 271.
(6) يُنظَر: ابن المستوفي، 1: 346- 352.