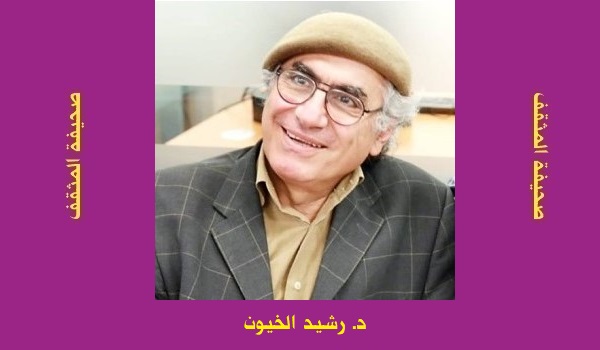قضايا
عصمت نصّار: الكذب في الثقافة الإسلاميّة وغرابيل الفلسفة النقديّة (4)

يبدو أن معظم شيوخ المعتزلة قد أدركوا مُسبقًا ما لم نلاحظه إلا مؤخرًا ألا وهو أن الكذب يمكنه ارتداء لباس الصدق ويتوقف ذلك على اتقان الراوي والحاكي، وفي مقدور الصدق أيضًا أن يرتدي رداء الكذب، إذا لم يخالف مقصده الحقيقي غير أن هذا الرداء الكاذب لم يصب حقيقة الخبر إلا في ظاهره ولم يبدل باطنه أو جوهره أو أصله الصادق.
وتسعفني الذاكرة في استدعاء أطرف وأصدق وأكذب بيت شعري في آن واحد الذي رواه المتنبي (ت 965 م) وبات من بعده مثلًا يذكر في عدة مناسبات منها: المُفارقة في المقصد والمغايرة في المظهر والابداع في الحرفية والحبكة فيقول المتنبي (بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبًا وحليبًا، فناديت عليه فلم يجب، ولقد كان ذئبًا في ثياب رجال)
ولما سُأل المتنبي عن ذلك البيت الذي ينضح كذبًا فأجاب أنه يعبر عن صورة صادقة رآها بعينه قائلًا (نعم إنّ الذئب لا يعرف كيفية الحلب والنملة أصلاً ليست بالحلوب، والصورة خيال لا يمكن تصوره مطلقًا.
أمّا الصدق فيها أني كنت مرة في أحد أسواق الكوفة فوقفت بجوار امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاءها رجل ثري في تكبره، وغني في هيئته، وسألها عن ثمن ما تبيع؟
فقالت المرأة: بخمسة دراهم السمكة الواحدة يا سيدي.
فقال الغني: بل بدرهم واحد.
فقالت يا سيدي: إن السمك ليس لي، وأنا لا أستطيع أن أبيع الواحدة إلا بخمسة، فرد عليها الغني أعطني عشر سمكات، ففرحت المرأة وأعطته ما أراد ولما مسك السمك بيده قام بحمله ثم ألقى لها بعشرة دراهم وانصرف، فصرخت المرأة تناديه فلم يجبها فروحت أناديه أيضًا فلم يسأل عني؛ فكتبت هذا البيت لأعبر عن تلك المظلمة؛ وذلك الجور الذي عايشت أحداثه ورويته بخيال الشعراء، فإذا كان الكذب في الكلمات والصور البلاغيّة؛ فالحقيقة كامنة في الواقعات الخفيّة، فالذئب هو الرجل الثري، والنملة هي المرأة التي كانت تبيع السمك ولا تملكه.
وواقع الأمر الذي أريد توضيحه والحديث عنه هو طبيعة العقل ومرتبته من اليقين عند معظم شيوخ المعتزلة؛ وقد تبين ذلك في أصولهم ومثقفاتهم ومناظراتهم وفي ردودهم على ما يعتقده مخالفيهم؛ فالعقل عندهم ليس حرًا بالقدر الذي يجحد أو يجنح عن المقصد الإلهي الذي يعتبرونه العقل المطلق بل هو آلية من نفس جنس خالقه، والدليل على ذلك أن حديث العقل الربّاني يوجه في المقام الأول للعقل الإنساني؛ ومن ثم يصبح العقل الإنساني هو الطريق الأقوم لفهم الوحي (كلام الله) والاجتهاد وإعمال العقل في النّص يمثل عندهم عين اليقين، وإذا ما تأكدوا من مطابقة ما فهموه بعقولهم مع المقصد الإلهي اطمئنوا آنذاك على أنهم، توصلوا مع (حق اليقين).
ويعني ذلك أن شيوخ المعتزلة لم يقنعوا إلا بحق اليقين، وذلك عن طريق غرابيلهم النقدية. أمّا دون ذلك فعندهم في مرتبة أقل (علم اليقين، عين اليقين)؛ فعلم اليقين عندهم يمثل الخبر الذي يوضع في الغرابيل لتفصل فيه بين الصدق والكذب. أما المُجرب والصالح والنافع في التطبيق أي في عين اليقين؛ فيصعد إلى مرتبة حق اليقين.
وإذا ما انتقلنا من النظر إلى التطبيق عند المعتزلة في قضية الكذب وجدناه على هذا النحو، فيبدأ الفكر المعتزلي بتحليل الخبر المروي أو الكلام المرسل معتمدًا في ذلك على الفهم المباشر لمعاني الألفاظ ودلالاتها ثم مقابلة التركيب اللفظي الذي يشكل عبارات الخطاب بمنطقية حدوثه في الواقع ثم يضعه في الغرابيل النقديّة للكشف عن دقة دلالاته والإحالات التي يقصدها إذا كان الخطاب رمزيًا أو إشاريًا ثم يعيد طرح ما توصّل إليه من دلالة (ليتبين إن كانت قطعية الثبوت والدلالة من عدمه؛ فإن كانت واضحة بذاتها فيؤكد صدقها وإن كانت إحالية في دلالاتها نجد شيوخ المعتزلة يستعينون بغرابيل التأويل التي تتفق مع النسق العام لموضوع الخطاب؛ الأمر الذي يجعل من تأويلاتهم خطوات إرشاديّة للمعنى الحقيقي الذي يتوافق مع المقصد الصحيح الصادق).
واعتقد أن هذا التصور لنهج المعتزلة العقلي يفسر لنا موقفهم من المرويات الواردة في كتب جُمَّاع الحديث التي لا تخلو من الدس والانتحال والاجتراء والكذب والتلبيس، سواء كان ورودها في كتب ما نطلق عليه (كتب الصحاح مثل البخاري ومسلم أو في كتب السنن) فهم لا يفرّقون بين صحة الأحاديث المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 870 م) في صحيحه وبين مرويات الربيع بن حبيب الأزدي (ت، ن 698 م) التي جمعها في مسنده فمعيار الصدق أو الكذب عندهم كما بينا هو موضوعية الخبر المروي في سياقه، وعدم تناقضه مع النسق القرآني في عمومه أي قياس المتغير على الثابت أو مقارنه علم اليقين بحق اليقين.
فعلى سبيل المثال نجد شيوخ المعتزلة يرفضون منطقية (حديث الفرقة الناجية، وارضاع الكبير) بغض النظر عن حجية تواترهما أو قبول بعض الفقهاء لهما، وبرهانهم على ذلك أن الحديث الأول يجعل الفرقة الناجية (المؤمنين) هم القلة ويعمل على تفريق الأمة وانتحال كلًا منها الشيفونية. أما باقي الفرق من أمة محمد فمصيرها إلى النار؛ الأمر الذي يناقض النسق العام لوعد الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر ....
أمّا الحديث الثاني فهو يناقض أيضًا النسق الأخلاقي وآداب المرأة مع الاغراب واستحالة حدوث الواقعة على النحو الذي ورد في الرواية من الناحية العلميّة.
ومن أقوال شيوخ المعتزلة التي تؤكد رفضهم لما يخالف صريح المعقول في كتب جماع الحديث قول عمرو بن عبيد (لو سمعت الأعمش - محمد بن سليمان الأعمش، وهو من كبار التابعين ورواة الحديث النبوي - يروي حديثًا مشكوك فيه لكذبته، ولو سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول ما يخالف صحيح المنقول وحق اليقين لرددته، ولو أدعى أحد الخطباء ونسب قوله إلى آية لقلت ليس على هذا القول أخذ الله ميثاقنا).
ومن ثم، يؤكد الجاحظ أنه لا يجوز للدعاة والمحدثين والخطباء التأول على الله قبل معرفتهم اليقينية بمقصده كما ينبغي عليهم التمعن في مصادر ما يقولون حتى لا يجنح أحدهم عن سبيله إلى حق اليقين فيقع في شرك الهوى فيكذب ويدلس ويزيف ويحرف الدلالات والمعاني ومقاصد العقل الإلهي.
ويرى إبراهيم النظام (ت 845 م) أن الخبر الكاذب يمكن حدوثه بين ما نطلق عليه حديث المتواتر؛ وذلك لأن هذا الحكم لم يبنْ على ثابت عقلي بل بني على كثرة الرواة، وذيوع الخبر وانتشاره، ومن ثم لا يجب الحكم عليه بالصدق إلا بعد عرضه على العقل.
وأقره على ذلك أبو هذيل العلاف (ت 840 م)؛ إذ ذهب إلى أن إجماع أهل الرأي غير المعصومين لا يستبعد كذب أحدهم فيردده الناس من بعده؛ فيصبح بذلك حديثًا متواترًا.
ويرى مخالفو شيوخ المعتزلة أن انتصار معظمهم لصريح المعقول، فاته نسبية أحكام العقل تبعًا للملابسات والظروف والأزمات وخبرة صاحب الغربال النقدي. غير أن مؤيديهم بينوا أن غرابيل النقد عند المعتزلة لم تتعرض إلى حق اليقين المتمثل في القرآن الذي لا يتسلل إلى آياته الشك أو الظن أو التدليس أو التحريف بيد أن خلاف المفسرين أنصب على المتشابه من آياته وفهم مقاصدها بمعزل عن النسق القرآني الشامل واكتفى بعضهم بالمعنى السياقي للآية؛ الأمر الذي دفع شيوخ المعتزلة إلى غربلة تلك التأويلات وليس نص الآيات لتبيان أقربها للعقل والواقع معًا من جهة والمتناغم مع شمولية العلم الإلهي من جهة أخرى؛ كما أن اختلاف الفقهاء حول التفسير والتأويل؛ ليس ببدعة أو خروج عن الملة، بل هو فرض عين للتدبر من قبل أهل الذكر فهو عين الاجتهاد الذي لا ينبغي انقطاعه؛ لأنه البرهان القاطع على أن القرآن لا يحده مكان ولا زمان وصالح للتطبيق على كل البشر حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً.
بل والأكثر من ذلك أن هناك بعض الأقوال الحسنة قد نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبها شيوخ المعتزلة استنادًا إلى أنها تتفق مع بنية النص القرآني مثل (اطلبوا العلم ولو في الصين) وقول إن كل المخالفات والأخطاء مقبولة إلا الكذب فهو يعادل الكفر البواح (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) كما أخذ على شيوخ المعتزلة أيضًا تقديمهم العقل على السمع؛ فجاء في ردهم على ذلك أن العقل النقدي الذي مكّن الانسان من فضح الأكاذيب والروايات المدسوسة والواقعات المُلفقة في الكتب التي قدسها الأغيار باعتبارها وحي إلهي، وهو منها براء. كما أن خطاب الله لأصحاب العقول والألباب يؤكد أن عقل الانسان قادر على الفصل بين الصدق والكذب، وذلك بمعرفته القبلية الفطرية لحقيقة الله رب الأرباب المدبر الحكيم.
أضف إلى ذلك كله؛ أن غرابيل المعتزلة العقلية ونهجهم الجدلي في التثاقف والتناظر والتصاول، كان من أقوى الأسلحة التي تصدت لعشرات الادعاءات والأكاذيب والمكائد التي جعلها الأغيار من أصحاب الملل والبدع معولًا وترياقاً سامًا لهدم الشريعة الإسلامية، وإغواء المسلمين لانتحال الأفكار والمذاهب والشعائر والطقوس التي تتعارض مع عقلانيّة القرآن وأصالة مقاصده؛ فلم يكن من اليسير الرد على ادعاءات الطاعنين في الإسلام بحديث الوعظ أو الاستشهاد بخطابات قاموا هم بتكذيبها، ودسوا في بعضها الإفك وارتابوا في البعض الآخر.
فلم يكن أمام شيوخ المعتزلة سوى مجادلة هؤلاء الكاذبين المكذبين بصريح المعقول ثم تبيان أن ما يسلم به العقل هو الذي ورد في النّص القرآني الذي لا سبيل لهم بتحريفه أو الشك في مصدره؛ وذلك لأنه محفوظ بنسقيته وخلو بنيته من الاضطراب والتناقض، وهو الاعجاز الذي لا يمكن لبشر أن يفكك أوصاله.
وسوف تظل كتابات واصل بن عطاء (ت 748 م) وأبي هذيل العلاف، وإبراهيم النظام، وعمرو بن عبيد والخياط (ت 933 م) والجاحظ والقاضي وغيرها من أقوى الغرابيل النقديّة التي فضحت إفك الطاعنين وزيف المضللين واجتراء الملحدين وصناع الأكاذيب التي تآمرت على الإسلام في مهده منذ النصف الثاني من القرن الأول؛ الأمر الذي يجعلنا نؤكد حاجتنا لتطوير نهج المعتزلة النقدي وتحديث تلك الغرابيل للحد من مكائد شياطين هذا العصر.
وحريٌّ بي أن أشيد بموقف هارون الرشيد، ومن سلك دربه في مؤازرة ودعم وتأييد شيوخ المعتزلة، ومباركة جهودهم في محاربة الأكاذيب وتنوير العقول وحماية الرأي العام، وذلك لتصديهم بالحجة والبرهان لأضاليل أرباب البدع والفاسد من النحل والخبيث من الشائعات والجانح من الفرق.
وخليقٌ بي في هذا السياق أيضًا أن أعبر عن أسفي من موقف صنّاع القرار في بلادنا الذين دمروا نهوج التفكير العقلي؛ واغلقوا منابره في حياتنا الثقافية المعاصرة وقادهم جهلهم إلى إهمال المشتغلين بالفلسفة واستبعادهم عن مواطن صناعة القرار فضلوا وأضلوا.
(وللحديث بقيّة عن عقلانية المعتزلة وغرابيلهم النقديّة).
***
بقلم: د. عصمت نصار