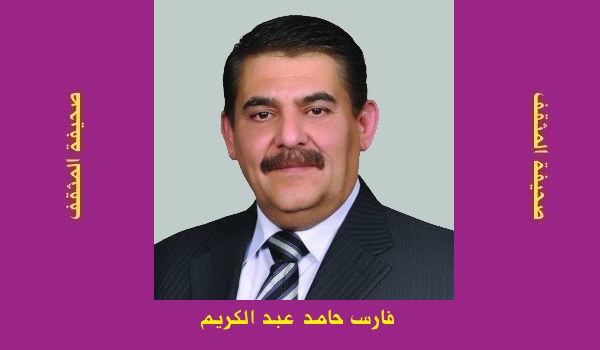قراءات نقدية
ميلود لقاح: التطاول على الموروث الدينـي في ديــوان

(تاريـخ يتمـزق في جسـد امـرأة) لأدونيس
تمهيـــد: عرف الشعر العربي الحديث حركة إبداعية حديثة ومتطورة، شكلت ظاهرة لفتت انتباه الشعراء والدارسين، تمثلت في تجاوزِ التجاربِ الشعرية السابقة إلى تعميق المضمون بالنهل من مختلف الثقافات الإنسانية، مثل الأساطير والرموز والتصوف، والفكر والفلسفة، والموروث الديني الوثني والسماوي؛ مما أضفى على القصيدة مسحة من الغموض والإبهام أحيانا، عُدَّا من نتائج تطور الشعر الحديث عند عدد من الدارسين منهم الدكتور عبد الرحمن محمد القعود الذي يضع ثلاثة عوامل لظاهرة الإبهام في الشعر العربي المعاصر: " العامل الثقافي والمعرفي وعامل الثقافة والمذاهب الأدبية الغربية، ثم هناك العامل الثالث المتمثل فيما أصاب الشعر العربي من تحولات في بنيته ومفهومـــه(1)
ومفهوم القصيدة الحديثة يَتَشَكّلُ من عالم شِعْري يُعبِّر عن رؤية للوجود والواقع والتاريخ والإنسان وقضاياه وكل ما يتعلق به؛ اعتمادا على رؤيا الشاعر؛ لذلك نهلت القصيدة الحديثة من روافد معرفية متعددة لا يمكن حصرها لدى أهم الشعراء العرب مثل أدونيس قطب الحداثة الشعرية العربية، الذي تتضمن أشعاره، بالإضافة إلى القيمة الفنية الحداثية التي عمل على تطويرها وتحديثها، قيمةً معرفية تتعلق بمختلف الثقافات الإنسانية من تراث فكـري فلسفي وتراث ديني سواء كان وثنيا أو سماويا، تجعل منه مفكرا ومثقفا موسوعيا فضلا عن كونه شاعـرا كبيـرا ومتفـردا. يقـول أدونيس: "لم تعد القصيدة الحديثة تُقَدِّمُ للقارئ أفكاراً ومعانيَ شأن القصيدة القديمة وإنما أصبحت تقدم حالة أو فضاء من الأخيلة والصور ومن الانفعالات وتداعياتها، ولم يعد الشاعر ينطلق من موقف عقلي أو فكري واضح وجاهز إنَّما أخذ ينطلق من مناخ انفعالي نسميه تجربة أو رؤيا"(2)
هكذا، إذاً، كتب شعراء الحداثة قصائدهم محمَّلةً بمضامينَ عميقةٍ تحتاجُ من القارئ أن يكون في مستوى ثقافتهم لفهم قصائدهم وتأويلِ معانيها غيرِ المباشرة التي لا يجوز الوقوفُ عند ظاهرها، بل تجاوزها إلى معانيها الخفيَّة عنْ طريق التأويلِ وفهمِ اللّغة الإيحائية في القصيدة.
وهذا الشعر الجديد حسب أدونيس "يعبر عن قلق الإنسان، أبديا. الشاعر الجديد، والحالة هذه، متفرد، متميز في الخلق وفي مجال انهماكاته الخاصة، كشاعر وشعرُه مركز استقطاب لمشكلات كيانية يعانيها في حضارته وأمته وفي نفسه هو بالذات".(3)
تلك (المشكلات الكيانية التي يَعْنيها الشاعر في حضارته وأمته) هي التي حدت بالشاعر أدونيس إلى النبش في التاريخ الإنساني، والموروث الفكري والديني فأنتج دواوين شهدت على رؤياه الخاصة للإنسان وحضارته، بدءا من (الكتاب)(4) الذي أعلن فيه أدونيس عن موقف جريء من التراث: فقد سعى إلى إزالة صفة القدسية عنه! معتبرا إياه حقلا ثقافيا أنتجه بشر يصيبون ويخطئون، ويمكن أن نحكم لهم أو عليهم، لذا أصبح أدونيس يمارس فكرا نقديا للتراث بلغة الشعر.
والمدونة الشعرية الأدونيسية منطوية على مخزون ثقافي هائل يضع أمام القارئ تراث الإنسانيةَ، بأساطيره ودياناته المختلفة وخرافاته وتاريخه وأحلامه ورموزه، فأدونيس يستدعي كل ذلك ويوظفه توظيفا فنيا يجعل من تجربته الشعرية علامة فارقة في المشهد الشعري العربـي.
ويعد ديوان (تاريخ يتمزق في جسد امرأة)(5) من الدواوين الجريئة في طرح التساؤلات و"تجاوز الخطوط الحُمْر" في تناول الموروث الديني، فقد تجاوز أدونيس ما يُعَدُّ قداسة في الدين. قد نتريث ونقول إن الشعر لغة استعارية بالدرجة الأولى، فيصعب أخذ هذا الديوان على ظاهره، لكن عندما نكتشف أنه يحكي: قصة أم نبي وزوجِ نبي و"معاناتها وكفاحها"، بشكل يناقض النص المقدس يجب أن نتريث لفهم النص الشعري ومقصديته. وكما قلنا سابقا، فأدونيس شاعر موسوعي ويلزمنا - نحن القراءَ- أن نوسع ثقافاتنا للوصول إلى مقصدياتٍ من هذا النوع من الأشعار التي تثير إشكالات كبرى مثل النظرة إلى الموروث الديني الذي يحفل به ديوان (تاريخ يتمزق في جسد امرأة). سنتريث ونحاول سبر أغوار هذا النص الأدونيسي بامتياز.
تأمـل العنـوان:
(تاريخ يتمزق في جسد امرأة) عنوان كبير جدا بالرغم من كلماته المعدوات؛ فالتاريخ علم كبيـر يُعَرِّفه ابن خلدون بأنه " خبرٌ عن الاجتماع الإنسانيِّ الذي هو عُمْران العالم، وما يَعْرِض لذلك العُمْرانِ من الأحوال؛ مثل التوحُّش والتآنس، والعصبيَّات، وأصناف التقلُّبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من المُلك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعايش، والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث من ذلك العمران من الأحوال"(6)
فهذا التاريخ بضخامته المادية والمعنوية يصيبه التلف والتلاشي عندما يُخْتزل في جَسَد المرأة، ولا يؤول إلى ذلك إلا بسبب "عقلية متخلفة". إن للعنوان بعدا نقديا معترضا على ما أصاب تاريخ الإنسانية وفكرها، فجسد المرأة هو الظاهر الذي يخفي كيانا تجاوزته "العقلية المتسلطة"، إن المرأة في (تاريخ يتمزق في جسد امرة) هي المحك الذي امتحنت فيه قيم الرجولة والعدالة عبر التاريخ، وهي "الضحية" التي "يرجمها العامة مع ابنها"، وكان بإمكان أدونيس أن يقول (تاريخ يتمزق في امرأة) لكن المقصود هو الجسد الذي نُظر إليه نظرة سلبية عبر العصور - في بعض التأويلات الخاطئة للمـوروث الديني- ، وهو الإنتاج المعرفي المستمد من النصوص الدينية، الذي تأوله علماء الدين في مختلف فروع المعرفة، وتم تناقله عبر الأجيال. ذلك الجسد هو العبء الذي جر على المرأة جميع لعنات التاريخ وخطاياه في المجتمعات الذكورية التي تسعى إلى "رجم امرأة مع ابنها". وهي التي كانت تتوق إلى الحرية والحب (أأنا حرة / لأغنيَ حُبــِّـي؟/ص65).
لكن قصدية الشاعر ومحتوى الديوان لا يمكن تَبَيُّنُهُما إلا بعد النبش في باطن قصيدة (تاريخ يتمزق في جسد امرأة) التي يتكئ فيها أدونيس على موروث ديني متنوع بشكل يدعو إلى الرَّويّة في التعامل معها نظرا للجرأة الاستثنائية التي اعتمدها.
- قصيدة بوليفونية:
يستحضر القارئ مباشرة بعد قراءة الأسطر الأولى من هذه القصيدة البوليفونية قصة هاجر زوجِ النبي إبراهيم التي أنجبت له النبيَّ إسماعيل عليه السلام، فهي زوج نبـي وأم نبــي تماما كما في المقطع الأدونيسي:
(هذهِ سيرةُ امرأةٍ عبْدةٍ وابْنِها
نُفِيَتْ لا لِشيْءٍ سوى أنـَّها
كَسَرَتْ قَيْدَها، وَيُحْكى
أنَّها زُوِّجَتْ لِنَـبِيٍّ،
وأنَّ ابْنَها
صارَ مِنْ بَعْدِها نَبِيَّا)(ص7)
إن الصفاتِ التي أسبغها أدونيس على شخصياته تُناقِض ما تضمنه الموروث الديني من عِفَّة وطهارةٍ واستقامَة وتقوى الشخصيات وامتثالٍ لأوامر الله تعالى، فإبراهيم عليه السلام سَلَّم بقضاء الله وترك ابنه وزوجَهُ في "وادٍ غير ذي زرع بمكة" إنها طاعة نبـي قام بما أُمر به من قبل إلهه الذي اصطفاه لتبيلغ الرسالة، وذلك اختبار إلهي، لكن النص الأدونيسي يقدم الأمور على نحو مختلف فالنبي ترك زوجَه وابنه "لا ماءَ لا زرْعَ ..". (ص23) وهذه المرأة في التصوير الأدونيسي شهوانية، تقدس الجسد ونزواته:
" ..ولي شَهـواتٌ،
وأبْحَثُ عَمّا يُمَتِّعُ؟ كَمْ يَصْدُقُ الكافِرونَ. شَهِيٌّ،
جَميلٌ أَنْ نَصُبَّ السَّماواتِ والأَرْضَ في كَأْسِ لَذاتِنا.(39)
وهذه جرأة كبيرة انْتُقد عليها أدونيس غير ما مرة. لقد قدَّم زوجَها النبي متسلطا تَعَمَّد تركها وابنَـها. صحيح أن المبدع يوظف التناص توظيفا خاصا؛ قد يخرج النصُّ الغائب عن مدلوله، لكن أن يتجرأ أدونيس على الشخصيات التي تعتبر شخصياتٍ مقدسةً فهذا توظيف سيء يخدش المشاعر وينبئ القارئَ بما ستأتي به هذه القصيدة المتعددة الأصوات (المرأة – الزوج/الرجل – الراوية) من تطاول على الموروث الديني.
الرجل (النبي/الزوج) متسلط متشبث بالتعاليم التي حصرها أدونيس في القبيلة والأسلاف ومتشبث (بكتاب قديم) ! وصِفَة القِدم عند أدونيس ليست إيجابية طبعا؛ بل ترمز إلى الماضي المتجاوَز وإلى العقلية المتحجرة. والتحرر هو أن "يَقْذِفَ الْحُبُّ جِسْمَ المرأةِ أنَّى يشاء ضد هذي السَّماء) ! (ص21)
يضع الراوي نفسه موضع المدافع عن امرأة: فقد نُفِيتْ لأنها "كَسَرتْ قَيدها"، وكسرُ القيد فعل إيجابي يعادل الحرية والحياة الكريمة، لكنْ أيَّ قيد يقصد أدونيس؟ إنه التعاليم السماوية التي جاءت بها كتب الأنبياء الذين لهم قداستهم في الموروث الديني؛ إنه يزيلها عنهم، فالنبي زوج المرأة العبدة "لم يَجِــئْ في تَعاليمِهِ أنَّها حُرِّرَتْ"(ص7) هذا يشير إلى أن النبي يقيد زوجه العبدة ويمارس قهرا عليها.
هذا هو المدخل الذي يفْتَتِح به أدونيس قصيدته البوليفونية التي تصدم المتلقي بما يراه تناقضا مع ما هو متعارف عليه في الموروث الديني؛ فالأنبياء إنما بعثوا من أجل كرامة الإنسانية وعدالة قضيتها فكيف يكون نبيٌّ طرفا في استهداف امرأة تريد "كسر قيدها".
تتعدد الأصوات ويتمادى الراوي في "تعرية الأنبياء" وفي الدفاع عن امرأة تمردت، لكنها مقيدة بالطفل وهو امتدادها؛ في مقابل حرص النبي زوجِها على " التعاليم الإلهية" حسب ما يُفهم من هذا النص الأدونيسي.
ويفيد الراوي أن كاهنا تحدث عن المرأة بإشفاق (إنها امرأة حية- ميتة)(ص9) مقابل ما "يصدر في حق المرأة من قبل النبي" ! لكنها امرأة النزوات التي تنهج لنفسها حرية التصرف في أنوثتها (قمر للأنوثة للجنس للنزوات وللصبوات)(ص11). هذا القمر الذي "تعبده" متمردةً على تعاليم السماء والأرض (قمر لا لأرض ولا لسماء). (ص11) وتعترض على كونها "عورة" وترتكب زلاتها، وهو اعتراض على ما جاء في غير موضع في الموروث الديني عن أن المرأة عورة. فقد جاء في سنن الترمذي، (حديث1093 ) أن "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان". وبالرغم من أن الحديث موجود في أكثر من موضع فهو غريب وضعيف عند فقهاء الحديث، لكن أثره كبير جدا في تشكيل الوعي الديني فيما يخص النظر إلى المرأة، وهو الوعي الذي استهوى أدونيس للدخول من خلاله إلى نقد الموروث الديني من باب الموقف السلبي من المرأة.
والمرأة في نظر المجتمع أداة لإشباع النزوات وما تبقى فهي شر(نصفها رحم وجماع والبقية شرٌّ)(ص13). وفي ذلك إشارة إلى ما تُدووِلَ في الموروث الديني، وتُؤُوِّلَ تأويلا خاطئا يسعى من خلاله أدونيس إلى بناء مواقفه التي تبدو في ظاهرها دفاعا عن المرأة وهي في واقع الأمر بيانٌ لـــتحقير الموروث الديني، ومناصرتها في اعتناق التصورات الوثنية التي تتفق على عبادة الطبيعة واتخاذ عناصرها آلهاتٍ مُبَجّلةً. ورد في نهج البلاغة أن الإمام عليا قال: (المَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْهَا). وفضلا عن أن هذا الحديث انفرد بروايته الشريفُ الرَّضِي في نهج البلاغة، وعلى فرض التسليم بصحته، يمكن حمل الشَّرِّ فِي الحَدِيثِ عَلَى الجَانِبِ الابْتِلَائِيِّ الَّذِي يَعِيشُهُ الرَّجُلُ مَعَ المَرْأَةِ لَا عَلَى الطَّبِيعَةِ وَالفِطْرَةِ، لِأَنَّ فِطْرَةَ المَرْأَةِ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ فِطْرَةِ الرَّجُلِ، فَالعَقْلُ وَالبُعْدُ الإِنْسَانِيُّ وَاحِدٌ فِي كِلَيْهِمَا، إِلَّا أَنَّ اسْتِعْدَادَاتِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَافْتِتَانَهُ بِالآخَرِ جَعَلَ المَوْضُوعَ يَكُونُ فِي مَحَلِّ الاخْتِبَارِ وَالابْتِلَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ. فَلِمَ ينزع أدونيس وهو المثقف والمفكر الكبير إلى التأويل الذي ينال من المرأة أولا ومن الموروث الديني ثانيا؟ !
إن تقديسَ الجسد ورفضَ تعاليم السماء، والاستعانةَ بالميتولوجيا الإغريقية الوثنية من أجل الصراع مع كل ما هو سماوي؛ من أهم الأسس التي بنيت عليها هذه القصيدة البوليفونية. فلابد "من إقفال السماء وعدم تواصل الجسد الذئب الكريم معها" و(أرتميس)، آلهة الصيد والبرية، حامية الأطفال، وآلهة الإنجاب، والعذرية، والخصوبة،(7) في الميتولوجيا الإغريقية؛ هي الـمَــثَلُ والقُدوة والمرجعُ لا تعاليمُ السماء.
ولا تتوقف الجرأة على الدين عند هذا الحد، فأدونيس ينتقل من مستوى إلى مستوى أكثر جرأة على لسان المرأة المتمرِّدة على السماء؛ فهي الحرة في جسدها/ معبودِها ...و"الملائكُ ليسوا ملوكا عليها"(ص17) ولا تجب طاعتهم والامتثالُ لما كُلفـوا بـه؛ بل الطبيعة الوثنية هي السبيل إلى التمرد والخلاص ولا بد من الاعتصام بها. وترفض هذه المرأة أن (تُطْفَأَ الطبيعةُ فيها)(ص18). إنها متمردة تواجِهُ السَّماء بما تحمله من رمزية لأن التعاليم نابعة منها لكنها حزينة، لأن العالم كلَّه يستهدفُها إذْ تريد حرية يرسم أدونيس معالمها الوثنية الشهوانية. وهو ما يرفضه الرجل "المتسلط الماضوي" المتشبث بالسماء وتعاليمها والقبائل وأمجادها وأعرافها.(ص19)
إن أدونيس كاتب موسوعي حقا، لكن موسوعيته في هذا الديوان توظف ضد الدين بشتى أنواع الإشارات والرموز من ذلك استخفاف المرأة "المتمردة" بمسألة فقهية هي (ميراث الحمْل): "كُلُّ ميراثها حَمَل ضائع(7))* ذلك أن الرجل إذا مات، وكان في بطن الأم جنينٌ، فتوريثه ثابت، في الشريعة الإسلامية، وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف. وقد فُصِّلت هذه المسألة في كتب الفقه. (8) كما تستخف بالوحي والتعاليم بنبرة تشكيكية وبلغة جرِّيئة: "هجَّرَتْنا تعاليمُه. أذلك وحي؟"(ص25)
ماذا يريد أدونيس من كل هذا البيان الفكري والموقف من التراث الديني؟ إنه يقدم صورة لامرأة يراها تتوق إلى الحرية وقرنها بأزواج "الأنبياء الذين اسْتَعْبَدوا بتعاليمهم السماوية القبلية المتحجرة المرأةَ" !!. لذا تمردت على الموروث والمجتمع ومارست حرية الجسد في مواجهة المجتمع الشرقي المقيد بأحكام الغيب وتعاليمِ كتبِ أنبيائه؛ فكانت مـدار الصراع ومحور النص وما يصدر عن الآخرين (الرجل والرواية والجوقة) ما هو إلا صدى لفكرها ومواقفها. أدونيس يريد أن "يُعـــرِّيَ" تاريخ البشرية في الشرق أمام العالم بشكل لم يجرؤ شاعر عربي حديث اعتماده؛ فهو، بالنسبة إليه، تاريخ أعمى تقوده رسالات الغيب التي جاء بها الأنبياء الذين "اعْتَدَوا" على الطبيعة الحسية للإنسان لكبت شهوته ونزواته. وفي مقابل كل ذلك ينحاز أدونيس للخرافات الميثولوجية ويعظم وثنيتها، وعلاقتها بالطبيعة وتقديس الجسد على حساب "الكتاب السماوي القديم" فتمني المرأة أن تكون (أرتميس) الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية؛ انحيازٌ لوثنيتها. والنبي - حسب أدونيس - "حائــر" لا يعرف كيف يتحايل على تعاليم كتابه السلفي المتوارَث والمفروض من "السماء/ الله" !!!!.
المرأة بين (الجوقة والراوية والرجل) "مناضلة متمردة" ضد ما جاءت به السماء في كتبها وتجاهر برفضها "لا كتاب، خطواتي كتابي"(ص47) كما تجاهر بوثنيتها مخاطبة زوجها:
"اخلعْ ثيابَ السماء، وجئني
في ثياب الطبيعة
لا نشوةٌ، لا كتاب
غير هذا التراب".(ص67)
سيؤول الأمر في آخر هذه المشاهد التي تنضح عصيانا لتعاليم السماء، وتشكيكا بكل ما يرتبط بها إلى رجم المرأة من قبل الحشد مع ابنها الذي اعْتُبِـــرَ جزءا من خطيئتها؛ فلا تسامح ولا رأفة بالمرأة من قِبَل من يرفضون حريتها ووثنيتها. وفكرهم في النص الأدونيسي ذو طبيعة غيبية (موثوقة بحبال النبوات) مناقضة لجوهر الطبيعة القائم على الحس وحرية الجسد دون رقيب سماوي !.
هذه هي النهاية المأساوية التي يختارها أدونيس لكشف (همجية يرى أنها مورست على امرأة تريد حريتها بتجاوز كل التعاليم السماوية وتقديس الطبيعة والجسد) وتعريةِ مجتمعٍ (خاضع لقوى الغيب وجاهل أو متجاهل معنى حياة الطبيعة الحسية).
نقول – مرة أخرى - ماذا يريد أدونيس من (تسفيه) كل ما له علاقة بالدين السماوي الذي يُعَدُّ الغيبُ أحدَ مرتكزاته. قال تعالى (ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ/البقرة آية 3:). إن ما سلكه أدونيس لم يطرقه حتى شعراء المجون والشعوبية في العصرين الأموي والعباسي. إنما الشعر لغة الجمال تهفو إليه النفس لما تشكل من صور يبدعها الخيال الثــَّرُّ الذي ينفر عادة من القبح ومن الصدام مع الخصوصيات الدينية كيفما كانت. فالتصدي لتلك الخصوصيات من شأنه إثارة النعرات الطائفية والدينية التي تؤول بالمجتمعات إلى الخراب.
لا تنتهي الأسئلة التي تبحث عن دوافع هذه اللغة الجريئة والمتطاولة على الدين. لعل الراحل جبرا إبراهيم جبرا كان محقا إذ قال مُعَلقا على انحرافات أدونيس الفكرية (لا تعجبوا إن فاز أدونيس بجائزة نوبل !!!) طبعا لم يفز بالجائزة وبقت أراؤه وأفكاره الجريئة تثير أكثر من تساؤل.
***
ميلود لقاح
......................
الهوامش:
1- الإبهام في شعر الحداثة: العوامل والمظاهر وآليات التأويل، عبد الرحمن محمد القعود، عالم المعرفة، الكويت 2002- ص279.
2- زمن الشعر: أدونيس –دار العودة بيروت - 1978 (ص 278)
3- زمن الشعر – ص: 9
4- دار السـاقــي- بيــروت 1995
5- دار الساقي 2008- ط: 2
6- المقدمة. ص33
7- قاموس المورد، البعلبكي، بيروت، لبنان.
* الشاعر فتح الميم في كلمة(حمل) للحفاظ على السياق العروضي للمتدارك.
8- [الملخص الفقهي:2/290-293] لصالح بن عبد الله آل فوزان.