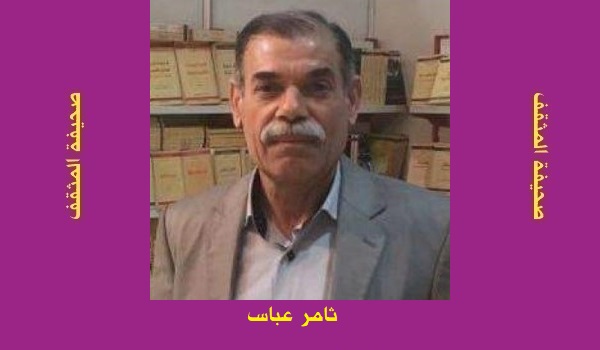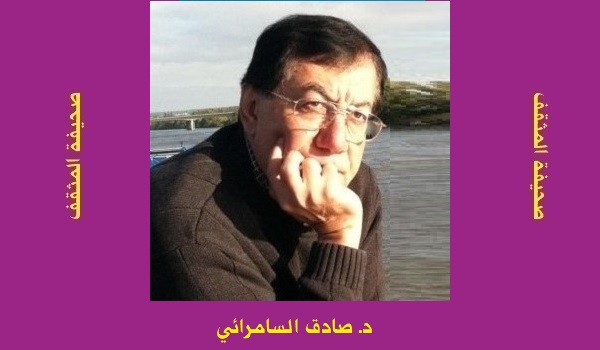قراءات نقدية
جبَّار ماجد البهادليّ: شِعرِيَّةُ الفَضاءِ المَكانِي

دِراسةٌ نَقديَّةٌ لِمدوَّنةِ زَيدِ الشَّهيدِ الشِّعريَّةِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي)
توطئةٌ: من مفاتيح هذه الدراسة النقدية المتقاطعة، أُفقياً(الأرضية)، وعموديَّاً(السطحيَّة) لهذه المدونة الشعرية مفتاحان هما:(الشعريَّةُ والمكانيَّةُ)، ولا وسيط ثالث بين حديهما إلَّا(الشاعريَّةُ). فأمَّا الشعريَّةُ فهي خبرة الشاعر الفذَّة التراكمية ومعرفته الابستمولوجية، وثقافته الذاتية التجدَّديَّة بقواعد وأصول دراسة الفنِّ الشِعري، والتي هي أداة الشاعر الوجودية وهُويةُ مروره المُعجميَّة في فنِّ الشعريَّة. وأمَّا المفتاح الثَّاني، فهو المكانيَّة التي تُظهرها قدرة الشاعرة الاستعداديَّة وموهبته الفُطريَّة (المَلَكَةُ) في توظيف أقانيم جغرافيا الفضاء المكاني وتوزيعها فنيَّاًعلى جسد القصيدة الشعريَّة توزيعاً مؤثِّراً.
لم يعدْ مفهوم الفضاء المكاني الشعري في أوجز تعريف له، ذلك الحيز الحسِّي المرئي أو التكوين الجغرافي المثابي، أو هو مِساحةٌ من الفضاء الأرضي الواسع الذي يحيا عليه الإنسان ويعتاش ويُعَمِّرُ ويفنى ويموتُ ويرتحلُ منه راغباً كان أمْ راهباً مضطراً، بل هو المكان الشعري الذي تنبثق منه مناطق الشعر وتتفجَّر منه عيوناً من الإبداع وتُشكِّل ما يُسمَّى فنيَّاً بـ(الفضاء الشعري) الحقيقي الذي يُسهم إسهاماً تخليقياً وإبداعيَّاً وبنيويَّاً في تجسيد لُغة الشاعر المُثلى، وتشكيل إيقاعه الأُسلوبي الفنِّي التعبيري. ويُسهم أيضاً حتَّى في إبراز صلة الشاعر الوثيقة بانتمائه البيئي المحيطي الخارجي الأرضي، أكان ذلك(المَدِيني أو الريفي أو الصحراوي) الذي يُحدِّد طابع وهُوية معجمه الشعري الخاص بشعريته.
فكلُّ هذه الأمكنة المثابية المتعدِّدة تؤدِّي دوراً مُهمَّاً وفعَّالاً في تشكيل ثقافة الشاعر وتعميق هاجس لغته الشعرية، وتجديد سماتها الكونية بالطبيعة (المتحركة أو الثابتة). فالمكان أيَّاً كان نوعه الوصفي هو صوت الشاعر المهمازي النابض بالحركة، وهو جزء عاكس لراهن هُويته وملامحه الثقافية والحضارية التي بها يُميَّز وتميَّزُ شاعريته عن مُجايليه من الشعراء أمثاله الآخرين.
ومن خلال هذه المثابات المكانية الشَّاخصة يتشكَّل الشعر الذي هو بطبيعة الحال جنسٌ غنائي أو بتعبير أدق هو شكل من أشكال الغناء الأرضي أو الشدو الغنائي الذاتي الرومانسي؛ كونه يمثِّل صوتاً صورياً مُتحرِّكاً، وإيقاعاً(تُونيَّاً)شعرياً عذباً مموسقاً بوحدات نغمية مقطعية تراتبية الضربات.
وبما أنَّ الشاعر يخرج بلغته الشعرية المتمايزة من رَحِمِ هذه المكانية الضاربة أطناباً وتجذُّراً في العمق التاريخي؛ فإنَّ هاجس الشعرية الجمعية أوسع وأجلَّ عمقاً من هاجس اللُّغة البيانية. وذلك كون اللُّغة وسيلة أو واسطة بيانية توظيفية لتلك المثابات الأرضية المكانية الواقعية المتباينة، في حين أنَّ الشعر مِخيال شعوري وانزياح لُغوي وانحراف أسلوبي أسلوبي بلاغي فنِّي شفيف يهبط على الشاعر نسمة كما يهبط الندى من الزرع أو الأشجار على أديم الأرض المخضرة فَتُحيِيها.
فالمكان، هو صومعة الشاعر الأيقونية ومثابة محرابه القدسي الذي ينطلق منه مُحلِّقاً برؤاه في بثِّ رسالته الشعرية الكونية عبر أثير مجسَّاته اللغوية الموقعة صورةً صورةً ودفقةً دفقةً. وبهذه المخايل الشعرية والصور الشعورية يصنع الشاعر من المكان مكاناً حقيقياً خالداً، أو لا مكاناً بديلاً افتراضياً مُتخيَّلاً في ذهن الشاعر وَمُتَصَوِّراً في عقله الفكري الذي فرضته عليه ضرورات الحياة.
فلا عجب أنْ يكون المكان وطنَ الشاعر المتأصِّل به ومنبت عشقه الأرضي الآسر، ومسقط رأسه الآسر، ولا عَجبَ أنْ يكون المكان بيت الشاعر الأوَّل ومكمن حبِّ عشقه الأزلي الذي شتتَ شمله في هواه مُبدَّداً. فمنه تنبعث رائحة الشعر وشآبيبه الماطر، الهاطلة غيومه زخَّاً وتسكاباً على أرض القارئ المُمْحِلة الظمأى ، فتخضرُّ عُشباً وإمتاعاً ومؤانسةً وابتداعاً لا مثيل له في قواعد الشعرية.
فهذا بدر شاكر السيَّاب الذي خلَّد بشعره آثارَ المكانيةِ لُغةً وصَوتاً وإيقاعاً ورَمزاً ومنزلةً. السيَّاب الذي صيَّرَ(بُويبَ)تلك الساقية أو(الشَّاخة)، أو المجرى الصغير إلى نهرٍ عظيم وخالدٍ. وجعل من (شبّاَكَ وفيقة)، تلك (الرازونَةُ) الكوة، أو المشكاة الصغيرة أيقونةً سيمائيةً شعريَّةً وتُحفةً جماليَّةً صارت أشبه بِقِبلةٍ للعُشَّاق والمُحبِّين، وليس هذا فقط، بل جعل من شناشيل ابنة الجلبي مثابات تراتيل شعرية يتغنَّى بها في الموروثات الشعبية كأناشيدَ وتَبتُّلاتٍ غنائيةٍ للأطفال موقَّعة مُوزونةٍ.
السيَّاب الذي خلَّد(جَيكُور) القرية الصغيرة الغافية على أرض الجنوب الشرقيِّ، وجعل منها مدينةً رمزيةً يعشقها القرَّاء ويتلهَّفُ بسماعها المُتلقُّون، ويُمَنُّون أنفسَهم ويُمتِّعونَ أعينهم برؤيتها وزيارة أثرها المكاني الذي مجَّده السيَّاب. في الوقت الذي تُوفِي فيه السيَّاب بعيداً عنها في منفاه الكويت(غريب على الخليج)، حيثُ جعل من المكان الأول اللَّامكان البديل الذي حَملَ رُفاته وموته.
وهذا هو مُحمَّد الجواهري الكبير الذي خَّلدَ(دجلةَ الخيرِ) في أسفاره الشعرية لحناً صوتياً وكتابةً، وأحالها إلى علامةٍ سيمائيةٍ متفرِّدة تتغنَّى بمجدها الأجيال في الوقت الذي توفي الجواهري بسورية في غُربته المهجرية بعيداً عن أرض وطنه العراق ومدينته الأولى النجف الأشرف. ونظيره الشَّاعر عبد الرزاق عبد الواحد الذي مات حسيراً كسيراً ظميَّاً على بلده العراق في مأواه الفرنسي البعيد.
ومثله أيضاً رفيقا الجواهري الشاعر البيَّاتي، والشيخ الدكتور مصطفى جمال الدين الذي خَلَّد مدينة بغداد وتخلَّدت به بقصيدة تتلوها الأجيال نشيداً للحبِّ وسِفراً وطنياً للجمال في الوقت الذي وافته المنيَّة بعيداً عنها ودُفِنَ مع الجواهري في مقبرة الغرباء في الشَّام. وهذا هو نِزار القباني شاعر الحبِّ والغزل الحسِّي والنساء والسياسة الرفض والاحتجاج الذي أكثر من ترديد عواصم العرب الكبرى دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء اليمن، وتُوفيَ في وطن اللَّامكان الأصلي. فمات مُتغرِّبَاً في منفاه الأخير بلندن عاصمة الضباب بعيداً عن مسقط رأسه الحقيقي الأول في سوريا.
ولا نعدم من هذه المكانية واللَّامكانية البديلة أثر محمود درويش وأمل دُنقل وغيرهم من شعراء المقاومة العرب وفلسطين الثائرين، وشعراء الحداثة الشعرية الماجدين خلوداً بمكانتهم لهذه الأمكنة.
والحقية أنَّ مثل هذه النماذج الشعرية المكانية تشي بأنَّ الشاعر قد لا يكون له مكان ثابت إلَّا في غربته ومنفاه وهجرانه، مع أنَّ مكانه الأول الأصلي في بلده منبت أرضه ومسقط رأسه ومربع صباه وطنه ومنزله الأول الذي أَلِفَهُ وعاش فيه بمدينته ومنه هاجر وتشتت وتغرَّب وضاع تِيهَاً.
ولا مكان يُذكَرُ لشعراء الصعلكة المحدثَين من العراقيين أمثال، (حسين مضردان، وعبد الأمير الحصيري. ، وجان دمو، وسركون بولص) غيرَ وطنِ الشَّتات والمنافي اللَّامكانية البعيدة والتشرُّد والتِيه والضياع، والحدائق العامَّة التي يُسميها حسين مردان بـ(الفنادق الهوائية)، كونها مثابةً للحريَّة.
والحقُّ أنَّ مثل هذه النماذج المكانية المتعدِّدة تُحيلنا إلى القول بأنَّ خصوصية المكان عند بعض الشعراء، ومنهم شاعرنا صاحب هذه المجموعة الشعرية ذو القصائد النثرية ممن تميَّزت أُسلوبيتهم الشعرية الذاتية بالحسيَّة العالية لوجودية الفضاء المكاني تُعادل أو تساوي من وجهة نظرهم رمزيَّةَ (اللَّامكان)الحقيقية أو الخيالية. ذلك لأنَّ الشعر يُعدُّ مثابة الشاعر الأيقونية الشاخصة ومثواه الأخير.
هندسة معماريةِ المدوَّنةِ الشعريَّةِ
لعلَّ هذا التنويه التصديري المكثَّف في تنظيره الرؤيوي من هذه الدراسة التحليلية لفضاءات الشعر المكانية، والمقترن إجرائيَّاً بفعل الممارسة القرائية المعرفية لمدونة(دولةٌ داخل قلبي) للشاعر والقاصِّ والروائيّ والمُترجم العراقيّ السَّماويّ المُثابر زَيدِ الشهيدِ، والصادرة بطبعتها الأولى عن دار الأمل الجديدة بدمشق-سوريَّة عام 2022م، وبفضاء كمي ونوعي بلغت مساحته الكليَّة(108) صفحة من القطع المتوسِّط.
أقولُ موضِّحاً تُحيلنا هذه التوطئة التقديمية لهذه المصفوفة الشعرية إلى الإجابة عن قواعد فنِّ الشعرية المكانية عند زيد الشهيد شاعراً، وإلى أثر تحولاتها الفنيِّة والجماليَّة، وتداعياتها الروحية والفكرية عبر سلسلة من النصوص الشعرية النثرية التي بلغت نحو (33) نصَّاً أو قصيدةً شعريَّةً.
وَأُعُدَّتْ بفكرة توليفٍ جديدةٍ قسَّمَ فيها الشاعر المجموعة على قسمين متتابعين، القسم الأول من الكتاب الذي وضع له عنواناً لافتاً (حُصنٌ هوَ القَلقُ.. الهُيامُ غَرَقٌ)، والذي احتوى على خمس عشرة قصيدةً من قصائد النثر الشعرية. أمَّا القسم الثاني الذي وضعه تحت عنوان (بالأسئلةِ لُغتِي تُؤسِّسُ مِملكتها)، قد ضمَّ هذا القسم ثماني عشرةَ قصيدةً نثريَّةً أيضاً. وكأني بالشاعر الشهيد يُلمِّحُ لقارئه الذكي ومتلقيه الذوَّاق بأنَّ القسم الأول هو لـ(لشعر.. هذه اللُّغة العاتيةُ)، وأنَّ القسم الثاني هو لشعرية (اللُّغة.. هذا الجبروت الطَّيعُ). وأنَّ الجمع بين المفهومين يعطيك فنَّ الشعرية الإبداعية.
لم يكتفِ الشاعر زيد الشهيد بهذه المُقدِّمة التي خصَّ بها كتابه من عتباته العنوانية، والتي يُصرِّحُ فيها مؤكِّداً أنَّ "الشعر:هُوَ خِفةُ القَلبِ فِي تَرنيمتِهِ، والبُستانُ فِي هُدوئهِ.. تَارةً يَجيءُ طَيفاً غَافيَاً عَلَى سَريرِ نَسمةٍ تَتَهادَى، وَتَارةً يَحضرُ عُصفُوراً نَزِقَاً مَشحُونَاً بَالتهجُّسِ أنْ يَقف َعَلَى غُصنِ الرُّوحِ.. مِنهُ أستقِي نِظامَ البَوحِ، فَأجيدَه؛ وَلَهُ أُقدِّمُ اِعترافاتِي فَأستقبلُ رِضاهُ". (دولةٌ داخلُ قَلبي، ص 9).
وإنَّما في راح الشاعر الشهيد في الوقت ذاته يؤكِّد موقفه الباذخ من مفردات هذه اللُّغة الجامحة فيقول:" اللُّغةُ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَضلٌ عَليَّ سِوَى أنَّهَا الوَسيلةُ الَّتي أعانتنِي عَلَى رَسمِ خَبَبِ الحُصانِ الجَامحِ فِي صَدرِي وَهيجَاناً بِمَا يَكفِي لِاعتلاءِ مُوجةِ الهُيامِ؛ وَسِوَى كَتابةِ النُّفورِ الَّذي اِتسمتْ بِهِ غَزالةُ الرُّوحِ، وَجعلتنِي أَهيمُ بِالجماَلِ فَأتأبَّطُ قَصائدِي وَخُطايَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءُ. (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 9).
عَتَبَاتُ المُدوَّنةِ الشِّعريَّةِ
من اللَّافت للنظر جِدَّاً في لافتة مدوَّنة زيد الشهيد(دولةُ داخلُ قلبِي) العناية الشديدة والدِّقَّة باختيار عتبتها العنوانية المكانية المثيرة في دهشتها للقارئ وفي كسر توقع جدار أفق المألوف العنواني الرتائبي الذي اعتاد عليه نظر القارئ شعراً ونثراً. فالعنوان هو(ثُريا النصِّ)الفناريَّة اللّافتة، وهالته الضوئية الشعرية المُشعة الموازية للخطاب النصِّي المُرسل، إيذاناً بخطى الدخول إلى مدينة الشعر الإبداعية القائمة. ومن ثمَّ التعرُّف على عقابيل رهاناته الواقعية الحادثة من خلال ما يُعرَفُ بفلسفة اليوتوبيا لأمكنته المخيالية المثالية والطوباويَّة القصيَّة في أدب الخَيْرِ بمدينته الشعرية الفاضلة.
والشروع بالكشف أيضاً عن تقفي آثار حفريَّات تناقضاته المكانية الساخنة في ديستوبيا الشَّرِّ المضاد والرفض والفوضى والظلم والاستبداد وممارسة قمع الحريَّات الثائرة في هذا العالم المَديني المُجرَّد من وقع إنسانيته إلى مسوخٍ معطوبةٍ مُتناحرةٍ لا ترى إلَّا في ممارسة فعل الشرِّ مَلاذاً آمناً.
وربَّما الأكثر إدهاشاً في لافتة العتبة العنوانية الرئيسة(دَولةٌ داخلُ قَلبِي)، تلك العلامة الأيقونية السيمائية الذاتية السادرة التي تشي موحياتها المضمرة والخفيَّة بالرمزية المكانية لمثابات هذه الدولة العميقة الرابضة في شغاف القلب وجنباته الخافقية الجناحية المُحلِّقة بريش القوادم وما تحت الخوافي الظاهرة منها والخفيَّة. إنها بكلِّ تأكيد تُمثِّل دولة الوجود المكاني للشعر ودولة اللَّا مكان غير الوجودي المؤسَّطر الذي يسعى الشاعر بكلِّ جدَّيَّة في كلٍّ من هذا وذاك الوصول إليه في تراتيل مساحاته الشعرية المتعدِّدة وترانيم لوحاته الروحية المتناغمة في مثل هذه الرمزية العالية.
وحينما يكون العنوان توصيفاً فنيَّاً مُحايثاً لواقعة الحدث الشعرية، وانزياحاً أسلوبياً لُغوياً مُنحرفاً، يكون الشعر مِرآةً ارتداديةً عاكسةً لتجلِّيات ذلك الواقع الآني المتغيِّر، ويكون شاخصاً فنارياً مضيئاً لمرافئ الشعر ومحطَّات سفته الشراعيَّة الراسية. فالقلب بحدِّ ذاته هو دولة الشعر ومركز الشعوريَّة المتحركة والثابتة. فكيف به إذا كان دولةً تربضُ في أعماق داخل دولة أخرى؟
إذا كانت لافتة الخطاب الشعري النصِّي الرئيس هي إحدى العتبات النصيَّة المُهمَّة التي أكَّدها الناقد والمفكر جيرار جينيت في معرض كتابه(العتبات النصية) الَّتي تصدَّرت لوحة غلاف الكتاب الخارجي الأولى المُعتمة الضوء في توحُّدها مع صورة الشاعر الخلفيَّة المُضَمَّخة بشدو تناثر الكلمات، وسحر الشاعرية الصورية لهذا الفتى الواثب قفزاً لإدراك تمنيات المعالي النفسية من غير الممكن والمُستحيل، فإنَّ هذه اللَّافتة العلامة الأيقونية صارت مفتاحاً إجرائياً مُوجِّهاً لعتبة التصدير الشعري الأخرى التي استهلها الرائي الشِّعري زيد الشهيد باستدعاء تناصينِ تصديرين مُتعاقبينِ.
فقد كان التناصَّ الأوَّل للشاعر والكاتب والأديب الناقد البرتغالي(أنطونيو فرناندو بيسوا) الذي يقدِّمُ فيه شَذرةً نثريةً لرؤيته الذاتية عن الحُريَّة والفنِّ وهويَّة الإنسان حينما قال مُطالباً بلغةٍ آمريَّةٍ شفيفةِ الأثرِ النفسي والمعنوي : "مُرْ أيُّها الطَّائرُ، مُرْ.. وَعَلمنِي كَيفَ أمرُّ" ؟! (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 7). أمَّا النصُّ التصديري الثَّاني فهو للشاعر والروائيّ والمُحرِّرِ الفرنسي(لويس أراكون) الذي يدعو فيه إلى تأكيد ثقافة لُغة الإنصات والاِستماع لنداء القلب الذي هو موضع الحبِّ والإيمان والشعور والتقوى ومصدر النقاء الباهي إذ يقول داعياً: "اَصمِتُوا كَي أستَمِعَ إِلى قَلبِي". (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص7).
والمعادل الموضوعي في العلاقة الخطيَّة لهذين التصديرينِ، النثري الأول والشعري الثاني الذي أراد الشاعر منهما الالتفات إلى لُغة الحُريَّة بدلالة(الطائر)، وتعلُّم ثقافة الصمت الشعري بدلالة (فنِّ الإصغاء) والاستماع إلى نداء القلب الكبير مُوئِل الدفقة الشعورية الهاربة لحظة انبجاسها. واللذين يشيران إلى ثقافة الشاعر الفلسفية وهُويته الشِّعريَّة المُتفرِّدة في مَضان هذه المصفوفة الشعرية. وإنَّ استخدام الكاتب أو الشاعر للتناصِّ في نصِّه المُبتدع يُضفي على المدونة مورداً ثرَّاً في التماهي الصوري والفكري لفضاء جماليات المثابات المكانية الشعرية والنثرية المتآلفة.
وقد أعقب الشاعر زيد الشهيد عتبة التصدير هذه بعتبةٍ فرعيةٍ أخرى، تلك هي عتبة (التقديم) الذاتي الذي لم يكن مألوفاً لنظر القارئ في النمط المتبع بطباعة المجاميع الشعرية وسياقاتها التي اعتادَ عليها نظر المتلقِّي النوعي والعادي. وقد قصر هذه المُقدِّمة على صفتين مُهمتين هما:(الشعر واللُّغة). وعنده "الشِّعرُ هذهِ اللُّغةُ العَاتيةُ". (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 9)، ووسيلته هذه " اللُّغةُ.. هذا الجَبروتُ الطَّيِّعُ". (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 9). في إشارةٍ خفيَّةً وذكيَّةٍ إلى فنِّ الشعريَّة التعبيرية، ومعجمية اللُّغة الشعريَّة أداة التوصيل الروحي والحسِّي بينه وبين المتلقِّي لشطآن هذه الشعرية وضفافها.
والعتبة النصية الثالثة التي جعلها الشاعر تصديراً ثانياً لكتابه هي عتبة الشعر في إشارةٍ إيحائية مُضمرة إلى الذات الشاعرية الصُلبة المُتعَبَة التي تَعاركتْ مع نوازع تَطاول الزمن واستمراء دهاليز الأسئلة المُحيِّرة لهذا الفتى الشُّجاع الذي نحتَ في إزميله الشعري من صَلابة الحجر أمانيَ شخصيةً، ومن المستحيل إدراكاً فكريَّاً لتحقيق ذاته وتكوين أناه الشاعريَّة، فَيُخبِرُ بتصديره الثاني:
مَشدودٌ إِلَى الزَمنِ
عَاكفٌ فِي دَواليبِ الأَسئلةِ
حَجَرٌ هَذا الَفتَى الَّذي صَنَعَ الأُمنياتِ
قَفزَاً لإِدراكِ المُستحيلِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 11)
وحرص الشاعر زيد الشهيد على أنْ يضع لكل قسم من أقسام الكتاب الاثنين عتبةً فرعيةً متمايزةً عن الأخرى بجوهر محتواها ينطلق منها في إنتاجه إلى شطآن الشعرية الخِصبَة.
ومن يتتَّبع العنوانات الفرعية لمدونة(دَولةٌ داخلُ قَلبِي) بقسميه الأول والثاني سينبهر بذلك الكم النوعي والعددي من العتبات الفرعية الداخلية لمتن الخطاب التي تَغلَّبت بنائياً وتركيبياً فيها العنوانات الفنيِّة المُنزاحة على نظائرها الأخرى القليلة من العتبات ذات التوظيف الحسي التقريري المباشر الذي لا يتطلب جهداً وتفسيراً وتحليلاً وفكاً لشفراته اللغوية في التنميطية الإطارية والقياسية المُعجمية المألوفة للقارئ والدارس والناقد في أدبيات القراءة والتلقِّي المعرفي الإبداعي.
ويُعزى كلُّ ذلك إلى بلاغة الانزياح اللغوي الأسلوبي لِمُعجمية الشاعر وثقافته الشعرية المكتسبة ومقدرته الفنيَّة الواثبة على صياغة عنوانات صورية فنيَّةٍ مُتحركةٍ في أنسنتها الروحية وإيقاعها الصوتي الأسلوبي التعبيري عن جماليات واقعة الحدث الشعرية، وتحوِّلات وتيرتها الحركية المتسارعة في تخليق وإنتاج لوحاتٍ شعرية متناميةٍ تجمع في مضانها التكويني بين ثنائية التجريب الشعري الوصفي والتجريد الفنِّي في رسم اللَّوحة الشعرية بهيأتها الكَماليَّة لنظر القارئ.
وعلى وفق ذلك فإنَّ العنونة قد تضيف بُعداً دلالياً وجمالياً جديداً على شعرية النصِّ، وقد تكون في كثير من الأحيان خلاصةً رمزيةً مُكثَّفةً لمسار الشعرية المكانية. وذلك لأنَّ العنونة قد تكون عنصراً مهمَّاً من عناصر روافد الإدهاش والتجلِّي النصيَّة المُتعدِّدة. حيثُ تُكرِّس العَلاقَة الخطيَّة المباشرة والتعالق السيمائي بين واقعة الحدث الموضوعية من جهة، ولافتة العنونة الموازية للنصِّ الشعري من جهة أخرى. فهي علامة أيقونية فارقة دالة على محتوى المجموعة وصورتها الكليَّة.
تَطبيقاتٌ إِجرائيَّةٌ لِفضاءِ المَكانِ التَّشعِيري
ومن أهمِّ النصوص الشعرية المكانية الجيَّدة التي تلفت الانتباه الفكري والموضوعي المُستجد بسمتها العنوانية المُدهشة، النصُّ الشعري القائم بذاته(دَولةٌ داخلُ قلبي)، والذي اتَّخذه الشاعر عتبةً عنوانيةً رئيسةً لمصفوفة هذا الكتاب الشعريَّة. ومن باب تغليب الأفضل تمَّ إطلاق اسم القصيدة الجزء على الكل العنواني؛ إيثاراً للعَلاقة الحَميمَة ما بين العنونةِ وواقعة النصيَّة الشعريَّة الداخلية.
وهي القصيدة التتي استهل مُفتَتَحهَا الشاعر بمجموعة من ضمائر الذات الفردية والجمعية المشتركة، وهي ضمائر( الخطاب والتكلُّم والغياب) بشتى أنواعها الذكورية أم الأنثوية، والفردية أم الجمعية. فضلاً عن الإشارة المباشرة لهذه الضمائر بأدواتها القريبة والبعيدة التي تعاضدت جميعاً وتشاركت في تأثيث وبناء أُس دولة القلب العظمى العميقة مثابةً مكانيةً راسخة لهُويَّةِ الحبِّ والفخر والزهو والخُيلاء في هذا المجد الشعري الخالد. فلنتأمل جماليات هذه الدولة المثالية:
أَنتَ، وَهوَ... أَنَا، وَنَحنُ، وَأَنتُمُ
أنتُمَا، وَأَنتُنَّ
كُلُّ هَؤلاءِ، وَأُولئِكَ
بَنُوا دَولَةً دَاخلَ قَلبِي (دَولةٌ دَاخلُ قلبِي، ص 25)
إذن كل هذه الضمائر الشمولية الداخلية المؤنسنة مشتركة ببناء دولة القلب، وهي تأكيد ذاتي على الخروج من ربقة الذاتية الضيقة والانفتاح على عميم الذات الجمعية الكُليَّة المشتركة؛ لتشمل كل الصفحات المكانية في داخل القلب النابض بالحبِّ وخارجه كدولةٍ حصينة لا يمكن أنْ تتزحزح:
لِكُلِّ الصَّفحاتِ الَتي زَرَعَتْ كَلمَاتٍ
وَحَفَرَتْ صُوَراً.. وَأَنتَجَتْ كِتَابَاً
دَوَلَةٌ حَصينَةٌ هُنَا (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 25)
هذا الشعور الطافح بالانفتاح الشمولي في الخروج من ذاتية الأنا الشعرية الضيَّقة والارتماء بأحضان ذاتية الجمع الكوني الشعبي الآخر، دفع بالشاعر زيد الشهيد إلى تأكيد حصانة تلك الدولة القصية المثالية والقريبة الفاضلة التي شيَّد صرح معمارها الفنِّي الهندسي في ثنايا قلبه النابض من خلال تقنية التَّكرار اللَّفظي الجزئي لكلمة(الدولة) التي تكرَّرت تَكراراً عمودياً في الجُمل الشعرية الأربع الأخيرة بهذه القصيدة؛ وذلك لتأكيد جلالة المعنى النصِّي، ونزع نية الشكِّ لحقيقة البناء في نفس السامع والقارئ. فجاءت ترانيم المقطع الرابع منها لتأكيد المكانية الظرفية لهذه الدولة الماجدة:
دَولَةٌ عَظيمَةٌ هُنَا..
تَمشِي لِمُدنٍ عَارِيَةٍ بِلَيْلٍ بَلِيْلٍ
تَستَحِمُ بِنَسماتِ الِّسِّحرِ
وَتُغنِّي مَا تَشَاءُ مِنَ العِشقِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 26)
وينتقل الشاعر في المقطع الخامس في تكراره اللَّفظي من دولة(العَظَمَةِ)الماكثة في جذورها العميقة إلى دولة(الجَمَالِ) الشِّعري الشاخصة في بنائها الماثل لجميع أبناء الشعر والجمال. فيقول في تأكيد ظرفيتها المكانية المعمارية بهذا التراتب المعماري الفنِّي من الكلمات الذي يسعى إليه:
دَولَةٌ جَمِيلةٌ هُنَا
صَمَّمَها مَعمَاريونَ مِنْ جَبَلِ الكَلمَاتِ،
مِنْ بُحُورِ الأَلوَانِ..
مِنْ طُوفانِ الفِكرِ الخَارِجِ لِتَبييضِ العُتمَةِ
مِنْ أَخبَارٍ لَمْ تِتِكِيَّن بِغَيرِ مُغامِرِينَ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص26)
وأخذ الشاعر يُكرِّر أيضاً الحرف(مِنْ) التبعيضية أربع مرَّاتٍ متواليةٍ في هندسة بناء الدولة، فقال: (مِنْ جِبلِ الكَلماتِ)، و(مِنْ بُحورِ الألوانِ..)، و(مِنْ طُوفانِ الفِكرِ..)، و(مِنْ أخبارٍ لَمْ تَتَكَيَّنْ..). ويمضي الشهيد في تواتره اللَّفظي التَّكراري لهذه (الدولة) في المقطع السَّادس ليؤكِّد حجم مصداقيتها وعدم اعترافها بأي نقصٍ؛كونها تقوم على الصدق وتأخذ الورد من الخالدين لِتُأكِّد خلودها المكاني:
دَولةٌ مُتكامِلَةٌ هُنَا.. لَا تَعترِفُ بِالنقصِ
وَلَا هِيَ بِحَاجَةٍ لِتَقييمِ الحُسَّادِ، وَالمُتطفِّلينَ، وَالمُتنطِّعِينَ.
دَولةٌ تَقولُ الصِّدقَ، وَتَشترِي الوَردَ مِنْ رِياضِ الخَالدِينَ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، 27)
وجاء الفضاء المكاني للمقطع السابع والأخير في تتابعه التكراري لحجم هذه الدولة المُتخيَّلة أسطورياً؛ لتؤكِّدَ خلودها الحضاري والثقافي من خلال هذه التشبيهات العجائبية والغرائبية لثقافتها:
دَولَةٌ خَالدةٌ هُنَا..
كَبُرجِ بَابلَ، كَشَلالاتِ نِيكَارَا
كَسورِ الصِّينِ، كَبَحرِ المَانشِ
كَأهراماتِ الفَراعنةِ ، كَيُوليسزَ، كَشكسبيرَ
كَبُؤساءِ هُوغُو، وَدراويشَ بَاشلَارَ
كَالمَجَرَةِ السَابحَةِ فِي الهُيولِي الغَامضِ والغَرِيبِ. (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص27)
ويُلاحظَ أنَّ الشاعر الشهيد اعتمد في تأثيث معمارية هذه الدفقة الشعورية الختامية على مجموعة كبيرة من تقانة بلاغة المقاربات التشبيهية العظيمة للرموز الثقافية والشعرية والأيقونات العالمية والدولية، ولمثاباتٍ مكانيةٍ وثقافيةٍ ورمزيةٍ مهمَّة شغلت فكر العالم المترامي بجلالها الساحر وجمال صرحها الحضاري الفضائي المكاني العالمي المائز، فكيف لا تشغل فكر الشاعر والمترجم فكانت بحقٍّ خطاباً نصيّاً يليق بأقانيم معمارية دولة اليوتوبيا الأسطورية الفاضلة وبمكانتها الخالدة.
وفي قصيدة (أحلامٌ تَتَعلَّمٌ الأناقةَ) الدالة عتبتها العنوانية على استدعاء أنسنتها الفنيَّة الرائعة التي أضفى فيها على الدلالة المعنوية غير المرئية لدالة (الأحلام) شيئاً من حسِّيَّات الإنسان البصريَّة، وهو (الأناقة) الذوقية الجمالية الشكلية والجوهرية. حيث ينقلنا فكر الشاعر الصوري من حلم الدولة القلبية المكينة الكبيرة إلى حُلُم(المدينة) المثابة الإفلاطونية التي تنعمُ بِرغيد الفرح والسعادة، وتخلو شوارعها الفسيحة من وجع الهمِّ والحزن والارتكاس والنكوص ومكابدات الذات الماسوشية.
حتى وصل الظنُّ الانزياحي برؤى الشاعر الأنسنية الحُلُميَّة إلى أنَّ السماء فيها تقرأ كُتُبَ الأماني المنشودة، وأنَّ الفراشات الرقيقة تُعطيك رَقَصَاتٍ مُهفهفةً عذبةً جذلى لمن يرسم لها لوحة الحبِّ شعراً ُمبشراً بشآبيب نَثِّ المطر في هذه الانثيالات التدفقية التي تقترب كثيراً من فنِّ السرديَّة:
فِي حُلمِكَ مَدينةٌ تَخلُو مِنْ شَوارعِ الأَحزانِ، تَقتَفِي الأشجَارَ خَطوَ سَعادتِكَ الَّتي تَبتَغِي وتَقرأُ السَّماءُ كِتابَ أَمانيكَ، بَينَمَا الفَراشَاتُ تَغدَقُ هَفهفَاتٍ عِذَاباً عَلَى رُمُوشِ مَنْ يُصاحبُ المَدينةَ صَدِيقاً يَكتُبُ لَهَا الحُبَّ طَيفَاً وَيُرسمُهُ شِعرَاً عَلَى خَدِّ غَيمَةٍ تُبشِّرُ بِالمَطَرِ. (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 53)
ويُلاحظ أنَّ الدولة القلبية التي أسسها الشاعر الشهيد في قصيدته السابقة، وتلك المدينة الطوباوية القصية في القصيدة الحُلُميَّة الثانية ذاتها هي مثابات للمكانية والزمانية التي ينشدها الشاعر في مدينته الخلودية. وليست مجرد أمكنةً تصوّريَّة شاخصة العلامات بمعالمها الأيقونية واضحة الأثر.
وهذا يشي بخيالية الشاعر الحلمية التي يريد أن تنتهي، ولا يريد أن تنتهي بانتهاء اللَّحظة الشعورية الصارمة للقصيدة. وهذا التداعي الشعوري الداخلي لا يمنع الشاعر من استمرار حلمه في المقطع الثاني من القصيدة نفسها، فيستدعي لهذه المدينة الحُلُمية بحيرةً من الأحلام، وأناساً فاعلين يحتفون بها كأنّهم يَستحِمُّون على ساحل بحرِ مثابةٍ مكانيةٍ، في لقطة تخاطر من الانثيال السَّردي:
في حُلُمِكَ بِحيرةٌ يَرخَى لَهَا الرَّملُ سَاحِلاً وَتَنتَصبُ المِظلاتُ، فَالنائِمونَ عَلَى الرَّملِ عِشاقٌ يَقرأُونَ مَا كَتَبتَ لِعروسةِ البَحرِ. هُناكَ.. فِي أعالِي مُحِيطاتِ الرَّغبةِ، وَأدنَى حُدُودِ القَلَقِ تَرى الشَّمسَ تُحاورُها، وَيَأتيهَا القَمَرُ يُبعِدُ الوَحشَةَ رَيثَمَا تَجِيءُ بِعواطفِكَ فَأنتَ المُنْتَظَرُ. (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 53)
وتأخذهُ نشوة الأحلام والتمنِّيات على جناح غيمةٍ حُبلى مَاطرة شوقاً لأناقة بودلير الفرنسي المُعلِّم، وإلى جماليات لوحات مونيه الفنيَّة المرصَّعة بفرادة الألوان والضوء، فيمنحك انطباعاً بالإشراق الفنِّي. وكأنّي بزيد الشهيد يُترجِمُ لهما زمكانياً بطريقة من يَسرد لكَ بلغته النثرية القريبة من الشعر:
فِي حُلمِكَ تُرافقُ بَودليرَ تِلميذَا يُعلمُكَ الأَناقةَ، وَيُشيرُ عَلَى مُونيهَ أَنْ يَسقيكَ كَأسَ الألوانِ والضَوءِ، فَالانطِبَاعُ زَهرةٌ تَكتُبُ العِطرَ شِعراً، وَالشُّعراءُ مِظلَّاتُ وَرَسائلَ.. وَإشراقٌ. (َدَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 54)
بهذا الهجس اللُّغوي والشحن الشعوري الطافح يُصَيِّرُ زيد الشهيد الرؤيا الحُلُمية الشاعرة إلى تراتيل مِساحاتٍ فنيَّةٍ شعوريَّةٍ، وواحاتٍ بصرية جماليةٍ خضراءَ سامقةٍ للطبيعة والفنِّ والحياةِ والمحسوسات الكونية المتحركة التي تُسعد نفس الإنسان السويِّ وتَرتقي به نحوَ الرفاهية والتقدُّم.
فكل هذه الأدوات الشعرية التي وظَّفها الشهيد الشاعر والمترجم والإنسان هي في حقيقة الأمر تعدُّ ميادين فنيَّةً وجماليةً لمثابات عناصر الحياة الكونية (السكونية والمُتحرِّكة) التي أخذت مأخذها الطبيعي المتساوق أسلوبياً في ثنايا هذه القصيدة الصورية. لتعلن عن نفسها لوحةً تصويرةً إيماجية متحركةً لا تقف بدورانها الشعري إلَّا بانتهاء الدفقة الشعورية الهاربة لعالمها الوجودي الأرحب.
ومن بين قصائد هذه المجموعة الشعرية قصيدته الزمكانية الناهضة بصورها الفردية والذاتية الجمعية المتماسة(حَرائقٌ تُعرِّشُ في الجُفُونِ). والتي يستحضر فيها الشاعر عديدَ الأمكنة الإنسانية الثابتة والمُتحوِّلة(الشوارعُ والأرصفةُ والأزقةُ والبيوت) مرتبطةً ارتباطاً فلكياً وثيقاً بقرص حركتها الزمانية المحدَّدة بوقت معيَّن ما، (الفجر، طلوعُ الشمسِ، الظهرُ، الضُحى).
ورُبَّما الأيام المتسارعة وانتهاء الساعات المنقضية، وزفير اللَّحظات الشعورية الانخطافية المُتصارعة من تاريخ بلادي المدوَّن بدفتر مَلاحيظ الأُمَّهات والزوجات الذارفات للدموع أسىً وتأسياً على مجد أعتاب هذا التاريخ المتتالد الدهور. فهذه الدموع الساكبة للعبرات هي لظى الحرائق النارية التي تعرَّشت في جفون العيون لهيباً حارقاً للقلب والروح المستهامة بالحبِّ.
لنتأمَّل بإمعان فكري نابه في المقطع الأول من مفتتح القصيدة حركةَ شعور الشاعر زيد الصباحية المُبّكِّرة، وهو يلفُّ الشوارع الساكنة بحركته التأمُّلية، ويمرُّ سائراً على قارعة الأرصفة النائمة الهامدة في وقت السَّحر في لوحةٍ فنيَّةٍ دراميةٍ مُتناميةٍ تجمع بين هدوء السواكن المُتحرِّكات:
كُلُّ يَومٍ أَنهضُ عِندَ الفَجرِ أَلفُّ الشَّوارعَ
وَأَمُرُّ عَلَى الأَرصِفَةِ
أَجمعُ الدُّموعَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ.
لَا أُريدُ أنْ يَضيعَ دَفترُ الأُمهاتِ وَالزَّوجاتِ
دُمُوعُهُنَّ تَاريخُ بَلَادِي
وَجَعَهُنَّ، تَرتِيلِهُنَّ عَلَى أَيامٍ مَزَّقَتهَا اِنتظارَاتُهُنَّ.
كُلُّ ظَهيرةٍ أَشقُّ الأَزقَةَ وَأخترِقُ الأَشواقَ.
ألحَقُ مَنْ رُحْنْ يُحَدِّقْنَ فِي الوُجُوهِ وَيَتشبَّثْنَ بِأَكُفِّ الَّشَبابِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 57)
ليس فقط همُّ الشَّاعر مَقصوراً مَقصديَّاً على عناصر هذه الحركة المكانية أو الزمانية المتراتبة إيقاعياً، وفواعلها الشخصية المتحركة فحسب، بل فلننظُرْ إلى إيقاع أسلوب وَحْدَنةِ الأفعال الحالية الزمانية المضارعة، (أنهضُ، ألفُّ، أمُرُّ، أجمعُ، أريدُ، أشقُّ، ألفُ، أتحرَّى)، ونتحسَّسُ بعمقٍ وقعَ مشاركتها الفعلية العملية المنتظمة التي أسهمت إسهاماً فنيَّاً وبنائياً تركيباً ومعجمياً في تحريك صورة الواقعة الشعرية وتفعيلها مكانياً وإيصال دلالاتها الشعورية الحارَّة إلى ذائقة المتلقِّي.
فتلك الأفعال التشاركية هي عرائش الكروم الزمانية التي ترفع الأغصان المكانية عَلِيَّاً وتُهيِّئ إلى قيام المثابات الوجودية في هذه الصورة واللَّوحات الشعرية الإنسانية التي تزدحم بها الوحدة الموضوعية لهذه المدوَّنة الشعرية كعلاماتٍ خطِّيِّةٍ فَارقةٍ في تحقيق مقاصد مَرامي الشاعريةِ.
ويستمرُّ الشاعر زيد الشهيد في نهجه الحركي المكاني الدائر بهذا التَّكرار الكلي(كلُّ) المقترن بالدالة الزمانية(ضُحىً) المُرتبطة بمثابة(البيت) المكانية في جملة إخبارية يتحرَّى فيها الشاعر متأملاً ويبحث عن الوجوه المشرقة الصبوحة التي تغرِّد كالبلابل في معزوفاتها الغنائية الشادية:
كُلُّ ضُحىً أًتركُ البَيتَ
أتحرَّى عَنْ وُجُوهٍ صَبُوحةٍ
كَانتْ كَمَا بَلابِلَ تَقُولُ الزَغاريدَ
أَجمعُهَا فَي أُغنيةٍ
لَا أُريدُ لِتَساؤُلاتِ الصِغارِ أَنْ تَتَبَدَّدَ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 58)
لم تكن المثابات المكانية عند زيد الشهيد على مستوىً واحدٍ نمطي ثابتٍ من تداعي الصور الفنيِّة والدراميَّة والبصريَّة المرئية. فالإيقاع الأسلوبي للحظة الشعورية الدافقة قد يتغيَّر جذرياً وكليَّاً بتغيُّر غرض الفكرة الموضوعية لوحدة القصيدة. فإذا كانت (الشوارع)، أو طرق الحركة الإنسانية المتزاحمة في القصيدة السابقة عنواناً لحركة فضاء الحياة اليومية المكانية، وعلامة أيقونيةً لديمومة استمرار نسغ الروح الحياتية بكل تجلياتها ومهيمناتها الصورية الظاهرة والمضمرة.
فإنَّ الشاعر في قصيدته(رُؤىً تَقتات وَقتَاً) الدالة على فكرتها الموضوعية المتوائمة قد أحال تلك(الشوارع) المكانية الواسعة إلى صُحفٍ ثقافيةٍ انتشرتْ عنواناتها بين الإرجاء وتبعثرتْ علاماتها الناطقة بالمعرفة إعلانياً. وفي الوقت ذاته أحال (الأُقبيَةَ)أو الأماكن الخفية التي تكمن في صدور الفقراء من عامة النِّاس إلى كلماتٍ شفيفةٍ تَنسكبُ منها زفرات العبرات شجناً، وتنحدر منها الآهاتُ دموعاً عصيَّةً، مُعَلِّلاً هاجسَ تلكَ الإحالة النفسية كي يُعيدَ للدمعة كبرياءَها الذاتي الجليل:
كُلُّ نَهارٍ أَرَى الشَّوارِعَ جَرائِدَ تَتَبَعثرُ عَناوينَهَا
وَفِي أَقبِيةِ صُدُورِ الفُقراءِ تَسكِبُ الكَلمَاتُ العَبَرَاتِ
أَعيدُ لِلدَمعَةِ كبرِياءَهَا (دُولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 67)
فمثل هذه النظرة الزمكانية في تناظرها الحركي والفكري قد قادت وعي الشاعر زيد الشهيد إلى الاستمرار في استخدام وتوظيف الدالة الجمعية ا لشمولية التوكيدية(كلّ) المقترنة بزمن كأداةٍ لمُفتتَحاتٍ في مقاطع القصيدة الأخرى(الأول والثاني والرابع والخامس)بحسب ما يتطلَّبه الموقف.
وغائية الشاعر من كل ذلك التشديد الكلي؛ لتأكيد فاعليتها الكية المكانية وأثرها الجمعي الشمولي في كلِّ زمانٍ دالٍ على حركة الشاعر وتنامي انثيالاته الصورية ورؤاه الفكرية الُمتحرِّرة في منظومةٍ شعريةٍ من التحشيدات الجمليَّة الملتقطة. والتي ترسم هواجس الشاعر ونظرته الثقافية عن واقعه الشعري الذي هو واقع مجتمعي. وهذه الاستمراريَّة تشي بأنَّ الشاعر يختلق المكانية ويحدِّدها، سواء أكانت حقيقيةً أم أسطوريةً متخيَّلةً ؛ لينتج لنا صوراً شعريةً تكامليةً تأثيريةً مفعمةً.
الشاعر الشهيد دائما يبحث في تجديده الشعري عن مفرداتٍ تُخلِّد القصيدة وتبعث فيها الروح الشاعرية والأثر التاريخي الناجم عن ثقافة الشاعر المكتسبة واستعداده الفطري في تجسيد الواقعة المكانية بشخوصها الرمزية القديمة والحديثة ذات الأثر التراثي الغائر بأطنابه في عمق التاريخ. وقد دعاه هذا الاستعداد الثقافي المعرفي الابستمولوجي إلى استخدام تقنية التضاد الفعليَّة الأمريَّة المُتوحدنة مع زمكانية الحدث(كُنْ)، (لاتَكُنْ)في إشارة نسقيةٍ إلى مصادر الخير والشرِّ ومنابعه:
كُنْ مَعِي كَهَارونَ لِمُوسَى فَأرسِمُكَ وَفَاءً
وَلَا تَكُنْ برُوتسَ لِقَيصرَ فَأحسبُكَ أَيقونَةً لِلغَدرِ.
كُنٍ نَهرَاً يُحَاوِرُ الأشجارَ عِشقَاً
وَلَا تَكُنْ صُخُوراً تَرشِقُ جَبهَةَ النَاظرِينَ.
اِجعَلنِي أَهفُو إِليكَ كُلَّمَا جَرَحتَ يَدَيَّ
شَوكَةُ بُغضٍ، أوْ وَقَفَ بِوَجهِي غُولُ الحِقدِ (دَولةٌ دَاخل قلبِي، ص 61، 62)
الشاعر في إثبات الوجود الهاملتي(أكون أو لا أكون)، وفي خطابه التحذيري لاستنطاق هُويَّةِ الآخر وديمومة بقاء النص الشعري(أيها الطالع من نهر الذاكرة) يتمنَّى أن يكون هذا الطالع بمنزلة هارون من موسى الأخوية الرساليَّة في صفة الوفاء والإخلاص التاريخي بتمام العهد، لا صفة الغدر والخيانة كمثل بروتس الصديق الغادر لقيصر الروم والضالع بالجريمة الجمعية. ويتكرر تردُّدُ هذا النداء النُّصحي الحَكيم لنظيره الآخر إيجاباً وسلباً فيدعوه بفعل أمرٍ طلبي ناسخٍ (كُنْ) أنْ يكون نهراً عاشقاً في حواره الروحي لأشجار الطبيعة الكونية المكانية، وليس صخراً جارحاً يشجُّ جبين الناظرين بهذا الترديد الأسلوبي الإيقاعي المموسق بينه وبين فكرة القصيدة المكانية.
هكذا يحوِّل الشاعر الشهيد المثابة الفضائية المكانية بهذا الترديد التضادي المتواتر التكراري إلى حلبة صراع بين الخير ونقيضه الشرُّ. وتتابع خُطى الشاعر زيد بهذا الهجس النفسي المتصاعد في مقاطع القصيدة المتتالية حتَّى نهايتها بإيقاع تَدَرَّجٍ أسلوبي تكراري تحدُّدي من الفرادة والإمتاع الروحي في تجسيم واقعة الحدث(المُعَلَّقةُ)وأرخنتها شعرياً لمكانها القديم وزمانها عصر الجاهلية:
كُنْ مُعلَّقَةَ الشِّعرِ يَحفظُهَا كُلُّ ذِي قَلبٍ جَمِيلٍ
وَلَا تَكُن سَيلَ الأوجاعِ الرَعنَاءِ
تَذِرُهَا رُوحِي وَتُسَمِّيكَ عَذَابَاً (دَولةٌ دَاخلُ قلبِي، ص 63)
وعند الالتفات إلى فكرة نصه الشعري المعنون (بالأسئلة لُغتي تُؤسِّس مِملكتها)، يقرُّ الشاعر زيد الشهيد في خواتيم هذه القصيدة الهَميَّة المنسكبة بسيل من الأقدار والهموم والتجلِّيات التلهفية، وبجمل شعرية خبرية واسمية متوالية باعترافه القارِّ عن مرافئ محطَّاته المكانية الخمرية فيقول:
لُغَتِي خَمرِي.. وَأنتِ مَدِينتِي
مِتعَةُ حَديقةِ الكَلِمَاتِ
إنْ اِرتكزَتْ إِلَى الصَّمتٍ تَبَعثًرَتْ (دَولةٌ داخلُ قلبِي، ص 76)
لا شكَّ إنَّ الإخبار عن مرافئ ومحطات الشاعر المكانية التي حولته إلى راءٍ للهموم والمرارات تنمُّ عن أسفٍ وتحسرٍّ وانكسارٍ ونكوص وشعور خيبة بالتذمُّر؛ لكن ما يعوض ذلك التراجع والانكسار الروحي الآسف هو لغته الشعرية التي هي هويته في مدينته الشعرية التي استحالت إلى حديقة هجسد من الكلمات الاستنطاقية التي لا تعرف الصمت والركون الهادئ.
والملاحظ أنَّ الفضاء المكاني في نصِّ هذه المدينة الشعرية الفاضلة لم يأتِ مصطنعاً قصدياً، بل حضرَ عفوياً انسيابياً تلقائياً سلساً غير متكلِّفٍ في معرض انثيالاته التبئيرية؛ لأنَّ الدفقة الشعورية الهاربة من شواطئ الصمت هي من تأتي به طيِّعةً منقادة تجرُّ أذيالها جرَّاً انسكابياً مدراراً كَغيثٍ منهمرٍ. هذا ما نرى استنطاقه العذب وديمومته في خطابه الشعري ومناداته الحُلُميَّة لمدينته الحياتية:
أَيَّتُهَا الحَياةُ يَا مَدِينَتِي
كُونِي شَوارِعَ بَهجَةٍ وَأرصفةَ تَرانيمَ
زَهرةً يَهتَدِي عِطرُهَا لِعُشَّاقٍ نَامُوا
عَلَى حُلُمٍ يَغرِقُ فِي الضِّحكِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 71)
ويلاحظ أن الشاعر الشهيد كان بمدونته مُلهَمَاً ومهووساً بِحبّه الجمِّ للفعل الماضي الناقص الناسخ (كان) وأثر تقلباته الاشتقاقية(أكنُ، يِكُنُ، تَكنُ، كُنْ، كُونِي، كُنتُ...). والحقيقة أنَّ هذه التردُّدات (الكانيَّة) الفعلية الحدثية المتناغمة التساوق الصوتي والحدثي في طيَّات القصيدة تمنح النصَّ الشعري إيقاعاً أسلوبياً عذباً ناتجاً عن شغاف نياط القلب وعلائقه الروحية بالآخر الذي يتماهى معه الشاعر زمانياً ومكانياً في مِساحاتٍ كبيرةٍ من سعة فضائه الشعري المتواشج علائقياً:
حَيثُ أَكونُ تَكونينَ قَفَصَاً
أيَّتُهَا السَّمَاءُ الَّتِي خَطفَتْ مِنِّي
سُلَّمَاً وَرَمَتنِي فِي المَتَاهَاتِ
صَحراءَ بِلَا وَاحَاتٍ أَنتِ
وَأَنَا الظَّبِيُّ الظَّمآنُ
أَكتُبُكِ شَوقَاً، لَكِنْ أَحصدَكِ نَهَارَاتٍ صَيفِيَّةً (دولة داخل قلبي، ص90)
فحينما يكون النداء التَّكراري خالصاً من ثنايا القلب يقع في القلب، وليس كما يخرج الكلم من اللِّسان فلم يجاوز إلَّا الأُذن، كما يَستدلُّ بذلك الأثر البالغ الجاحظ في بيانه الساحرعن اللَّفظ والمعنى. فلننصت إلى ما يقوله الشاعر في رحيله المكاني الذي هو يقين القلب الثابت الذي لا يتزحزَحُ:
وَتَرَكتُ غُيُومَ التِّيهِ
قِطَارَاتٍ َترحَلُ إِلى مَحطَّاتٍ
لَعلَّهَا اليَقِينُ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 82)
ومن يتتبع الجمل الشعرية المتوالية لقصيدة(اقتفاءُ أثرِ النَّيازكِ)، سيلحظ بعين بصريَّةٍ ونقديَّةٍ ثالثةٍ سَيلاً من الأفكار التساؤلية عن الأمكنة الوجودية التي يبحث فيها الشاعر عن ضالته المفقودة وعن وجوده الكوني في هذا العالم الواسع المليء بالمتاهات السرابية الضيِّقة والغوايات المُهلكة:
إِلَى أيِّ المَرافِئ الغَائمَةِ تَأخذُنَا النَوافذُ المُسرِعَةُ؟
إِلَى أيِّ سَراباتِ المَتاهَاتِ تُسَلِّمُنَا ضِياءُ الغُوايةِ؟
وَإِلا مَا نَنَحَتُ الكَلماتِ كَي تَبقَى زَرعَاً أخضرَ؟ (دَولةٌ دَخل قَلبِي، ص 97، 98)
فالأداتان الاسمان(أيّ)، و(إلاما)، هما أداتا استفهام تساؤليتان بحاجةٍ إلى إجاباتٍ شافيةٍ للوصول إلى شاطئ الحقيقة المكانية عن مدلولاتهما المعنوية الزمكانية التي قدحت فكرتهما إلى وعي الشاعر زيد الشهيد وذخيرته الشعرية إلى الهجس بهما بهذا التساؤل عن ذاته الشاعرية المُتحيِّرة.
حينما تكون العنونة النصيَّة الموازية لتجلِّيات النص الشعري المرسل إلى القارئ علامةً ضوئيةً وفناراً سيميائياً كاشفاً عن محطَّات النصِّ المكانية وفضاءاته الزمانية الحالية والمستقبلية وصولاً لمرافئ الحقيقة الوجودية اليقينية الثابتة والمتحركة المعبِّرة عن هجس الشاعر الفكري وقلقه، تكون العلامة الخطية بين موحيات العنوان والمتن الشعري علامة صدقٍ لـ( الوُصولِ إِلى مَجرَّةِ اليَقينِ).
والتي هي ثيمة النصِّ الفكري التي يخوض غمارها الشاعر صوراً فنيةً سابحةً في فضاءات المكانية وانزياحاتها لعنونة أسلوبية تنعم بها تجليات النصِّ الشعري؛ لتبعث برسالة مفادها أنَّ الرغباتِ آمالٌ واعدةٌ، ، وأن الوصول إلى عين الحقيقة الوجودية للمستقبلية وإنْ كان مُكلِّفاً ومُتعباً شاقَّاً لا يخرج عن حدِّه عن كونه يقيناً روحيَّاً فكريَّاً يبعث عن مكملات الطمأنينة والسلام والدِّعة والاستقرار النفسي ذي المردود الفكري والمكاني التخليقي المنتج لا التافه المُستهلِك لجوامع الكلم:
سَأبحَثُ فِي فَضَائِكَ مُدُنَا تَرتَدِي قُمصَانَاً مِنْ رَغَبَاتٍ
وَتَتَعثَّرُ كَالأطفَالِ وُصُولاً إِلَى مَجَرَّةِ اليَقِينِ
رَاكِضَاً فِي بَرارِيكَ أَحلامَاً تَتَهَايَفُ فِي شَوارِعَ
تَبحثُ عَنْ عِربَةٍ لَا تُقِلُ الظُنُونَ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص 101)
إنَّ السباحة في فضاءات المدن، وارتداء قمصان الرغبات النفسية، والتَّعثُّرَ كالطفولة، والركض في براري الأحلام، هي جمل شعرية وصورية فنيَّة ناطقةٌ بجماليات الصوت والحركة الدرامية كَفيلةٌ بتحقيق المنشودات الذاتية الحُلُمية من خلال استدعاء صور هذه الفضاءات المكانيَّة الصادقة.
فالمشتقان اللَّفظيان(سابحاً وراكضاً) اللَّذان افتتح بهما الشاعر مستهل قصيدته وصولاً بها إلى مجرَّة اليقين الدالة على معنى عتبتها، ما هما إلَّا علامة سيمائية دالة موحياتها الدلالية على سعي الشاعر زيد الدؤوب وحركته الشعرية المتوثبة تجريدياً في إمتاع القارئ بهذه الانزياحات الضوئية المؤنسنة القريبة للروح في مؤثِّراتها النفسية وعملها الحدثي الفاعل بالأثر.
وقد زانها جمالاً وفنَّاً حركياً على فنٍّ ساكنٍ حينما قال بأنَّها:(تَتهايفُ في شَوارعَ)، وكأنَّ الأحلام فتاةٌ هيفاءٌ رشيقة القوام عذبة الروح تسرُّ صورتها الكُليَّة الممشوقة نظر الرائين ورضاهم الذاتي؛ كونها (تَبحثُ عنْ عَربةٍ لا تُقِلُّ الظُّنُونَ)، أي الشكَّ، بل تُقلُّ اليقين القلبي الثابت.
ولننظر بتؤدة وإمعان دقيقينِ إلى صورة المقطع الأخير من أواخر قصيدة للشاعر بهذه المصفوفة الشعرية المتصالحة مع نفسها، والتي وضع لها عنواناً خبريَّاً وفنيَّاً طويلاً لا يخلو من فن بلاغة التعبير القولي عن تزاحم همومه النارية المتسكعة بقوله: (أتركُ هُمومِي تَتَسكَّعُ وأرفو جذوتي).
كيف يترك الشاعر الشهيد همومه الذاتية وأناه الشاعرية إنساناً يتسكُّع كخيَّاطٍ رافياً بها جذوته القلبية الملتهبة ناراً لا تنطفئ جذوتها المشتعلة بهذه الصور المُحتشدة بالأماني والفضاءات المكانية الَّتي أكلت عمره وشيَّبتْ، شعر رأسه، وقوَّضت وعي فكره، ومرَّضت العلّة نفسه؟ إنَّها المخايل:
وَأمانٍ كَبَحرٍ يَغرقُ فِي ضَبَابٍ
شَوارِعٌ تَتَعثَّرُ، وَأقبِيَةٌ تَئِنُّ
لَافتَاتٌ تَمرَضُ مِن تَمزُّقِهَا
آخرُ الخُريطةِ يَتمَرَّغُ بِغُيومِ الحَقيقةِ الغَائِبَةِ (دَولةٌ دَاخلُ قَلبِي، ص104، 105)
والعجيب أن الشاعر الحقيقي هو من يجمع وقع هاجسه الفكري المحتشد بين مُدخلات اللَّقطة الشعرية الشعورية المُحتدمة الصراع ومخرجاتها الكليَّة الجاهزة. بين عالمها الداخلي الأرضي المكاني الضيِّق ومحيطها الخارجي الكوني الوحدوي الوسيع. وما مفردات، (البحرُ، والضبابُ والغُيومُ) إلا عناصر من عناصر الطبيعة الكونية الخارجية(الصامتة والمتحرِّكة)، وقد تواشجت فنيَّاً وجماليَّاً مع دالات مدلولات فضاءاتها المكانية الداخلية المتشابكة الصور، (شَوارعٌ تتعثرُ)، و(أقبيةٌ تئِّنُ)، و(لافتاتٌ تَمرضُ)، (التَّمرغُ بغُيومِ الحقيقةِ) المكانية المقترحة.
هكذا يرسم زيد الشهيد حمولاته الفكرية الضاجَّة في لوحةٍ شعريَّةٍ واعدةٍ بالفنِّ توصيفاً وتجريداً وتكنيكاً لقواعد الفنِّ الشعري في زمن تكالبت عليه ثعالب الشعر القميء الطارئ، وفي فضاء مكاني نامت نواطير الشعر وحُرَّاسهُ عليه بالشخر والسُّبات الدائم، وباتت فيه قصيدة النثر الشعرية عند الكثير من مُدَّعي الشعر ليس إلَّا إسهالاً لفظيَّاً ناشزاً لا يمكثُ زبده الطَّافي إلا بتجاوز الأذنين.
المُعجمُ الشِّعريّ لِزَيدِ الشَّهيدِ
إن ما يميِّز المعجم الشعري لزيد الشهيد في قصائده النثرية الزاخرة التي احتفت بها مدوَّنته الشعرية الثرَّة، (دُولةُ دَاخلُ قَلبِي)، هو رشاقته لغته الشعرية الباسلة في تماسكها النصِّي حَبكَاً لُغويَّاً مُتجدِّداً وسَبكَاً دلالياً رصيناً مُحكمَاً. وفضلاً عن ذلك تنوِّع وكثافة صوره الشعرية البلاغية والجمالية الزاخرة بالعطاء الفنِّي، وجرأته الانحرافية المِقدَامة في بثِّ انزياحاته التعبيرية المِخياليَّة في تأثيث وصياغة وتركيب جمل شعرية ومجازية إدهاشيةٍ ثرةٍ في دلالتها اللفظية ومعانيها الكليَّة.
وبالتالي قادرةً على كسر توقُّع أفق المألوف الشعري بفنية التعبير الأسلوبي في إنتاج وتخليق منظومات شعرية متكاملة الصور والأثر لا في تركيبها النحوي فحسب، بل في موحيات علاقاتها الخطيَّة الاستدلالية والتضادية والرمزية الاستعارية المهمّة في صناعة الأثر الشعري بعيداً عن المُباشرة والتقريرية والإملال الممقوت.
فهذه المنظومات والنتاجات الشعرية هي بطبيعة الحال تُشكِّل ثقافياً ورمزياً أشكال ثقافةٍ ما مثلما هي أشكال معاني ما. ويعضد هذه الانحرافية البلاغية الجديدة جماليات الشاعر في اختيار عنواناته الفنيَّة الحسيَّة والبصرية التي تُناسب وحدة واقعة الحدث الموضوعية التي هي بؤرة الشعر الفكريَّة، وتخدم النصَّ الرسالي الذي يُلامس ذائقة شغاف القارئ المتلقِّي الذكي النوعي ويُثير وقع اهتمامه.
ويرافق كل هذه الأسلوبية الشعرية بصمة الشاعر المُعجمية في إنتاج قصائد شعرية نثرية خالية من إيقاع الموسيقى الخارجية لبنية النصِّ أو القصيدة الشعرية. فالشعرية الحقَّة لا تتأتى دوماً من إيقاع الوحدات الوزنية العروضية أو القافية الشعرية الموحدة، بل ربَّما قد تأتي من ذلك التنغيم الصوتي والموسيقي المتواشج عشقاً وتعالقاً وتركيباً.
فهذه العلاقة التجاذبية المُوحدنة تظهر نتيجة الانسجام بين وحدة الأفكار الموضوعية والأسلوبية الإيقاعية التي تحصل أو تنشأ على مستوى تقنية التَّكرار الصوتي المُتعدِّد(الحرفي أو الاسمي أو الفعلي أو الجُملي)، أو على مستوى والطباق والجناس والموازاة ورُبَّما المقابلة الناشئة على مستوى التركيب النحوي والصوتي والموسيقى الداخلية والعلاقات المعجمية داخل البنية الشعرية للنصِّ.
وتبقى المفارقة الشعرية والمباغتة الصورية الفنيَّة والرمزيَّة المذهلة السِّمة الأشدَّ بروزاً في عملية التخليق الشعري، والتي تنماز بها فلسفة الشاعر المتفرِّد شعريَّاً وثقافيَّاً عن فلسفة شاعر النصوصية المُتفرِّد بلاغياً في معجمه الشعري الرتائبي.
وأنَّ آخر أقانيم تخوم التميُّز المُعجمي الشِّعري تشي بأنَّ زيدَ الشهيد الشاعر والمُترجِم والرِّوائي والقاصّ والمثقَّف والإنسان يُعدُّ صاحب مشروع شعري ثقافي فكري مُتجدِّد في منهج رؤاه الشعرية وفلسفة تطلعاته الحداثوية في مدائن الشعر الفاضلة وفضاءات السرد الفاعلة وحافاته الفنيَّة الحافلة بالإبداع والابتداع الجمالي التي أسس لها كياناً بدولة الشِّعر القلبيةِ ومدينةِ السَّردِ المثاليَّةِ.
***
د. جبَّار ماجد البهادليّ