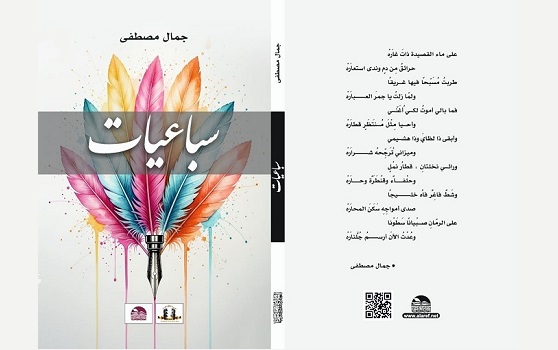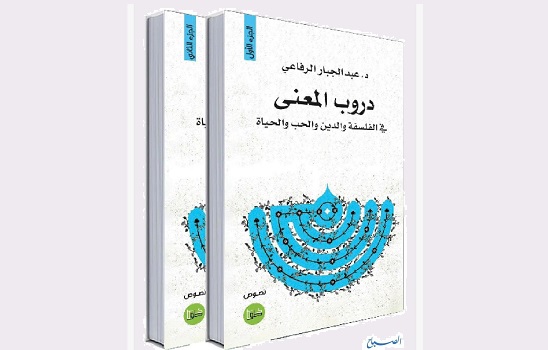قضايا
محمد البطاط: مفهوم الإستغراب ومنهجيته في فكر حسن حنفي

أثار موضوع الاستشراق Orientalism وملازماته المتنوعة العديد من ردود الفعل التي عمد إليها الشرقيون في سبيل مواجهة النزوع الغربي صوب قراءتهم قراءة لا تخلو من الغرضية، إن لم تكن تتأسس عليه أصلاً، الأمر الذي آل الى إعتقاد جملة من الشرقيين بضرورة تفعيل المعادل الموضوعي، أو الضد المعرفي المقابل للإستشراق، والذي قد تمثل بما أُطلق عليه بـــ"الاستغراب Occidentalism" ، فإذا كان الاستشراق يقوم على دراسة الشرق من قبل الغربيين، فإن الاستغراب يكشف عن دراسة الغرب من قبل الشرقيين، ولعل من أبرز الطروحات الداعية والمنظّرة لموضوعة الاستغراب ما قدمه المفكر المصري حسن حنفي (1935-2021م) في كتابه (مقدمة في علم الاستغراب)، والذي إعتقد فيه أن الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل، بل والنقيض، من الاستشراق، فإذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا (الشرق) من خلال الآخر (الغرب)، فإن علم الاستغراب يهدف الى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر، والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر، كما مايز بين الإستغراب و التغريب Westernization"، إذ عدّ حنفي الأخير سلبياً لإمتداد أثره الى مناحي الحياة كافة، وهو التمايز الذي لم يلتفت إليه غالبية الباحثين الذين خلطوا بين المصطلحين.
وتجنباً لهذا الخلط بين المصطلحات، وبعيداً عن الدلالة اللغوية التي قد لا تكشف الفرق الجوهري بينها، إذ، أحياناً، لا تكشف التحليلات اللغوية عن عين العمق في التمايز الذي تضعه الإجراءات المفاهيمية على الصعيد الاصطلاحي، بعيداً عن ذلك يمكن القول ان الاستغراب يمثل حالة تقابلية للإستشراق، في حين ان التغريب يمثل النزوع صوب التأثر بالغرب والاقتداء به والدوران في فلكه، كما أن هناك مصطلح (الاغتراب) الذي يمثل حالة الضياع في الهوية، وهو إحدى إرهاصات الفلسفة الغربية نتيجة لما مرت به من أزمات، فيتحول وفقها الإنسان الى شيء غريب عن واقعه ومحيطه.
ولابد من القول ان حسن حنفي لم يكن أول من دعا وسعى الى إعتماد الاستغراب كآلية لمعرفة الآخر، إذ وجدت العديد من محاولات الاستغراب التي لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها، وان هذه المحاولات كانت تشكل بداية موفقة في زمن رفاعة رافع الطهطاوي في مصر من خلال كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" وتأليف السفير العثماني محمد أفندي في فرنسا كتاب "جنة المشركين" الذي سجل فيه عادات وتقاليد وجغرافية المجتمع، كما يمكن إدراج محاولات العرب والمسلمين في كتب الرحلات الذين أثبتوا من خلالها دراساتهم للشعوب الأخرى.
بيد ان حسن حنفي يعتقد ان الوقت الراهن ملائم جداً لإعادة طرح مشروع يتقوم بفكرة إمكانية تحويل الآخر الى موضوع علم بدلاً من ان يكون مصدراً للعلم، لكن هل ستكتنفُ الاستغرابَ عينُ الإشكاليات التي صاحبت الاستشراق؟ يرى حنفي ان ذلك لن يحصل لوجود جملة فروقات بين الاثنين (مقدمة في علم الاستغراب، ص24):
1 – ظهر الاستشراق قديماً إبّان المد الاستعماري الأوربي في حين يظهر الاستغراب في عصر الردة وحركات التحرر العربية، والشعوب مهزومة في مرحلة الدفاع، لذلك يظهر الاستغراب كدفاع عن النفس.
2 – ظهر الاستشراق محملاً بإيديولوجية مناهج البحث العلمي والمذاهب السياسية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر من وضعية وتاريخية وعلمية وعنصرية وقومية، في حين يظهر الاستغراب اليوم في إيديولوجية مناهج علمية مخالفة مثل مناهج اللغة وتحليل التجربة المعاشة والتحرر الوطني.
3 – الاستشراق الآن تغير شكله وورثته العلوم الإنسانية خاصة الانثروبولوجيا الحضارية وعلم اجتماع الثقافة، في حين ان الاستغراب ما زال بادئاً ولم يطور أي شكل له بعد.
4 – لم يكن الاستشراق القديم محايداً، بل غلبت عليه مناهج تعبر عن بنية الوعي الأوربي التي تكونت عبر حضارته الحديثة مثل المناهج التاريخية والتحليلية والاسقاطية والأثر والتأثر، في حين ان وعي الباحث الآن في علم الاستغراب اقرب الى الشعور المحايد نظراً لأنه لا يبغي السيطرة أو الهيمنة، بل يبغي فقط التحرر من أُسار الآخر حتى يوضع الأنا والآخر على نفس المستوى من الندية والتكافؤ.
هكذا يسعى حسن حنفي الى تبيئة مشروع الاستغراب كعلم هادف الى دراسة الآخر لمعرفة ورفع وعي الأنا به؛ بغية إعادة بناء تراتبية طرفي الأنا والآخر من المنحى العمودي الى المنحى الأفقي، أي من علاقة الأعلى والأدنى الى حيز التساوي.
لعل بالإمكان إيراد جملة من الأسباب التي يمكن أن تكون دواعي البعض في رفض الاستغراب كحالة تقابلية للإستشراق، والتي تتمثل بالآتي:
1 – ان الشرق يعيش حالة من الضعف مقارنة بالغرب الذي يتفوق عليه بالكثير من الميادين والمجالات، ومن ثم يصعب على الشرقيين توفير الوسائل اللازمة التي تسهم في دراسة الغرب، ففي الوقت الذي مرت فيه على الغرب قرون عديدة من دراسات حول الشرق، إذ أقصى ما يوجد مجموعة صغيرة من مراكز الدراسات التي تصدر دوريات أو كتب عن الغرب، دون وجود أقسام علمية متخصصة تتولى مسؤولية تخريج "مستغربين" أكفاء.
2 – لقد عانى الشرقيون الكثير من سياسات التدخل الاستعماري والاضطهاد الممنهج المُمارس من الغرب، وهذا يدل على وجود حالة من الشعور بـــــ "الاضطهاد الجماعي Collective Paranoia"، إن جاز التعبير ولاق، الأمر الذي من الممكن ان يقود الى عدم حيادية القراءة الشرقية لما موجود في الغرب، إي سيقع المستغربون في عين الأخطاء والإشكاليات التي وقع فيها المستشرقون.
3 – ان ظهور الاستغراب سيزيد من تعقيد العلاقة بين الشرق والغرب، فإذا كان الوجود التفردي للإستشراق جعل الشرقيين يردون بأن المستشرقين لم يتفهموا حقيقة ما موجود في الشرق، وإنهم بحثوا عن قضايا جانبية وجزئية في المجتمعات الشرقية وعمدوا الى تعميمها، والنظر إليها على أنها الكاشف الحقيقي والواقعي لما موجود، فإن الاستغراب سيعيد نفس الكرة ولكن بطريقة عكسية، إذ سيرد الغربيون على ما يطرحه "المستغربون" بأنه لا يمثل بشكل حقيقي ما موجود في المجتمعات الغربية، وان ما تم طرحه لا يعدو كونه مجرد تشخيصات جزئية تم تعميمها تحت ضواغط إيديولوجية كردة فعل على الاستشراق.
بيد ان هذه الدواعي يجب ان لا تدفعنا صوب التماهي كلياً مع الموقف السلبي من الاستغراب، فالمشروع ما زال في بداياته ولم يخرج للآن عن إطار الدعاوى الفردية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، ان الأمر يتطلب وعياً مؤسساتياً وجهوداً متضافرة في سبيل إنهاضه وإنجاحه، صحيح ان الكفة لن تكون متساوية بين الاستشراق والاستغراب، غير ان الحاجة ستبقى ملحة وبمزيد من الضغط على الشرقيين في سبيل تحصيل المعرفة الناجعة حول الغرب، معرفة تقترب، جهد الإمكان وقدر المستطاع، الى ان تفهم الغرب قريباً مما هو عليه، وإلا فإن الفهم الحقيقي والواقعي، بعد التحليل الخطابي للإستشراق والاستغراب على حدٍ سواء، سيكون من الأمور الصعبة، إن لم تكن مستحيلة، عموماً ان غاية ما في الأمر هو ان الاستغراب على الرغم مما يسجل عليه من ملاحظات في تسبب عدم تحقيق النتائج المتوقعة منه، فإن ذلك يجب ان لا يؤدي الى إيصاد الباب بوجه المشروع الذي قد يسهم في فعالية المعرفة الشرقية بالغرب.
***
د. محمد هاشم البطاط