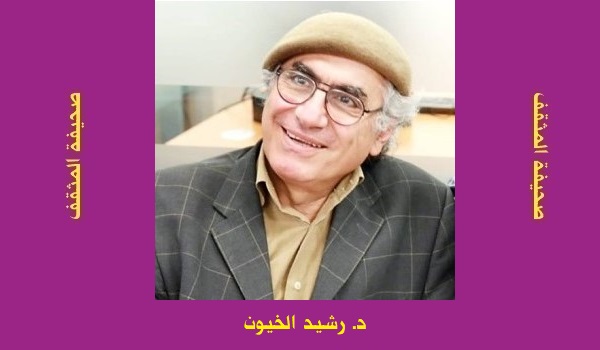قضايا
عصمت نصّار: من غيبة آليات المعقول إلى الارتياب في قداسة المنقول

محنة غرابيل الفلاسفة (2)
يبدو أنّه قد بات لزامًا عليَّ التأكيد على أن ما أوردناه وما سوف نقوم بتحليله بعد قليل من خطابات مرسلة، وانتقادات مجترئة، وادعاءات غير مُبررة، كل ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور تتعلق بالطابع العام للبنية الفلسفية للموضوع الذي نحن بصدده، الذي ننشد تحليله للوقوف على محنة الغرابيل؛ طبيعتها وأسبابها التي تتمثل في:
أولها: أن هذا العصر (الفترة الفاصلة بين العصر الهيلينستي والعصر الحديث في الغرب) قد اتّسمت معظم خطاباته بالأضاليل والأكاذيب التي انتجتها المصاولات والمعارك الدائرة بين القوة المهيمنة على الثقافة الرومانية آنذاك (اللاهوتيون، الفلاسفة، السّاسة، الوثنيون، السّحرة) ومن ثمّ قد اقتضت الضرورة البحثية الوقوف على طبيعة تلك المحاورات والمناظرات بوصفها المضمون الحاوي لكل أشكال الأكاذيب المطروحة التي عجزت الغرابيل عن الفصل بينها أو نقدها كما أشرنا.
ثانيها: أن تلك المساجلات وما حوته من تلفيقات وهرطقات وتأويلات ودفوع وتبريرات قد كشفت عن عشرات المسائل والقضايا التي تحولت منذ أخريات العصر الوسيط إلى القاعدة التي انطلقت منها الفلسفة المسيحية ثم كل القضايا التي شغلت الفكر الغربي بدايةً من عصر النهضة حتى الآن وعلى رأسها :
- قضية تقديم النقل على العقل أم العكس (أؤمن كي أعقل أم أعقل كي أؤمن).
- قضية العلاقة بين الدين والعلم (توفيق، تلفيق، إقصاء أحد الطرفين أي فصل بينهما، تجاور دون تداخل).
- قضية الالحاد ودرجاته تجديد وتبديد، اجتراء وتجديف، مروق وزندقة وهرطقة، تصويب وتحقيق، تزييف واستبعاد، ارتياب لا ينقطع واللاأدرية.
- قضية ماهية الدين ومعنى المقدس وعلاقة العقيدة وما تحويه من تعاليم ومعارف بالأساطير والآداب الشعبية التراثية.
- قضية اخضاع الخطاب الديني للعلوم الحديثة (اللغة، التاريخ، الأنثروبولوجيا السياسة، الاقتصاد)؛ وذلك بعد رفع صفة القداسة عنه.
- وأخيرًا قضية الدين السائد ووحدة الأديان وما بعد الدين والدين النسوي.
أمّا ثالثها؛ فيتمثل في حرص كاتب هذه السطور على الالتزام بالحيدة في السرد والوصف والتحليل تجاه الآراء الكامنة في تلك الثقافة وتفضيل أرجاء النقد إلى التعقيبات.
وهذا هو دأبي منذ أكثر من ربع قرن فقد انتهجته في أول دراساتي في فلسفة اللاهوت (دعوة العقل لقراءة أنجيل متى الذي صدر عام 1987 وكذا في كتابي فلسفة اللاهوت المسيحي الذي صدر عام 2008) ذلك فضلًا عن عشرات الرسائل والأبحاث التي شاركت في بنائها وتحليل بنيتها.
ولم أجنح عن هذا النهج فيما أكتب، فلم تكن غايتي ولن تكون سوى الوقوف على الحقائق التي شكلت بنية الفكر الفلسفي وانعكاسات ذلك على الثقافة السائدة أملًا في تقويم ما فسد وتوضيح ما غمض وإتاحة الفرصة أمام العقل للتحاور العلمي بمنأى عن كل أشكال التعصب ولاسيما في الأمور والقضايا ذات الصلة بالثوابت العقدية ومشخّصات الهُويّة محاولًا إنقاذ الرأي العام من الأحاديث والكتابات المتهافتة وغير المسؤولة التي تثير الرأي العام التابع وتشوش على مدركاته ومعارفه وتثير الفتن في بنية مجتمعنا الصلبة التي لم تفلح المكائد ولا الأكاذيب في تفكيكها.
**
وإذا ما عدنا إلى ادعاءات المتفلسفين تجاه الدين الوافد الذين رفضوا بنيته الغيبية ومحاكاته للتصورات الأسطورية سوف نجدها تمضي كسابقتها على هذا النحو: -
- إنّ أصحاب الدين الجديد قد افتقرت خطاباتهم اللاهوتية إلى النسقيّة التي يمكن للعقل قبولها؛ فالأناجيل الأربعة المعتمدة - من قبل اللاهوتيين المسيحيين- قد اختيرت من بين مئات الصحائف اختيارًا عشوائيًا مثل : (أنجيل توما، أنجيل الحق، أنجيل مريم المجدليّة، أنجيل برنابا) ويبدو ذلك في اضطراب نهجها السردي والتاريخي كما لا تخلو من الاضطراب العقدي والواقعات التي يجحدها المنطق من جهة وتدحض مضامينها الحقائق التاريخية والأدلة العلمية من جهة أخرى. وعلة ذلك كله؛ ترجع إلى غيبة النص الأصلي ووحدة المصدر فقد كتب بعضها أحد التلاميذ ونسب إحداها لشخص لم يرْ يسوع قط، وثالث كان يجهل أصول الكتابة اللاهوتية والتاريخية معًا؛ وقد عجز اللاهوتيون الأوائل تبرير ذلك.
- إنّ أصحاب الدين الجديد لم يفلحوا في الرد على منتقديهم بمنطق مقارعة الحجة بالحجة وقياس الأدلة بالبراهين فما جاءوا به يهدم الكثير ممّا ثبت في التوراة في حين أنهم زعموا في شذراتهم المقدسة بأن معتقدهم مكمل وليس هادم لما قبله (لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل) (أنجيل متى 5:17).
كما ادّعى كهنتهم أن تعاليمهم المقدسة ضد السحر والشعوذة والخداع في حين نجد آباء الكنيسة يتفننون في صناعة الأحجبة ويحتالون على العوام بأكذوبة صكوك الغفران تلك التي ابتدعها البابا لاون العاشر(1475:152) وذلك في عام 1517 بحجة حاجته للمال لبناء كنيسة القديس بطرس في روما.
كما زعم قساوستهم أن شذراتهم المقدسة تأمر المؤمنين بيسوع بتقديم الحب على الكراهية والتسامح عوضًا عن العنف في حين أن كنيستهم قد بدلت تلك العقيدة غير عابئة بأنها تهدم النسق الياسوعي كله فعلمت بنقيض ذلك (لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض، ما جئت لألقي سلامًا بل سيفًا) (أنجيل متى 10:34) وأضافوا أيضًا بدعة (الحربة المقدسة) التي خولت لقياصرة الرومان وملوك أوربا الحروب الصليبية على الشرق وأطلقوا عليها الحرب المقدّسة وأصل الحكاية ترجع إلى أكذوبة اخترعها أحد قادة الجيوش الصليبية فوسوس بها لرجل فقير يدعى بطرس بارثولوميو أنه قد رأى في المنام أن الحربة التي طعن بها المسيح عقب صلبه موجودة في كنيسة بطرس بمدينة إنطاكية؛ وإذا عثر عليها الصليبيون كان النصر حليفهم وأمر هذا الرجل الساذج بترويج هذه الأكذوبة وإشاعتها بين الجنود الذين أوشكوا على الفرار أمام جيوش السلاجقة. ولمّا سمع الجند هذه الشائعة انطلقوا مدفوعين ببركة الروح القدس فاستولوا على إنطاكية وهزموا الأعداء وذلك في نحو عام(1098م)
وعلى الرغم من ارتياب عصبة من الرهبان في هذه البدعة إلا أنهم آثروا الصمت خوفًا من بطش قادة الرومان أصحاب هذه الأكذوبة الأصليين الذين لم تقف أكاذيبهم عند هذا الحد بل كلفوا أحد السوريين أن يشيع أكذوبة أخرى تروي رؤيته أنه شاهد في كنيسة مريم المباركة القديس مرقس حيث أخبره بأن السيد المسيح وتلاميذه جاؤوا إلى إنطاكية لنصرة الصليبيين في حربهم وتتابعت الأكاذيب والحكايات والخرافات وجميعها يؤكد أن ساسة الرومان هم الذين يكتبون الأخبار المقدسة ليصبح المسيح إلهًا للغزو والعنف وقتل الآمنين في أوطانهم (والمسيح من ذلك كله بريء).
أمّا الحروب الصليبية المقدسة فتعود أكذوبتها إلى خطبة البابا أوربان الثاني (1035:1099م) وذلك في محفل يضم مئات القساوسة والكهنة والفرسان ورجال السياسة بصدد إعلان حرب مقدسة عام (1095) محاولًا بهذه الاكذوبة إنقاذ الإمبراطورية الرومانية والبلدان الأوربية من الاضمحلال الاقتصادي الذي كان يعاني منه المجتمع الغربي أنذاك) حيث دعا إلى محاربة الأتراك المسلمين (السلاجقة) وقتلهم وذلك ردًا على ما ارتكبوه في حق الإمبراطورية الرومانية التي باركها الرب باعتناق أهلها لدين المخلص يسوع المسيح. ونعتوا المسلمين والمسيحيين الأرثوذوكس الشرقيين المجندين ضمن الجيش الإسلامي بأنهم برابرة منتسبون إلى عرق ملعون كافر بدين المسيح، وعليه دعى البابا إلى تقتيلهم ثم الاستيلاء على أراضيهم في آسيا الصغرى وتطهير القدس من ساكنيها أعداء الرب قائلًا (فمن العار أن يكون قبر المسيح في أيدي العرب المسلمين) وفي عام 1096م انطلق 60 ألف مقاتل يقاتلون باسم الحرب المقدسة.
وأضاف الفلاسفة على ادعاءاتهم السابقة أن هذه الأقوال المقدسة التي روج لها قادة الدين الوافد تناقض الشذرة القائلة على لسان السيد المسيح (سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوك. أمّا أنا فأقول لكم: أحبوا أعدائكم وأحسنوا إلى مبغضيكم)، ومن ثم يرى المتفلسفة في هذا الادعاء أن أثر ساسة الرومان على كهنة الكاثوليك الغربيين كان من أكبر العوامل التي أدت إلى غيبة النسقية في تعاليمهم المقدسة لذا نجد معظم فلاسفة الغرب منذ القرن السادس عشر الميلادي ينادون بضرورة فصل الدين عن السياسة، ثم العولمة الكاملة في القرن الثامن عشر.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الفكرة العدوانية ترجع إلى ساسة الغرب وسيما المنتمين إلى فرقة البروتستانت المتأثرة في تعاليمها بيهود الخزر.
فها هو القائد الفرنسي هنري غورو (1867:1946 م) يقول أمام قبر صلاح الدين الأيوبي: (ها نحن عدنا يا صلاح الدين) عند دخوله دمشق عام 1920 م. ويحدثنا المؤلف يوسف العاصي الطويل عن علة تحيز الإنجليز والأمريكان لاحتلال إسرائيل للقدس بحجة أن اليهود المتعصبين أحفاد (قبائل الخزر الهمجية في الغرب هم الذين يمثلون الحزب اليميني الإسرائيلي اليوم وهم من أكثر القبائل الهمجية سفكاً للدماء وتنكيلًا للأغيار؛ وذلك في كتابه "الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة في أسباب التحيز الأمريكي" الذي نشر عام (1987 م) في دولة الامارات العربية المتحدة.
- أنّ أصحاب الدين الجديد لم يفلحوا في تفسير أو تبرير عقيدة العودة أو المجيء الثاني التي روجوا لها في أوربا بين العوام، وراحت الكنائس تؤكدها ذلك في دروسها وكتاباتها اللاهوتية؛ الأمر الذي دعا الفلاسفة إلى تكذيبها عقليًا واعتقاديًا مبررين جحدهم لهذه الأفكار الميتافيزيقية بعدة طعون وجهها العقل وجحدها المنطق - من وجهة نظرهم - نذكر منها: -
- إن فكرة المخلص ليست جديدة على مائدة التصورات الأسطورية ولا المعتقدات الميتافيزيقية؛ فقد ذكرت في كتابات الغنوصيين وأساطير المصريين وفي الديانة الهندوسية والفلسفة البوذية والنزعة الجينية وأخيرًا في اليهودية الذين أطلقوا أسم المسيا على المخلص بمفهوم مغاير لتصور الكنيسة.
- إنّ علة وجود المخلص في الفكر الميتافيزيقي الشرقي القديم ترجع إلى حاجة المجتمعات - المروجة لهذا التصور- لإصلاح النظم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والعقدية؛ الأمر الذي لم تفعله المسيحية ويبدو ذلك في موقفها السلبي ممّا كان يعاني منه المجتمع الغربي بعامة والإمبراطورية الرومانية بخاصة (الظلم، القهر، الاستبداد، الثراء الفاحش، الفقر المفجع، الفساد الأخلاقي، الجهل المعرفي، التفكك الاجتماعي)؛ وذلك عندما صرحت الكنيسة بأن كل هذه الأوضاع لا فكاك منها ولا قدرة لأحد على تغييرها لأنها قدر واختبار من الرب ومن ثمّ يجب على المنتمين للدين الجديد الصبر والفناء في العبادة والدعاء حتى يتحقق المجيء الثاني ليسوع ليقيم العدل ويرفع الظلم ويقتص من الشيطان واتباعه.
ويرى الهراطقة من الفلاسفة -أنذاك- أن قضية الفداء والخلاص التي صورتها الكنيسة غارقة في الدراما المأساوية التي لا تبرير لها سوى عجز الإله عن تحقيق ما يريد عوضًا عن التضحية بإبنه أو ترك المؤمنين به يعانون من فرط القسوة والظلم أو عودته ثانيةً لفعل ما تقاعس عن فعله بداية.
كما أن تصور الخلاص الكنسي في الدين الجديد لم يسهم في إصلاح المجتمع الغربي على الصعيد الأخلاقي فلم يقدم الخطاب الكنسي - في ظل هذا التصور- أي علاج عملي ناجح؛ فالعظات والنصائح النظرية والوعود بالسعادة الأبدية لم تغير من سوء الواقع شيئًا بل زادت على ما فيه المجتمع من فساد أكذوبة (عقيدة الاعتراف) تلك التي جاءت في مجمع لاتران الرابع في روما عام (1215 م) عندما أقر اللاهوتيون الكاثوليك أن عقيدة الاعتراف سر مقدّس؛ ومن ثم يجب الاعتراف بالخطايا أمام الكاهن فرضًا على جميع المؤمنين مرة واحدة في السنة على الأقل حتى تقبل توبتهم وتمحى خطاياهم من سجل الآثام.
بذلك كله برر المتفلسفة في العصر الوسيط هرطقتهم أو رفضهم التام للخطاب الكنسي الكاثوليكي.
ولم يفطن أصحاب هذا الخطاب إلى الظروف والملابسات المحيطة بالخطاب العقدي اللاهوتي واعتبروا أن كل ما جاء به القساوسة أصحاب الدين الجديد يجب ادراجه ضمن الأكاذيب التي أرشدت إليها غرابيلهم النقديّة.
وللحديث بقية عن ادعاءات الوثنيين وردود الفلاسفة المؤمنين.
***
بقلم: د. عصمت نصّار