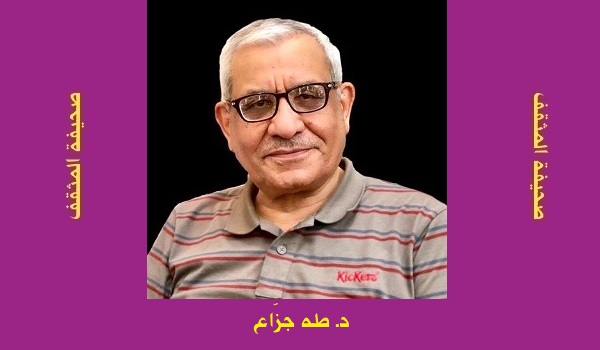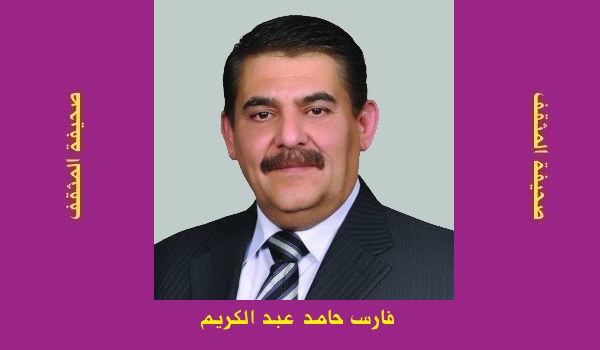قضايا
سجاد مصطفى: الصمت الذي يفكر
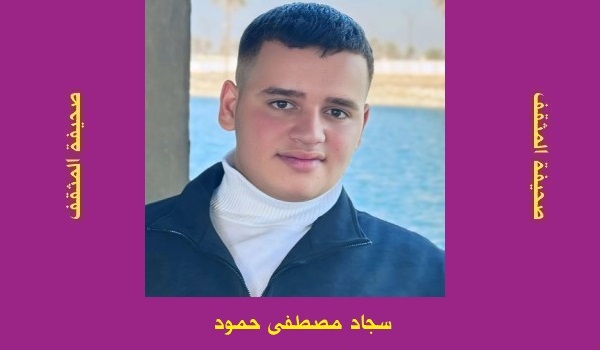
المقدمه: العقل… ذلك الصرح المعقد، ذلك الكائن المزدوج الذي يحمل في طياته ضوءًا يكشف الظلام، وظلامًا يخفي النور. إنه القوة والقيود، الحرية والحدود، الوضوح والغموض؛ يتآمر على ذاته كما يتآمر على العالم، يشرعن خطأه كما يبرر الحقيقة، ويصوغ الأوهام كما يصنع المعارف. العقل ليس مجرد أداة تفكير، بل هو ساحة صراع دائم بين ما يطمح الإنسان أن يكون وما يفرضه عليه وعيه ومجتمعه وتاريخه. لقد نبّه علي الوردي إلى هذه الحقيقة حين قال: *(العقل البشري قد يكون أبرع من الشيطان في تبرير الأهواء، فهو يخلق منطقًا لخطئه ليشعر بالطمأنينة)*¹، وهو قول يكشف حجم المؤامرة الداخلية التي يمارسها الإنسان ضد ذاته، حين يتحول العقل من مرشد للحرية إلى حارس للوهم. وشوبنهاور أكد أن العقل خادم للإرادة، لا يسعى للحقيقة بقدر ما يسعى لإشباع الرغبات²، بينما رأى هايدغر أن العقل الغربي وقع في (نسيان الكينونة)، فأصبح أسيرًا لمقولات جاهزة، مغلقًا على أفق يظنه الحقيقة³. وفي العراق، يشير الدكتور طه باقر إلى أن العقل غالبًا ما يُوظف للحفاظ على الهياكل الاجتماعية والسياسية القائمة⁴، ويضيف نجيب محفوظ العراقي: (العقل كثيرًا ما يبحث عن مبرر للاستسلام بدل أن يبحث عن الحقيقة). أما الفلاسفة الشرقيون، فقد حذّر بوذا: (العقل أحيانًا أعظم العوائق أمام التنوير، لأنه يخلق الأنا ويخفي الرؤية)، في حين أكد كونفوشيوس أن الانضباط العقلي بدون حكمة يصبح وسيلة للسيطرة لا أداة للتحرر⁵. العقل، إذن، ليس مجرد مرآة للواقع، بل صانع للحدود، مبدع للأوهام، ومنتج للحرية الزائفة؛ يقسم الزمن إلى لحظات ثابتة كما يرى برغسون، وينتقي من الذاكرة ما يخدم مصالحه ويغفل ما يهدد شرعيته. ويصبح الوهم مزدوجًا حين يقنع نفسه بالحرية، بينما هو محكوم بالثقافة واللغة والتاريخ والذاكرة، كما قال فوكو: *(الإنسان يظن نفسه حرًا، بينما هو محكوم بأنساق معرفية تسبقه وتتحكم فيه)*⁶، وفي المقابل، يذكر فيتغنشتاين: *(حدود لغتي هي حدود عالمي)*⁷، ما يعني أن العقل داخل اللغة دائمًا متواطئ مع تحيزاتها، حتى وهو يظن أنه يفكر بحرية مطلقة. العقل يشتغل أيضًا كأداة سلطة، يبرّر الخطأ، ويقدّس العادات، ويحوّل التقاليد إلى مقدسات. كما يرى غرامشي في المثقفين العضويين، الذين يجعلون العقل أداة لاستدامة النظام القائم، بينما يصبح النقد الذاتي شرطًا لفهم العالم وفهم العقل ذاته. أفلاطون لم يتركنا نغفل هذا الجانب حين قال: (العقل الذي لا يراجع نفسه يعيش في سجن من وهمه). وهكذا، يصبح العقل قضية أخلاقية وفلسفية، قبل أن يكون مجرد أداة للمعرفة؛ يستنهض فينا التأمل، ويحفز الإنشاد، ويشدّنا إلى مواجهة تناقضاتنا الداخلية، فيظلّ مسرحًا للمعركة بين الوهم والحقيقة، بين الحرية والزيف، بين ما نريد أن نكون وما نصنعه بأيدينا ونظن أنه قدرنا. لكن، لعلّ أخطر ما في العقل ليس أوهامه الظاهرة، بل تلك المكائد الخفية التي ينسجها في صمتٍ ضد ذاته. إنّه الماكر الذي يضع الأقفال، ثم يتباهى بمفاتيحه، يزرع الحواجز ثم يدّعي أنّه يهدمها. هنا يتجلى العقل كـ خائن وفيّ: يخون الحقيقة ليبقى وفيًّا لرغباته، ويزوّر المعنى ليحافظ على طمأنينته. لقد أشار نيتشه إلى أن العقل كثيرًا ما يخترع (أصنامًا مفهومية) ليخفي ضعفه، وقال: (الحقيقة أوهام نسينا أنّها كذلك)، بينما صرخ الجاحظ منذ قرون: (العقل قد يُستعمل سلاحًا للهدم كما يُستعمل سلاحًا للبناء)، وأكد الفيلسوف العراقي عبد الجبار الرفاعي أن العقل الديني – بل والعقل الجمعي – قد يتحول إلى (سجن للأفكار بدل أن يكون فضاءً لها)، وهو وصف يضع اليد على موضع الداء: العقل لا يتآمر علينا من الخارج، بل يتآمر من الداخل، من عمق وعينا. أما في الفكر الشرقي، فإن لاوتسه ينبّه إلى أنّ العقل الصاخب يحجب حكمة الصمت، وبوذا يذكّر بأن العقل المأسور بالأنانية يصير عدوًّا للسلام، وكأنّ الشرق أراد أن يقول إن أخطر ما في العقل هو قدرته على أن يجعل من الأنا مركزًا للعالم، ثم يفرض هذا المركز على الآخرين وكأنه الحقيقة المطلقة. من هنا، يصبح السؤال أشدّ مرارة: ألسنا نحن أسرى لعقولنا أكثر مما نحن أسرى للعالم؟ ألسنا محكومين بما نُسمّيه (الحرية) بينما هي قيود منسوجة بخيوط لغتنا، بذاكرتنا الانتقائية، بتاريخنا المعلَّب، وبخطاب سلطتنا؟ إنّ نقد العقل ليس ترفًا فلسفيًا، بل هو فعل تحرر وجودي؛ لأن من لا يراجع عقله، يظلّ عبدًا له وهو يحسب نفسه سيّدًا عليه.
العقل ليس صديقك، بل خصمك المستتر. إنّه ليس النور الذي يقودك إلى الحقيقة، بل القناع الذي يخفيها عنك. العقل أخطر من الجهل، لأن الجهل يفضح نفسه، أما العقل فيتآمر على ذاته ليمنحك وهم المعرفة. إنّه المحقق والجلاد في آنٍ واحد؛ يبني لك السجون ثم يقنعك أنك تسكن القصور، يلبسك ثوب الحرية وهو يحكم وثاقك بقيود اللغة والتاريخ والذاكرة. قال نيتشه: (الحقيقة أوهام نسينا أنها أوهام)، وكأنه أراد أن يفضح المسرحية الكبرى التي يديرها العقل. وهايدغر لم يتردد في اتهام العقل الغربي كله بأنه غرق في (نسيان الكينونة). أما علي الوردي فكان أشد صراحة حين وصف العقل البشري بأنه (أبرع من الشيطان في تبرير الأهواء)، والعراقي عبد الجبار الرفاعي حذّر من أن العقل الديني قد يتحول إلى (سجن يُغلَق من الداخل)، فيغدو الإنسان سجين نفسه قبل أن يكون سجين سلطة أو مجتمع. العقل هنا ليس بوابة إلى الحرية، بل ورشة كبرى لإنتاج الزيف. إنه يتواطأ مع اللغة فيحصر العالم في حدود الكلمات، ويتواطأ مع الذاكرة فينتقي ما يرسّخ سلطته، ويتواطأ مع الزمن فيقطّعه إلى لحظات ميتة. كما قال برغسون: (العقل يقيس الزمن، لكنه لا يعيش تدفقه). وبهذا، يصبح العقل شاهد زور على نفسه، يكذب وهو مقتنع أنه يقول الحق. أفلاطون حذّر قبل ألفي عام: (العقل الذي لا يراجع نفسه يعيش في سجن من وهمه). ونحن اليوم، أحوج من أي وقت مضى، إلى أن نخلع هذا السجن من داخلنا، أن نحاكم العقل أمام محكمته هو، أن نجرّده من قدسيته، ونكشف أن الخطر الأعظم ليس في الجهل، بل في عقل يتقن فنّ تزوير الجهل إلى يقين.
أولاً: العقل كأداة تبرير
إنّ العقل، في سياقاته التاريخية والمعرفية، لم يكن دائمًا أداةً للبحث عن الحقيقة كما يدّعي الفلاسفة، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى وسيلةٍ لتبرير الواقع القائم وإضفاء الشرعية على الأوضاع المهيمنة. وكأنّ وظيفته لم تُخلق ليحرّر الإنسان من القيود، بل ليُقنعه بأنّ تلك القيود قدر محتوم. فالعقل الذي صاغ أنظمة الأخلاق والدين والسياسة، كثيرًا ما كان عقلًا (تبريريًا) أكثر منه (تحرريًا). يقول الفيلسوف الألماني هيغل: (كل ما هو واقعي عقلاني، وكل ما هو عقلاني واقعي)؛ جملة ظاهرها الحكمة، وباطنها تكريس لواقعٍ مشوّهٍ لا يجرؤ العقل على زعزعته. وكأنّ العقل هنا يُستَعمل كأداة دفاع عن البنية القائمة، لا كسلاح لكسرها. وقد التفت الفيلسوف العراقي مدني صالح إلى هذه الإشكالية حين قال: (إنّ العقل عندنا يُستعمل لذرّ الرماد في العيون أكثر مما يُستعمل لإضاءة البصائر)، في إشارة إلى انحراف الوظيفة المعرفية للعقل نحو التبرير بدل الكشف. أما في الفلسفة الشرقية، فنجد عند كونفوشيوس إشارات مماثلة حين قال: (العقل الخانع يصنع الاستبداد)، وهو ما يعكس البعد الكوني لهذه الإشكالية: فالعقل إذا لم يُحرّره النقد، أصبح عبدًا للعادة والتقاليد، وأداة لتقديس الزيف. إذن، يمكن القول إنّ العقل في صورته التبريرية هو أخطر من الجهل نفسه، لأنّ الجهل يُترك عاريًا واضحًا، بينما العقل المبرّر يكسو الزيفَ بلباس الشرعية، ويجعل الاستسلام يبدو حكمةً، والضعف يبدو فضيلةً، والقهر يبدو قَدَرًا لا مفر منه.
ثانيًا: العقل كأداة تحرير
إذا كان العقل في صوره التاريخية قد ارتدى ثوب التبرير، فإنّه في صورته الأصيلة يظلّ أداةً للتحرر والانعتاق. إنّ قدرته الكبرى ليست في جعل الواقع مقبولًا، بل في جعله موضع سؤال، وفي زعزعة يقينياته حتى تُفتح أبواب البدائل. يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أشك، إذن أنا موجود؛ فهنا الشك العقلي ليس وسيلة للهدم فقط، بل مدخل للتحرير من سلطة الموروثات واليقينيات المزيفة. والعقل النقدي – بخلاف العقل التبريري – لا يكتفي بتفسير ما هو كائن، بل يسعى إلى تجاوز الكائن نحو الممكن.
وفي تراثنا العراقي، يذكّرنا علي الوردي بأنّ: العقل الحرّ لا يتكيّف مع القوالب الجاهزة، بل يحطّمها، إذ رأى أنّ وظيفة العقل الحقيقي ليست في صناعة أقنعة للزيف، بل في فضحه وتعريته. وهذا الموقف يضع العقل في مواجهة مباشرة مع العادة والتقليد والسلطة.
أما في الفلسفة الشرقية، فنجد بوذا يقول: لا تصدّقوا قولًا لمجرد أنّه مرويّ عن الحكماء، ولا لمجرد أنّه مكتوب في الكتب، بل جرّبوه بعقولكم، فإن وجدتم فيه صدقًا فخذوا به، وإن لم تجدوا فاتركوه؛ وهو إعلان صريح بأنّ العقل يجب أن يتحرر من سلطة النصوص والأشخاص معًا.
هنا يظهر العقل بوصفه قوّةً مزدوجة: فهو من جهة يفضح زيف المسلمات، ومن جهة أخرى يفتح المجال لوعيٍ جديد يحرّر الإنسان من سلطات التقليد، ويعيد صياغة العلاقة بين الفكر والوجود. إنّه عقل مقاوم لا عقل خانع، عقل يشتبك لا عقل يبرّر.
ولعل أخطر ما يميز العقل التحريري هو أنّه لا يقدّس شيئًا خارج النقد، حتى العقل نفسه يضعه موضع التساؤل، لأنه يدرك أنّ الحرية تبدأ من الداخل قبل أن تُفرض من الخارج.
ثالثًا: العقل كأداة تمويه وخداع
ليس كلّ ما ينتجه العقل سبيلًا إلى الحقيقة، فقد يتحوّل إلى أدهى أدوات التضليل وصناعة الوهم. فالعقل حين ينقاد للأهواء والمصالح يصبح ساحرًا ماكرًا، يلبس الزيف لبوس الحقيقة، ويحوّل الأكاذيب إلى براهينٍ منمّقة. قال نيتشه: العقل ليس باحثًا عن الحقيقة، بل خادمٌ للرغبة في البقاء والسيطرة؛ فكثيرًا ما يُستَعمل العقل لا ليكشف الواقع، بل ليطمس معالمه، ويقدّم سرديات مريحة تُرضي الغرور الإنساني. وفي التجربة العراقية يذكّرنا مدني صالح بقوله: العقل الذي لا ينقد نفسه، لا يعدو أن يكون خدعة يتقنها صاحبها، أي أنّ التمويه يبدأ من الداخل قبل أن يُصدَّر إلى الخارج. وكم من عقلٍ تبريري انقلب إلى عقل مخادع، يوظّف المنطق لا لإظهار الحقائق بل لتزييفها.
أما في الشرق، فقد جاء في نصوص الطاوية أنّ: العقل حين يغرق في حساباته الدقيقة يفقد بصيرته الكاملة فيغدو الحساب المفرط قناعًا يُخفي الجوهر بدل أن يكشفه. وهكذا يُستَعمل العقل كدخان كثيف يحجب عن الإنسان مسالك الحقيقة البسيطة.
إنّ خطورة هذا الوجه من العقل تكمن في أنّه يُقنع صاحبه قبل أن يُقنع الآخرين، فيصبح الإنسان أسير حججه هو، وعبدًا لمصنوعاته الذهنية، معتقدًا أنّه بلغ قمة اليقين بينما هو غارق في سراب متقن الصياغة.
العقل المخادع إذن ليس مجرّد خصمٍ خارجي، بل خصمٌ داخلي يتسلّل في ثيابنا الفكرية، يضع الأقنعة على وجوهنا ونحن نظنّ أننا نكشفها.
رابعًا: العقل كأداة مقاومة وثورة
إذا كان العقل في بعض تجلّياته خادمًا للتبرير أو أداة للتمويه، فإنّه في جوهره الأصيل يستطيع أن يكون نارًا متقدة تقاوم الزيف وتثور على كلّ أشكال الاستعباد. إنّه السلاح الذي لا يُقهر حين يتسلّح به الإنسان في وجه السلطة والجهل والقدر المزيّف.
يقول الفيلسوف كانط: لتكن لديك الشجاعة لتستعمل عقلك بنفسك، فهذا هو شعار التنوير؛ فالعقل الحرّ لا يخضع لوصاية أحد، ولا يقبل أن يُساق بزمام العادة أو الخوف، بل يقاوم كلّ سلطة تُريد تحويل الإنسان إلى تابعٍ أعمى.
أما في الذاكرة العراقية، فنسمع حسين مروّة يصرّح: العقل الثائر هو الذي يزعج المستبدّ أكثر من ألف سيفٍ مسلول لأنّ الثورة الفكرية أخطر من أيّ ثورة مادية، فهي تفكّك شرعية الطغيان من جذورها، وتعيد بناء وعيٍ جديد يحرّر الجماعة من أسر الأوهام.
وفي الحكمة الشرقية يرد عن كونفوشيوس قوله: العقل المستنير لا يطيع السماء عميانًا، بل يتحاور معها، أي أنّ العقل لا يقف خانعًا أمام القدر، بل يدخل في صراعٍ جدلي مع الوجود، ليحوّل المعاناة إلى وعيٍ والاضطهاد إلى مقاومة.
إنّ العقل المقاوم ليس ترفًا فلسفيًا، بل هو ضرورة وجودية. فمن دونه يبقى الإنسان ألعوبةً في يد القوى الخارجية، ومن خلاله وحده يستطيع أن يكتب مصيره لا أن يُكتب له. إنّه عقل يهدم الأصنام، ويفضح الأوثان، ويُعيد للإنسان صوته في مواجهة الجموع. ولعلّ أخطر ما في هذا الوجه أنّه لا يكتفي بالرفض السلبي، بل يتقدّم بفعلٍ إيجابي: يُعيد تعريف العالم، ويقترح طرقًا جديدة للعيش والفهم، فيتحوّل من مقاومة إلى ثورة، ومن ثورة إلى مشروع بناءٍ جديد.
خامسًا: العقل كأداة ارتقاء وكشف
العقل ليس مرآةً مشروخة تعكس الزيف فقط، ولا سوطًا في يد السلطة لترويض الإنسان، بل هو أيضًا سلّمٌ يفتح أمامنا آفاق الارتقاء والكشف. إنّه الضوء الذي يقتحم العتمة، فيجعل من المجهول مجالًا للمعرفة، ومن الصمت لغةً جديدة، ومن المستحيل إمكانًا يلوح في الأفق. قال ابن سينا: العقل جوهرٌ شريف، متى استعمله الإنسان على وجهه صار من جنس الملائكة؛ فهو ليس أداة دنيوية وحسب، بل جسرٌ بين الأرض والسماء، بين المحدود واللامحدود. أما برغسون فقد رأى أنّ العقل إذا تخلّص من قوالبه الجامدة، استطاع أن ينفذ إلى الحدس الخالص الذي يكشف الحياة في تدفقها، لا في تقسيماتها الميتة.
وفي التراث العراقي، نُقل عن المفكر جواد علي قوله: العقل إذا بقي سجين الماضي مات، أمّا إذا تحرّر من قيوده صار ذاكرةً للمستقبل، كأنّ العقل لا يُعرِّفنا بما كُنّا فقط، بل بما يمكن أن نكونه.
أما الحكماء الشرقيون، فقد أشار لاوتسو إلى أنّ: العقل الصافي هو الذي لا يتشبّث، بل يترك الأشياء تنكشف بذاتها. هنا يظهر البعد التأملي: العقل ليس مطرقةً تكسر، بل نافذةً تُطلّ على الغيب، تسمح للإنسان أن يرى ما وراء حدود النظر.
العقل في هذا المستوى يصبح طريقًا للارتقاء؛ لا يرتفع بالإنسان في درجات المعرفة فحسب، بل يُنمِّي إنسانيته العميقة. إنّه يقودنا إلى ما فوق المصلحة والهوى، إلى منطقة الكشف التي تتخطّى الحواس واللغة معًا، حيث تنكشف الحقيقة لا بوصفها معادلة، بل بوصفها تجربة حيّة. وهكذا يتجلّى العقل كأداة مزدوجة: يُبرّر ويُضلّل، يقاوم ويكشف. وبين هذين الحدّين يتأرجح مصير الإنسان: إمّا أن يبقى حبيس تآمره على ذاته، أو أن يسمو به ليصير نورًا يتخطّى ذاته ليصل إلى جوهر الوجود.
سادسًا: العقل والذاكرة – بين التذكر والتواطؤ
العقل لا يعمل في فراغ، بل يستند إلى ذاكرةٍ انتقائية تختار ما يخدم مصالحه، وتغفل ما يهدد سلطته. وهنا يظهر الوجه الأكثر خفاءً في تآمر العقل على ذاته: حين ينسى، ينسى بعقلٍ متواطئ؛ وحين يتذكر، يختار التذكر بما يخدم الصورة التي يريدها عن ذاته والعالم. قال الفيلسوف العراقي عبد الجبار الرفاعي: الذاكرة حين تُستَغل من العقل، تصبح أداة لتزييف الواقع أكثر من كونها وعاءً للحقيقة وكأنّ العقل، بالتحكم في الذاكرة، يعيد كتابة التاريخ ليخدم مصالحه أو مصالح من يتحكم فيه.
وفي الفكر الغربي، يشير هابرماس إلى أنّ العقل الجمعي يمارس النسيان الانتقائي فيحوّل ما يهدد النظام السائد إلى فراغ، ويضخّم ما يرسّخ الشرعية. وبهذا، يتحوّل العقل من كاشف إلى كاتب، ومن مفكّر إلى صانع سرديات تُزيّف الواقع.
أما في التراث الشرقي، فقد أشار بوذا إلى أنّ العقل الممسك بالتجارب الماضية دون وعي يتحوّل إلى سجينٍ في قبضة الذكريات، فلا يرى الحاضر، ولا يخلق المستقبل، وكأن الزمن نفسه يُقيد بحرية الإنسان. هنا يلتقي التذكر بالتواطؤ: العقل يتآمر على ذاته في صمت، يجعل من النسيان اختيارًا، ومن التذكر أداة لتزييف الحقائق، ويحوّل وعي الإنسان إلى مساحة تحكمها أهواؤه لا حقائق واقعه. إن فهم العلاقة بين العقل والذاكرة ليس ترفًا فلسفيًا، بل شرطًا لفهم الإنسان نفسه، وفهم التاريخ، وفهم كيف يمكن للوعي أن يتحرّر من قيود الذات قبل قيود العالم.
سابعًا: العقل واللغة – حدود العالم
العقل يعمل ضمن اللغة، واللغة ليست محايدة. فهي ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل إطار يحدد شكل التفكير ذاته. كما قال فيتغنشتاين: حدود لغتي هي حدود عالمي"؛ أي أنّ العقل الذي يفكر ضمن اللغة محكوم بتحيزاتها، حتى وهو يظنّ أنه يفكر بحرية مطلقة.
اللغة تصنع العالم بنفسها، فهي تصيغ المفاهيم، وتضع حدودًا للخيال، وتتحكم في ما يمكن قوله وما يُمنع. وهنا يظهر الوجه الآخر لتآمر العقل على ذاته: حين يظنّ أنه يفهم، يكون في الواقع أسيرًا لقيود اللغة، يُعيد إنتاج نماذج مألوفة بدل أن يخلق رؤى جديدة.
وفي الفلسفة العراقية، يقول علي الوردي: الكلمات التي نعتقد أنّها تعبير عن الفكر، هي غالبًا قيود على العقل؛ فهي توظف العقل في خدمة التقاليد، وتجعله يبرّر ذاته بدلاً من كشف حقيقته. أما في التراث الشرقي، فقد أشار كونفوشيوس إلى أنّ العقل الذي لا يتجاوز حدود الكلام يفقد جوهر المعرفة: من يقيّد فكره بالكلمات، لا يرى ما وراءها وهكذا يُرى أنّ اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل قوة مزدوجة، تتيح الفهم وتحدّه في الوقت ذاته.
إنّ فهم العلاقة بين العقل واللغة ليس ترفًا، بل ضرورة لتمييز ما بين حرية التفكير الحقيقية والوهم الذي يزرعه العقل لنفسه، لتصبح اللغة مرآةً للعقل، لكنها أيضًا قيودٌ عليه.
ثامنًا: العقل والزمن – بين القياس والتدفق
العقل يميل إلى تنظيم الزمن بشكل خطّي، يقسّمه إلى لحظات ثابتة، ويحوّل التجربة الحية إلى معادلات قابلة للقياس والمقارنة. هنا يظهر تناقضه: فهو يسيطر على الزمن ليجعله مفهومًا، لكنه يفقد قدرة الإنسان على عيش تدفقه الفعلي.
برغسون أشار إلى أنّ: العقل يقيس الزمن، لكنه لا يعيش تدفقه؛ فالوعي الحي يتجسد في الزمن كثقافة وتجربة، لا كخطوط وأرقام. العقل إذن يتآمر على تجربتنا الزمنية، يحوّلها إلى أدوات للمراقبة والتحليل، فيغدو الإنسان أسير لحساباته بدل أن يكون مشاركًا حيًا في سير الحياة.
وفي الفلسفة العراقية، يقول الدكتور مدني صالح: العقل الذي يسيطر على لحظات الذاكرة، يفقد القدرة على فهم اللحظة الحاضرة؛ أي أنّ التجربة نفسها تُفقد حيويتها حين يحاول العقل ضبطها وتحجيمها ضمن إطار محدود. أما في الفكر الشرقي، فقد أشار لاوتسو إلى أنّ: من يركض وراء الزمن يضيّع ذاته؛ فالعقل حين يسعى لجعل كل لحظة قابلة للقياس، يضيع الفهم العميق للوجود، ويصبح الزمان أداة قيد بدل أن يكون مجالًا للوعي. هنا، يصبح نقد العقل تجاه الزمن ضرورة لا غنى عنها، لأن الحرية الحقيقية لا تبدأ إلا حين نُعيد الاعتبار للتجربة، ونستعيد العلاقة الحية مع الزمن، بعيدًا عن قيود العقل التحليلي والتجزئة الاصطناعية للحياة.
تاسعًا: مثال واقعي – العقل السياسي وشهادة الزور
أوضح مثال على تآمر العقل على ذاته نجده في الخطاب السياسي المعاصر، حيث تستخدم الأنظمة الشعارات الكبرى لتبرير أفعال تتناقض مع هذه الشعارات. فالأنظمة التي ترفع شعار "الديمقراطية" تُبرّر تدخلاتها العسكرية باسم "حماية الديمقراطية"، وهنا يصبح العقل السياسي شاهد زور على نفسه: يستخدم المنطق لإبطال المنطق، ويحوّل الأخطاء إلى حقائق مقنعة. يقول الفيلسوف العراقي عبد الجبار الرفاعي: العقل الذي يبرر الاستبداد يتحوّل إلى شريك في الجريمة، دون أن يشعر؛ فالعقل هنا لا يكتفي بتبرير الواقع، بل يشارك في إنتاجه وصيانته.
وفي الفلسفة الغربية، يرى ميشيل فوكو أنّ الإنسان يظن نفسه حرًا، بينما هو محكوم بأنساق معرفية تسبقه وتتحكم فيه، ما يجعل العقل وسيلة لإدامة الهيمنة بدل أن يكون أداة للتحرر.
أما في الفلسفة الشرقية، فقد حذّر بوذا من أن العقل المأسور بالأنا والتحيزات يتحوّل إلى عدو لنفسه وللآخرين، ويصبح سببًا في استمرار الظلم الاجتماعي والسياسي. هذا المثال الواقعي يوضّح أنّ العقل ليس مجرد أداة للفهم أو التحليل، بل هو جزء من الآليات التي تنتج الواقع، وتعيد إنتاجه، وتشرعن القيم الزائفة، ما يجعل نقده واجبًا أساسيًا لفهم المجتمع والسياسة والإنسان نفسه.
الخاتمة – العقل: بين القوة والتقييد
العقل، إذن، ليس مجرد أداة محايدة، بل جهاز مزدوج، يفتح إمكانات الكشف كما يغلقها، يبرّر كما يفضح، يقمع كما يحرّر. أخطر ما فيه ليس عجزه عن الفهم، بل قدرته على تحويل فهمه الجزئي إلى حقيقة مطلقة، على تزييف الواقع من الداخل قبل أن يواجه العالم. قال علي الوردي: العقل البشري أبرع من الشيطان في تبرير الأهواء وهايدغر أكّد أنّ العقل قد يغرق في (نسيان الكينونة)، فيصبح أداةً للحبس الذاتي بدل التحرر. وفي التراث الشرقي، حذّر بوذا من أن العقل المأسور بالأنا يتحوّل إلى العائق الأعظم أمام التنوير. إن نقد العقل ليس ترفًا فلسفيًا، بل ضرورة وجودية لفهم العالم وفهم أنفسنا. يجب أن نضعه موضع السؤال المستمر، أن نكشف عن تضليله، وأن نواجه قدراته على إنتاج الوهم. العقل الحرّ هو الذي يراجع ذاته، ويكشف تآمره الداخلي، ويعيد تعريف العلاقة بين الفكر والواقع، بين الحرية والزيف، بين ما نريد أن نكون وما نصنعه بأيدينا. وهكذا، يظل العقل ساحة الصراع الأعظم: بين التقييد والتحرر، بين التبرير والكشف، بين الوهم والحقيقة. ومن خلال هذا الصراع، فقط، يمكن للإنسان أن يتجاوز ذاته، ويصنع وعيًا حقيقيًا، يحرّر الفكر، ويعيد للوجود ألقه ومعناه
***
الكاتب سجاد مصطفى حمود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهوامش والمراجع
1. ديكارت (فرنسا)
أنا أشك، إذن أنا موجود – René Descartes، Meditations on First Philosophy
2. علي الوردي (العراق)
العقل الحرّ لا يتكيّف مع القوالب الجاهزة، بل يحطّمها – علي الوردي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
3. بوذا (الشرق)
لا تصدّقوا قولًا لمجرد أنّه مرويّ عن الحكماء، ولا لمجرد أنّه مكتوب في الكتب، بل جرّبوه بعقولكم، فإن وجدتم فيه صدقًا فخذوا به، وإن لم تجدوا فاتركوه – تعاليم بوذا، Dhammapada
4. نيتشه (ألمانيا)
العقل ليس باحثًا عن الحقيقة، بل خادمٌ للرغبة في البقاء والسيطرة – Friedrich Nietzsche، Beyond Good and Evil
5. مدني صالح (العراق)
العقل الذي لا ينقد نفسه، لا يعدو أن يكون خدعة يتقنها صاحبها – مدني صالح، مقالات فلسفية
6. الطاوية (الشرق)
العقل حين يغرق في حساباته الدقيقة يفقد بصيرته الكاملة – نصوص الطاوية، Tao Te Ching (لاوتسو)
7. كانط (ألمانيا)
لتكن لديك الشجاعة لتستعمل عقلك بنفسك، فهذا هو شعار التنوير – Immanuel Kant، What is Enlightenment?
8. حسين مروّة (العراق)
العقل الثائر هو الذي يزعج المستبدّ أكثر من ألف سيفٍ مسلول – حسين مروّة، المقاومة الفكريه
9. كونفوشيوس (الشرق)
العقل المستنير لا يطيع السماء عميانًا، بل يتحاور معها – Confucius، Analects
10. ابن سينا (الشرق)
العقل جوهرٌ شريف، متى استعمله الإنسان على وجهه صار من جنس الملائكة – Avicenna، Book of Healing
11. برغسون (فرنسا)
العقل إذا تخلّص من قوالبه الجامدة، استطاع أن ينفذ إلى الحدس الخالص الذي يكشف الحياة في تدفقها – Henri Bergson، Creative Evolution
12. جواد علي (العراق)
العقل إذا بقي سجين الماضي مات، أمّا إذا تحرّر من قيوده صار ذاكرةً للمستقبل – جواد علي، الموسوعة الثقافية
13. لاوتسو (الشرق)
العقل الصافي هو الذي لا يتشبّث، بل يترك الأشياء تنكشف بذاتها – Laozi، Tao Te Ching
14. عبد الجبار الرفاعي (العراق)
الذاكرة حين تُستَغل من العقل، تصبح أداة لتزييف الواقع أكثر من كونها وعاءً للحقيقة – عبد الجبار الرفاعي، مقالات فلسفية
العقل الذي يبرر الاستبداد يتحوّل إلى شريك في الجريمة، دون أن يشعر – عبد الجبار الرفاعي، الوعي السياسي
15. هابرماس (ألمانيا)
العقل الجمعي يمارس النسيان الانتقائي – Jürgen Habermas، The Structural Transformation of the Public Sphere
16. فيتغنشتاين (النمسا/إنجلترا)
حدود لغتي هي حدود عالمي – Ludwig Wittgenstein، Tractatus Logico-Philosophicus
17. هايدغر (ألمانيا)
الإنسان يغرق في نسيان الكينونة – Martin Heidegger، Being and Time