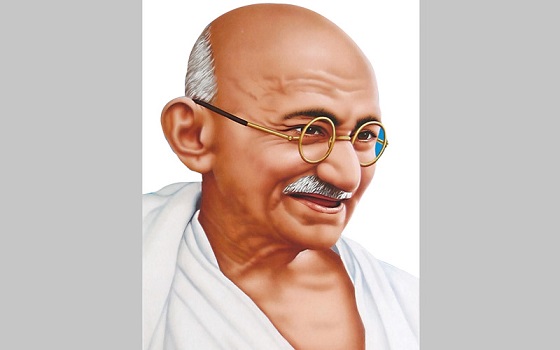قضايا
خليل إبراهيم الحمداني: الإنسان المؤجَّر

الفردانية كسجن ناعم والحرية بضاعة كاسدة للبيع
المقدمة: ليست الفردانية قصة بريئة عن تحرر الإنسان، بل مسار دموي عن ولادة وحش يتغذى على أوهام الحرية المطلقة. ما بدأ في أوروبا التنوير كتحرر من قبضة الكنيسة والإقطاع، تحوّل سريعًا إلى دين جديد: دين السوق والاستهلاك، دين الذات المنعزلة. لقد أعيد تشكيل الإنسان كسلعة، كمشروع رأسمال بشري، كحزمة مهارات قابلة للتسويق.
وفي العالم العربي، لم تنشأ الفردانية كتطور طبيعي من سياقنا الاجتماعي والثقافي، بل هبطت علينا عبر العولمة والانفتاح الاقتصادي. جاءت في صورة هواتف ذكية، منصات عمل مرن، إعلانات عن "البراند الشخصي"، لكنها اصطدمت بالبنى التقليدية: العائلة، القبيلة، الدين. وهكذا نشأ تمزق داخلي، حيث يعيش الفرد العربي بين "أنا نيوليبرالية" مستوردة و"نحن تقليدية" ما زالت تمارس ضغطها اليومي.
الجذور الفلسفية – وهم الاستقلال الفردي
بدأت القصة مع جون لوك، الذي ربط الحرية بالملكية الخاصة (Locke, 1690, p. 287). من يمتلك جسده وثمار عمله هو إنسان حر. هذه الفكرة زرعت بذور الانفصال بين الحرية والتضامن. جاء كانط بعده ليعطي للاستقلال الفردي بعدًا أخلاقيًا، معتبرًا أن الإرادة الحرة هي جوهر الكرامة الإنسانية (Kant, 1785, p. 44).
لكن في واقع أوروبا آنذاك، كما في واقعنا اليوم، كانت هذه الحرية مجرد وهم فلسفي. فبينما يحتفل الخطاب باستقلال الفرد، كانت القوى الاجتماعية والاقتصادية تحوله إلى وحدة في السوق. وفي العالم العربي، لم تكن هناك خلفية فلسفية للفردانية، لذا حين وصلت الفكرة إلينا، جاءت كـ"شعار سياسي" أو "منتج ثقافي"، بلا جذور معرفية حقيقية.
الفردانية والاقتصاد السياسي – من المصنع الأوروبي إلى السوق العربي
مع الثورة الصناعية في أوروبا، تحوّل الإنسان إلى ترس في ماكينة الإنتاج، ثم إلى مستهلك أبدي في المدن الحديثة (Taylor, 1989, p. 172). هنا بدأت الفردانية تتحول من فلسفة إلى اقتصاد.
وفي العالم العربي، حملت السبعينيات ملامح مشابهة: الطفرة النفطية، الهجرة إلى الخليج، والانفتاح الاقتصادي في مصر والمغرب وتونس. العامل المهاجر صار يُختزل في "تحويلاته المالية"، والإنسان في المدن الكبرى صار يُقاس بقوة استهلاكه: سيارة حديثة، هاتف ذكي، أو شقة في ضاحية جديدة. السوق أعاد تعريف الذات العربية، لا باعتبارها فردًا في جماعة، بل كمستهلك دائم.
النقد الكلاسيكي – تفكيك الوهم في الغرب والشرق
ماركس رأى الفردانية الليبرالية استلابًا، حيث يُلقى الإنسان كذرة معزولة في السوق (Marx, 1844, p. 112). دوركهايم حذّر من الأنوميّة – انهيار المعايير والفراغ الوجودي (Durkheim, 1897, p. 210). مدرسة فرانكفورت كشفت الوهم: الحرية الحديثة مجرد اختيار بين سلع متشابهة (Adorno & Horkheimer, 1944, p. 154).
هذا النقد يجد صداه في واقعنا العربي:
- الشباب العربي بعد "الربيع العربي" وجد نفسه ذرات معزولة في سوق عالمي لا يرحم. بطالة مرتفعة، عمل غير مستقر، وهجرة بلا أفق.
- معدلات الاكتئاب والانتحار المتزايدة في تونس ومصر والأردن تجسد بالضبط ما وصفه دوركهايم بالأنوميّة. مجتمع بلا روابط متينة ولا أفق سياسي واضح.
- الحرية في منطقتنا كثيرًا ما تتحول إلى حرية استهلاكية: شراء أحدث هاتف أو مشاهدة محتوى على نتفليكس، بينما تبقى القيود السياسية والاجتماعية كما هي.
المنعطف النيوليبرالي – الإنسان كرأسمال بشري
في السبعينيات، النيوليبرالية غيّرت قواعد اللعبة. الفرد لم يعد مستهلكًا فقط، بل صار "شركة صغيرة" تستثمر في ذاتها (Foucault, 1979, p. 226). ديفيد هارفي أشار إلى أن السوق ابتلع كل علاقة إنسانية (Harvey, 2005, p. 3).
في المنطقة العربية، تجلت النيوليبرالية بشكل فاضح عبر برامج الخصخصة وإصلاحات صندوق النقد الدولي. في مصر والمغرب والأردن، تقلّص دور الدولة في التعليم والصحة، وصار كل فرد مطالبًا بتحمل عبء نفسه. "لا تنتظر من الدولة شيئًا" تحوّلت إلى شعار غير معلن. أما في الخليج، فبرز نموذج الفردانية الاستهلاكية المطلقة: الحرية تقاس بعدد السيارات الفارهة أو الماركات التي ترتديها.
الفردانية والتكنولوجيا – العبودية الرقمية
التكنولوجيا كانت الوعد الكاذب بالتحرر، لكنها جلبت معها سجنًا ناعمًا. في أوروبا وأميركا، ظهر "اقتصاد المنصات" الذي حوّل البشر إلى "ذرات عمل رقمية". في العالم العربي، نسخة مشوهة من هذه التجربة تترسخ:
- في القاهرة وبيروت، آلاف الشباب يعملون في أوبر وكريم، لكنهم أسرى لخوارزميات تحدد دخلهم وتوقيت عملهم.
- في الخليج، صارت تطبيقات التوصيل مثل "طلبات" و"جاهز" نموذجًا لعبودية مرنة بلا حماية قانونية.
- حتى الخريجون الجامعيون يبيعون وقتهم على منصات عالمية كمستقلين، مقابل دولارات قليلة، بلا حقوق أو أمان اجتماعي.
الحرية الموعودة عبر "العمل الحر" ليست إلا عبودية جديدة، يرضى بها الفرد لأنه يظن نفسه سيد نفسه، بينما هو عبد للتطبيق والخوارزمية.
الفردانية المستوردة – التمزق العربي
العولمة لم تصدّر إلينا فقط التكنولوجيا، بل أيضًا الفردانية كسلعة ثقافية. الشاب العربي يظن أنه حر لأنه يملك آيفون جديدًا أو حسابًا نشطًا على تيك توك، لكنه في الحقيقة مستهلك في قفص.
النتيجة خليط متناقض: شابة سعودية أو أردنية تبني "براند شخصي" على السوشيال ميديا، لكنها تُحاكم اجتماعيًا على ملابسها. شاب مصري يفتخر بأنه "مستقل" عبر أوبر، لكنه في الحقيقة تحت رحمة خوارزمية تحدد سعر رحلته. إنها حرية مشوهة، حرية بلا سيادة.
الفردانية وحقوق الإنسان – الحرية كقناع
في الغرب، الفردانية المتطرفة أفرغت الحرية من معناها. وفي العالم العربي، صارت الحرية مجرد "رخصة استهلاك". الدولة تشجعك أن تكون مستهلكًا نشطًا، لكنها تكبح أي حرية سياسية. المواطن صار "زبونًا" أكثر من كونه مواطنًا.
الحرية هنا قناع: قناع للسوق، قناع للتكنولوجيا، قناع يغطي غياب الحقوق الحقيقية.
الأفق الإنسانوي – نحو إنقاذ الإنسان من الفردانية
رغم زحف الوحش الفرداني، بدأت في الأفق إرهاصات تيار مغاير، يمكن تسميته بـ الإنسانوية الجديدة. هذا التيار لا يريد العودة إلى "الجماعة التقليدية" التي تقمع الفرد، ولا أن يستسلم لفردانية السوق التي تحوله إلى سلعة، بل يبحث عن صيغة تعيد التوازن: فرد في جماعة، وجماعة لا تسحق الفرد.
1. في الفكر الغربي:
- أمارتيا سِن (Sen, 1999): قدّم تصورًا بديلاً للحرية عبر مفهوم "القدرات". الحرية ليست مجرد اختيار بين سلع، بل هي تمكين الإنسان اجتماعيًا (تعليم، صحة، بيئة آمنة) ليكون قادرًا على عيش حياة يختارها. هذا طرح إنسانوي صريح.
- مارثا نوسباوم (Martha Nussbaum): طوّرت مع سِن "مقاربة القدرات" وربطتها بالعدالة والكرامة. شددت على أن الإنسان لا يُقاس بما يملكه، بل بقدرته على تنمية إمكاناته.
- زيغمونت باومان (Zygmunt Bauman): نقد "الحداثة السائلة" والفردانية المائعة، ودعا إلى استعادة "المسؤولية الأخلاقية" كركيزة إنسانوية.
- ألان تورين (Alain Touraine): تحدّث عن "عودة الفاعل الاجتماعي"، مؤكداً أن الإنسان لا يمكن أن يُختزل في السوق، بل هو مشروع ذاتي وجماعي معًا.
2. في الفضاء العربي والإسلامي:
- محمد عابد الجابري: في قراءاته للتراث والحداثة، شدّد على أن الإنسان لا يُفهم إلا في سياق جماعته، لكنه رفض اختزال الحرية في سلطة الجماعة التقليدية.
- عبد الله العروي: ركّز على "المفهوم التاريخي للحرية"، وبيّن أن الحرية لا تتحقق إلا ضمن مشروع اجتماعي شامل، لا في عزلة فردية.
- مالك بن نبي: تحدث عن "الإنسان الفعال" الذي يُقاس بقدرته على المشاركة في نهضة مجتمعه، لا بمراكمة الاستهلاك الفردي.
- مهدي عامل وحسين مروة: طرحا نقدًا جذريًا للاغتراب الرأسمالي في السياق العربي، وأشارا إلى ضرورة استعادة الإنسان كفاعل تاريخي لا كذرة معزولة.
- وفي الحاضر، يمكن الإشارة إلى أصوات شابة في الحركات الاجتماعية (حركات حقوق المرأة، البيئة، العدالة الاجتماعية) التي تطرح خطابًا يتجاوز الفردانية الاستهلاكية إلى أفق إنساني مشترك.
3. ملامح الأفق الإنسانوي:
- إعادة تعريف الحرية: ليست حرية السوق، بل حرية التمكين (قدرة الفرد على التعليم، الصحة، المشاركة السياسية).
- التضامن بدل التذرر: بناء روابط اجتماعية جديدة (نقابات، حركات مدنية، شبكات تضامن رقمي) تعيد للفرد قوته من خلال الجماعة.
- الكرامة كمعيار: قيمة الإنسان ليست في "قيمته السوقية"، بل في إنسانيته غير القابلة للتسليع.
- إعادة توظيف التكنولوجيا: بدل أن تكون أداة سيطرة، تصبح أداة للتواصل والتضامن والتمكين.
الخاتمة
إن كان الوحش الفرداني قد خرج من رحم التنوير ليجتاح العالم، فإن بذور بدائل إنسانوية بدأت تنبت. إنها ليست دعوة للعودة إلى الماضي، بل لمستقبل يعيد تعريف الحرية والكرامة. من "مقاربة القدرات" عند سِن ونوسباوم، إلى "الحداثة النقدية" عند باومان وتورين، ومن قراءات الجابري والعروي إلى حركات الشباب العربي، هناك أصوات تتجمع لتقول: الإنسان ليس سلعة، الحرية ليست استهلاكًا، والكرامة لا تُقاس بعدد المتابعين أو حجم الرصيد البنكي.
هذا الأفق الإنسانوي ليس تيارًا مهيمنًا بعد، لكنه بذرة مقاومة، قد تكون الأمل الوحيد في مواجهة الوحش النيوليبرالي.
لقد وُلد الوحش في التنوير، ترعرع في الرأسمالية، وانفلت في النيوليبرالية، حتى غزا منطقتنا عبر العولمة. لكنه لم يستقر هنا كما استقر في الغرب، بل جاء مشوهًا: حرية استهلاكية بلا مضمون، استقلال رقمي بلا حماية، واغتراب عميق يمزق الأفراد بين "أنا" نيوليبرالية و"نحن" تقليدية.
المعركة اليوم ليست بين الغرب والشرق، بل بين الإنسان والوحش الذي يلتهمه. إنها معركة لاستعادة الكرامة، للتضامن، لإعادة تعريف الحرية بما يعيد للإنسان إنسانيته.
***
خليل إبراهيم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
...................
المراجع:
- Adorno, Theodor, and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. 1944.
- Durkheim, Emile. Suicide: A Study in Sociology. 1897.
- Foucault, Michel. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. Palgrave Macmillan, 2008.
- Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, 2005.
- Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. 1785.
- Locke, John. Two Treatises of Government. 1690.
- Marx, Karl. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Progress Publishers, 1959.
- Mbembe, Achille. On the Postcolony. University of California Press, 2001.
- Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
- Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard University Press, 1989.
- Nussbaum, Martha. Creating Capabilities. Harvard University Press, 2011.
- Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity. Polity, 2000.
- Touraine, Alain. Can We Live Together? Equality and Difference. Stanford University Press, 2000.
- الجابري، محمد عابد. الدين والدولة وتطبيق الشريعة.
- العروي، عبد الله. مفهوم الحرية.
- بن نبي، مالك. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي.