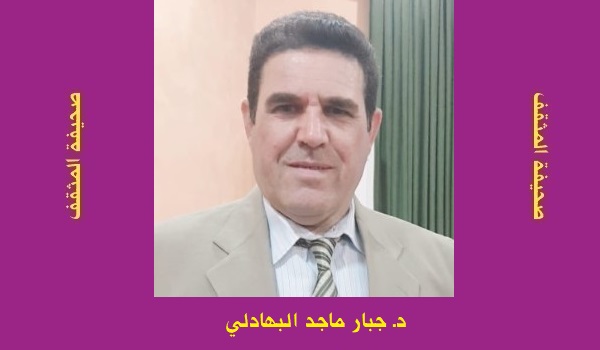قضايا
محمد قاسم الطائي: التفكيرُ النقدي في بلورة الإبداع

الإنسانُ كائنٌ مفطورٌ على التفكيرِ والتساؤلِ، والبحثِ عن آفاقِ الحُلولِ التي تُحقّقُ سعادتَه وتُناسبُ كمالَه الإنسانيّ. التفلسفُ من خصوصيّاتِ الإنسانِ التي تميّزَ بها في هذا الوجودِ. التفكيرُ والتفلسفُ توأمانِ لا يفترقانِ. التفلسفُ هو السعيُ نحو الحكمةِ، وهو ممارسةٌ عقليّةٌ وروحيّةٌ يتأمّلُ الإنسانُ من خلالها العالمَ والوجودَ والحياةَ والقيمَ والذاتَ، أمّا الإنسانُ، فلماذا يتفلسف؟ لأنّهُ يشعرُ - بشكلٍ فِطريٍّ - أنّ الجهلَ والتعتيمَ مشينٌ، ونقصٌ في ذاتِه. وهذا الإحساسُ لا يحتاجُ إلى مُنبّهٍ خارجيٍّ، بل هو إدراكٌ أَوّليٌّ بديهيٌّ نابعٌ من صميمِ الذاتِ الإنسانيّةِ بخصوصِ قُبحِ الجهلِ.
وبالتالي يفرُّ الإنسانُ منهُ بطبعِه، ولا يقبلُهُ، حتّى وإنْ كانَ فعلًا موصوفًا به. ومن خلالِ ذلك، يسعى لمحاولةِ الفهمِ والاكتشافِ والوعيِ المُخلِّصِ، ومنها البحثُ عن لذّةِ الدهشةِ، كما عبّر سقراط: «الدهشةُ هي بدايةُ الفلسفةِ» وبكلِّ الأحوالِ، حينما يندهشُ الإنسانُ من شيءٍ عاديٍّ يقتحمُ حياتَه - كالزمنِ الذي يتسلّلُ من بين يديه بصمتٍ، أو الموتِ الذي يخطفُ الأحبّةَ دون إنذارٍ، أو الوعيِ الذي يُشعرُه بوجودِه بشكلٍ غريبٍ - يبدأُ سيلُ التساؤلاتِ الوجوديّةِ بالانفجارِ في داخلِه.
أسئلةٌ تبدو في ظاهرِها بسيطةً، لكنها تحملُ أثقلَ الأجوبةِ: من أنا؟ لماذا وُجِدتُ؟ ما هي الحقيقةُ؟ ما الغايةُ من كلِّ هذا؟ وإلى أينَ المآلُ؟
والحقيقةُ أنَّ هذا النوعَ من الدهشةِ والتساؤلِ لا يُشبهُ الفضولَ العابرَ، بل هو لحظةٌ وجوديّةٌ صِرفةٌ، تجعلُ الإنسانَ يتوقّفُ ويتأمل، ويبدأُ رحلةَ البحثِ عن معنىً لحياتِه، وعن موقعِه في هذا الكونِ. ومن هنا، يُولَدُ التفلسفُ، ليس كترفٍ عقليٍّ، بل كحاجةٍ داخليّةٍ مُلِحّةٍ لفهمِ ما لا يُفهَمُ بسهولةٍ.
ومنها دوافعُ الرغبةِ العارمةِ في مَسكِ خيطِ الحقيقةِ، إذ الإنسانُ بطبعِه لا يكتفي بالظواهرِ، بل يسعى لاكتشافِ حقائقِ الأشياءِ، وسبرِ أغوارِها وأبعادِها، والوصولِ إلى ما وراءَها - حسبَ مقدرتِه البشريّةِ. وعلى ضوءِ ذلك، عدَّ فلاسفةُ الدينِ أنَّ حبَّ الخيرِ والجمالِ والتديُّنِ، وحبَّ الاستطلاعِ، والفضولَ المعرفيَّ، تشعُّباتٌ من خصائصِ الإنسانِ الفِطريّةِ التي لا يُستغنى عنها بأيِّ حالٍ، حتّى وإنْ أخطأت أهدافَها المشروعةَ.
الأهمُّ من ذلك أنَّ القلقَ الوجوديَّ - كمسألةِ الحريّةِ والمصيرِ والخوفِ من الموتِ - تُعدُّ مناجمَ بركانيّةً فاتحةً لبابِ التأمُّلِ والفهمِ العميقِ المتعلّقِ بإثارةِ الأسئلةِ، وإلفاتِ الغريزةِ البحثيّةِ. كما يرى "مارتن هايدغر":"القلقُ يكشفُ لنا حقيقتَنا: أنّنا موجودونَ نحو النهايةِ".
ثَمّةَ علاقةٌ وطيدةٌ بين محطةِ الإبداعِ والتفكيرِ النقديِّ؛ فالتفكيرُ النقديُّ خُطواتٌ إجرائيّةٌ ممنهجةٌ في إثارةِ الأسئلةِ إزاءَ المشاكلِ والقضايا الكبرى المطروحةِ. وعلى حدِّ وصفِ كارل بوير: "العِلمُ لا يبدأُ من الملاحظةِ، بل من المشاكلِ." التفكيرُ النقديُّ هو القُدرةُ على تحليلِ المعلوماتِ والأفكارِ بشكلٍ منطقيٍّ، بهدفِ التحقّقِ من صحّتِها، واكتشافِ الفرضيّاتِ، والتمييزِ بين الحقيقةِ والرأيِ الخاطئِ، وتحليلِ المفاهيمِ والمعطياتِ، وتقييمِ الأدلّةِ والحججِ، والاستنتاجِ المنطقيِّ القويمِ، والمرونةِ الذهنيّةِ في قَبولِ وُجهاتِ النظرِ المختلفةِ.
يعتمدُ التفكيرُ النقديُّ بشكلٍ مَاسٍّ على قواعدِ التحليلِ والاستدلالِ العِلميِّ، والتقييمِ الموضوعيِّ المُنصفِ، والاحتكامِ النزيهِ، والتأمّلاتِ الذاتيّةِ المُنتِجةِ في استظهارِ رُؤى الأشياءِ.
أمّا الإبداعُ، فهو القُدرةُ التوليديّةُ على صِياغةِ الأفكارِ، أو طرحِ الحُلولِ الأًصيلةِ والمُبتكرةِ، في الوقتِ ذاتهِ موضعتُها حسبَ الموقفِ الإشكاليِّ والحاجةِ المطلوبةِ. العلاقةُ بين التفكيرِ النقديِّ والإبداعِ هي علاقةٌ تفاعليّةٌ، وليست انفعاليّةً؛ بمعنى أنّ كُلًّا من الطرفينِ (التفكير النقديّ والإبداع) يُؤثّرُ ويتأثّرُ بالآخرِ في دورةٍ عقليّةٍ مُتبادلةٍ تكامليّةٍ. فالتفكيرُ النقديُّ لا يُلغِي الإبداعَ، ولا الإبداعُ يُعارضُ مِبضَعَ النقدِ. إنّ دورَ التفكيرِ النقديِّ - وفقًا لضوابطِه المعرفيّةِ - يتمثّلُ في تصحيحِ وتقويمِ الأفكارِ المطروحةِ، دون الانشغالِ بشخصِ قائلِها، وهي ممارسةٌ صحّيّةٌ تفتحُ آفاقًا للتفاؤلِ، لما تُتيحه من تجديدٍ في النشاطِ المعرفيِّ، وإيجادِ بدائلَ أكثرَ نُضجًا وفاعليّةً. أمّا الإبداعُ، فيحتاجُ دومًا إلى جُرأةِ السؤالِ، والتفكيرِ المختلفِ. وما من إبداعٍ إلّا ومنشأُهُ قوّةُ التمحيصِ والفحصِ، وجرأةُ التفكيرِ النقديِّ. وهذا ما نَجِدهُ مُصداقَه بدقّةٍ في طيّاتِ التراثِ الإسلاميِّ — مثلًا — عندَ ابن رُشدٍ الفيلسوفِ في نظريتِه "الفصلِ بين الحقيقةِ الشرعيّةِ والفلسفيّةِ"، التي تُوّجتْ بنقدِه للغزاليِّ في "تهافتِ الفلاسفةِ"، حيثُ اتّهمَ الأخير الفلاسفةَ بالتكفيرِ، فردَّ عليهِ ابنُ رشدٍ في كتابِه "تهافت التهافت". أمّا جانبُهُ الإبداعيُّ، فقد انتهى بتأسيسِ رؤيةٍ فلسفيّةٍ جمعتْ بين الإيمانِ والعقلِ، أثّرتْ في الغربِ اللاتينيِّ لقرونٍ عديدةٍ، وكان لجهادِه العقليِّ دورٌ في ظهورِ عصرِ العقلِ والأنوارِ في أوروبا، وفي الوقتِ ذاتهِ، شنَّ الغزاليّ هجومًا نقديًّا مُدجّجًا على قلاعِ الفلاسفةِ، وانتهى به المطافُ إلى الربطِ بين المنطقِ والفكرِ الإسلاميِّ، وسادتْ به كتبُهُ مثل: إحياءِ علومِ الدين والمنقذِ من الضلال. مثلًا، نظريّةُ "المقاصدِ الشرعيّةِ" عندَ الشاطبيِّ جاءتْ نتيجةَ نقدِه لمدارسِ الفقهِ المدرسيِّ، والتجزيئيِّ، وغيابِ النظرِ الكلّيِّ في مشروعيّةِ الاجتهادِ — أقولُ ذلك بصرفِ النظرِ عن قيمةِ ومقبوليّةِ النظريّةِ.
كذلك، مثلًا، ابنُ الهيثمِ البَصْريُّ عندما نقدَ نظريّةَ بطليموس في الرؤيةِ والبصرياتِ القائلةِ إنّ "العينَ تُرسلُ شعاعًا نحو الجسمِ"، وأثبتَ عكسَها: أنَّ الضوءَ يدخلُ إلى العينِ، وقد استخدمَ منهجًا تجريبيًّا مُبدعًا، ويُعدّ بذلك أوّلَ من وضعَ أُسسَ المنهجِ العلميِّ الحديثِ. والنماذجُ بهذا الصددِ وافرةٌ وكثيرةٌ.
من شروطِ صناعةِ النهضةِ الحقيقيةِ تفعيلُ التفكيرِ النقديِّ في مواجهةِ آفاتِ التسطيحِ، وسياساتِ التجهيلِ، وآليّاتِ التقليدِ الأعمى. فلا يُكتبُ لأمّةٍ النهوضُ والفلاحُ وهي تُقصي أدواتِ العقلِ، وتخشى أصواتَ النقدِ الذاتيِّ، وتمتهنُ الصمتَ المُطبقَ أمامَ تشخيصِ عللِها وهمومِها الحضاريةِ.
وللأسفِ نعيشُ حالة مَقلقةً من التُّخمةِ المعرفيّةِ والخمولِ العقليِّ في التعاملِ مع قضايا الفكرِ، حتى أصبحَ البعضُ يتعاطى مع النصوصِ، وكأنّها محفوظاتٌ يوميّةٌ لا تُحرّكُ العقلَ ولا تُثيرُ التساؤلاتِ. أمّا الدرسُ الفلسفيُّ، فلا يزالُ في كثيرٍ من الأحيانِ وعمومِ حالاتهِ دونَ مستوى الطموحِ، إذ ما يُعرفُ بالفلسفةِ الإسلاميةِ باتَ أشبهَ بـ"علمِ كلامٍ موسّعٍ" يتكرّرُ فيه الجدلُ بأساليبَ تقليديةٍ دونَ أن يُنتجَ رؤيةً جديدةً أو يُلهمَ عقلًا معاصرًا.
إنّ كثيرًا من "المثقّفينَ" اليومَ يُعانون من أزمةِ إبداعٍ حقيقية، فيتصوّرُ بعضُهم أن حفظَ أسماءِ الفلاسفةِ والروائيينَ، أو تكرارَ الأقوالِ والمقولاتِ، كافٍ ليَحمِلَ لقبَ المفكّرِ أو الناقدِ! والحالُ أن عصرَنا مغلوبٌ بالتقليدِ، مُثقلٌ بالتهميشِ، تائهٌ في غيابِ المعنى حتى باتَ يُشبهُ عصرَ "النسخِ العقليِّ" لا عصرَ النهوضِ والتحديثِ. نحنُ بأمسِّ الحاجةِ إلى إعادةِ الاعتبارِ لمكانةِ العقلِ الخالصِ، لا بوصفِهِ تابعًا مُقلّدًا، بل صانعًا ومُساءلًا ومُبدعًا، قادرًا على التفكيكِ، وإعادةِ البناءِ، واكتشافِ المساراتِ المتنوّعةِ. فالتفكيرُ النقديُّ لا يهدِمُ الثوابتَ، بل يفتحُ آفاقًا رحبةً لفهمِ النصوصِ والمتونِ، ويُنقذُنا من سطوةِ الجمودِ والانبهارِ الأجوفِ، ويَرسُمُ ملامحَ وعيٍ مُتجدّدٍ يجمعُ بين الأصالةِ والمعاصرةِ، ويُؤسسُ لعقلٍ حرٍّ قادرٍ على المساءلةِ والإبداعِ والتجاوزِ، لا عقلٍ يكتفي بالتكرارِ والتلقينِ
***
محمد قاسم الطائي