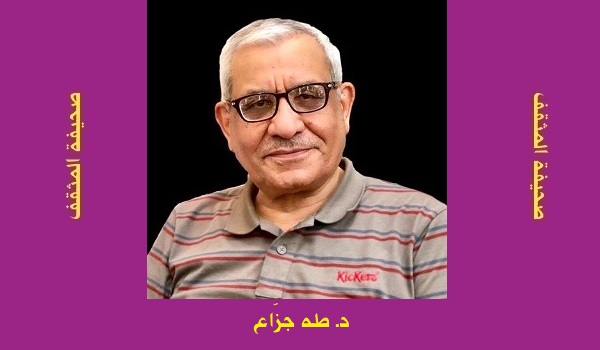قضايا
عبد السلام فاروق: الترجمة جسراً لمستقبل ثقافي أفضل

كم مرة وقفنا مأخوذين أمام رفوف مكتبة، نحدق في عناوين متراصة، بحثًا عما يهز عقولنا أو يفتح في وعينا نوافذ جديدة، فنفاجأ بذلك الفراغ الثقافي حين نكتشف أن كتبًا غيرت مجرى الفكر الإنساني ما تزال غائبة عن لغتنا؟ كم مرة أحسسنا بالعجز أمام فكرة حديثة، أو نظرية تشعل الجدل، فقط لأنها ظلت محبوسة خلف حواجز لغوية؟
اللغة، في هذه اللحظات، لا تكون وسيلة اتصال، بل تصبح جدارًا. وهنا تتدخل الترجمة لا بوصفها مجرد نقل، بل كفعل تحرري، يخلخل هذا الجدار، ويعيد تشكيل وعينا.
الترجمة: سفرٌ بين أزمنة وثقافات
حين تصفحت حديثًا كتاب "حياتي ومغامراتي" لأرمينيوس فامبيري، و"حول أصل اللغة" لإرنست رينان، أيقنت أن الترجمة ليست فعلاً أكاديميًّا محضًا، بل سفرًا وجوديًّا. إنها تخط لحدود الزمن، عبور إلى عوالم لم نعشها، وإصغاء إلى أصوات من عصور غابت، لكنها تركت آثارها فينا.
قراءة الكتابين تجعلني أتساءل: كيف لنا أن نفهم الآخر دون أن نقرأ كيف رآنا؟ وكيف نفسّر لغتنا، وهي هويتنا الأولى، دون أن نعرف كيف فكّر العالم في أصلها؟
الترجمة، في هذا السياق، ليست مجرد جسر بل هي مرآة ورؤية، سؤال ودهشة. من هذا المنطلق يطرح الكتابان علي المثقف العربي أسئلة تمس صميم وجوده الثقافي: أسئلة عن الاستشراق ليس كخطاب جامد، بل كساحة صراع بين المعرفة والسلطة. وأسئلة غيرها تضعنا أمام لغز اللغة، ذلك السر الذي ما زال يحير الفلاسفة والعلماء منذ فجر التاريخ. وسؤال إضافي ذو دلالة عميقة لابد له من جواب: هل نترجم لملء فراغ أرفف المكتبات، أم لنغير العقول ولنطور إدراكنا نحو مستجدات العصر؟
في هذا المقال، أحاول أن أتتبع أثر هذين العملين في سياقهما الفكري، وأتأمل دور الترجمة كجسر بين الماضي والحاضر، بين الشرق والغرب، بين اللغة كأداة للتواصل واللغة كسر وجودي. لأننا فى الواقع لا نترجم كتباً صماء، بل نترجم أنفسنا لنكتشف ذواتنا ونقارنها بالآخر.
مرآة الاستشراق ورؤية الذات
في "حياتي ومغامراتي" للمستشرق أرمينيوس فامبيري (1832-1913) بترجمة زكريا صادق الرفاعي وتقديم ماكس نوردو، يكشف فامبيري المستشرق المجري ذي الأصول اليهودية، الذي جاب الشرق في القرن التاسع عشر، عن أبعاد أدب الرحلة حين يتجاوز الحكاية إلى السياسة، وحين تصبح المغامرة مدخلاً إلى فهم علاقة الغرب بالشرق.
تكشف الوثائق البريطانية الحديثة، ظهرت عام 2005م، أن فامبيري لم يكن مجرد رحالة، بل عميلًا مزدوجًا للإنجليز والعثمانيين، وهو ما يفتح السؤال الكبير: هل كان الاستشراق علمًا محايدًا؟ أم كان أحد أذرع القوة الاستعمارية؟ الكتاب يجسد ببراعة هذا التناقض، ما بين رؤى النخبة الفيكتورية للشرق، وبين معلومات نغرق في خضمها عن الحياة فى آسيا آنذاك.
الكتاب يظهر بوضوح كيف كان الشرق مادة للدراسة والمراقبة، ولكنه أيضًا كان مساحةً للمواجهة بين المعرفة والهيمنة، بين التدوين والاستغلال. إعادة ترجمته اليوم ليست استعادة للماضي، بل قراءة جديدة في مرآة الآخر، وتعرية للصورة النمطية التي صاغها الغرب عن الشرق.
في البدء كانت الكلمة: لغز اللغة وأصلها
أما كتاب "حول أصل اللغة"، لإرنست رينان بترجمة سحر سمير يوسف وتقديم عبد الرحمن محمد طعمة، فهو رحلة فكرية آسرة في أعماق الوعي البشري. إنه استكشاف للّحظة التي نطق فيها الإنسان الأول الكلمة، ومن ثم بنى بها حضارته، وصاغ بها فلسفاته، وأسس بها وجوده. إنه ليس مجرد كتاب عن أصل اللغة، بل هو رحلة في أعماق العقل البشري وتطوره بحثاً عن الجذور الأولى للكلمة التي ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات.
يتبع رينان في هذا الكتاب المنهج المقارن لتتبع أصول اللغات، ساعياً لإعادة بناء ملامح "اللغة البدائية الأولى". لكن الأهم من ذلك هو تركيزه على دور اللغة كوثيقة تاريخية تكشف أسرار الحياة الإنسانية في عصور ما قبل التاريخ، وكأداة لفهم نشأة العقل البشري وتطوره. إن اللغة هنا ليست مجرد وسيلة اتصال، بل هي وعاء للفكر، وأداة لتشكيل العالم .
رينان لا يكتب بلغة العلم البارد، بل بلغة الفكر المتسائل. يطرح أسئلة كبرى: هل اللغة طبيعية أم اختراع صناعي؟ ما علاقتها بالأعراق؟ كيف تتحول الكلمة إلى وعاء للمعنى، إلى بيت للذاكرة والهوية؟ إنه ينقّب في التاريخ واللاهوت والأنثروبولوجيا، لينسج رؤية لغوية عميقة تتجاوز القوالب التقليدية. الكتاب، بترجمته الدقيقة وتقديمه المستنير، يفتح أمام القارئ العربي بابًا إلى فهم أوسع للّغة: لا كقواعد، بل ككائن حي، يتنفس، يتطور، ويعكس تشكّل الذات في علاقتها بالعالم.
سؤال محوري
ترجمة أعمال كهذه، تطرح سؤالاً جوهرياً عن دور الترجمة في عصرنا: هل نترجم لنضيف رقمًا إلى فهارس المكتبات؟ أم لنُعيد تشكيل العقل العربي على ضوء أسئلة جديدة؟ هذا هو السؤال المركزي الذي يطرحه هذان العملان. إن الترجمة الحقة لا تقاس بعدد الصفحات، بل بقدرتها على إحداث اهتزاز داخلي في القارئ، على تقويض المسلّمات، وتحفيز النقد، وخلق وعي متعدد الأبعاد.
إن ترجمة كتاب مثل: "حول أصل اللغة" ليست ترفًا فكريًّا، بل ضرورة حيوية، في زمن تتسارع فيه علوم اللغة والدماغ والذكاء الاصطناعي، بينما بقيت دراسة اللغة العربية حبيسة نظرة تقليدية ونظام مغلق. وحاجتنا لترجمة الجديد بمجال اللغويات تنبع من عدة عوامل:
-التطور الهائل في علوم اللغة: فالعالم يشهد كل يوم نظريات جديدة في علم اللغة العصبي، واللغويات الحاسوبية، وتحليل الخطاب، والتي لا يمكن للباحث العربي الإحاطة بها دون ترجمتها، وما يتم تقديمه كثير وغزير ويتطلب جهداً مضاعفاً لمواكبته.
-الحوار بين الحضارات: فاللغة هي أداة هذا الحوار، وفهم كيفية نظر الآخرين إلى ظاهرة اللغة يسهم في إثراء الفكر اللغوي العربي .
-مواكبة المناهج الحديثة: فدراسة اللغة لم تعد تقتصر على النحو والصرف، بل تشمل العلاقة بين اللغة والدماغ، واللغة والمجتمع، واللغة والذكاء الاصطناعي .
إن "المركز القومي للترجمة" في مصر، من خلال إصداراته مثل هذين الكتابين، يلعب دوراً حيوياً في ردم الفجوة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى. وهذا الدور ليس جديداً، فقد كانت مصر عبر تاريخها بوابة العرب إلى العالم، ومنارة للمعرفة تنير الدرب للأمة جمعاء.
نحو مشروع عربي طموح للترجمة
لا يقتصر احتياجنا الثقافي اليوم على ترجمة أعمال كبرى، بل ينبغي البحث عن مشروع ثقافي واسع وطموح؛ يربط الترجمة بالنهضة، بالتحول الحضاري.
فمن خلال قراءتي لهذين الكتابين وللدرس البليغ المستمد منهما: المعرفة والاستشراق كأداة للسلطة، والمعرفة كغاية عليا. مثل هذا التوتر بين المعرفة كقوة والمعرفة كقيمة هو ما يجعل الترجمة فعلاً ثقافياً بالغ الأهمية .
من هذا المنطلق؛ فإنني أدعو إلى مشروع ترجمي عربي جديد يركز على عدة محاور:
1. انتقاء الأعمال التي تقدم إضافات نوعية للمكتبة العربية في مختلف المجالات، وخاصة في حقل الدراسات اللغوية الحديثة.
2. الاهتمام بجودة الترجمة ودقتها، بحيث تكون قادرة على نقل الأفكار المعقدة بأمانة ووضوح.
3. توسيع نطاق اللغات المترجم عنها، فلا نقتصر على الإنجليزية والفرنسية، بل ننفتح على لغات أخرى تحمل رؤى مختلفة للعالم .
4. ربط الترجمة بالبحث العلمي، بحيث لا تكون مجرد نقل، بل إعادة إنتاج للمعرفة في سياق عربي.
5. الاهتمام بالتقديم النقدي للكتب المترجمة، كما هو الحال في الكتابين موضوع هذا المقال، حيث جاء كل منهما بمقدمة تضع العمل في سياقه وتقيمه تقييماً نقدياً.
هكذا نترجم ذواتنا
في النهاية، نحن لا نترجم كتبًا فقط. نحن نترجم وعينا، نعيد كتابة ذواتنا في لغة العالم. فالترجمة في جوهرها هي انفتاح ومقاومة وحوار متبادل بين فكرين مختلفين .
الترجمة هي الوسيلة التي نطل بها على الآخر، لا لنخافه أو نقلده، بل لنتحاور معه، لنفهمه ونفهم أنفسنا من خلاله. كما قال جوته : "من لا يعرف اللغات الأجنبية لا يعرف شيئًا عن لغته"
إننا، حين نقرأ أنفسنا بعيون الآخر، نكون قد خطونا أولى خطوات التنوير.
***
د. عبد السلام فاروق