قضايا
سجاد مصطفى: العبيد المولودون.. كيف تسرقك الصدفة والعادة من حريتك؟
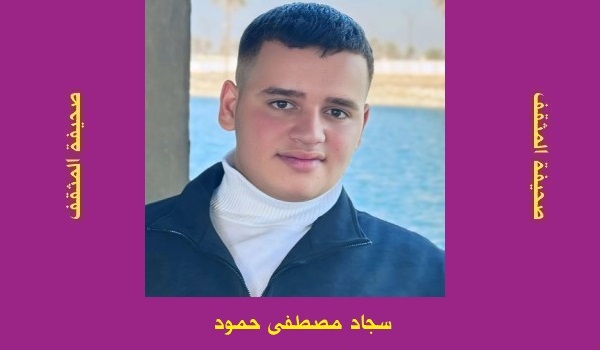
الملخّص: يبحث هذا العمل في البنية المزدوجة التي تحكم مسار الوعي الإنساني، والمتمثلة في الصدفة التي تصوغ البدايات، والعادة التي تكرّس النهايات. ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن تحالف هذين العاملين يُسهم في تعطيل الفعل الإنساني الواعي، ويحول دون ممارسة الحرية الحقيقية. تتناول الدراسة، من خلال إطار فلسفي-اجتماعي، تعريف كل من الصدفة والعادة في ضوء التراث الفكري العراقي والعالمي، ثم تفحص آليات تداخلهما وتأثيرهما على أنماط التفكير والسلوك. وتعتمد المنهج التحليلي النقدي، ممزوجًا بالمنهج المقارن، لإظهار التباين والتقاطع بين رؤى فلاسفة عراقيين أمثال علي الوردي ومدني صالح، وفلاسفة عالميين مثل مارتن هايدغر وحَنّة أرندت وزيغمونت باومان. ويخلص البحث إلى أن تجاوز هذه البنية يتطلب مشروعًا معرفيًا مزدوجًا يقوم على تفكيك المسلّمات الموروثة، وكسر دورات التكرار التي تمنح الأمان الزائف، وصولًا إلى إعادة تعريف الحرية باعتبارها القدرة على الفعل المدروس المختار لا مجرّد التحرر من القيود الظاهرة.
المقدمة
ليست الصدفة في حياة الإنسان مجرّد حادثة عابرة تُسجّل في دفتر الأيام، ولا العادة مجرد تكرار رتيب للسلوك؛ بل هما، في العمق، قوتان متلازمتان، تعملان على رسم خريطة الوعي من أول منعطفاته حتى آخر محطاته. ففي حين تلقي الصدفة بالإنسان في بيئة وثقافة وزمن لم يخترها، تأتي العادة لتشيّد حوله أسوار المألوف، حتى يغدو حركته داخل دائرة مغلقة، يظنها أفقه الطبيعي. قال أحد المفكرين العراقيين: «ليست المصيبة أن تولد في بيئة لم تخترها، بل أن تموت وأنت لا تعرف أنك كنت سجينها». هذه الكلمة تختزل مأساة ملايين الأفراد الذين يعيشون حياتهم على إيقاع ما لم يختاروه، ثم يرحلون دون أن يمارسوا لحظةً واحدةً من الفعل الحرّ الذي يتجاوز شروط البداية ويكسر تكرار النهايات. تسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذا الإشكال من خلال تحليل فلسفي واجتماعي معمّق لمفهوم الصدفة والعادة، واستكشاف كيف يتواطآن في تشكيل وعي الإنسان وتحديد مساره. ويتجاوز هذا البحث الطرح الأدبي المجرّد، لينخرط في قراءة نقدية مؤسّسة على مناهج الفكر الحديث، ويقارن بين التجربة الفكرية العراقية، التي انشغلت طويلاً بمسألة الموروث والعرف، وبين أطروحات الفلسفة الغربية المعاصرة التي تناولت قضايا البنية والحرية والفعل الإنساني.
إن الإلحاح على هذا الموضوع ينبع من الحاجة إلى إعادة النظر في معنى الحرية ذاتها. فليست الحرية، كما تذهب بعض التصورات الساذجة، مجرد تحرر من القيود الظاهرة، بل هي في جوهرها القدرة على نقد البدايات وفحصها، وكسر النهايات المكرورة التي تتحوّل بمرور الزمن إلى ما يشبه «القدر الاجتماعي». وهنا تكمن أهمية الفحص المزدوج: تفكيك ما جاءت به الصدفة من محددات أولى، ومساءلة ما فرضته العادة من تكرار. كما أن هذا البحث يهدف إلى تقديم تصور نظري قادر على صياغة استراتيجية للتحرر من أسر الصدفة والعادة، وذلك عبر بناء وعي نقدي، وخلق مساحات للفعل المقصود، حيث يصبح الإنسان فاعلاً في مسار حياته، لا مجرد مُساقٍ فيه. ولتحقيق هذا الغرض، سننطلق أولاً إلى تحديد المفاهيم، ثم تحليل آليات عملها، قبل الانتقال إلى المقارنة بين التجارب الفكرية المختلفة، وصولاً إلى طرح رؤية تتجاوز المأزق وتفتح أفقًا جديدًا للحرية والفعل.
الإطار النظري
أولًا: مفهوم الصدفة بين الفلسفة والمجتمع
منذ بدايات التفلسف الإنساني، ظلّت الصدفة مفهومًا ملتبسًا، يتأرجح بين كونها عاملًا عرضيًا خارج منظومة القوانين، وبين كونها أداة خفية في يد القدر. في الفكر اليوناني القديم، رآها أرسطو ضمن «العَرَض» الذي يقع خارج سلسلة العلل المنتظمة، لكنه لم ينكر أثرها في تحويل مجرى الأحداث. وفي المقابل، حاول الرواقيون ردّ كل ما يُسمّى بالصدفة إلى نظام كوني شامل، معتبرين أن ما يبدو لنا صدفة إنما هو جهل بترتيب الأسباب. أما في التصور الإسلامي الكلاسيكي، فقد نُظر إلى الصدفة باعتبارها وهمًا، لأن كل ما يقع إنما يقع بقضاء وقدر، لكن هذا لم يمنع من الاعتراف بوجود أحداث لا يتوقعها الإنسان، فتأخذ في وعيه شكل المفاجأة.
في السياق العراقي الحديث، تناول علي الوردي الصدفة في إطار تحليله للمجتمع التقليدي، فاعتبر أن نشأة الفرد في بيئة معينة «مقامرة وجودية» تحدد ملامح شخصيته، قبل أن يمتلك القدرة على الاختيار. وذهب مدني صالح إلى القول إن «أكبر صدفة في حياة الإنسان هي أن يولد»، مؤكدًا بذلك أن البداية ذاتها ليست من صنعه، بل تُفرض عليه فرضًا.
وهنا أقول: «الصدفة هي اليد التي تضعك على رقعة اللعب قبل أن تعرف شكل الرقعة أو قوانين اللعب، ثم تتركك لتظن أن وجودك هناك كان قرارك». هذا الاقتباس يوضح أن الصدفة ليست مجرد حادثة زمنية، بل هي بنية تأسيسية تحدد شروط الانطلاق، وتفرض على الإنسان مسارًا أوليًا قد يقضي حياته كلها داخله، ما لم يمتلك وعيًا ناقدًا لتفكيك تلك الشروط. من الناحية الاجتماعية، الصدفة هي المحدد الأكبر لما أسماه بيير بورديو بـ«الرأسمال الأولي»؛ فهي التي تمنح أو تحرم الإنسان من رأس المال الاجتماعي والثقافي منذ اللحظة الأولى. فالولادة في بيئة فقيرة أو غنية، في مجتمع متسامح أو متعصب، ليست سوى نتائج مباشرة لصدفة الميلاد، لكنها تُترجم سريعًا إلى فروقات هائلة في الفرص والخيارات. ولعل أخطر ما في الصدفة أنها كثيرًا ما تُموَّه في الوعي الجمعي تحت عناوين «القدر» أو «المشيئة» أو «الحظ»، بحيث يصبح نقدها ضربًا من التجديف أو الجحود. كما أقول: «أخطر الصدف هي التي تُعاش كأنها قدر مقدس، لا يقبل المساءلة ولا الفحص». هذا النوع من الصدفة هو الذي يغلق باب الفعل الإنساني الحر، لأنه يخلط بين ما فُرض على الإنسان قسرًا وبين ما يمكنه تغييره إذا امتلك الوعي والشجاعة. على المستوى الفلسفي المعاصر، يرى مارتن هايدغر أن الإنسان «مُلقى في العالم» (Geworfenheit)، أي أن وجوده يبدأ من نقطة لم يخترها، وعليه أن يتعامل مع المعطيات التي وجد نفسه فيها. هذا الإلقاء هو المعادل الوجودي لفكرة الصدفة، لكنه عند هايدغر لا يلغي إمكانية أن يتحرر الإنسان عبر ما يسميه «الوجود الأصيل»، الذي يقوم على مواجهة الذات للظروف وإعادة تعريفها. غير أن أغلب الأفراد لا يقطعون هذه المسافة، بل يعيشون كما يقول زيغمونت باومان في حالة «حياة سائلة»؛ حيث تتحدد مساراتهم بفعل قوى خارجية وظروف أولية، ويكتفون برد الفعل بدل صناعة الفعل. وهنا أقول: «الصدفة تكتب السطر الأول في كتاب حياتك، لكنك إذا لم تمسك القلم، فإنها ستكتب الفصول كلها».
إن فهم الصدفة، إذن، لا يقتصر على رصد لحظة الميلاد أو بداية الحدث، بل يتطلب تفكيك البنية الكاملة التي تنتجها، وفهم كيف تتداخل مع العادات لاحقًا لتشكل مصير الإنسان. وهذا يقودنا إلى المحور الثاني، حيث تتحول الصدفة إلى عادة، والعادة إلى قيد محكم.
ثانيًا: مفهوم العادة بين الفلسفة والمجتمع
العادة ليست مجرد تكرار آلي لسلوك أو تصرف، بل هي آلية ثابتة تحفظ التوازن الزمني للسلوك الإنساني، وتكرس ثقافة الأفعال، فتغدو من خلال ذلك عاملًا مؤثرًا في تشكيل الهوية والوعي. في الفكر الفلسفي، نظر إليها أرسطو على أنها ممارسة متكررة تؤدي إلى تكوين الفضيلة أو الرذيلة، أي أن العادة تبني الشخصية وتحدد مآلاتها. أما في الفلسفة الحديثة، فقد أعاد ديڤيد هيوم تعريف العادة باعتبارها القوة التي تربط بين الأفكار، وتشكل توقعاتنا للسلوك، لكن هيوم لم يتجاوز المنظور النفسي للفرد. في الفلسفة الاجتماعية، خاصة عند علماء الاجتماع، تنظر العادة إلى أنها مجموعة من الأنماط المستقرة، التي توارثتها المجتمعات لتضمن استمراريتها. وقد شدد علي الوردي، في تحليله للمجتمع العراقي، على أن «العادة تتجاوز كونها سلوكًا، لتصبح قانونًا غير مكتوب يتحكم في حياة الفرد، ويُعيق أي محاولة للخروج عن المألوف».
وهنا أقول: «العادة هي القيد المموّه الذي تلبسه الذات كدرعٍ يحميها من مواجهة اللايقين، لكنه في الوقت نفسه يحول دون حركتها الطبيعية». هذه العبارة تعكس الثنائية المأساوية للعادة، فهي من جهة تمنح شعورًا بالأمان والاستقرار، ومن جهة أخرى تمنع النمو والتغيير. على المستوى الاجتماعي، تُعتبر العادة مؤسّسة النظام القيمي، لكنها في كثير من الأحيان تتحول إلى آلة تُسقط كل محاولة للتمرد أو النقد. فالمجتمع الذي يعاني من عادات جامدة، كما قال مدني صالح، هو «مجتمع يعيش في زنزانة غير مرئية، حيث تصبح العادة حكمًا قضائيًا على كل جديد». في الفلسفة الوجودية، لاحظ سارتر أن الإنسان «محكوم بالحرية» ولكنه كثيرًا ما يهرب من هذه الحرية إلى العادات والتقاليد، لأنها توفر له ملاذًا آمنًا من قلق الاختيار والمسؤولية. وفي هذا الإطار، أقول: «العادة ليست فقط تكرارًا، بل هي استسلامٌ ضمنيٌّ لخطاب ما، ينتج طقوسًا وقوانين تلغي الفعل الحر، وتخنق الوعي تحت طبقات التكرار». عبر هذه المفاهيم، تتضح خطورة العادة كعامل يمنع الإنسان من إعادة قراءة الصدفة التي وُلد بها، ويُبقيه أسير تكرار موروثات لا يدرك أصلها ولا إمكانية تجاوزها.
وهكذا، يصبح فهم العادة ضرورة جوهرية لفك القيود التي تحيط بالإنسان، وهي الخطوة التي ستفتح الباب للتحليل الأعمق لتشابكها مع الصدفة، وكيف يؤثر هذا التزاوج على تعطيل الفعل الإنساني، وهو موضوع المحور التالي.
ثالثًا: التقاطع بين الصدفة والعادة وتعطيل الفعل الإنساني
إن العلاقة بين الصدفة والعادة ليست مجرد تتابع زمني، بل هي علاقة تشابك بنيوي ينتج حالة من الجمود المعرفي والسلوكي، تعيق الفعل الإنساني الحر، وتكرس حالة من «الوعي المعلّق» بين فرضيات لم تُسائل وأفعال لم تُختبر. فالصدفة، كما وضحنا، تمثل وضع الإنسان في نقطة بداية غير مختارة، تُحيط به شروط وأطر لا يد له في تحديدها. لكن ما إن تتلبّس هذه البداية بعباءة العادة، حتى تتحول إلى شبكة حديدية تحاصر الفكر والفعل. هذا التحالف الخفي يحول الحياة إلى دائرة مفرغة، حيث يُعيد الإنسان إنتاج ذاته وفق نمط محدد مسبقًا، تفرضه ثقافة صارت مألوفة. وقد عبر في أحد المقالات قائلاً: «أن تستسلم للمألوف، هو أن تضع نفسك في قبضة مزدوجة من الصدفة والعادة، لا حرية فيها ولا تحرر». هذه العبارة تلخص مصير كثيرين ممن يعيشون بلا نقد، بلا اختيار، بلا فعل مُنتج.
يضاف إلى ذلك أن هذا التعطيل لا يطال فقط الفرد، بل يمتد إلى البنى الاجتماعية، حيث تُكرّس المؤسسات التعليمية والدينية والسياسية هذه الثنائية، بحجة المحافظة على الاستقرار، وتجنب الفوضى. فتتحول الصدفة إلى «مقدس» لا يُمس، والعادة إلى قانون لا يُخالف. هذا السياق يجعل من الفعل الإنساني الفاعل حالة استثنائية، تُحسب لها ألف حساب، لأن تجاوز هذا الوضع يتطلب مواجهة مزدوجة: تفكيك إرث الصدفة، وكسر قيد العادة.
من هنا أقول: «الحرية ليست غيابًا عن الصدفة، ولا انفصالًا عن العادة، بل هي القدرة على أن تُعيد قراءة البداية، وأن تُعيد رسم المسار، فتصبح فاعلًا حقيقيًا في كتاب حياتك». هذه القدرة على الفعل الواعي هي جوهر النقد الفلسفي الحديث، كما عبرت عنه حنّة أرندت في مفهومها عن «الفعل» كخاصية إنسانية تميزه عن سائر الكائنات، ومن خلاله يُظهر الإنسان ذاته في العالم، ويخلق التاريخ. غير أن تحقيق هذا الفعل ليس ممكنًا إلا عبر وعي نقدي يُميز بين «الوجود المُلقى» والوجود المختار، بين ما وُضع عليه من شروط وما يمكنه تغييره. وهذا الوعي هو الذي يتحقق من خلال الأسئلة المستمرة، والمقاومة المدروسة للدوران في حلقة الصدفة والعادة.
وقد ورد في خطاب فلسفي: «حين تعيش حياتك كما رُسِمت لك، فإنك تموت قبل أن تعيش». هذه الجملة تلخص هشاشة الوعي المعلّق، الذي لم يجرؤ على كسر الدائرة، ولم يملك الشجاعة لمواجهة بداياته المفروضة. إن هذا التحليل يدفعنا للتساؤل عن آليات التحرر الممكنة، وكيف يمكن استنهاض الوعي ليُعيد صياغة العلاقة مع الصدفة والعادة، بحيث تتحول إلى أدوات للتجديد لا قيودًا للتكرار.
رابعًا: قراءة مقارنة بين الفلسفة العراقية والفلسفة العالمية
1. الرؤية العراقية
تناول الفلاسفة والمفكرون العراقيون قضية الصدفة والعادة من منطلق تأملي نقدي عميق في سياق المجتمع العراقي المركب بين التقاليد والعصرنة.
علي الوردي، في مؤلفاته الاجتماعية، أبرز كيف أن الفرد العراقي يولد في بيئة «مهيمنة بالصدفة الاجتماعية»، فالمولد في عائلة، طبقة، وبيئة ثقافية محددة لا يملك حيالها خيارًا، وأن هذه الصدفة تُشكّل «النشأة الاجتماعية» التي تحدد الكثير من توجهاته وسلوكياته. كما أكد الوردي أن العادة في المجتمع العراقي ليست مجرد سلوكيات متكررة، بل هي «آليات دفاعية ضد التغيير والاختلاف»، تجمّد العقل وتعيق الفعل الحر. مدني صالح، من جهته، ذهب إلى أن «الصدفة الاجتماعية، والارتباط بالعادة، يشكّلان في العراق منظومة ضاغطة تُقيّد إمكانيات التحرر الفردي والاجتماعي»، مبرزًا أن هذا الواقع ينجم عن تراكمات تاريخية وثقافية عميقة. وفي هذا الإطار، أقول: «الصدفة والعادة ليستا مجرد ظواهر، بل منظومة متكاملة من القيود النفسية والاجتماعية، التي تجعل من الإنسان سجينًا لظروفه، ما لم يملك وعيًا نقديًا لمواجهتها».
2. الرؤية العالمية
في المقابل، تناولت الفلسفة الغربية المعاصرة هذا الموضوع من منطلق وجودي نقدي وفلسفي واسع.
مارتن هايدغر، عبر مفهومه «الوجود الملقى» (Geworfenheit), أبرز أن الإنسان يبدأ حياته في ظروف مفروضة لا يمكن اختيارها، لكنه لا يزال يملك إمكانيات التحرر من خلال ما سماه «الوجود الأصيل»، الذي يقتضي وعيًا نقديًا وإرادة فعلية للخروج من العشوائية. حنّة أرندت، من جانبها، ركّزت على «الفعل» كشرط أساسي لإنسانية الإنسان، معتبرة أن الفعل الواعي والمقصود هو الذي يخلق التاريخ، ويحرر الإنسان من براثن «العادة» و«الروتين». زيغمونت باومان قدم تصورًا للمجتمعات «السائلة» حيث تغدو العلاقات والوعي مؤقتين ومتحولين، ما يجعل الصدفة والعادة عناصر أكثر تعقيدًا في تشكيل الوعي الحديث، ويدفع الإنسان إلى البحث المستمر عن معنى الحرية والفعل.
وبهذا، نجد أن الفلسفة العالمية تقدم أدوات تحليلية قوية لفهم وتجاوز الصدفة والعادة، من خلال التركيز على الوعي النقدي والفعل المقصود، وهو ما يفتح نافذة أمل للتحرر.
خامسًا: مقترح نظري للتجاوز: بناء وعي نقدي وفعل حر
في مواجهة ثنائية الصدفة والعادة، التي تقيد الفعل الإنساني وتجعله أسيرًا لأطر لم يختَرها، ينبثق الإشكال الفلسفي المركزي: كيف يمكن للإنسان أن يتحرر من هذا القيد المزدوج، ويستعيد قدرته على الفعل الواعي؟
يستند هذا المقترح النظري إلى مبدأين أساسيين:
1. تفكيك المسلّمات الموروثة
إن الخطوة الأولى في التحرر تبدأ بفعل نقدي حاد تجاه كل ما تلقاه الإنسان عبر الصدفة، فليس كل ما وُرِث صالحًا للبقاء، ولا كل ما رافق النشأة ضرورة لا يمكن تجاوزها. كما أقول:
ليس من حرية حقيقية أن تعيش في ظل افتراضات لم تُختبر، أو أن تمضي في حياة مُرسمة قبل أن تُفكر بها. ينبغي أن يتحول الإنسان إلى ناقد دائم للموروث الثقافي والاجتماعي، مفرّق بين ما يخدم حياته ووجوده، وما هو عبء يمنعه من النمو والتطور.
2. كسر دورات التكرار والروتين
العادة، التي تمثل الدوران في حلقة مفرغة من السلوك والتفكير، تحتاج إلى استراتيجية منهجية لكسرها، عبر ممارسة فعل واعٍ متكرر يقتحم هذا الروتين، ويمارس فيه حرية الاختيار لا الإجبار.
يُعدُّ إدخال الوعي النقدي في الحياة اليومية وتشكيل عادات جديدة قائمة على الفعل المقصود هو الطريق إلى التحرر. كما أكدت حنّة أرندت على أهمية الفعل في إحداث تغيير جوهري، حيث إن الفعل ليس مجرد حركة، بل هو إعلان وجود إنساني مميز.
3. إعادة تعريف الحرية
الحرية ليست غياب القيد فقط، بل هي القدرة على اتخاذ القرار الواعي المبني على الفهم الكامل للشروط المحيطة، وتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
وهنا أقول: الحرية ليست فراغًا من القيود، بل هي ممارسة مستمرة لإعادة كتابة قواعد اللعبة التي وُضعت لك.
4. بناء وعي نقدي متعدد الأبعاد
ينبغي أن يتخطى الوعي النقدي حدود الذات الفردية إلى البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية، فيكون نقدًا شاملًا يواجه الموروثات الاجتماعية التي تُكرس الصدفة والعادة.
5. الفعل الاجتماعي والتغيير المؤسساتي
التحرر الفردي لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع فعل اجتماعي يغيّر الهياكل التي تكرّس الصدفة والعادة، سواء في التعليم، أو الثقافة، أو السياسة. هذا يتطلب وعيًا جماعيًا ومبادرات منظمة ومستمرة.
الخاتمة
إن البحث في ثنائية الصدفة والعادة يكشف عن عميق مأزق الوعي الإنساني بين فرضيات لا اختيار فيها وأفعال متكررة لا نقد لها. ففي الصدفة، يولد الإنسان داخل إطار لا يختاره، وفي العادة، يُكرّس هذا الإطار بأفعال مألوفة تعوق الحرية الحقيقية.
لقد بينّا من خلال الاستشهاد برؤى الفلاسفة العراقيين والعالميين أن هذه الثنائية ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هي بنية وجودية عميقة تُعطل الفعل الإنساني الواعي، وتجعل الإنسان أسيرًا لدائرة مفرغة من التكرار والجمود. لكن لا يعني هذا اليأس، بل على العكس، إنّ إدراك هذه الحقيقة هو الخطوة الأولى نحو التحرر. فالوعي النقدي، وممارسة الفعل الواعي، وإعادة تعريف الحرية، هي مفاتيح كسر القيد المزدوج، وبناء ذات حرة قادرة على صنع التاريخ بدلاً من أن تكون مجرد تابع له.
كما أقول: لا يكفي أن تُولد، بل يجب أن تعيش بإرادة، لا أن تموت وأنت نسخة من صدفة وعادة.
ولذلك، فإن الدعوة إلى إعادة قراءة البدايات، ومساءلة النهايات، ورفض الاستسلام للموروثات الجامدة، هي مشروع إنساني لا يقل أهمية عن أي مشروع تحرري آخر. في الختام، يظل الفعل الإنساني الحر أملًا متجدّدًا، يتطلب الشجاعة والإرادة، لكنه وحده الذي يُحرّر الإنسان من أسر الصدفة والعادة، ويفتح أمامه آفاقًا رحبة من الإمكانيات اللامحدودة
***
الكاتب: سجاد مصطفى حمود







