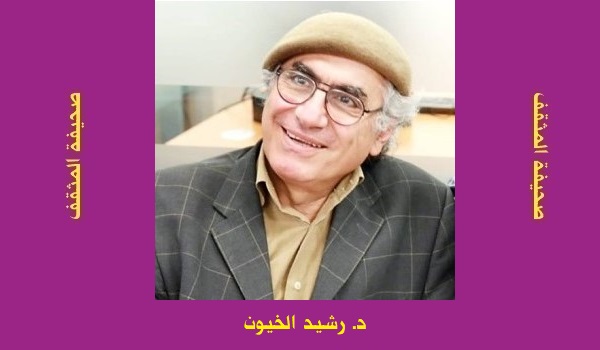قضايا
مصطفى غلمان: الاستبدادُ عالميّا وبِروح عربية

الإقبال على إعادة محاولة فهم "الاستبداد"، ليس استثناء زمنيا، أو رافعة منذورة لتصيد الفراغ من أحداث تجبر العالم على النظر البعيد والانتظار الحاسم لعواقب شديدة العتمة.
لقد كان "الاستبداد" كحالة فلسفية متعاقبة وسيرورية، متحركا ومتشابكا، وأحيانا غامضا ومغلقا، يحتاج دوما إلى تفكيك متعالي عن طبيعة التفكير ومراوحة التأويلات المتعددة. ولهذا نجد أنفسنا محاطين بالشكوك حول درجاته، وقدراته الخفية، و(برمجياته) الخرافية التي تطبع جزءا كبيرا من تفوقه على نفسيات الإنسان وسلوكياته المتقلبة وتجاويف إحداثياته في الكينونة والمصائر المستتبعة.
إن أهم احتمالات وقوع الاستبداد، كما هو مطبوع في الذهنيات الثقافية والتاريخية، كونه ينتج عن صراع الفعل المرضي للسلطة لدى الحاكم، أو "الحكومة"، ما يشكل نسقا طبائعيا عنيدا، يراكم الخيبات والضلالات واللا عدل وتكريس الفساد وإغراق المجتمع بالنظام الفرداني الاستحواذي، وتعليق كل أشكال قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية؟، وهو أمر عكف معظم الفلاسفة والمفكرين على تحليله وشرحه، وتقريضه وتنكّبه، حتى بلغ الحلقوم، وانتهى في تخوم علوم النفس المرضي وأراجيفه، فلم يبق سوى النزوع إلى تعليق جثثه على حبل النفض والاستغفال.
ولم يصر الشعب المنقاد المستسلم، شعبا "توكليا" و"جاهلا" وفاقدا للهمم ومنشغلا بمعيشته البهيمية البدائية، بعيدا عن الحرية الفكرية والأخلاقية، إلا لأن المستبد أسير قفص التعظيم وهوى النفس، وما وُجِدَ الاستبداد إلا لتشويش الحقائق وقلب الموازين، والأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية، كما قال الكواكبي.
وأضحت هذه الظاهرة العولمية القاهرة، مندوحة للقطعيات الكبرى، في عالم السياسة الدولية، ونوازعها المثاقفاتية المشمولة بقوة الصراع الحضاري والانزياحات الحاضرة في النسيج العام للقرية الكونية الصغيرة.
وهي إلى قهريتها المفرطة، وشدة بأسها في آليات الردع الجديدة، ضمن معيارية "التخلف" و"التبعية"، صارت تؤطر الواقع السياسي الدولي، بحمولاته التجزيئية وتفاعلاته مع وضعيات "سلط العالم الجديد" الذي تنظمه وتسيطر على قواعده "الدول العظمى" المسيطرة. وقارئ التاريخ الحديث، يعلم جيدا، أثر هذا "الاستبداد" وحتمياته الفظيعة، ولم تكن اتفاقية سايكس بيكو الموقعة في 1916 ، المعاهدة السرية بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا وتقسيم الدولة العثمانية التي كانت المسيطرة على تلك المنطقة في الحرب العالمية الأولى، سوى دليل على استمرار اصطراع منظومة "الاستبداد الدولي" في تدوير "العالم" وإغاضته على الشكل المطلوب والآمن، بحسب المصالح والمنافع الاستعمارية المعلومة.
ومن ثمة يصبح "الاستبداد" طبعا عولميا متحولا، ينجذب إلى التقليد والمراوحة، ومغايرة الثقافة واستئثار لغة الآخر بكل صروف الحذاقة وسرعة التقييس، وتوطين مخالفة الذات ونقذها، مع التفريخ اللازم لتقبل تشويه الذاكرة وتحجيم قيمها وأخلاقها.
والعالم الآن، يهيأ لنزوع استبدادي أكثر قتامة ومسخا مما انجلى في قرون غابرة. فقد توسع افتراق الاستبداد بالحدود الجغرافية وبالعددية الديمغرافية للأوطان المستقلة بحدودها المفترضة. واستقصدت الحاضنة العقلية والوجدانية للشعوب، لتكون أحوازا بديلة للقارات الكونية المشدودة بمؤثرات وخلفيات أيديولوجية وسيكولوجية فتاكة، تسكر أدمغة التابعين الخانعين، وتجمد أوردة عروقهم، وتحاصر أفكارهم وأحلامهم وخيالاتهم، وتروض في أقصى مواجهاتها الصعبة مناطق الارباك والتشويش، حتى آخر الحسم، الذي يصل السكين بالعظم والقشرة الدقيقة بمخ المآل الحتف؟.
ومن قتامة هذا الغزو الجبروتي الكذوب الأفاق، أن يركب المثقفون ونخب المجتمع موج الكمين، فلا يكاد يرى من كثرة الغيم والشبورة، من يكون القدوة، ومن يحمي الحمى، ومن ينثر العدل، ومن يحفظ الكرامة ويصونها، ومن يقاوم العسف والإذعان، ومن يكسر شوكة الاستبداد ؟.
ذلك أن الاستبداد/ الموت الأسود الآن، أغلق مسامع كل شيء، مما كان يطلق به سحر البروبجندا قبلا، ك "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية" وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والرحمة... إلخ، متساقطا عبر واقع استعباد العالم وإحالته على السجن، بكل معاني الوحشية والتطويع والتركيع والتجويع والإبادة والتهجير القسري. وما عاد لنا اليوم، سوى العودة مجددا إلى اقتفاء أسرار تقشير بصل "الاستبداد" وتوسيع دياجيره، حتى يكون طعما مستحضرا لتجميل صورة "الغرب" النكوصي وتابعه "العربي" الطائع، الذي استنفذ وجوده الحضاري وأعادنا إلى الصكوك الأولى من وجع التخلف والقصور والشذوذ عن آفاق الممكن وحتمياته في الصيرورات والسنن الكونية.
***
د. مصـطـــفى غَـــلْمَــان