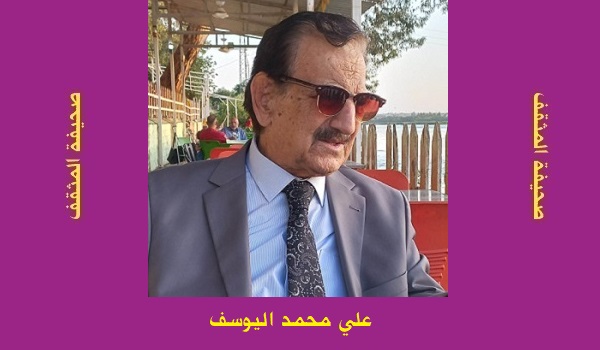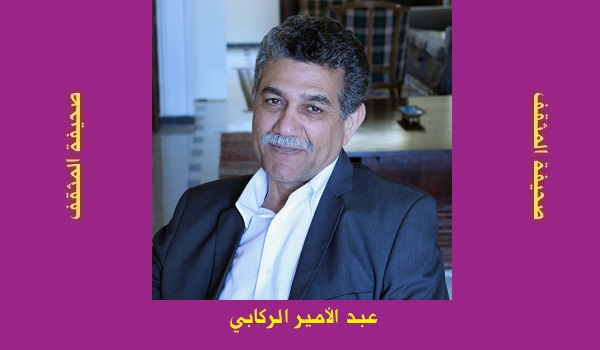شهادات ومذكرات
عدنان حسين أحمد: موجات مرتدّة.. سيرة ذاتية صادقة

بعيدًا عن التنفّج والتكبّر والغرور
بالتعاون مع نادي حبر أبيض البريطاني نظّم مركز لندن للإبداع العربي أولى محاضرات المشغل السردي بلندن التي تمحورت على السيرة الذاتية للقاص والروائي والكاتب الصحفي زهير الجزائري التي انضوت تحت عنوان "موجات مرتدة" بأجزائها الثلاثة "النجف والطفولة، بغداد والستينات"، "ذكريات فلسطينية" و "العودة للعراق" ونظرًا لطول هذه السيرة الذاتية التي انطوت على مذكرات ويوميات أيضًا فإننا سنتوقف عند الجزء الأول فقط الذي بلغ 377 صفحة، وسوف نعرّج على الجزأين الثاني والثالث عند صدورهما لاحقًا كي نغطي غالبية المحطات التي مرّ بها زهير الجزائري كصحفي، وقاص، وروائي، وشيوعي معارض لفكر البعث، وإنسان مُرهف الحسّ والمشاعر قبل هذه الصفات والعناوين الأدبية والفكرية آنفة الذكر.
إذا ما أردنا أن نضع كتاب "موجات مرتدّة: النجف والطفولة، بغداد والستينات" للقاص والروائي زهير الجزائري في مشغلنا السردي فإنّ علينا أن نمسك بالعصب النابض لهذا السِفر الذي ينطوي على مذكّرات ويوميات وأحداث تغطي حياة الكائن السردي منذ عام 1943 في أقل تقدير وحتى يوم الناس هذا.
ما الذي يميّز هذه السيرة الذاتية عن غيرها من سِير الكُتاب العراقيين أو العرب على وجه التحديد؟ هل أنّ ما يميّزها هو الشكل أم المضمون أم اللغة المجنّحة أم أنّ هناك أشياءَ أخرى عصيّة على التوصيف؟ ولكي لا نشتطّ في الكلام أو نتوسع كثيرًا نقول إنّ ما يميّز هذه السيرة عن غيرها من السِير الذاتية أنّ كاتبها صادق وصريح إلى درجة كبيرة ولعله قال كل شيء تقريبًا إلّا باستثناءات محدودة سنأتي على ذكرها في الوقت المناسب.
وبما أنّ قراءاتنا متقاربة إلى حدٍ ما فإنها ستسهِّل الوصول إلى بعض الاستنتاجات المنطقية. فحينما يتحدث عن الروائي العراقي غائب طعمة فرمان لا يقع في مطب المبالغة أو التهويل وإنما يقول بصراحة تامة :"حينما تحدث لجمهور عربي ارتبك خجلًا فضرب المايكروفون في أول حركة من يده وتعثّر كثيرًا في الحديث على عكس تدفقه في الكتابة"(ص، 324). وهذا التعثّر هو نفسه الذي لفت انتباهي حينما شاهدت الفيلم الوثائقي المعنون "غايب، الحاضر الغائب" للمخرج قاسم عبد إذ صعقتني لغته الضعيفة المهلهلة التي لا تتناسب مع قامة أدبية بحجم غائب طعمة فرمان فأيقنت لحظتها بأنّ الجزائري يقول الحقيقة كما هي عارية من رتوش المجاملات والنزعات الإخوانية. أو حينما يتحدث عن عفوية الشاعر جان دمّو وصراحته وآرائه الصادمة بكل شيء تقريبًا. فذات مرة سأله الجزائري عن لوحة "صهيل الحصان المحترق" لفايق حسين وهي عبارة عن ليفة حمّام أُلصقت على الكانڨاس وخلفها ألسنة نار فأجاب بشكل خاطف وسريع "تجربة مكثفة"!. وهذا الأمر ينسحب على تشخيصه لغالبية الشخصيات التي عرفها أو رافقها ردحًا من الزمن أمثال سعدي يوسف، ويوسف الصايغ، وفاضل العزاوي، وسرگون پولص، وفاضل عباس هادي وعشرات الأسماء التي يصعب حصرها في هذا المضمار.
يسعى القائمون على المشغل السردي التوقف عند الثيمة الرئيسة للنص الأدبي سواء أكان قصة أم رواية أم سيرة ذاتية. وتأمل الصيغ السردية المُتعارف عليها، وتشخيص ودراسة الميتا - سرد والتعالقات الأخرى التي تُثري النص الأدبي.
لا بدّ من الإشارة إلى مؤثرات الوالد علي هادي الجزائري، المعلّم وعازف العود ومؤدي أغاني محمد عبدالوهاب ولولاه لكان مصير زهير مختلفًا عمّا هو عليه الآن. فقد كان محظوظًا بهذا الأب المتفتِّح ذهنيًا حيث اختار، عن قناعة تامة، الأفندية الخمسة من عشيرته الذين يشاركونه اهتماماته الثقافية والفنية المتحضرة، وتجنب صداقة المُعممين إلّا في حدود المجاملات الضيّقة التي تضطره لمخالطتهم. فمن شبّاك البيت كان زهير يرى والده وحيدًا وسط غابة من العمائم. ولعل غربة الوالد قد انتقلت إلى الابن مبكرًا فلاغرابة أن يبتعد عن الأجواء العامة المكفهرة ليجد نفسه بين أقرانه المعدودين الذين يحتفون بالأدب والفن والثقافة التي لا تنسجم مع العقليات القديمة التي تنبذ كل جديد ومُحدث سواء في التفكير أو السلوك الاجتماعي الذي لم يعهده الآباء والأجداد.
نُفي الوالد علي هادي الجزائري بسبب نشاطه المُعارض إلى "سدّة الهندية" فوُلد زهير في "المنفى". لا يتذكر زهير أنّه رأى والده عصبيًا أو حادّ المزاج وإنما كان يراه ساخرًا، محمّر الوجه بعد كؤوسه الأربع. ولو تجاوزنا تأثير الوالد قليلًا لوجدنا أن زهيرًا قد صنع نفسه بنفسه بعد جرعة الوالد الكبيرة. كما كان يتوفر على خصال غريبة أبعدته عن التنفّج والتكبّر والغرور.
لا يدّعي زهير ما ليس فيه، ولا يتبجح بمَلَكاته الدراسية حيث يقول بالفم الملآن:"كنتُ واحدًا من أكسل التلاميذ. أكرهُ الدرس فأشرد بعيدًا عن كلام المعلّم"(ص،23). وسوف نعرف أنّ زهير الجزائري لا يميل إلى تقنية "الحفظ والاستظهار" وإنما كان يميل كليًا إلى البحث والتحليل وامتصاص المادة المعرفية والتشرّب بها.
إذا أردنا أن نقسّم حياة زهير الجزائري إلى محطات مهمة فإن انتماءه إلى اتحاد الطلبة سنة 1957م وهو في سن الرابعة عشرة هو المحطة الفكرية الأبرز التي تؤشر على أنّ اختياره للشيوعية لا يخلو من مجازفة كونه يعيش في مدينة "مقدّسة" يعتبر أبناؤها هذا الحزب مُلحدًا وكافرًا وما إلى ذلك من توصيفات مشينة تُحرّض الآخرين وتؤلبهم عليه. أمّا المحطة الثانية فتتمثل في كتابة الرسائل العاطفية لشباب المحلة حيث كان ينصت إليهم ويدوّن مشاعرهم الداخلية نيابة عنهم. وإذا ما وضعنا مرحلة الطفولة والصبا جانبًا فإن تركيز الكاتب سينصبُّ على جيل الستينات النجفي الذي يتألف من ثمانية أدباء وهم على التوالي: عبدالإله الصائغ، عبدالأمير معلة، حميد المطبعي، حميد سعيد، زهير الجزائري، عبدالرضا الصخني، موسى كريدي وجاسم الحجاج". كما يتناول العديد من أسماء الجيل الستيني في مدن ومحافظات العراق الأخرى وخاصة العاصمة بغداد وكركوك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ربما تكون مجلة "الكلمة" هي الإنجاز الأهمّ لجماعة الستينيين ليس في النجف فقط وإنما في عموم المحافظات العراقية فقد أصدروا العدد الأول مجلة "الكلمة" سنة 1967م ولم تتوقف إلّا عام 1974م بعد أن تجاوزت أعدادها الثلاثين عددًا وهي "تهتم بالأدب الحديث ولا تلتزم به تعبيرًا بالضرورة" وقد أصبحت منبرًا للجيل الستيني في العراق برمته.
نتعمّق أكثر بشخصية الجزائري فنعرف أنّ قراءاته وجودية وميوله يسارية، بدأ بدراسة اللغة الألمانية في كلية اللغات بجامعة بغداد. كان يرغب بدراسة الهندسة المدنية والفنون الجميلة لكن معدله الضعيف دفعه إلى القبول بدراسة اللغة الألمانية وأحب طبيعة الحياة المتفاعلة في الجامعة حيث "كان المثقف الحكّاء أكثر جاذبية من الوسيم الثري"(ص، 116)
تتعدد الثيمات الرئيسة والفرعية في هذه السيرة من بينها عودة الراوي إلى الحزب وأنّ جيل الستينات هو جيل نغل بلاء آباء ويأخذون على رموزهم اهتمامهم بالموضوع السياسي والاجتماعي على حساب الذات التي كانت موضوع الستينيين المفضّل. أراد الستينيون أن يتحرروا من تجارب أجيال سبقتهم وأن يتخلصوا من تقاليد الشعر العمودي وغنائية الخمسينات. نشر فاضل العزاوي قصائد ميكانيكية، وتحرر الجزائري من المكان حينما دخل عالَم الحُلُم في قصة "النجوم الصدئة".
يصف الجزائري سنواته الثلاث في حياته الوظيفية بالأتعس "لأنها سنوات التخاذل والتنازلات والزيف وستبقى هذه السنوات مؤرقة بتعذيب الضمير"(ص، 255). فيقدّم استقاله ويقرر أن يغادر روتين الحياة المميتة ويقفز إلى العالم المتناقض المتحرك.
تتضمن هذه السيرة العمل في مؤسستين متناقضتين وهما مجلة "الإذاعة والتلفزيون" البعثية وصحيفة "طريق الشعب" الشيوعية حيث ينفر من الأولى ويجب الثانية ويندمج فيها. لقد كتب الجزائري في العديد من الحقول: السينما، المسرح، الأدب، الآثار متفاديًا الجد الكامن في السياسة متحايلًا بالألغاز على السلطة التي تريد أن تطوّعهم.
ينطوي هذا الكتاب على شذرات جميلة سواء داخل العراق أو خارجه ففي طشقند يتحدث عن الهزات الأرضية والهاويات التي تبتلع أحياءً كاملة بسكّانها. ويمكن أن نُدرج بعض آرائه بمدن أخرى مثل بيروت ودمشق وعمّان وبوخارست وبراغ وموسكو وما سواها من مدن وحواضر عربية وعالمية. تتناول السيرة انهيار الجبهة الوطنية وإعدام عدد من الشيوعيين شنقًا أو رميًا بالرصاص لأنهم لا يريدون حلفاء وإنما خدم في مضايفهم. كما يسلّط المؤلفُ الضوء على ملاحقة واعتقال وتعذيب العديد من الأدباء والكُتّاب الشيوعيين من بينهم عبدالمنعم الأعسم، وصباح الشاهر، وفاطمة المحسن، وعبدالحسين زنگنة. في 19 / 5 / 1979م يختفي الراوي في أحد البيوت ويصل إليه نسيبه كاظم شبّر ويضع أمامه جواز سفر مزور ويخبره: "أنتَ منذ الآن لستَ أنت، انسَ زهير وأدخل ذاتًا جديدة؛ تاجر أردني اسمه ناظم كمال"(ص، 374).
***
عدنان حسين أحمد - لندن
....................
1- مركز لندن للإبداع العربي تديره الشاعرة دلال جويّد.
2- نادي حبر أبيض الريطاني يرأسه الشاعر جمال نصاري.