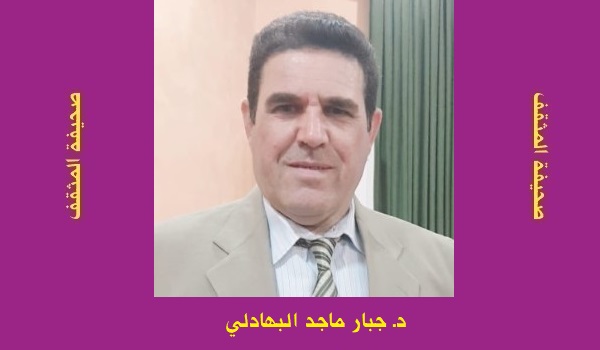تجديد وتنوير
عبد الأمير كاظم زاهد: المعوق الطائفي لصيرورة المجتمع المدني

لقد خاضت البشرية على طول تاريخها تجارب طويلة وقدمت تضحيات بالغة لاجل ان تحقق لعيشها على هذه الأرض الرفاه والسلام والأمان ويسود القانون والحقوق والحريات المدنية عالمها وكان جهدها في العالم الغربي (أوروبا وامريكا) قد توج بصدور الشرعة الدولية لحقوق الانسان الذي مثلّه الإعلان العالمي للحقوق الصادر في 10 / كانون الأول / 1948 وما تلاه من تشريعات وقوانين دولية، وقوانين خاصة بالدول حول تطوير حق الانسان المطلق في الحياة والكرامة والامن والتعليم والتكامل وأقيمت الحياة المدنية في الغرب على هذه الشرعية، بيد ان اكثر ما ينتقد به الغرب ازدواجية التصرف فهو من جهة يطبق بحرص لائحة الحقوق في بلدانه، ويهدرها تماما عندما يتعامل مع بلدان العالم الثالث او بقية بلدان العالم الأخرى.
اما في العالم الإسلامي فان تاريخ هذه البلدان ينطوي على تراث نظري قيمي رفيع من الحقوق والحريات ممثل بالشرعة الإسلامية التي اسسها القرآن الكريم والسيرة النبوية وسرة الائمة في معطياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية، سواء كانوا حكاما او في سلوكهم كمعارضين للسلطات او في سلوكهم كمواطنين ضمن تجربة سياسية.
بيد اننا – بكل اسف – يجب ان نعترف بان التجربة السياسية للخلافة الإسلامية (بدءا من العصر الاموي – حتى سقوط الخلافة العثمانية 1924 م) كانت تجربة غير محمودة من جهة الممارسة الحقوقية وتوفير الحريات المدنية للمواطنين فالذي وجد في هذه التجربة فترات قصيرة جدا توفرت فيها بعض الحقوق والحريات ولكن الى جنبها فترات طويلة وممتدة كانت السلطات قد صادرت فيها الحريات واشاعت سياسات القمع والاستبداد السياسي والديني.
لكن ذلك: لم يجعل بعض الفقهاء واهل العلم والمفسرين والكلاميين متجاوبين من سلطات الاستبداد والتخلي عن تأسيس لائحة حقوق مدنية وحريات مستمدة من الشريعة الإسلامية بحيث أصبحت اراء هولاء العلماء لائحة حقوقية تفوق الشرعة الدولية الامام زين العابدين والقاضي عبد الجبار الهمداني وابن مسكويه وابن رشد
وهذا يمكّنني من القول ان لائحة حقوق الانسان الإسلامية نظريا ربما تنافس اللائحة الدولية التي شرعت عام 1948، والتي استندت الى الفلسفة الليبرالية الفردية وتتفوق على قيمها في مجال حقوق الانسان والحريات المدنية سواء كان مصدرها الفلسفة الليبرالية الفردية، اوالفلسفة الهيجلية الماركسية.
وايا كان الاختلاف او عدم التوافق في المنطلقات والمسارات والاهداف بين هذه الفلسفات وما ينتج عنها من حقوق وحريات ومصالح إنسانية، فان ما تلتقي عليه هذه المنظومات مجموعة أمور منها (الاتفاق على حق الانسان في الحياة، وحق الانسان في اختيار المعتقد والتعبير عنه) فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) وعن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) قال: (الانسان بنيان الله لعن الله من هدم بنيانه) . فالانسان صنيعة الله، وهو الذي وهبه الحياة فصار حق الانسان في الحياة حقا فطريا، وحقا شرعيا لا يجوز سلب هذا الحق منه – تحت كل الظروف – الا ما نصّ القانون عليه لوقف (الاعتداء على النفس بتشريع القصاص في الشريعة)، وان لكل انسان الحق في اتخاذ عقيدة له والاعتزاز بها والتعبير عنها بكل اشكال التعبير – شرط عدم الاعتداء على عقائد الاخرين ودياناتهم.
ونصت المادة الثالثة من اعلان حقوق الانسان الدولية 1948(ان لكل فرد حق في الحياة، وحق في الحرية، وحق في الأمان) وجاء في المادة التاسعة عشر من الإعلان (ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير).
ومجتمع مثل ما تنص عليه نظريات المسلمين الحقوقية وتسوده هذه الرؤية القيمية الفلسفية التي تدعو الحكام وعموم الانسان الى تكريم أخيه الانسان واحترام اختياراته الفكرية.. هو الأصل الذي خلق الله الناس عليه وجعله المجتمع الأول الفطري الذي لم يصب بالتشوهات ولعله الانموذج الذي يجب ان تسعى اليه الجهود الإنسانية المعاصرة في بناء وصياغة المجتمعات المعاصرة فان كانت مجتمعات ذات ثقافة واحدة فعليها احترام ثقافات المجتمعات الأخرى وان كانت مجتمعات تعددية فيجب ان تتحول التعدديات الفكرية، والعرقية، والدينية، والمذهبية الى تعدديات التنوع الذي يكّمل بعضه بعضا على وفق نظرية المعرفة النسبية، ويجعل العيش المشترك هو القيمة الارفع والأكثر إحتراما وعلوا على كل قيم المجال المختلف فيه
فالاثنيات على وفق مبدا لا اكراه على عقيدة لاتجبر غيرها على الاعتقاد بما تعتقد، بل تحاول جمع المشترك الفكري والعقائدي والتوافق على (المختلف فيه) بان يكون العيش المشترك هو المهيمن والدافع الى تكييف معطيات المختلف فيه عقائديا.
انعكس هذا هو ما نجده في عالمنا الإسلامي المعاصر فاننا نشهد اشتعال اوار الطائفية المقيتة في بلدان هذا العالم على صعيدين: الديني مثل(مصر) والقومي مثل (المغرب العربي) والمذهبي مثل (العراق، سوريا، لبنان)،ومن هنا عرف العالم الإسلامي المعاصر ازمة صدام المعتقدات والأعراف فكانت الطائفية بكل تنوعاتها هي المشكلة الراهنة.
والطائفية نوعان: طائفية عقائدية، وطائفية سياسية.
الطائفية العقائدية: هي توجه حركي توظف المعرفة الدينية ويحولها الى (ايديولوجيه) غالبا ما تكون متشددة ومحتكرة للحقيقة لصناعة واقع سياسي شمولي، او لتحقيق مصالح دنيوية محددة وتعتمد في ذلك على تاويل غير ملتزم بمنهج برهاني وضوابط الإنتاج المعرفي ويغلب على مثيري الطائفية الدينية انهم ثلاث فئات هم (بعض رجال الدين) الذين يثيرون الكراهية والتباعد عن طريق الفتوى التحريضية ودوافع الصراع وحشد السياسيين لحشد الاتباع وراءهم والممولون لاستثمار الأوضاع الناتجة لاستثماراتهم القادمة في ظل جو من الفساد المالي.
مما تقدم يظهر ان للطائفية الدينية صلة بالاستبداد السياسي، وصلة بالتضليل السياسي وصلة بالفساد المالي، والمضمون النهائي لها انها الدعوة لاتجاهات متشددة غرضية
ويظهر: ان الطائفية الدينية بهذا الوصف ليست اتجاهاً دينياً قيمياً روحانياً ينطلق من الايمان ويهدف الى تعزيز الايمان انما هي توجه سياسي فئوي يسعى لتحقيق مجموعة من المصالح.
وتتفرع عن الطائفية الدينية: الطائفية السياسية: وهي عبارة عن ممارسة سياسية تحقق التمييز بين (المواطنين) على أساس المعتقد الديني والمذهبي في الحقوق وفي الحريات، وتنمو: هذه الممارسة حينما تكون السلطة: ذات طبيعة استبدادية فهناك علاقة جدلية بين الاستبداد السياسي وبين الطائفية السياسية فكل يوجد الاخر.
وفي الغالب يتم اللجوء للطائفية السياسية عندما تخفق الحركات السياسية في إحكام القبضة على السلطة (ومن تلك التجارب: التجربة المصرية التي انتهت في 30/6/2013، او عندما تفتقد جهة سياسية الى صياغة برنامج وطني للتنمية والتطوير، او عندما تفشل مجموعة حاكمة في تحقيق الانماء او في عموم إدارة الدولة.
أي: ان الطائفية السياسية تعد كهف الاختباء، او زورق النجاة لمن يفشل في اسعاد الناس او من يمارس سياسات الاستبداد، وبذلك تبدو الطائفية ضداً نوعياً لحقوق الانسان السياسية، وضدا نوعيا للحقوق المدنية والحياة الكريمة المرفهة، بل محرض على سلوكيات العنف فعندما يتحول البرنامج السياسي لمجموعة سياسية من انتهاج للوسطية والعقلانية الى التطرف والقسرية والتمييز الطائفي فانه سيؤسس لمقدمة تكوين حاضنة اجتماعية وسياسية لممارسة العنف سواء صدر من السلطة (الطائفية) على مواطنيها كفعل كما حصل في سياسات ما قبل 2003، او من المقهورين طائفيا ضد سلطة التمييز الطائفي كرد فعل أي ان دورة العنف العقائدي ستكون عبارة عن (حلقة الفعل العنفي ورد الفعل) وبذلك يصبح العنف تصورا متوقعا وممكنا وناتجا عن التصورات الطائفية.
وفكريا فان الطائفية في اول تكوينها تضع الطرف الاخر تحت عنوان أصحاب الرؤية المنشقة ثم تنتقل بهم الى (اتباع البدعة) وتنقلهم من البدعة الى الكفر فتكون الطائفية في مرحلتها الأخيرة شريعة للتكفير ثم تستند الى التكفير حينما تستأصل الاخر.
وكما تقسم الطائفية الناس على فرضياتها الى جماعتين جماعة مع الله واخرى أعداء الله، وتمنح لمن جعلتهم (مع الله !!) حق إبادة واستئصال من اسمتهم (أعداء الله !!) فانها تقسم بلدان الأرض الى ملكوت الله ودولة الشيطان وبذلك تضع الطائفية أساسا دينيا للعنف تحت دواعي اعتقادية او مبررا عقائديا لاستئصال الاخر تحت ذات المبرر.
ونستطيع الجزم بان أي مسار طائفي سينتهي الى العنف الدموي وان بدا في اول وهلة خلافا نظريا، وتمييزا طفيفا في الحقوق والحريات والامتيازات، الا انه جنين قابل للتطور ولديه إمكانية ان يتحول الى خطر يهدد وحدة المجتمعات حينما يجهض من فلسفاتها قيم (حقوق الانسان) عند ذاك يسقط(الدين) الذي يمارس بعض اتباعه هذا الاقصاء الاستئصالي من كونه مشروعا حضاريا ربانيا إنسانيا عالمي النطاق ويتحول الى أيديولوجيا متشددة تبيح لمجموعة من القتلة والعصابيين سلوكيات إجرامية إزاء الانسان والحياة، ويختزل الدين في فئة صغيرة تحوله الى مشروع للهدم والابادة ومنشأ للتخلف، ويفتقد اتباع ذلك الدين – حتى غير الطائفيين منهم – الى ذلك النبض الإيماني والروحي والقيمي ويتحول الى ترقب على أساس الخوف والقلق على الذات وعلى الوجود والحذر من الاخر، فيكون التشكيك بالاخر هو السائد بدل قيم الثقة، والخوف مقابل الاطمئنان النفسي والترقب بدل الانشغال في الإنجاز المدني، والقلق بدل الشعور المستقر بالامن.وان كل هذه التهديدات والتحديات ضد الانسان والمدنية تدور حول (حق الانسان بالحياة وبالوجود) وحقه في التفكير والتعبير وبذلك يتضح ذلك القدر الكبير من التضاد بين حقوق الانسان والتورط في الطائفية.
ويحبط هذا التورط تماما إمكانية قيام مجتمع المواطنة ويصيب رؤية المواطنة بالخلل المصداقي سعيا وراء مجتمع الجماعات والطوائف والعرقيات الى جانب ما يعقد من المسالك للتفكير ببرامج تنموية لدولة مدنية فتنزلق المجتمعات في ظلها الى متاهات الفقر والحرمان والانانية ومجتمع الجريمة، والخفية والمعلنة.
ان كل الاخطار التي تعد تداعيات التفكير الطائفي او معطيات للممارسة الطائفية تتعارض أساسا مع الدعوة التي يبشر بها اتباع الديانات من انهم حملة قيم الرحمة والرأفة والعدل وهم جالبو بركة السماء وحاملو القيم الإنسانية فتحولهم الطائفية الى المؤسسين لمجتمع الشقاء، وامارات الدويلات، ومجتمعات الاحتراب ان لم يكن – مجتمع الفقراء الذين يعيشون تحت رحمة اللصوص والقتلة العتاة.
وفكريا: يتحول الفكر الديني – في خضم الطائفية – كتصور نظري الى رؤية تعبوية سياسية تستخدم الدين لتصنع به عقلا ايديولوجيا دوغماتيا احادي الرؤية وكلما تتسع نطاق هذه الايديولوجيا. تتهيأ ظروف ذلك البلد للدخول في دوامة العنف لذلك فالطائفية هي المقدمة الفكرية الشرطية لتنامي موجات الإرهاب ذلك الخطر الكبير و الممنهج على حق الانسان في الحياة وحقه في اختيار عقيدته ودينيا: فان أي رؤية تعددية تفترض، بل تقر وتدافع عن لا نهائية الطرق الى الله، فالطرق الى الله كما قال الراسخون في العلم متعددة بتعدد انفاس الخلائق في حين ان الرؤية الطائفية تفترض ان طريقها الى الله هو الطريق السليم وبقية الطرق مبتدعة، فهي مؤسسة على انكار حق الاخر الديني او المذهبي في ان طريقه من الطرق الى الله، وبذلك يحتل الطائفيون الجنة وفردوس الله ويوزعونها غنائم على اتباعهم، وتخصص لخصومهم نار جهنم كمأوى لهم.
اما فلسفيا: فان الفلسفة هي (برهان على موضوع واقع في نطاق الشك) والحال الطبيعي: ان كل انسان يرى انه على حق ولكن ليس بالضرورة انه يمتلك كل الحق، بل ليس بالضرورة ان مخالفيه هم باطل محض وهنا تكمن فائدة النسبية المعرفية في حين يرى الطائفيون: انهم يمتلكون الحكمة الإلهية المتعالية وحدهم وبشكل حصري وبهذه المعطيات: يظهر التضاد الموضوعي بين حقوق الانسان والطائفية.
كما يظهر الخطر الواقع فعليا وهو ان الطائفية من مقدمات الإرهاب وإشاعة الرعب، فالإرهاب تنتجه الطائفيات.
- وفكريا فانها تشوه عقائدي يصنع مسلكاً تغييرياً بنيوياً شمولياً في مجتمع ما، ويقوم بغسل الادمغة لصنع إنموذج عقائدي واحد يتمتع بدعوى الصحة.
- وانها قيميا: مسلك غير أخلاقي لانه مسلك انتهازي يدخل بسرعة في المناطق الرخوة معرفيا ليملأ الفراغ، ومسلك احتيالي لان ابرز وسائله الاغتيال الجماعي العشوائي للناس اعتمادا على نظرية التترس كما سماها الغزالي.
وهنا لابد من الإشارة الى ان زمن التأسيس للطائفية في الوسط الإسلامي هو زمن قديم لكن انتاج الطائفية المعاصرة للارهاب المعاصر نشا من جراء المنهجية النصية التلقينية الحرفية التي عمت مدارس (الحجاز) ذات المسلك الوهابي، ثم اتجهت الى المناطق الرخوة (كالسودان وأفغانستان) تحت علم ورعاية ودعم المخابرات الامريكية في تجربة طالبان وتجارب المجموعات السلفية في المغرب العربي ومن حرب المتشددين في أفغانستان ضد السوفييت نشأت ثقة موهومة ان التشدد والطائفية موجة دينية مقابل التطور الحضاري الإنساني وفي حربهم الثانية ضد الامريكان تحولت طائفية الإرهاب من حركة محلية الى نظرية عمل عالمية سرعان ما اتسع نطاقها
وتشير خارطة معهد (Rand) الى انها تؤسس حاليا حول اوروبا والجمهوريات السوفياتية سابقا حزاما هجوميا خطرا فهي تتوجه مرة أخرى لضرب روسيا بعد ان تطلعت الأخيرة لدور دولي، وتصر على حربها الصورية ضد الغرب وتركز على ضرب المسلمين في بلدانهم لمجرد انهم يختلفون معهم في التفاصيل الفرعية.
اما القوى الغربية: التي اشرنا الى تعاملها المزدوج مع قيم حقوق الانسان فإنها تتعامل هي الأخرى مع الإرهاب على أساس ما يحققه لها من معطيات ومن تلك ان الإرهاب والطائفية تحول دون إقامة تجارب دستورية في بلدان العالم الإسلامي، وتؤسس لإقليم جيو سياسي متوتر يصرف ثلث ايراداته على برامج مكافحة الإرهاب، ويضعف الإرهاب الناتج عن طائفية سياسية قوة الممانعة لدول العالم الإسلامي المجابهة للتمدد الغربي في النفوذ واستنزاف تجارة العالم المتقدم لثروات وفرص التنمية في دول العالم الفقير.
وهكذا يعوّق الإرهاب سياسات الطاقة التي هي ثروة المسلمين الحالية والمستقبلية باعتبار ان هذه الدولة منتجة للطاقة، بناء هذا العالم ويكسر ارادتها في امتلاك التقنيات المتقدمة لتحديث التجربة المدنية.
كيف نواجه الطائفية في العراق؟ لعل هذا السؤال هو اهم ما يجب ان نفكر فيه تفكيرا جادا ونضع له تصورا اولياً.
سبل المواجهة:
1. ان تضع المؤسسات الاكاديمية الإسلامية في العراق، والاقسام العلمية في الكليات ذات التخصصات الإنسانية حقائق أساسية كمنطلقات لمشرع وطني (فكريا وفلسفيا)، ثم يتحول هذا التصور الى برامج عمل تدريسية، وثقافية، ليكون البلد على أعتاب صناعة العقل السياسي الوطني غير القابل للانزلاق بالطائفية وذلك:
ا/ بان نقوم بمراجعة المقررات الدراسية (للمراحل كافة) والتشديد على قيمة الانسان التي تعلو على القيم الاخرى.
ب/ وإزالة كل الإشارات التي تشجع على الغلو في التصور الفئوي او المذهبي او الديني او الجهوى على حساب (حق الانسان في الحياة وحقه في اختيار العقيدة).
2. تشريع قانون يجرّم الخطاب الطائفي، والدعوات التحريضية ضد السلم الوطني، ويعاقبها عقابا رادعا أيا كانت الوسائل التي تتوسل بها.
3. إصدار الفتاوى الدينية التي تحرّم أي خطاب تحريضي وطائفي وتجيز للسلطات محاسبة أصحابه ومعاقبتهم ومنعهم من تشويه الوعي وبث صناعة الموت.
4. دعوة المؤسسات الثقافية وصناع الراي العام ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة الخلّاقة في حملة (عراق بلا طائفية) ببرامج فاعلة، لان الطائفية لا تكون بديلا عن الوطن ولا تبني وطنا وان يخطط لهذه الحملة وتنفذ على مراحل.
5. مد الجسور مع المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي كالازهر الشريف والعالم اجمع كالفاتيكان والمساهمة في المسعى الى تقارب الأديان وتعارف الثقافات وتأصيل الحوار والتفاهم والتضامن مع حقوق الانسان.
6. المساهمة في حملة دولية حقوقية لتجريم الدول والجماعات المثيرة للطائفية والإرهاب، والممولة لها ومقاضاة هذه المؤسسات في القضاء الدولي واعتبارها من جرائم الإبادة، او الجرائم ضد الإنسانية او التطهير العرقي.
واعتقد: ان هذه الإجراءات ضرورية للمواجهة الحالية لان بلدان عالمنا الإسلامي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى في دمار العبث بمصائرها ومستقبلها من فئات جاهلة ومعصوبة العين والعقل وغير قادرة على التفكير الجاد، لم تجد وسيلة للتعويض عن بلادتها ومعنويتها الا إشاعة التشدد الطائفي بوصفه عنصرا (سرابيا جاذبا) لمجموعات يسهل التغرير بها.
***
ا.د. عبد الأمير كاظم زاهد