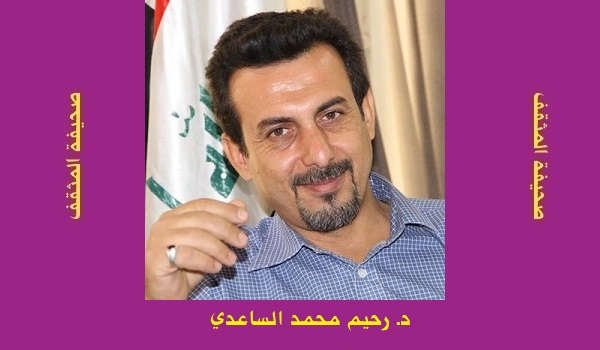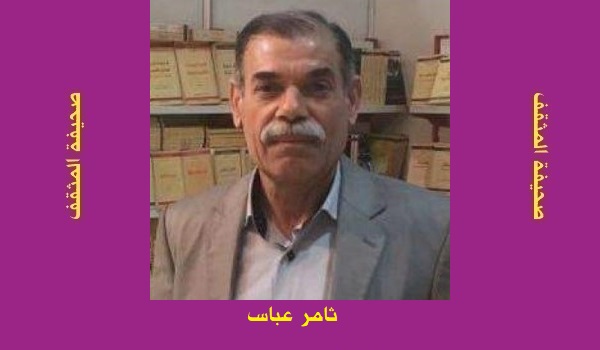تجديد وتنوير
محمد السليطي: الدين حين يختنق بالسياسة.. لماذا يجب أن ننتقد الدين السياسي؟

مقدمة: بين الرسالة والأداة
ليس من وظيفة الدين أن يؤسس سلطة، ولا من مهمته أن يُسيّر شؤون الدولة. الدين في جوهره دعوة للسمو الروحي، وتحفيز للأخلاق، وإطار للتأمل في الغاية والمعنى. لكن حين يُختطف الدين ويُحشر في أروقة الحكم، يتحوّل من رسالة إلى أداة، ومن دعوة إلى سلطة، ومن نور إلى عصا بيد الحاكم. في هذا السياق يصبح نقد "الدين السياسي" ليس خيارًا فكريًا، بل واجبًا أخلاقيًا وفكريًا، من أجل حماية الدين من التشويه، والناس من الاستغلال.
لم يكن اقتران الدين بالسياسة يومًا مجرد صدفة عابرة، بل ظاهرة متكررة في التجارب البشرية. فمنذ العصور القديمة كانت السلطة السياسية تبحث دائمًا عن شرعية عليا تُحصّن وجودها من النقد والمساءلة. في أوروبا العصور الوسطى مثلًا، تحوّل الدين الكنسي إلى غطاء للاستبداد السياسي، فخضع الناس لسلطة مزدوجة: سلطة الملك وسلطة الكنيسة، حتى جاءت حركة الإصلاح الديني والثورة الفكرية التي فصلت بين المجالين.
وفي التجربة الإسلامية، ورغم أن الإسلام في بدايته لم يقدَّم كدولة مؤسساتية، بل كرسالة دينية وروحية، إلا أن تطور الدولة الأموية والعباسية وما تلاهما جعل الدين جزءًا من شرعنة الحكم. فالمؤسسة الفقهية في كثير من المراحل التاريخية لم تكن مستقلة تمامًا، بل خاضعة أو متداخلة مع مشروع السلطة، تمنحه الغطاء، وتُعيد إنتاج خطاب "طاعة ولي الأمر" باعتباره واجبًا دينيًا.
حين نتحدث عن "الدين السياسي"، فإننا لا نقصد الدين في ذاته، ولا الممارسات الروحية أو الشعائر التي يقوم بها الأفراد والجماعات. بل نعني تحديدًا تحويل الدين إلى أداة سياسية عبر:
- تديين الدولة: حين تُصبح القوانين والسياسات العامة مُعرّفة حصريًا بمنظور ديني تفرضه السلطة.
- أسلمة السياسة: حين تستخدم الأحزاب والحركات السياسية الدين كأيديولوجيا للتعبئة وكسب الشرعية.
- احتكار الحقيقة: حين تحتكر فئة معينة – سواء دولة أو مؤسسة دينية رسمية – تفسير النصوص ومن ثم تُسكت الأصوات الأخرى.
الدين السياسي بهذا المعنى ليس إيمانًا ولا تجربة روحية، بل أيديولوجيا تُستعمل لإدارة الصراع السياسي، ولإضفاء القداسة على قرارات دنيوية.
تكمن خطورة تسييس الدين في أنه يُنتج نوعًا من "الاستبداد المقدس". فالسلطة حين تفرض قراراتها باسم الله، تُصبح عصيّة على النقد، وتحوّل أي معارضة سياسية إلى "كفر" أو "خيانة". هكذا يتضاعف القمع: فبدل أن يكون سياسيًا فقط، يغدو قمعًا روحيًا وأخلاقيًا يطال الضمائر والنيات.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا التداخل يضر بالدين ذاته: إذ يفقد مصداقيته لدى الأجيال الجديدة حين يرونه أداة بيد الساسة، ويغدو عرضة للتآكل الأخلاقي لأنه يُستعمل لتبرير الظلم والفساد. وكثير من مظاهر العلمنة التي شهدها التاريخ الحديث لم تكن نتيجة عداء جوهري للدين، بل كرد فعل على استغلاله السياسي المتكرر.
في واقعنا العربي والإسلامي المعاصر، تتجلى مظاهر "الدين السياسي" بأشكال متعددة:
- دول تُشرعن حكمها عبر مؤسسات دينية رسمية.
- أحزاب ترفع شعارات دينية لتبرير هيمنتها.
- جماعات مسلحة تحتكر "الشرعية الإلهية" وتُقصي الآخرين.
وفي كل هذه الصور، نجد أن الضحية الكبرى هي: حرية الإنسان، واستقلالية الدين، ومصداقية الخطاب الأخلاقي.
إن نقد الدين السياسي اليوم ضرورة ملحة، ليس لأنه يُعطل مسار السياسة فقط، بل لأنه يُعطّل إمكان تجديد الدين نفسه. ما دام الدين أداة للسلطة، سيظل أي إصلاح ديني مشبوهًا أو متهمًا، وسيظل العقل مُحاصرًا. وحده النقد الصريح والشجاع يمكن أن يفتح الباب أمام عودة الدين إلى جوهره: دعوة للسمو، لا وسيلة للاستغلال.
من الدين لله إلى الدين للسلطة
أ. الدين كتجربة حرّة
في أصل نشأته، كان الدين دعوة مفتوحة للضمير الإنساني، لا يحتاج إلى قوة قهرية أو جهاز سلطوي ليفرض نفسه. هو تجربة روحية تنبع من الداخل، حيث يجد الفرد في الصلاة والخشوع والذكر سبيلًا للسمو والتطهر، لا أداة للانضباط السياسي. الدين لله يعني أن العلاقة قائمة على الحرية: الإيمان خيار، والطاعة لله ليست مرسومًا سلطويًا بل انقيادًا قلبيًا نابعًا من القناعة.
هذا ما نلمسه في البدايات التأسيسية للأديان. فالمسيحية الأولى كانت حركة إيمانية صغيرة مضطهدة من قبل الإمبراطورية الرومانية، والإسلام في مكة كان دعوة أخلاقية وروحية تواجه الطغيان المكي من خارج بنية السلطة، لا من داخلها.
ب. الدين حين يلبس ثوب السلطة
لكن التحول يبدأ حين تكتشف الدولة أن الدين يملك قوة رمزية هائلة، وأن بإمكانها استثمار هذه القوة لبناء شرعيتها. هنا ينتقل الدين من فضاء الحرية إلى فضاء السلطة. لم يعد "نداءً من السماء" بقدر ما أصبح "مرسومًا من القصر"..يتجلى هذا التحول في ثلاث صور أساسية:
1. الصلاة كإعلان ولاء: حين تُحوَّل الجماعة الدينية إلى طقس سياسي. ففي الإسلام الأموي، صارت خطبة الجمعة تُفتتح بالدعاء للخليفة، لتصبح الصلاة فعلًا مزدوجًا: عبادة وبيعة.
2. الخطبة كمنصة دعائية: لم تعد موعظة لتذكير المؤمنين بالله، بل خطابًا رسميًا ينقل سياسات الدولة إلى الناس. وفي التاريخ الإسلامي، كان عزل أو تعيين الخطباء مرتبطًا بموقفهم من السلطان.
3. الفتوى كمرسوم قانوني: الفقيه لم يعد باحثًا حرًا عن الحكم الشرعي، بل موظفًا في جهاز الدولة يُنتج فتاوى تخدم حاجاتها.
ج. أمثلة تاريخية على هذا التحول
المسيحية مع الإمبراطور قسطنطين (القرن الرابع): انتقلت من ديانة مضطهدة إلى دين الدولة الرسمي. هذا التحول منح الكنيسة قوة هائلة، لكنه سلبها حرية الروح، إذ صارت أداة لإمبراطورية تريد توحيد شعوبها باسم الصليب.
الإسلام الأموي والعباسي: جرى تحويل خطبة الجمعة إلى أداة سياسية، بحيث تُلعن فيها المعارضة، ويُعلن الولاء للخليفة. الإمام مالك نفسه تعرّض للتعذيب لأنه رفض إصدار فتوى تجبر الناس على بيعة بعينها.
العصر الحديث: في الأنظمة الجمهورية ذات الطابع الديني (إيران مثلًا)، صار الدين مرجعية رسمية تفرض نفسها عبر أجهزة الدولة، لا عبر قناعة المؤمنين.
د. من المقدس الحر إلى المقدس المؤدلج
التحول من "الدين لله" إلى "الدين للسلطة" يعني أن المقدس لم يعد مجالًا للبحث عن الله، بل مجالًا لتثبيت الدولة. هنا نفرق بين:
- المقدس الحر: حيث يتوجه الإنسان إلى الله بعيدًا عن وصاية السلطة.
- المقدس المؤدلج: حيث يُختزل الدين في خطاب رسمي، ويُختطف الله ليُستخدم كحارس للعرش.
الفيلسوف سبينوزا تنبّه إلى هذه النقطة حين فرّق بين الدين بوصفه أخلاقًا تقود إلى الحرية، والدين بوصفه مؤسسة تابعة للسلطة تنتج الطاعة. وكانط ميّز أيضًا بين "الدين الأخلاقي" (القائم على العقل الحر) و"الدين الكنسي" (القائم على الطاعة العمياء).
هـ. النتائج المترتبة على هذا التحول
حين يتحول الدين إلى سلطة، يفقد جوهره الروحي، ويخسر المجتمع حريته في الإيمان. وتكون النتيجة:
1. قتل حرية الضمير: لم يعد الإيمان اختيارًا، بل واجبًا مفروضًا.
2. تسييس الطقوس: تتحول العبادة إلى إظهار ولاء سياسي.
3. عسكرة المقدس: يصبح الدين غطاءً للحروب والتصفيات الداخلية والخارجية.
كيف تُنتج الدولة رجال دينها؟
أ. من الفقيه الحر إلى الشيخ الموظف
في أصل الفكرة، رجل الدين ليس موظفًا لدى أحد؛ بل هو شاهد على الحقيقة، ومجتهد في النصوص، وناقد للسلطة إن انحرفت. لكنه حين يدخل في منظومة الدولة، يتحول من صاحب رسالة إلى أداة وظيفية. يصبح دوره ليس البحث عن الحق، بل تبرير الواقع. لا يعلو صوت الفقيه إلا إذا بارك الحاكم، ولا ينجو إلا الشيخ الذي يطيع.
هذا التحول البنيوي يجعل المؤسسة الدينية جزءًا من جهاز الدولة: ليست مستقلة، بل خاضعة، بل ومُنتَجة بشكل مباشر.
ب. آليات إنتاج "الشيخ الرسمي"
الدولة لا تترك رجال الدين ليكونوا أحرارًا، بل تصنعهم وفق حاجاتها. وهذا يتم عبر ثلاث آليات رئيسية:
1. الانتقاء والتعيين: الدولة تتحكم في المناصب الدينية العليا (المفتي، شيخ الأزهر، المرجعيات الرسمية، مجالس الإفتاء). ومن خلال آلية التعيين، تضمن أن من يصل إلى المنبر هو من ينسجم مع خطابها السياسي.
2. التأهيل الأكاديمي والإداري: الجامعات الدينية الرسمية (الأزهر، الحوزات الممولة من الدولة، كليات الشريعة الحكومية) لا تخرّج علماء مستقلين، بل موظفين مدرَّبين على الانضباط البيروقراطي. فيصبح تكوينهم الديني مشروطًا بلغة "الخدمة العامة" لا بحرية البحث.
3. العقاب والثواب: من يطيع: يُكافأ بالمنصب والراتب والظهور الإعلامي.
من يعارض: يُقصى أو يُشهر به أو يُحاصر ماليًا.
الاستقلال الديني يُعامل كتهمة، والاجتهاد الحر يُترجم إلى "خيانة"، والخروج عن الخط الرسمي يُسوَّق كفتنة أو زندقة.
ج. أمثلة تاريخية ومعاصرة
في العصر العباسي: ظهر "قاضي القضاة" كوظيفة رسمية، بحيث يُنتخب القاضي الأعلى بقرار من الخليفة، ليصبح الدين جزءًا من جهاز الدولة القضائي.
في العثمانيين: مؤسسة "شيخ الإسلام" لم تكن مستقلة، بل ذراعًا رسمية تصدر الفتاوى وفق مصالح الباب العالي.
في إيران المعاصرة: تمت تصفية أو تهميش مرجعيات كبرى مثل السيد شريعتمداري والطباطبائي القمي ومحمد رضا الشيرازي، لأنهم رفضوا الخضوع لمبدأ ولاية الفقيه. فالبقاء ليس للأعلم، بل للأكثر ولاءً.
في العراق: نرى كيف تحولت بعض المرجعيات إلى أدوات بيد أحزاب سياسية، تُستخدم فتاواها لتبرير صفقات السلطة أو منح الشرعية لمشاريع مذهبية.
في السعودية: المؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء) ارتبطت تمامًا بخط الدولة، بحيث تتحرك الفتوى صعودًا أو هبوطًا مع اتجاهات السلطة.
د. التبعية مقابل الاستقلال
المسألة هنا ليست مجرد انحراف أفراد، بل بنية سلطوية: الدولة تنتج رجال الدين كما تنتج موظفيها الآخرين، وفق منطق الولاء لا وفق منطق المعرفة. ولهذا، نجد أن "العالم المستقل" مهدد دومًا بالتهميش أو الاتهام، بينما "العالم الموالي" يجد الطريق مفتوحًا أمامه.
وهنا تكمن خطورة الظاهرة: الدين نفسه يُختزل في خطاب موظف. الفقيه لم يعد مرشدًا للناس، بل موظفًا في قسم العلاقات العامة للسلطة.
هـ. النتيجة: قتل الاجتهاد
حين يُختزل الدين في مؤسسة رسمية، يُقتل الاجتهاد الحر. لا يعود هناك مجال للتفكير النقدي أو إعادة قراءة النصوص. المطلوب ليس "العالم المبدع"، بل "المكرر المطيع". وهكذا، تُغلق أبواب الإصلاح من الداخل، ويتحوّل الدين إلى خطاب جامد يعيد إنتاج السلطة ويمنع أي تغيير.
الدين حين يتحول إلى أيديولوجيا قمع
من أخطر تحولات الدين في المجال السياسي أنه يفقد بعده الروحي والأخلاقي ليُختزل في خطاب قمعي. فالدين السياسي لا يكتفي بأن يكون حارسًا للسلطة، بل يتجاوز ذلك ليصبح أداة أيديولوجية لإسكات الشعوب. أي أنه لا يُستخدم لحماية الإيمان، بل لحماية النظام القائم.
أ. القمع بالنصوص: بين التقديس والتوظيف
السلطة لا تحتاج دائمًا إلى السيف، بل يكفيها أن تجعل السيف "مقدسًا". وهنا تكمن خطورة التديين: تُستدعى النصوص الدينية لتبرير الطاعة وتحريم المعارضة، فيُصبح الخروج على الحاكم خروجًا على الله، ويُختزل الاحتجاج في كلمة "فتنة"، ويُجرَّم الإصلاح بوصفه "مؤامرة".
النص القرآني والحديثي ــ بما يملك من سلطة معنوية ــ يتحول إلى أداة ضبط اجتماعي، بحيث لا يكون الحاكم بحاجة إلى تبرير دنيوي، بل يستعير غطاءً مقدسًا يعفيه من أي مساءلة. وهذا هو ما يسميه ماكس فيبر "الشرعية التقليدية-الكاريزمية"، حيث تُستمد السلطة لا من الكفاءة أو العقد الاجتماعي، بل من نسبتها إلى المقدس.
ب. القمع الرمزي: من بورديو إلى الواقع الإسلامي
وفقًا لمفهوم العنف الرمزي عند بيير بورديو، فإن السلطة الأخطر ليست تلك التي تُمارَس بالعنف المادي، بل بالعنف الرمزي: أي حين يقتنع الناس بأن خضوعهم هو "طاعة لله"، وأن معارضتهم للحاكم "إثم". هنا يتحول القمع من فعل خارجي إلى قناعة داخلية، ويُعاد إنتاج الاستبداد من داخل وعي المجتمع نفسه. وهذا ما حدث في تجارب عديدة:
في العصر الأموي، جرى ترويج خطاب "طاعة أولي الأمر" حتى في ظل ظلمهم، مما حوّل الدين إلى آلية لضبط المجتمع.
في العصر العباسي، استُخدمت "محنة خلق القرآن" لتصفية المعارضين الفكريين باسم الدين، رغم أن القضية كانت سياسية بامتياز.
في أوروبا القرون الوسطى، وظّفت الكنيسة مفهوم "الحق الإلهي للملوك" لتجعل الطاعة للملك جزءًا من العقيدة الدينية.
ج. الأمثلة الحديثة: من الشرق الأوسط إلى العالم الإسلامي
إيران: أي احتجاج يُوصف بأنه "خروج على ولاية الفقيه"، فيُعتبر تمردًا ليس فقط سياسيًا بل عقائديًا، فتُسحق المظاهرات باسم حماية الدين.
السعودية سابقًا: رُوّجت فتاوى "تحريم الخروج على ولي الأمر" كذراع أيديولوجي لإخماد أي حراك، حتى المطالب الإصلاحية السلمية.
العراق: خلال انتفاضة تشرين، صُوّر المحتجون على أنهم "مؤامرة غربية" أو "منحرفون دينيًا"، ليُشرعن قمعهم عبر خطاب ديني-سياسي مزدوج.
د. المفارقة: الدين من تحرير إلى تقييد
الدين في جوهره رسالة تحرير: "فكّ رقبة"، "كلمة حق عند سلطان جائر"، "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". لكنه في ظل التحالف مع السياسة ينقلب إلى أيديولوجيا قمع، حيث تُقتل الحرية باسم الطاعة، وتُصادر الكرامة باسم الحفاظ على الوحدة، ويُعاد إنتاج الاستبداد بغطاء مقدس.
الدين السياسي عدو الإصلاح
أ. الإصلاح كحاجة دينية لا كترف سياسي
الإصلاح في جوهره ليس ترفًا فكريًا ولا مؤامرة غربية، بل هو ضرورة دينية وحضارية. فكل دين يحمل في داخله بذور الإصلاح المستمر، لأن النصوص تُقرأ في سياقات متغيرة، والواقع يفرض أسئلة جديدة لم يعرفها الأسلاف. الأنبياء أنفسهم كانوا مصلحين ضد جمود مؤسسات دينية سبقتهم. وبالتالي، يصبح الإصلاح تعبيرًا عن حيوية الدين وقدرته على التجدد.
لكن في ظل الدولة الدينية، يُختزل الإصلاح في كونه تهديدًا سياسيًا؛ لأن السلطة لا ترى فيه مشروعًا لبعث الروح، بل خطرًا على شرعيتها القائمة على قداسة غير قابلة للنقاش. وهكذا يُحوَّل المصلح إلى "خائن" والمفكر إلى "زنديق"، وتُغلق أبواب التجديد باسم حماية الدين.
ب. لماذا يُخيف الإصلاح الدولة الدينية؟
1. الإصلاح يفتح باب النقاش: الدولة الدينية تريد خطابًا نهائيًا، مغلقًا، لا يقبل إعادة القراءة. أي محاولة للنقاش تزعزع سلطة "الحقيقة الرسمية".
2. الإصلاح يُضعف الشرعية الرمزية: إذا كان النص قابلًا للتجديد، فهذا يعني أن قداسة السلطة القائمة عليه قابلة للتقويض.
3. الإصلاح يعيد الكلمة للعقل: الدولة تريد أن يكون المنبر الرسمي المرجع الأعلى، بينما الإصلاح يعيد الاعتبار لاجتهاد الفرد وحرية التفكير.
ج. الإصلاح في الإسلام الحديث: الداخل والخارج
منذ القرن التاسع عشر، برز اتجاهان إصلاحيان متوازيان في العالم الإسلامي:
1. إصلاح من داخل المؤسسة الدينية:
جمال الدين الأفغاني دعا إلى إحياء روح الإسلام في مواجهة الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي.
محمد عبده سعى إلى تحديث الفكر الإسلامي، وإعادة قراءة النصوص بروح عقلانية، وإصلاح مناهج التعليم الديني.
محمود محمد طه قدّم مشروعًا تجديديًا للشريعة يقوم على التمييز بين آيات المرحلة المكية والمدنية، لكنه أُعدم في السودان بتهمة الردة.
هؤلاء جميعًا كانوا ينطلقون من موقع ديني، أي من داخل فضاء الفقه والتفسير، ومع ذلك وُوجهوا بالتخوين والتكفير، لأنهم كسروا احتكار المؤسسة الرسمية لسلطة "التأويل المشروع".
2. إصلاح من خارج المؤسسة الدينية:
طه حسين دعا إلى قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي والتراث الأدبي، مستعينًا بمناهج حديثة.
محمد عابد الجابري قدّم مشروعًا لفحص "العقل العربي" ونقد آليات إنتاج المعرفة في التراث.
فرج فوده طالب بفصل الدين عن الدولة بشكل صريح، فواجه حملات تكفير وانتهى باغتياله.
هؤلاء لم يتكلموا كفقهاء بل كمفكرين، ومع ذلك تعرّضوا لاتهامات أشد قسوة: التغريب، الخيانة، الكفر. لأن نقدهم لم يقتصر على النصوص بل تعدى إلى بنية التحالف بين الدين والسلطة.
د. الإصلاح الديني في أوروبا: درس تاريخي
تجربة أوروبا تكشف بوضوح أن الدين حين يُحتكر من قبل السلطة السياسية والدينية معًا، يصبح الإصلاح مستحيلًا إلا عبر صدام كبير.
الإصلاح البروتستانتي (لوثر وكالفن): بدأ كمطلب لاهوتي ضد بيع صكوك الغفران وسطوة الكنيسة، لكنه تحوّل إلى ثورة اجتماعية وسياسية قلبت الخريطة الأوروبية.
الكنيسة الكاثوليكية رأت في الإصلاح تهديدًا لهيمنتها المطلقة، فلاحقت المصلحين بالحرمان والقتل.
لكن مع الزمن، أدى الإصلاح إلى فصل نسبي بين الدين والسياسة، وإلى ظهور قيم مثل حرية الضمير وحق الاختلاف.
الدروس الأوروبية مهمة للعالم الإسلامي: الإصلاح لا يضعف الدين، بل ينقذه من التكلس والارتهان للسلطة. أما الجمود فهو الذي يحول الدين إلى أداة قمع، ويُفقده بريقه في عيون الناس.
هـ. كيف يتحول الإصلاح إلى "خيانة"؟
الدولة الدينية تصنع معادلة مقلوبة:
نقد الفقه = هجوم على الدين.
نقد التراث = إضعاف الهوية.
نقد المؤسسة الدينية = تفكيك الأمة.
نقد الحاكم = خروج على الله.
وبهذا، يصبح الإصلاح – في نظر السلطة – جريمة مركبة: سياسية ودينية في آن واحد.
و. النتيجة: موت الدين الحي
حين يُمنع الإصلاح، يتحول الدين إلى قوالب جامدة. يُستعمل في الخطب والإعلام كأداة طاعة، بينما الناس يفقدون إيمانهم بجدواه. وهكذا، بدل أن يكون الإصلاح وسيلة لإحياء الدين، يصبح غيابه وسيلة لقتله. الدين يفقد روحه، ويظل قائمًا كشعار سلطوي لا كإيمان حي.
بين لاهوت التحرير ولاهوت الطاعة
ليس كل حضور للدين في المجال العام يفضي إلى القمع. فالدين يمكن أن يتحول أيضًا إلى قوة مقاومة، وإلى مصدر إلهام للتحرر من الاستبداد. لكن المسألة تتعلق بكيفية قراءة النصوص، وبالبنية التاريخية والاجتماعية التي تحدد وظيفة الدين: هل يكون أداة لتحرير الإنسان، أم لتقييده؟
أ. لاهوت التحرير: الدين كقوة مقاومة
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، شهدت أمريكا اللاتينية بروز ما عُرف بـ"لاهوت التحرير"، وهو تيار مسيحي جديد قاده لاهوتيون مثل غوستافو غوتييريز (بيرو)، وكاميلو توريس (كولومبيا)، وليوناردو بوف (البرازيل).
هذا التيار انطلق من فكرة أن الإنجيل لا يمكن أن يُقرأ بمعزل عن واقع الفقر والظلم، وأن "ملكوت الله" ليس وعدًا مؤجلًا في السماء، بل مشروع عدالة على الأرض. لذلك، تبنى لاهوت التحرير موقفًا صريحًا إلى جانب الفقراء والمهمشين، وجعل من الدين لغة مقاومة ضد الديكتاتوريات العسكرية والرأسمالية المتوحشة.
الدين هنا لم يكن أداة قمع، بل أداة تحرر. الكنيسة لم تكن ذراعًا للسلطة، بل ملجأً للمضطهدين. النصوص لم تُقرأ لتكريس الطاعة، بل لإعلان الثورة: "طوبى للجياع والعطاش إلى البرّ".
ب. لاهوت الطاعة: الدين كأداة انضباط
في المقابل، ظلّ حضور الدين في العالم الإسلامي (في أغلب تجلياته السياسية) أقرب إلى "لاهوت الطاعة" منه إلى "لاهوت التحرير". منذ العصور الأولى، جرى توظيف النصوص لإنتاج خطاب الطاعة والخضوع: "من خرج على إمامه فمات، مات ميتة جاهلية"، "اسمعوا وأطيعوا وإن ضرب ظهركم وأخذ مالكم".
هذه النصوص، بغضّ النظر عن سياقاتها التاريخية وتأويلاتها، استُخدمت لتكريس مبدأ الانضباط بدل مقاومة الظلم. فبينما كان الدين في أمريكا اللاتينية يُقرأ كنداء للثورة على الطغيان، كان في العالم الإسلامي يُقرأ ـ في كثير من الأحيان ـ كأداة لمنع أي خروج على الحاكم.
ج. لماذا أنتجت المسيحية لاهوت التحرير والإسلام لاهوت الطاعة؟
السؤال المحوري هنا: ما الذي جعل المسيحية الحديثة قادرة على إنتاج "لاهوت التحرير"، بينما ظلّ الإسلام السياسي في معظمه يكرر "لاهوت الطاعة"؟.يمكن الإشارة إلى عدة أسباب:
1. البنية المؤسسية: الكنيسة في أمريكا اللاتينية كانت مؤسسة قائمة بذاتها، لها استقلال نسبي عن الدولة، مما أتاح لها تبنّي خطاب مقاوم. بينما في التاريخ الإسلامي، غالبًا ما جرى إدماج الفقهاء في جهاز الدولة (القضاء، الإفتاء، الحسبة)، ففقدوا استقلالهم.
2. طبيعة النصوص والتأويل: النص المسيحي (خصوصًا الأناجيل) يركّز على البُعد الأخلاقي والاجتماعي، ما يترك مجالًا واسعًا للتأويل التحرري. أما النص الإسلامي، فبما أنه احتوى أيضًا على أحكام سياسية وفقهية، فقد أُعيد تأويلها تاريخيًا بما يخدم الاستقرار السلطوي.
3. التجربة التاريخية: المسيحية الأوروبية عاشت صراعًا طويلًا مع الدولة (خصوصًا بعد عصر الإصلاح الديني)، ما جعلها قادرة على تطوير خطاب نقدي تجاه السلطة. في حين أن الإسلام المبكر نشأ متداخلًا مع تجربة الدولة، فصار من الصعب الفصل بين "الديني" و"السياسي".
د. المفارقة الكبرى
هكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة عميقة: في أمريكا اللاتينية، الدين كان درعًا للفقراء وسيفًا ضد الطغاة، وفي العالم الإسلامي، غالبًا ما كان الدين درعًا للحكام وسيفًا ضد المعارضين. لكن هذه المفارقة لا تعني أن النص الإسلامي مغلق على الأبد، بل أن تأويله جرى في إطار بنية تاريخية سلطوية. ولو أتيح له فضاء حر ومستقل، لكان قادرًا على إنتاج "لاهوت تحرير" إسلامي، كما حاول بعض المفكرين المعاصرين مثل علي شريعتي، وعبد الكريم سروش، ومحمد مهدي شمس الدين، وغيرهم ممن سعوا إلى قراءة الدين كقوة تحرر لا كأداة استعباد.
لماذا نحتاج إلى نقد الدين السياسي؟
أ. لحماية الدين من التسييس
أول ما يكسبه الدين السياسي هو خسارة الدين ذاته. حين يتحول الدين إلى خطاب رسمي للدولة، فإنه يُجرّد من طاقته الروحية، ويُختزل في نصوص تبريرية تُستخدم عند الحاجة، ويُحوَّل إلى شعارات تُرفع لا إلى قيم تُعاش. وهكذا، يصبح الدين نسخة باهتة من ذاته، أشبه بظلّ باهت لفكرة عظيمة.
النقد هنا ضرورة، لأنه الوسيلة الوحيدة لوقف هذا التشويه. فالدين لا يُصان بالتحصين من النقد، بل يُصان بأن يُحرَّر من الاستخدام النفعي الذي يحوله إلى مجرد أداة.
ب. لحماية المجتمع من الاستبداد
الدين السياسي لا يكتفي بتشويه الدين، بل يمدّ أنيابه إلى المجتمع. حين يُقال للناس إن الحاكم يحكم "باسم الله"، تُغلق أبواب المحاسبة. وحين يُقال إن الاعتراض على الدولة هو اعتراض على "الإسلام"، يُصبح أي نقد خيانة، وأي إصلاح فتنة. بذلك، يصبح الدين السياسي درعًا للاستبداد: يحميه من النقد، ويمنحه قداسة كاذبة..ولذلك، فإن نقد الدين السياسي واجب اجتماعي، لأنه يحرر المجتمع من الخوف، ويفتح المجال للمساءلة، ويعيد السياسة إلى طبيعتها: مجال بشري خاضع للنقد والتغيير.
ج. لكسر احتكار الحقيقة
أخطر ما يفعله الدين السياسي أنه يختزل الحقيقة في خطاب رسمي واحد، يصبح الإمام الرسمي أو المرجع المقرّب من الدولة هو "المتكلم باسم الله"، يُقصى أي اجتهاد حر بدعوى أنه "خارج عن الجماعة"، يُسخَّر التراث ليكون ملكًا حصريًا للسلطة.
لكن الدين، في جوهره، خطاب مفتوح للتأويل، متعدد الأبعاد. وتاريخه يشهد على جدل واسع وتنوع في الفقه والكلام والتصوف والفلسفة. نقد الدين السياسي هو إذن نقد لادعاء احتكار الحقيقة، وفتح الباب لعودة التعددية التي هي روح الحياة الفكرية والدينية.
د. لفتح المجال للإصلاح
الإصلاح الديني والفكري لا يمكن أن ينمو في بيئة يهيمن عليها الدين السياسي، أي محاولة لإعادة قراءة النصوص تُتهم بالزندقة، أي اجتهاد يُعتبر تهديدًا للأمن القومي، أي فكر نقدي يُقدَّم كخيانة أو مؤامرة. النقد هنا لا يكون مجرد ترف فكري، بل هو شرط لتحرير المجال الإصلاحي من القيود. إذ لا يمكن لمجتمع أن يُجدد دينه ما دام محكومًا بخطاب سلطوي يدّعي أنه "التفسير الوحيد".
هـ. لأن الدين السياسي يتناقض مع روح الإيمان
الإيمان فعل حر. وإذا سُلبت الحرية، سقط الإيمان وصار مجرد طقس آلي. الدين السياسي يُفرغ الدين من محتواه الروحي لأنه يربطه بالإكراه، بينما النصوص المؤسسة تؤكد أن الإيمان لا يفرض بالقوة: "لا إكراه في الدين".
النقد إذن ليس مجرد معركة ضد سلطة سياسية، بل هو دفاع عن حقيقة الإيمان ذاته، فالدين الذي يُفرض بمرسوم ليس دينًا، بل أيديولوجيا سياسية مغلفة بعباءة الدين.
و. من أجل المستقبل
المجتمعات التي لا تجرؤ على نقد الدين السياسي تبقى أسيرة دورات متكررة من الاستبداد: يتقدم الحاكم باسم الدين، وتُقمع الحريات باسم الدين، وتنهار الثقة بين الناس والدين نفسه، ثم تنفجر المجتمعات في صراعات دامية بين دعاة التدين ودعاة التحرر.
نقد الدين السياسي هو استثمار في المستقبل، لأنه يمهّد الطريق لتوازن جديد: دين حرّ من السلطة، وسياسة بلا قداسة زائفة.
ي. خلاصة
إن الحاجة إلى نقد الدين السياسي ليست مطلبًا نخبويًا أو قضية أكاديمية، بل هي مسألة وجودية تمسّ صميم الدين والمجتمع معًا. هو دفاع عن الدين من التشويه، ودفاع عن المجتمع من الاستبداد، ودفاع عن العقل من المصادرة، ودفاع عن المستقبل من التكرار المأساوي.
بكلمة: إن نقد الدين السياسي ليس رفضًا للدين، بل إنقاذًا له، وإعادته إلى مكانه الطبيعي: مجال الضمير، لا أداة السلطة.
خاتمة: بين سلطة الله وسلطة الحاكم
حين نعيد النظر في العلاقة الملتبسة بين الدين والسياسة، ندرك أن أخطر ما شهده تاريخنا لم يكن صراع المذاهب أو اختلاف الفقهاء، بل لحظة اختطاف الدين وتحويله إلى ذراع للسلطة. منذ أن صار "الإيمان" شعارًا للولاء، و"الفتوى" غطاءً للاستبداد، و"الخطبة" منبرًا للدعاية، فقد الدين جزءًا من معناه الأصلي: كونه فضاءً للحرية والبحث عن الله، لا أداة للسيطرة.
النقد الذي وجهناه هنا للدين السياسي ليس نزوة فكرية، ولا عداءً مع الدين، بل هو دعوة لإنقاذه من التوظيف. إن الدين، في جوهره، أسمى من أن يتحول إلى موظف صغير في بيروقراطية الدولة أو شعار أجوف على لافتة حزبية.
الله لا يحتاج إلى وزارة، ولا إلى حزب، ولا إلى خطاب رسمي. ما يحتاجه هو قلوب صادقة، وعقول حرة، ونفوس تبحث عن المعنى.
1. حين تختلط السلطتان
تاريخ التجارب البشرية – من أوروبا في العصور الوسطى إلى تجارب إيران والعراق ومصر وغيرها – يعلّمنا أن زواج الدين بالسياسة ينتج دائمًا كائنًا مشوهًا: دينًا بلا روح، لأنه مُختزل في خدمة السلطة. وسياسة بلا مساءلة، لأنها تحتمي بقداسة زائفة. بهذا الخلط، يُظلم الدين مرتين: مرة حين يُستعمل ضد خصوم السلطة، ومرة حين يفقد الناس ثقتهم به فيرونه مرادفًا للفساد والاستبداد.
2. الحرية جوهر الإيمان
الآية القرآنية "لا إكراه في الدين" ليست مجرد جملة بلاغية، بل قاعدة أنطولوجية: الإيمان لا يولد بالإكراه. كل دين يُفرض بالسيف يتحول إلى أيديولوجيا، وكل صلاة تُؤدى خوفًا من سلطة تفقد معناها، وكل فتوى تُستخدم لحماية حكم تفرغ من روحها.
من هنا نفهم أن نقد الدين السياسي ليس خروجًا عن الدين، بل دفاع عن الإيمان كخيار حر، وعودة إلى جوهر العلاقة الأصلية بين الإنسان وربه: علاقة بلا وسطاء سياسيين، بلا ابتزاز، بلا شعارات قسرية.
3. ضرورة النقد من أجل الإصلاح
أي محاولة لإصلاح الفكر الديني ستظل عقيمة ما لم تُفكّك أولًا شبكة المصالح التي تحكم العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة. فالإصلاح لا يخيف الدين، بل يخيف الدولة، الدولة تخشى إعادة قراءة النصوص لأنها تُعيد السلطة إلى العقل، الدولة تخشى تعددية الاجتهاد لأنها تُضعف هيمنة الصوت الرسمي، الدولة تخشى النقد لأنه يفضح تواطؤها باسم الدين، إذن، لا سبيل إلى إصلاح حقيقي ما لم نجرؤ على نقد الدين السياسي وتعرية بنيته الأيديولوجية.
4. نحو فصل لا يعني عداء
حين نقول "فصل الدين عن السياسة"، لا نقصد نفي الدين عن الحياة العامة، ولا عزله في الزوايا والمعابد. بل نقصد تحريره من سلطة الدولة، ومن تحويله إلى أداة هيمنة. فالدين يمكن أن يظل قوة أخلاقية ملهمة، يذكّر الإنسان بواجباته نحو الآخر، نحو العدل، نحو الفقراء والمظلومين. لكن هذه القوة الأخلاقية تذبل حين تُختزل في خطاب رسمي أو في مؤسسة تحتكر النطق باسم الله.
بكلمة أخرى: نحن لا ندعو إلى دين بلا حضور، بل إلى دين بلا وصاية سياسية.
5. المستقبل بين خيارين
المستقبل مفتوح أمام خيارين: إما أن يستمر تحالف الدين والسياسة، فنظل ندور في حلقة الاستبداد المقدس، حيث تُستغل النصوص لتكميم الأفواه وتكريس الجمود. أو نجرؤ على الفصل والتحرير، فنفتح الطريق أمام دين متجدد، وسياسة مدنية عقلانية، ومجتمع يتنفس الحرية.
التجارب التاريخية، من الإصلاح الأوروبي إلى محاولات الإصلاح الإسلامي، كلها تقول لنا شيئًا واحدًا: لا نهضة مع دين سياسي، ولا مستقبل مع قداسة زائفة للسلطة.
6. كلمة أخيرة
إننا إذ ننتقد الدين السياسي، فإننا لا ننتقد الدين بل نحميه من أن يكون أداة بيد الحاكم، لا ننتقد الإيمان بل نحميه من التشويه، لا ننتقد الروح بل نحميها من أن تُسجن في قفص السلطة. المؤمن الحقيقي لا يبحث عن "دولة باسم الله"، بل عن حرية تقوده إلى الله. والسياسي النزيه لا يتكئ على قداسة دينية ليبرر حكمه، بل يحتكم إلى عقد اجتماعي وشرعية مدنية.
بين سلطة الله وسلطة الحاكم مسافة هائلة. وحين تختفي هذه المسافة، يُفسد الحاكم الدين ويُفقد الدين معناه، ولذلك، فإن نقد الدين السياسي ليس خروجًا عن الدين، بل عودة إليه.
***
محمد ساجت السليطي - كاتب وباحث
..........................
المصادر والمراجع
1. برهان غليون – نقد السياسة: الدولة والدين
2. عادل ضاهر – أولية العقل: نقد أطروحات الإسلام السياسي
3. رشيد الخيون – مائة عام من الإسلام السياسي
4. سعيد عبد الله حارب – السياسة والدين بين المبادئ والتاريخ
5. أنتوني بلاك – الغرب والإسلام: الدين والفكر السياسي في التاريخ العالمي
6. مكرم عباس – الإسلام والسياسة في العصر الوسيط
7. مقال جدلية الدين والدولة في الفكر السياسي الإسلامي، حمزة بوملي