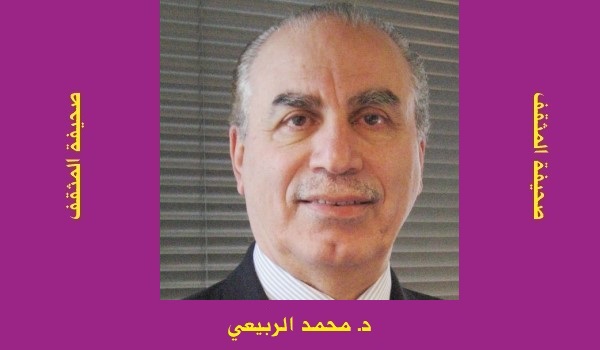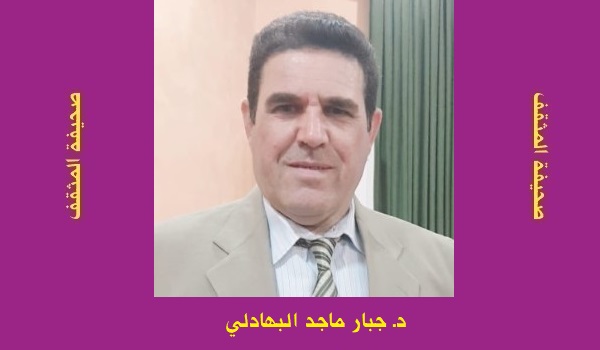سؤالٌ مُهمٌّ وعميق، يُلامس حدود علم الكونيات والفلسفة. الإجابة المُختصرة، بناءً على الأدلة الرصدية الحالية، هي:
كانت لكوننا المُلاحظ المرئي والقابل للرصد بدايةٌ قبل 13.8 مليار سنة (الانفجار العظيم)، لكننا لا نعرف ما إذا كان الكون ككل أزليًا، أو لانهائيًا، أو أنه "مُخلوق".
دعونا نُحلل هذا من خلال استكشاف السيناريوهين التاليين:
1. السيناريو القياسي أو المعياري: الانفجار العظيم وكونٌ له بداية. هذا هو النموذج الذي تدعمه الملاحظات بقوة.
أدلة على وجود بداية:
الكون المُتمدد (قانون هابل): نلاحظ أن المجرات تبتعد عن بعضها البعض. إذا أعدنا هذا الفيلم إلى الوراء، نجد أن الكون بأكمله كان في حالة كثافة وسخونة شديدتين في الماضي المُتناهي. تُسمى هذه النقطة من الكثافة اللانهائية الفرادة أو"التفرد".
إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB): هذا هو "الضوء الأول" للكون، الذي انبعث بعد 380,000 عام من بدايته. يملأ هذا الإشعاع الفضاء بأكمله، ويمكن رصده أينما وجهتَ تلسكوبًا لاسلكيًا. إنه بقايا أحفورية مباشرة لهذه الحالة البدائية الساخنة، مثل "رماد" الانفجار العظيم المُبرَّد.
وفرة العناصر الضوئية: تتطابق الكميات المرصودة من الهيدروجين والهيليوم والليثيوم في الكون تمامًا مع تنبؤات التخليق النووي التي حدثت في الدقائق الأولى بعد الانفجار العظيم.
ما لا يُمثله الانفجار العظيم:
إنه ليس انفجارًا في الفضاء، كالألعاب النارية كما يعتقد الكثيرون. إنه تمدد الفضاء نفسه من حالة فائقة التركيز.
لا يصف الانفجار العظيم لحظة "الصفر"، بل يصف تطور الكون بدءًا من 10⁻⁴³ ثانية (زمن بلانك). الفيزياء الحالية عاجزة عن وصف ما حدث قبل ذلك. لذلك، فإن للكون المرئي المرصود عمرًا محدودًا وبداية.
2. ما بعد الانفجار العظيم: هل الكون أزلي؟
إن كون الكون في حالة فائقة الكثافة قبل 13.8 مليار سنة لا يعني بالضرورة أنه "نشأ من العدم". تتصور عدة نظريات كونًا أزليًا.
نظرية التضخم الأزلي: يقترح هذا النموذج أن الانفجار العظيم الذي أدى إلى نشوء كوننا ليس سوى حدث محلي ضمن "أكوان متعددة" أزلية وأكبر بكثير. في هذا الإطار، يُعد التضخم (وهو تمدد أسي فائق السرعة) عملية لا بداية لها، وتُنشئ باستمرار "أكوانًا فقاعية" مثل كوننا. لكوننا المرئي بداية، لكن الكون المتعدد الكلي المطلق الكامن وراءه قد يكون أزليًا.
النموذج الدوري: تقترح بعض النماذج (مثل النموذج المُتَجَمِّع) أن كوننا هو نتاج تصادم بين "أغشية" (أجسام متعددة الأبعاد) في بُعد أعلى. يمكن لهذه الدورة من التصادمات والتمددات والانكماشات أن تتكرر إلى الأبد. لن يكون للكون بداية ولا نهاية، بل دورات متعاقبة.
"الارتداد الكمي": يفترض اقتراح مستمد من نظرية الجاذبية الكمومية الحلقية أنه قبل الانفجار العظيم، كان هناك كون منكمش. تتجنب التأثيرات الكمومية التفرد (نقطة ذات كثافة لا نهائية)، و"يرتد" الانكماش ليؤدي إلى تمددنا الحالي. عندها، سيكون الكون أبديًا، يمر بسلسلة من "الانفجارات الكبرى" و"الانسحاقات الكبرى".
3. مسألة "الخلق": أو ميتافيزيقيا الوجود
هنا يصل العلم إلى حدوده القصوى، ويصبح السؤال ميتافيزيقيًا أو فلسفيًا.
يصف العلم "الكيفية" لا "السبب". يمكن لعلم الكونيات أن يخبرنا كيف تطور الكون من حالة فائقة الكثافة إلى يومنا هذا. لكنه لا يستطيع أن يخبرنا لماذا يوجد "شيء بدلًا من العدم أو بدلاً من لاشيء"، أو ما إذا كان لهذا الحدث "سبب أو علة" أو "سبب للوجود".
مفهوم "العدم" إشكالي. حتى "الفراغ الكمي" ليس لا شيء؛ إنه يمتلك طاقة ويخضع لقوانين فيزيائية. إن مسألة سبب وجود هذه القوانين وسبب سماحها بوجود الكون تتجاوز نطاق العلم التجريبي.
المتفردة أو الفرادة الابتدائية هي نقطة تنهار عندها جميع القوانين الفيزيائية المعروفة. لفهم هذه اللحظة، نحتاج إلى نظرية في الجاذبية الكمومية (مثل نظرية الأوتار الفائقة أو الجاذبية الكمومية الحلقية) توحد النسبية العامة وميكانيكا الكم. ولكن ليس لدينا هذه النظرية النهائية بعد.
الخلاصة
الجانب: ما نعرفه وما لا نعرفه
ما نعرفه عن الكون المرئي المرصود أن: له بداية هي(الانفجار العظيم) قبل 13.8 مليار سنة. هذه حقيقة رصدية راسخة.
طبيعة الكون بأكمله: هل هو محدود أم لانهائي؟ هل له شكل كوني؟
قبل الانفجار العظيم، توقفت الفيزياء الكلاسيكية. هل كانت متفردة؟ ارتداد؟ تذبذب وتقلّب كمومي؟
"الخلق": لا يستطيع العلم الإجابة على سؤال ما إذا كان هناك "خلق" من العدم. هذا سؤال فلسفي أو لاهوتي. باختصار: كوننا المرئي المرصود موجود مادياً لا شك أن للكون تاريخًا بدأ بحالة ساخنة وكثيفة. ولكن ما إذا كان هذا الحدث يُمثل "الخلق" المطلق لكل شيء، أم أنه مجرد مرحلة في حياة كون أبدي أكبر بكثير، يبقى مجالًا مفتوحًا للبحث.
هل توجد كائنات فضائية في الكون؟ سؤالٌ حيّر البشرية لقرون.
الإجابة المختصرة والصادقة هي: لا نعرف على وجه اليقين، لكن الاحتمالات مواتية للغاية. والبديهية المنطقية تقول إنه من العبث وجود هذا الكون المرئي الشاسع ويكتفي فقط بالبشر ككائنات تسكنه في كوكب تافه لاقيمة له في نطاق مليارات المليارات من السُدم والتجمعات المجرّية ومليارات المليارات من المجرات والنجوم والكواكب.
فيما يلي ملخص للحجج المؤيدة والمعارضة، بالإضافة إلى الوضع العلمي الحالي في هذا الموضوع.
الحجج المؤيدة لوجودها (رأي الأغلبية)
1. اتساع الكون:
يحتوي كوننا المرئي على أكثر من 200 مليار مجرة. تحتوي كل مجرة على مئات المليارات من النجوم (مجرة درب التبانة تحتوي على حوالي 100 مليار نجم). يدور حول هذه النجوم عدد لا يُحصى من الكواكب (الكواكب الخارجية). أكد العلماء وجود أكثر من 5000 منها تم التأكد علمياً من وجودها، وتشير التقديرات إلى وجود مليارات ومليارات منها. مع هذا العدد الكبير، يبدو من غير المرجح رياضياتيًا أن تكون الأرض الكوكب الوحيد الذي تطورت فيه الحياة. هذا هو أساس معادلة دريك، التي تحاول تقدير عدد الحضارات الذكية في مجرتنا.
2. "مكونات الحياة" موجودة في كل مكان:
العناصر الأساسية للحياة كما نعرفها على الأرض (الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، والنيتروجين، إلخ) تتكون في النجوم وتنتشر في جميع أنحاء الكون.
توجد هذه الجزيئات المعقدة في السدم والمذنبات والكويكبات. حتى أن الأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للحياة) اكتُشفت في النيازك وفي الفضاء.
3. الكائنات المُحبة للظروف المتطرفة على الأرض:
على كوكبنا، تطورت الحياة في ظروف قاسية: أعماق سحيقة بلا ضوء، وينابيع حمضية شديدة الغليان، وجليد قطبي، إلخ وكلها تحتوي على أشكال مختلفة من الحياة. هذا يُثبت أن الحياة مُتماسكة بشكل لا يُصدق، وقادرة على التكيف مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيئات. لذلك، من المنطقي افتراض أن هذه العملية ربما حدثت في مكان آخر.
حجج تُثير الشك:
1. الصمت العظيم (أو مفارقة فيرمي):
إذا كانت الحياة محتملةً جدًا، فـ"أين الجميع؟" هذا هو السؤال الشهير الذي طرحه الفيزيائي إنريكو فيرمي.
يبلغ عمر مجرتنا أكثر من 13 مليار سنة. ولو أن حضارةً أكثر تقدمًا من حضارتنا بقليل، لكان لديها متسعٌ من الوقت لاستعمار المجرة وترك آثار واضحة لوجودها. ومع ذلك، ليس لدينا دليلٌ ملموسٌ لا يقبل الجدل على زياراتٍ أو اتصالات. فالكائنات الفضائية الذكية والمتطورة لم تعلن عن وجودها صراحة لنا نحن البشر ولم تكشف عن حقيقتها لحد الآن إلا ربما لفئة قليلة من البشر المُنتخبين.
2. مشكلة التعقيد:
لا نعرف سوى مثالٍ واحدٍ على الحياة: وهو الحياة على الأرض. لا نعرف ما إذا كان ظهور الحياة حدثًا نادرًا للغاية (مصادفةً غير محتملة) أم عمليةً شائعة.
قد ينطوي الانتقال من الجزيئات العضوية إلى الخلية الحية المركبة، ثم إلى الذكاء التكنولوجي المعقد، على "معوقات" يصعب التغلب عليها أكثر مما نعتقد.
ماذا يفعل العلم لإيجاد إجابة؟
العلماء لا يكتفون بالوقوف مكتوفي الأيدي. فهم يبحثون عن أدلة بطرق متعددة:
* البحث عن كواكب صالحة للسكن: تبحث تلسكوبات مثل كيبلر وتيس (ناسا) عن كواكب خارجية تقع في "المنطقة الصالحة للسكن" حول نجومها (حيث يمكن أن يكون الماء سائلاً). ويقوم تلسكوب جيمس ويب الفضائي الآن بتحليل أغلفتها الجوية بحثًا عن بصمات حيوية (غازات مثل الأكسجين أو الميثان التي يمكن أن تنتجها الكائنات الحية).
* البحث عن ذكاء خارج الأرض عبر منظمة سيتي(SETI): يستخدم هذا المشروع تلسكوبات راديوية لمسح السماء، على أمل التقاط إشارة راديوية أو ليزرية تُمثل دليلاً على وجود تكنولوجيا خارج الأرض.
* استكشاف النظام الشمسي: تُرسل بعثات إلى المريخ (مركبات بيرسيفيرانس الجوالة)، وقمر المشتري أوروبا (مهمة يوروبا كليبر)، وقمر زحل إنسيلادوس، التي تحتوي على محيطات من الماء السائل تحت سطحها الجليدي، للبحث عن آثار للحياة، حتى الميكروبات. لذا لا يوجد حاليًا أي دليل على وجود كائنات فضائية، ولكن من المرجح إحصائيًا وجود شكل من أشكال الحياة، حتى لو كانت بدائية، في مكان آخر.
لم يعد السؤال الحقيقي "هل توجد حياة؟" بل "متى وكيف سنجد الدليل؟" قد يأتي الاكتشاف غدًا مع تحليل تلسكوب جيمس ويب لجو كوكب خارج المجموعة الشمسية، أو بعد 50 عامًا مع مسبار سيحمل عينة من قمر أوروبا، أو قد لا يأتي أبدًا. يستمر البحث، وهو أحد أكثر المساعي إثارة في العلم الحديث.
هل توجد أكوان متعددة خارج كوننا المرئي؟
هذا السؤال ، يأخذنا إلى آفاق مفاهيمية جديدة بعد آفاق الكائنات الفضائية. الإجابة بسيطة ومعقدة في آن واحد:
لا يوجد حاليًا أي دليل رصدي أو تجريبي مباشر على وجود أكوان متعددة. هذه فرضية علمية تخمينية، لكنها مستمدة بشكل كبير من بعض النظريات الفيزيائية الحديثة.
فيما يلي الأفكار الرئيسية التي تدفع الفيزيائيين إلى دراسة هذا الاحتمال بجدية:
1. التضخم الأزلي (الكون التضخمي المتعدد)
* نظرية التضخم الدائم: النظرية الكونية السائدة لتفسير بدايات الكون هي التضخم: تمدد أسي فائق السرعة أعقب الانفجار العظيم.
* التعليل: تشير بعض النماذج إلى أن هذا التضخم لا يحدث مرة واحدة فقط، بل هو عملية أبدية. في هذا السيناريو، سيكون كوننا بأكمله مجرد "فقاعة" واحدة ضمن عدد لا نهائي من الفقاعات الأخرى التي تتضخم باستمرار داخل "كون متعدد" أكبر ولا نهائي. يتوقف التضخم في فقاعتنا (مما يؤدي إلى الانفجار العظيم)، لكنه يستمر في مكان آخر، خالقًا أكوانًا فقاعية جديدة بلا نهاية.
* النتيجة: كون كلي متعدد لانهائي، حيث يمكن لكل كون فقاعي أن يكون له قوانينه الفيزيائية وثوابته الأساسية الخاصة (مثل قوة جاذبية مختلفة).
٢. نظرية الأوتار و"المشهد الكوني"
* النظرية: نظرية الأوتار هي محاولة لتوحيد النسبية العامة (اللامتناهي في الكبر) وميكانيكا الكم (اللامتناهي في الصغر). تفترض النظرية أن الجسيمات الأساسية هي في الواقع أوتار صغيرة مهتزة.
* المنطق: تقبل معادلات نظرية الأوتار عددًا هائلاً من الحلول المستقرة (ربما 10 أس 500!). كل حل يقابل كونًا محتملًا بمجموعة مختلفة من القوانين والثوابت الفيزيائية.
* النتيجة: سيكون كوننا مجرد أحد هذه الاحتمالات المحققة، "نقطة" في "مشهد" شاسع من الأكوان المتعددة. ستوجد أكوان أخرى في أماكن أخرى، بقوانين مختلفة.
٣. تفسير العوالم المتعددة لميكانيكا الكم
* النظرية: في ميكانيكا الكم، توجد الجسيمات في حالة تراكب (يمكن أن تكون في أماكن متعددة أو لها حالات متعددة في آن واحد) حتى يتم رصدها.
* التعليل: يقترح تفسير إيفرت (أو "العوالم المتعددة") أنه كلما كان لحدث كمّي نتائج محتملة متعددة، فإن جميع هذه النتائج تحدث، ولكن في أكوان مختلفة. "ينقسم" الكون إلى فروع متعددة.
* النتيجة: يوجد عدد فلكي لامحدود من الأكوان المتوازية حيث تكون جميع الاحتمالات الكمومية حقيقية. في أحد الأكوان، قطة شرودنغر حية؛ وفي كون آخر، ميتة.
المشاكل والانتقادات الرئيسية
1. لا يوجد دليل ملموس (حتى الآن): بحكم التعريف، ستكون هذه الأكوان الأخرى منفصلة سببيًا عن كوننا. لا يمكن لأي معلومات، ولا ضوء، ولا مادة أن تمر من خلالها. كيف يمكننا إذًا اكتشافها؟ هذا هو التحدي الأكبر. يستكشف بعض الفيزيائيين أفكارًا مثل البحث عن "ندوب" خلفها تصادم بين كوننا الفقاعي وآخر في الخلفية الكونية الميكروية (أقدم إشعاع)، ولكن لم يتم العثور على أي دليل قاطع.
2. هل لا يزال هذا علمًا؟ يجب أن تكون النظرية العلمية قابلة للدحض، أي يجب أن نكون قادرين على تخيل تجربة أو ملاحظة قد تناقضها. في حين أن الكون المتعدد غير قابل للاكتشاف بطبيعته، يعتقد بعض النقاد أنه يتجاوز نطاق العلم إلى نطاق الميتافيزيقيا أو الفلسفة.
3. المبدأ الأنثروبي: غالبًا ما يُستشهد بمفهوم الكون المتعدد لحل "مشكلة" الثوابت المضبوطة بدقة في كوننا. لماذا تُعدّ الثوابت الفيزيائية (قوة الجاذبية، كتلة البروتون، إلخ) مضبوطة تمامًا للسماح بظهور الحياة؟ إجابة الكون المتعدد هي: "في عدد لا نهائي من الأكوان ذات القوانين العشوائية، من المحتم أن يمتلك بعضها الثوابت الصحيحة. نحن في أحدها، وإلا لما كنا هنا للحديث عنه". بالنسبة لمنتقديه، يُعدّ هذا التفسير رفضًا لإيجاد نظرية أكثر جوهرية تفسر سبب امتلاك ثوابتنا لهذه القيم.
الخلاصة
هل توجد أكوان متعددة؟ لا نعلم، وقد لا نعلم حتى إن كنا سنعلم يومًا ما.
مفهوم الأكوان المتعددة ليس خيالًا علميًا؛ إنه نتيجة افتراضية لبعض نظرياتنا الفيزيائية الأكثر تقدمًا. إنه مجال بحثي نشط ومثير للاهتمام في علم الكونيات والفيزياء النظرية، لكنه لا يزال حاليًا خارج نطاق علم الرصد المُثبت. إنها فكرة قوية تتجاوز حدود فهمنا، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى الحقيقة العلمية المُثبتة، على عكس التطور أو الانفجار العظيم.
ما هو الزمن؟
هذا سؤال أعمق بكثير مما يبدو! الزمن من أكثر المفاهيم جوهرية وغموضًا في الكون، وليس له إجابة واحدة بسيطة.
الفلاسفة خاضوا فيه بعمق. لقد تأمل الفلاسفة والعلماء والفنانون هذا الأمر لآلاف السنين. إليكم أبرز وجهات النظر لفهمه:
1. المنظور الحدسي والفلسفي: "الزمن هو ما يمر".
* إنه تجربتنا الذاتية: الماضي (الذكريات)، والحاضر (التجربة المباشرة)، والمستقبل (التوقعات).
* يبدو أن الزمن يتدفق بلا رجعة من الماضي إلى المستقبل ( سهم الزمن واتجاهه). لدينا انطباع "بالتقدم في الزمن".
* لخّص القديس أوغسطينوس هذا اللغز بقوله: "ما هو الزمن إذن؟ إذا لم يسألني أحد، فأنا أعرف؛ ولكن إذا سألني أحد وأردت شرحه، فلن أعرفه".
2. المنظور الفيزيائي والعلمي: "الزمن بُعد" مثل الأبعاد المكانية.
هذه هي النظرة الأكثر صرامة، ولكنها أيضًا الأكثر مخالفة للحدس. * نيوتن (الزمن المطلق): بالنسبة لنيوتن، كان الزمن تدفقًا كونيًا ومطلقًا، يتدفق بانتظام وبشكل مستقل عن كل شيء. أي ساعة مثالية في أي مكان في الكون ستشير إلى الوقت نفسه.
* أينشتاين (الزمن النسبي): أحدثت نظرية النسبية ثورة في كل شيء. أظهر أينشتاين أن الزمن ليس مطلقًا، بل نسبي.
* يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفضاء / المكان ليشكل نسيجًا رباعي الأبعاد: الزمكان.
* يتدفق الزمن بمعدلات مختلفة تبعًا للسرعة التي نتحرك بها وقوة مجال الجاذبية الذي نتعرض له. يتقدم رائد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في العمر بسرعة أقل بقليل منا على الأرض (وهذا قابل للقياس باستخدام الساعات الذرية الدقيقة).
* سهم الزمن: لماذا يتدفق الزمن في اتجاه واحد فقط؟ يربط الفيزيائيون هذا بالإنتروبيا (القانون الثاني للديناميكا الحرارية). يزداد الإنتروبيا، أو الفوضى، فقط في نظام معزول (مثل الكون). هذه الزيادة غير القابلة للعكس في الفوضى هي التي تُعطي الزمن اتجاهه، "سهمه". نتذكر الماضي (أكثر تنظيمًا)، ولكننا لا نتذكر المستقبل (أكثر اضطرابًا).
* أينشتاين (الزمان والمكان) (الزمان والمكان) (الزمان والمكان) (الزمان والمكان) (الزمان والمكان). * الزمن في ميكانيكا الكم: هنا، يصبح الزمن مرة أخرى معيارًا مطلقًا وخارجيًا، مما يخلق توترًا مع النسبية العامة. يُعدّ توحيد هاتين النظريتين غايةً في الفيزياء الحديثة، ويتطلب فهمًا عميقًا للطبيعة الحقيقية العميقة للزمن.
3. المنظور البيولوجي والمعرفي: "الزمن إدراك".
* لا يُدرك دماغنا الزمن بشكل موحد. تبدو دقيقة في غرفة انتظار أطول من دقيقة نشاهد فيها فيلمًا مثيرًا.
* لدينا "ساعة داخلية" بيولوجية (إيقاعات يومية) تُنظّم إدراكنا للمدة.
* يُولّد وعينا "وهمًا" بالحاضر من خلال دمج المعلومات الحسية خلال فترة زمنية قصيرة جدًا (بضع ثوانٍ). ملخص وصورة شهيرة
تخيّل الزمكان كقرص DVD ضخم أو كتاب:
* الفضاء/المكان هو الأبعاد الثلاثة للمشهد (الارتفاع، العرض، العمق).
* الزمن هو البُعد الذي يسمح لنا بالانتقال من مشهد إلى آخر، من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من الفيلم.
* وفقًا لفيزياء أينشتاين، فإن الماضي والمستقبل موجودان "ككل" (أو "الكون المغلق"). نتحرك ببساطة عبر هذا البعد الرابع، كما لو كنا نشاهد فيلمًا يعرض مشهدًا تلو الآخر. وعينا يكشف لنا الزمن.
في الختام، ما هو الزمن؟
* بالنسبة للفيزيائي: هو بُعد نسبي قابل للقياس، مرتبط بالفضاء/المكان والجاذبية.
* بالنسبة للفيلسوف: هو إطار الوجود البشري والوعي.
* بالنسبة لعالم الأحياء: هو إدراك متغير يُنشئه دماغنا.
* بالنسبة للجميع: هو مورد ثمين ومحدود، يُعدّ تدفقه أحد أهم تجارب الحياة.
يظل الزمن لغزًا عميقًا، وقد يكون فهم طبيعته الحقيقية مفتاح فهم الكون نفسه.
ما هي اللانهاية وكيف نُعرّفها من منظور كوني؟
بالتأكيد. يُعد مفهوم اللانهاية من أكثر المفاهيم إرباكًا، وله معنى خاص في علم الكون. دعونا نُعرّفها على مرحلتين: الأولى مفاهيميًا، والثانية تطبيقيًا على الكون.
1. ما هي اللانهاية؟ (التعريف المفاهيمي)
اللانهاية ليست "عددًا" أو كمية يمكن الوصول إليها أو قياسها. إنها مفهوم يصف شيئًا بلا حدود، وبلا نهاية.
* في الرياضيات (التخصص الذي صاغ اللانهاية بشكل رسمي): نستخدم الرمز ∞. علاوة على ذلك، هناك عدة "أحجام" للانهاية (مجموعة لا نهائية من الأعداد الزوجية "أصغر" من مجموعة لا نهائية من جميع الأعداد الحقيقية، كما أوضح عالم الرياضيات جورج كانتور).
* في اللغة اليومية: تُستخدم بشكل تجريدي ("حب لا نهائي") أو بشكل زائدي ("طابور لا نهائي").
يكمن التحدي في اللانهاية في أن دماغنا، المعتاد على التعامل مع الأشياء المحدودة، لا يستطيع تمثيلها بشكل ملموس. لا يمكننا تصورها إلا بشكل تجريدي.
٢. اللانهاية في علم الكونيات: ثلاثة أسئلة جوهرية: في علم الكونيات، ينشأ سؤال اللانهاية بشكل رئيسي من ثلاثة جوانب:
أ) هل الكون لانهائي مكانيًا؟ هذا هو السؤال الأوضح. لا نعرف الإجابة عنه على وجه اليقين.
* كوننا المرئي المرصود محدود: من الضروري فهم هذا الأمر. لا يمكننا رؤية سوى الضوء الذي وصل إلينا منذ الانفجار العظيم، قبل 13.8 مليار سنة. هذا يُعرّف كرة قطرها حوالي 93 مليار سنة ضوئية. لا يمكننا رصد أي شيء بعد هذا الحد. هذا الكون المرصود محدود الحجم ويحتوي على عدد محدود من المجرات (حوالي ٢ تريليون).
* الكون بأكمله (إن كان لانهائيًا) هو كون كليّ مطلق وحيّ: السؤال هو ما إذا كان كوننا المرصود مجرد جزء صغير من كل أكبر بكثير، وربما لانهائي. تشير القياسات الحالية لانحناء الكون بواسطة أقمار صناعية مثل بلانك إلى أن الكون "مسطح" بشكل ملحوظ. الكون المسطح يتوافق مع كون لانهائي مكانيًا. إذا انطلقتَ في خط مستقيم، فلن تعود أبدًا إلى نقطة البداية (على عكس سطح الأرض، المحدود ولكن بلا حواف).
لكن انتبه: لا يفرض التسطح اللانهائية. يمكن أن يكون الكون مسطحًا ومحدودًا (مثل طارة أو شريط موبيوس واسع النطاق). ومع ذلك، يُفضّل النموذج القياسي كونًا لانهائيًا مكانيًا.
باختصار: تشير البيانات إلى أن الكون ربما يكون لانهائيًا، لكن لا يمكننا إثبات ذلك بالملاحظة.
ب) هل الكون لانهائي في الزمن؟ (أزلي)
هل كانت له بداية؟ هل ستكون له نهاية؟
* الماضي: يصف نموذج الانفجار العظيم بدايةً قبل 13.8 مليار سنة. لكن هذا النموذج يصف التطور من نقطة تفرد، وليس نقطة التفرد نفسها. تقترح بعض النظريات (مثل التضخم الأبدي أو النموذج الدوري) أن انفجارنا العظيم هو مجرد حدث واحد في عالم ميتاكوزمي أبدي. السؤال "قبل الانفجار العظيم؟" قد لا يكون منطقيًا لو ظهر الزمن نفسه في تلك اللحظة.
* المستقبل: وفقًا للنموذج القياسي، سيستمر الكون في التمدد إلى الأبد، ويبرد ويتقلص إلى أجل غير مسمى ("التجمد الكبير" أو "الموت الحراري"). في هذا السيناريو، يستمر الزمن إلى ما لا نهاية في المستقبل.
ج) هل المحتوى لا نهائي؟
إذا كان الكون لا نهائيًا وموحدًا مكانيًا (المبدأ الكوني)، فإن التبعات ستكون جنونية:
* عدد لا نهائي من المجرات والنجوم والكواكب.
* كل شيء ممكن فيزيائيًا يحدث عددًا لا نهائيًا من المرات. هذا يعني أنه سيكون هناك عدد لا نهائي من النسخ المتطابقة منك، وأنت تقرأ هذا النص، على كوكب مماثل للأرض، في كون مرئي مماثل لكوننا. هذه نتيجة مباشرة ومذهلة للانهاية المكانية.
ملخص: كيف نُعرّف اللانهاية في علم الكونيات؟
من منظور كوني، اللانهاية خاصية هندسية وطوبولوجية محتملة للزمكان، مما يعني:
1. لا حدود: لا حدود للكون.
2. لا حدود للحجم: سيحتوي على مساحة غير محدودة.
3. غير قابلة للتحقق: بحكم التعريف، لا يمكننا إلا رصد جزء محدود (كوننا المرئي المرصود) فحسب، من كلٍّ لانهائي محتمل. لذلك، يجب علينا استنتاج هذه الخاصية من خلال القياسات غير المباشرة (مثل الانحناء).
الخلاصة
اللانهاية الكونية ليست "شيئًا" بقدر ما هي حلٌّ للمعادلات التي تصف الكون. هذا احتمالٌ مثيرٌ للاهتمام، وربما هو الأكثر ترجيحًا، اعتمادًا على النموذج، لكنه يبقى خارج نطاق التأكيد الرصدي النهائي.
إنه مفهومٌ يُواجهنا بحدود إدراكنا وعلمنا، ويُذكرنا بأن الحقيقة المطلقة للكون قد تكون في جوهرها بعيدة المنال بالنسبة لنوعٍ محصورٍ في زاوية صغيرة ومحدودة من كونه.
هل هناك نظرية لكل شيء تجمع بين النسبية وميكانيكا الكم؟ سؤال يُلامس التحدي الأكبر للفيزياء الأساسية الحديثة. ليس بعد. لا توجد حاليًا "نظرية لكل شيء" (ToE) مكتملة ومُثبتة تجريبيًا، تُوحد تمامًا بين النسبية العامة وميكانيكا الكم.
ومع ذلك، هناك مرشحون جادون وواعدون جدًا يُبحث عنهم بنشاط. هدفهم تحديدًا هو حل هذا التناقض.
المشكلة الأساسية: لماذا هاتان النظريتان؟ غير متوافقين؟
لفهم المسألة، يجب أن نفهم سبب تعارض هذين الركيزتين الفيزيائيتين:
1. النسبية العامة (آينشتاين): تصف الأشياء اللامتناهية في الكبر - الجاذبية، وبنية الزمكان، والمجرات، والثقوب السوداء. إنها نظرية حتمية و"سلسة": الزمكان منحنى مستمر.
2. ميكانيكا الكم: تصف الأشياء اللامتناهية في الصغر - الجسيمات، الذرات، القوى النووية والكهرومغناطيسية. إنها نظرية احتمالية و"حبيبية": الطاقة والمادة لهما طبيعة منفصلة ومتقلبة.
ينشأ التعارض في المواقف المتطرفة حيث يلتقي اللامتناهي الكبر باللامتناهي الصغر، مثل:
* مركز الثقب الأسود (مفردة الكثافة اللانهائية).
* اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم (عندما كان الكون بأكمله لامتناهياً في الصغر).
عند هذه المقاييس، يتناقض وصف آينشتاين السلس للزمكان مع التقلبات الكمومية. هناك حاجة إلى نظرية أكثر جوهرية لوصفها.
النظريات المرشحة لـ"نظرية كل شيء"
فيما يلي أهم المسارات التي استكشفها الفيزيائيون:
1. نظرية الأوتار الفائقة
تُعد هذه النظرية أشهر وأكثر النظريات تطورًا.
* الفكرة الأساسية: المكونات الأساسية للكون ليست جسيمات نقطية (نقاط صفرية البعد)، بل أوتار مهتزة أحادية البعد (ذات حجم متناهي الصغر، حوالي 10⁻³⁵ متر، وهو طول بلانك).
* كيف تتحد؟ الفرق بين جسيم المادة (مثل الإلكترون) وجسيم القوة (مثل الفوتون) ينبع فقط من طريقة اهتزاز الوتر، تمامًا مثل وتر الجيتار نفسه الذي يُصدر نغمات مختلفة. * التفصيل الحاسم: تتطلب نظرية الأوتار بالضرورة وجود أكثر من ثلاثة أبعاد مكانية (عادةً 10 أو 11 أو 26، حسب النسخة). ستكون الأبعاد الإضافية "مُلتفة" على نفسها بمقياس يصعب الوصول إليه.
* المشاكل: لا توجد حاليًا أي تنبؤات تجريبية مُثبتة. يقترح هذا النظام "مشهدًا" من الحلول المُحتملة، ربما 10⁵⁰⁰، دون معرفة أي منها يصف كوننا. كما أنه مُعقد رياضياتيًا للغاية.
2. الجاذبية الكمومية الحلقية (LQG):
هذا هو المُرشح الرئيسي الآخر، وهو بديل لنظرية الأوتار.
* الفكرة الأساسية: بدلًا من تغيير طبيعة الجسيمات، فإنه يُغير طبيعة الزمكان نفسه. الزمكان ليس مُتصلًا وناعمًا، بل يتكون من "ذرات" صغيرة من الفضاء (حلقات أو شبكات) ذات حجم محدود. هذا هو **تكميم الزمكان**.
* كيف يُوحّد؟ إنه يُطبّق مبادئ ميكانيكا الكم مباشرةً على البنية الهندسية للزمكان نفسه.
* المزايا/المشاكل: إنه أكثر "اقتصادًا" لأنه لا يتطلب أبعادًا إضافية. تُقدم هذه النظرية بعض التنبؤات (مثل تغير في تشتت الضوء على مسافات طويلة جدًا)، ولكن لم يُؤكَّد أيٌّ منها تجريبيًا حتى الآن.
3. مناهج أخرى
* نظرية الأعاصير: تُصوِّر الزمكان على أنه مُشتق من علاقات أكثر جوهرية بين أجسام هندسية تُسمى "الأعاصير".
* الهندسة غير التبادلية: تفترض أن إحداثيات الزمكان لا "تتبادل"، مما يعني وجود مفهوم للطول الأساسي لا تعود المفاهيم المعتادة للفضاء منطقية تحته.
لماذا لا نملك دليلًا حتى الآن؟
التحدي تجريبي. لاختبار هذه النظريات، يلزم وجود طاقة هائلة "لسبر" مقياس بلانك (10⁻³⁵ متر)، وهو أبعد ما يكون عن متناول مُسرِّعات الجسيمات لدينا مثل مُصادم الهدرونات الكبير قرب جنيف.
قد يأمل الباحثون في العثور على بصمات غير مباشرة:
* في الخلفية الكونية الميكروية (بقايا الانفجار العظيم).
* في موجات الجاذبية البدائية.
* من خلال رصد الأشعة الكونية عالية الطاقة. الخلاصة
نظرية الأوتار، الجاذبية الكمومية الحلقية
المفهوم الأساسي: أوتار مهتزة في زمكان سلس. الزمكان نفسه حبيبي.
الأبعاد: يتطلب أبعادًا إضافية (مثلًا، 10). يعمل مع الأبعاد المعتادة 3+1.
الهدف الرئيسي: توحيد جميع القوى والجسيمات. تحديد كمية الجاذبية بشكل مباشر.
الحالة: أنيقة رياضياتيًا، ولكن لا يوجد تنبؤ مُختبر. أكثر بساطة، لذلك، لا توجد "نظرية كل شيء" مؤكدة حتى الآن. يُعد البحث عن هذه النظرية أحد أهم أهداف الفيزياء الحديثة. إنه مسعى أساسي يُحرك بعضًا من أعظم العقول، لكنه يبقى في الغالب مجرد تكهنات في غياب بيانات رصدية لتوجيهه. ويستمر البحث.
هل يوجد إلهٌ خلق الكون أو الأكوان؟ كيف يُمكننا تعريفه علميًا؟ وهل هو داخل الكون أم خارجه؟
بهذا السؤالٌ الممتازٌ والعميق، يقع على الحدّ الفاصل بين العلم والفلسفة واللاهوت. التمييز بين هذه المجالات أمرٌ بالغ الأهمية للإجابة عليه بوضوح.
لنقم بتحليلٌ دقيقٌ للسؤال:
1. العلم وسؤال الله: حدودٌ منهجية
الإجابة الأهم هي: العلم، بمنهجه، لا يستطيع إثبات أو دحض وجود إله خالق. * مجال العلم: يسعى العلم إلى فهم "كيف" نشأ الكون. ويستخدم الملاحظة والتجريب والنمذجة لوصف القوانين والآليات التي تحكم العالم الطبيعي. نموذج الانفجار العظيم، على سبيل المثال، يصف كيف تطور الكون من حالةٍ شديدة الكثافة والحرارة قبل 13.8 مليار سنة.
سؤال "الخلق": السؤال "لماذا يوجد شيءٌ بدلًا من العدم أو بدلاً من لاشيء؟" أو "ما هو السبب الأول لوجود الكون؟" سؤال ميتافيزيقي. يتجاوز نطاق العلم لأنه يتعلق بواقع محتمل خارج النظام الفيزيائي الذي يدرسه العلم. السبب "الأعلى" أو "الأول" أو العلة الأولى ليس ظاهرة يمكن ملاحظتها أو إعادة إنتاجها في المختبر.
باختصار: لا يمكن تصميم أي تجربة علمية للكشف عن "الله". وجود خالق ليس فرضية علمية قابلة للدحض.
2. كيف يعالج العلم الأسئلة "النهائية"؟
حتى لو لم يستطع الحديث عن "الله"، فإن العلم يستكشف المجال الذي يُطرح فيه السؤال: إذا كان الله هو خالق الكون فمن خلق الله؟
* الانفجار العظيم وبداية الكون المرئي ونحن في داخله: تُظهر نظرية الانفجار العظيم أن للكون المرئي عمرًا محدودًا وبداية. بالنسبة للبعض، يشير هذا إلى "سبب" خارجي. وبالنسبة لآخرين، يؤجل هذا ببساطة المشكلة (من خلق الله؟) أو يفتح الباب أمام نماذج للأكوان الأبدية (مثل التضخم الأبدي أو النماذج الدورية) التي لا تتطلب "بداية". * ضبط الكون بدقة: تُضبط الثوابت الفيزيائية الأساسية (قوة الجاذبية، كتلة الإلكترون، إلخ) بدقة مذهلة للسماح بظهور الحياة. أي تغيير طفيف سيجعل الكون عقيمًا.
التفسير أ (علمي/طبيعي): مبدأ الأنثروبولوجيا. لو لم تكن الثوابت هكذا، لما كنا هنا للحديث عنها. في الأكوان المتعددة (عدد لا نهائي من الأكوان ذات الثوابت العشوائية)، من المحتم أن يمتلك بعضها الثوابت والقيم الصحيحة بمحض الصدفة. ونحن في أحدها. التفسير ب (ميتافيزيقيا): هذا الضبط الدقيق هو من عمل "مصمم عظيم" ذكي (مصمم) اختار هذه الثوابت.
لا يستطيع العلم الاختيار بين هذين التفسيرين. نظرية الأكوان المتعددة نظرية تخمينية (مع أنها ممكنة رياضياتيًا)، وفرضية المصمم غير قابلة للاختبار.
3. هل الله داخل الكون أم خارجه؟
هذا السؤال فلسفي ولاهوتي بحت. يتعارض مفهومان رئيسيان:
* الإله المتعالي (الخارجي): هذا هو المفهوم الأكثر شيوعًا في الديانات التوحيدية (المسيحية، الإسلام، اليهودية). الله متميز عن خلقه؛ فهو خارجي وسابق عليه. هو العلة الأولى غير المسبب. هو "يتجاوز" الكون ولا يخضع لقوانينه (المكان، الزمان، المادة). هو الله الخالق للكون من العدم (من العدم؟) ماهوالعدم.
* الإله الداخلي (الباطني): هذا مفهوم أقرب إلى وحدة الوجود (الله هو الكون) أو وحدة الوجود (الله موجود في الكون ولكنه متعالٍ عليه). في هذا المنظور، ليس الله كائنًا شخصيًا خارجيًا، بل قوة، أو وعيًا، أو جوهرًا يتخلل كل شيء في الطبيعة. وبالتالي، فإن الكون تجلٍّ لله.
لا علاقة للعلم بهذا الجدل، لأنه يتعلق بطبيعة الله ذاتها التي لا يستطيع أحد وصفها أو توصيفها، وهو مفهوم لم يُعرّف علميًا.
الخاتمة: جدول ملخص
الجانب: الموقف العلمي
الموقف الفلسفي/اللاهوتي
وجود إله خالق: لا يمكن إثباته أو دحضه. خارج نطاق العلم. إنها مسألة إيمان وعقل. تُناقش حجج مختلفة (كونية، غائية)، ولكن دون دليل قاطع.
التعريف العلمي لله: مستحيل. "الله" ليس مفهومًا علميًا قابلًا للاختبار أو القياس. يُعرّف الله بالنصوص المقدسة والفلسفة والتجربة الشخصية (مثل: أبدي، كلي القدرة، عليم، خيّر).
الموقع (داخلي/خارجي): غير قابل للتطبيق. يدرس العلم الكون المادي. إذا كان الله خارجه، فهو خارج نطاق دراسته. موضوع جدل عمره آلاف السنين بين التسامي (الخارجي) والمحايثة (الداخلية).
باختصار:
يقدم لنا العلم وصفًا رائعًا ومتزايد الدقة لكيفية عمل الكون وتطوره. لكنه يتجاهل السؤال الجوهري حول سبب وجوده وهل له "سبب" أو "معنى".
الإيمان بإله خالق هو خيار شخصي، أو إيمان، أو قناعة فلسفية مدعومة بحجج تتجاوز المنهج العلمي. لا يُؤكدها العلم ولا يُدحضها، بل توجد في نطاق مختلف من المعرفة البشرية.
***
د. جواد بشارة