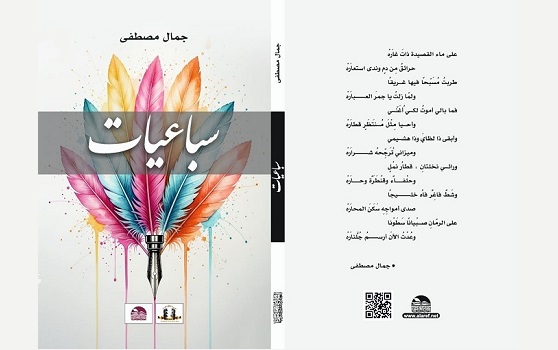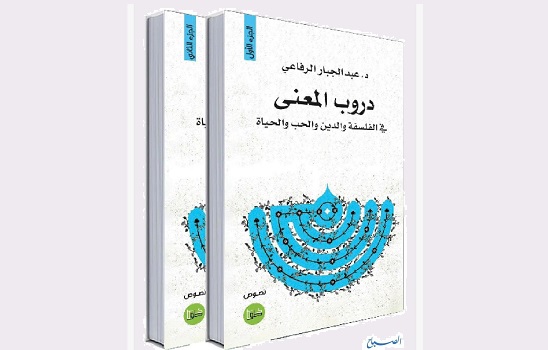قراءات نقدية
كوثر بلعابي: شواهد الواقع التّونسي وروافده بصيغة روائيّة في رواية: "زهرة الصّبّار"

قراءة تتقصّى تشكّلات الواقع في الخطاب الرّوائي
تصدير: يكون الأدب واقعيّا متى أعاد إنتاج الواقع سيميائيّا برؤيا فنّيّة خاصّة ومختلفة.
تقديم: قامت الواقعيّة كمفهوم أدبيّ عامّ على مبدأ تعامُل الأدب مع الواقع بطرق ومن زوايا نظر عديدة؛ بما أنّ كلّ أثر أدبيّ مهما كان نوعه هو بالضّرورة سليل أديمه الحضاريّ والاجتماعيّ وخاصّة في فنّ الرّواية الذي بات الأكثر استقطابا للأدباء والقرّاء كليهما باعتبار ما ينعكس فيه من أصداء الواقع حتّى قيل: (إنّ الرّواية هي الشّكل الأدبي الأقوى والتّعبير الأنسب عن الواقع... فلا توجد رواية مهما كانت طبيعتها تاريخيّة أو خياليّة أو رمزيّة... خالية من آثار الواقع - محمّد الخبو - " مداخل إلى قصصيّة المعنى") فمابالنا بالرّواية الواقعيّة التى عرفت مسيرة متطوّرة مع التّحوّلات التّاريخيّة والعلميّة والنّظريات الفلسفيّة في العالم والتي انضمّت إليها الرّواية العربيّة في مرحلة متأخّرة عن الأدب الغربي بشكل جعل لها ملامحها المرتبطة بالواقع العربي وبالهويّة الثّقافيّة العربيّة رغم انصياعها النّسبيّ والمتفاوت إلى الأصول العامّة للواقعيّة الغربيّة على الأقل في مستوى البُنى الفنّيّة للخطاب السّردي. ومن البديهيّ أن يكون للواقع العربيّ وما شهده من تغيّرات وما شمله من تناقضات واهتزازات أثرُه في تطوّر الرّواية العربيْة عامة والتّونسيّة خاصّة والتي كان لتيّار الحداثة فكريّا والالتزام فنّيّا تأثيره العميق والواضح على شكلها ومضامينها؛ تأثيرا انسحب على الإبداعات الرّوائيّة النّسائيّة بدورها. وقد سجّل العقدان الثامن والتّاسع من القرن العشرين تزايدَ انخراط المرأة في الحياة الأدبيّة ليس بدافع منافسة الرّجُل وتجاوز دونيتها إنّما لإثبات وجودها الإنسانيّ وإبراز قدرتها على الإنجاز والإبداع حيث طفقت بالفعل تفرض وجودَها في كتابة الرّواية بمقوّمات التيّار الأدبي السائد آنذاك في سياق مرحلة انتقاليّة بين الواقعيّة النّقديّة (التي تزامنت مع مرحلة الالتزام في الشّعر وبروز جماعة الطّليعة) وبين بدايات التّوجّه نحو تّيّار التّجريب بحثا عن مُمكِنات كتابة جديدة. ولمعت خلال تلك المرحلة أسماء كاتبات سجّلن الإضافة البارزة والحقيقة بالتّنويه إلى المدوّنة الأدبيّة التّونسيّة وربّما حتّى العربيّة أذكر من بينهنّ مثلا: صاحبة الإسم المستعار زكيّة عبد القادر في رواية " آمنة " 1983 عروسيّة النّالوتي في رواية " مراتيج " 1985 وعلياء التّابعي في " زهرة الصّبّار " 1985 (بغضّ النّظر عن تاريخ إصدارها: أفريل 2003). وهي روايات تعاقدت مع الواقع بشواهده وروافده بطرق متباينة في فترة تاريخيّة ساخنة عاشتها البلاد التّونسيّة على وقع أحداث خطيرة من الصّراعات السّياسيّة والإيديولوجيّة بين نظام الحكم والمعارضة النّقابيّة واليساريّة خاصّة وبين القوى اليساريّة والقوى اليمينية التي سرعان ما انتشرت وتغلغلت في المجتمع منذ نشأتها مع منتصف السّبعينيات. من هنا كان اختيار رواية " زهرة الصّبّار " التي كُتِبت بقلمٍ وظّف شواهدَ ذاك الواقع وروافدَه برؤيا نسائيّة يساريّة في منتهى الثّوريّة منطلقا في تناول موضوع الرّواية الواقعيّة النّسائيّة في تونس.
وأعني بالشواهد تلك السّمات والدّلائل التي استمدّها الخطاب السّردي من الواقع التّونسي في مرحلة تاريخيّة حدّدتها علياء التّابعي كفضاء ومادّة لروايتها.
وأعني بالرّوافد جملة المرجعيّات الثّقافيّة والمعرفيّة التي صحبت ذلك الواقع وحدّدت هويته وساهمت في تكوين الرؤيا السّرديّة للرّواية على مدى الوعي بقضاياه ومشاكله.
فكيف أنشأت علياء التّابعي من هته السّمات والمرجعيّات مُنجَزا روائيا استطاع أن يكون؟؟
شواهد الواقع التونسي في رواية "زهرة الصَّبّار":
تمتدّ هذه الرّواية الصّادرة عن دار الجنوب للنّشر - تونس - ضمن سلسلة عيون المعاصرة على 140 صفحة وعلى تسعة فصول متفاوتة من حيث الكم متفرّقةٌ، ترتيبُها العدديّ على غير نظام زمنيّ او مشهديّ جليّ، قدّمها الدّكتور هشام الرّيفي في 20 صفحة. لم تخلُ واجهتُها / عَتباتُها مِن شواهد سواء في مستوى العنوان الذي يحيل على الغطاء النّباتي والعلامة المميّزة لجبال الشّمال الغربي ذاك العماد الرّفيع لتونس الدّاخل؛ مُتّكأ تونس السّاحل. أو في مستوى تسجيل المؤلّفة في عقب الرّواية لتواريخ تأليفها ومراجعتها (ص 170: تمّت... تونس 84 - 1985... روجِعَت في المنستير 1987 / 1989) أو على مستوى التّنبيه الذي صحب الإهداء المُترع بالعرفان للأساتذة، والمؤلّفة منهم وتعرف مقدار فضلهم على البلاد والعباد، (ص 29) التنبيه المراوغ يروم تنصّل الرّواية من شواهد الواقع فيعمّق توريطها فيه بأحداثها وشخصيّاتها: (تنبيه: كلّ شخصيّات الرّواية ووقائعها خياليّة وكلّ تشابه بينها وبين أشخاص حقيقيين محض صدفة لا دخل للكاتبة فيه) وهذا يغلُب على القارئ عدم تصديقِه في حقيقة الأمر بعد إتمام القراءة.
قام البناء الدّرامي للرّواية (أو هيكل الأعمال على حدّ تسمية النّاقد الصّادق قسومة) على لقاء عاديّ في ظاهره بين امرأة سمّتها المؤلّفة " رجاء " ورجُل سمّته " أحمد " جمعتهما قصّة حبّ مقبورة رغم عمقها. كان لقاء مراجعة ومحاسبة أكثر منه لقاء عتاب بين حبيبين شطّت بهما النّوى طيلة أكثر من خمس سنوات: حدث وحيد ذاتيّ استغرق ليلة واحدة تناسلت منه أحداث عقد كامل من الزّمن بين منتصف سبعينيّات القرن العشرين ومنتصف ثمانينيّاته تداخل فيها الذّاتيّ والموضوعيّ في حركة سرد لا تقوم على منطق ناظم لهذه الأحداث بقدر ما تقوم على استدعائها حسب ظهور الشّخصيات. فاستوعب اللّقاءُ تاريخَ مرحلة سياسيّة واجتماعيّة وثقافيْة بأسرها. أجادت المؤلّفةُ، في الإلمام بها، إستخدامَ الوسائل الرّوائيّة الحديثة من تنويع لأصوات السّارد وزوايا نظره، ولأشكال توظيف الحوار الدّائر بين الحبيبين أثناء لقائهما، وخاصّة تنويع استخدامات تقنيتَيْ الاستبطان والتّذكّر (flash bac) بشكل مكّن من وضع الشخصيّات في محيطها الواقعيّ وجعلها تخبر عن ملامحها وتركيبتها وعلاقاتها من حيث هي نماذج من مكوّنات المجتمع التّونسيّ ونخبته المثقّفة.
هذا اللّقاء الحدث الذي تنفرط منه أزمنةُ الرّواية وشخصيّاتُها وأحداثُها ومشاهدُها لتنتظم فيه وتعود إليه في بناء دائريّ مغلق كما السّجن الكبير المحدق بالوطن ومَن فيه؛ استغرق من زمن النّصّ (زمن الحبكة) ليلة واحدة، كما ذكرتُ سلفا، بدأت بعد عودة أحمد من باريس مصطحبا ابنه من زوجته الفرنسيّة (آن) إلى أرض الوطن وبعد الوصول إلى منزل شقيقته بالمرسى حيث ترك ابنه في رعايتها ليتّجه مع بداية اللّيل إلى باب الخضراء حيث تُقيم " رجاء " واستمرّ إلى أن (ص 169: أذّن عبد الباسط للفجر وتحرّكت ستائر غرفة رجاء بنسائم الفجر الاطمئنان) فترة زمنيّة كانت كافية قياسا إلى سعة خيال المؤلّفة لاستدعاء زمن تونسيّ مُتعدّد (من عصر عليسة وحنّبعل إلى عصر الأغالبة ثمّ عصر البايات والإستعمار الفرنسي ومعارك التّحرير الوطني وعصر الاستبداد والحكم الفردي وما ترتّب عنه من معارك)، وزمن عربي تعاورته الخيبات، وزمن عالمي ممتدّ من الثّورات (الاتّحاد السوفييتي والصّين) إلى الحروب النزاعات (كوبا جنوب أفريقيا) إلّا انّ الزّمن الموضوعي السّائد والبارز والمتداخل مع الزّمن النّفسي للشّخصيات وتحديدا شخصّة " رجاء " في الرّواية هو بالأساس زمن اليسار في تونس؛ زمن ما بعد أزمة "حركة آفاق / perspectives " التي احتدّت ملاحقةُ السُّلطةِ لعناصرها بسبب مُشاركتِها في تنظيم التّحرّكات في عقب هزيمة حزيران / جوان 1967 إلى أن تلاشى وجودها في 1975. هو زمن حكاية " رجاء " مع اليسار التّونسي مع حبيبها " أحمد " الذي تركها وهي في أمسّ الحاجة إليه وفرّ إلى باريس دون سابق إنذار ومع زوجها " عادل " صديقه الذي أحاطها برعايته وأخلص لها وهو يعلم أنّ قلبها ليس له. وزمن حكاية تونس الوطن مع عشّاق الدّاخل الذين كانوا (ص 118 119: يساريين في واقع يمينيّ يريدون إخضاعه لمعادلات صيغت في الاتّحاد السّوفييتي أوالصّين...) وزُناة الخارج الذين (ص 34: خادنتهم ورقصت لهم ولم تُقلع عن آفة التّبرّج لهم...). حكاية تونس التي توالت عليها التّواريخُ الحالكة (ص 143: جانفي الأسود وخميسه الدّامي 1978.. ص 163 وخريف 1981 الذي زوّرت فيه الانتخابات الرّئاسيّة…).
هكذا حضر الزّمن في تعدّده واقعيّا متظافرا يؤرّخ لما منعته حُجُب التّاريخ الرّسميّ في تونس والعالم بطريقة السّرد الأدبي وليس بطريقة التّوثيق العلمي في كتابة روائيّة تنبش في التّفاصيل المغمورة تنفض عنها غبار النسيان وتسائلها عن حقيقة الذي كان. سنلاحظ أنّ ملامحها بدأت تتبلور أكثر مع روايات القرن 21 مع العديد من الأدباء
شّخصيّات الرّواية بدورها تحمل في أحوالها وأقوالها وأفعالها والفضاء المكاني الذي تتحرّك فيه شواهدَ هذا الواقع: " فرجاء" التي قدّرت لها المؤلفة وزر دور بطولة الرّواية بما يعنيه من صراعات وجدانيّة ووجوديّة واجتماعيّة باعتبارها امرأة مثقّفة في مجتمعنا الذّكوري ويساريّة ثوريٍة في بلد يحكمه الاستبداد. وشاءت لها أن تكون نَبتَة صبّار لم يستطع أن يُزهر ونُزِعَ عنه شَوكُه رغم توقها للإزهار تعيش (ص 91: الصّراع المرير مع كلّ سلطة عمياء وأوّلها سلطة الأب). شابّة تونسيّة من العاصمة استفادت مع جيلها من البنات من سياسة التّعليم العمومي الحداثيّة والملزمة قانونا بتعليم البنات والأولاد على قدم المساواة شأنها شأن المؤلّفة وتخرّجت أستاذة مثل المؤلّفة أيضا من كلّية الآداب بتونس. ولمّا عُيّنت للتّدريس بمنطقة ريفيّة جبليّة (مكثر من ولاية سليانة) ينبُت فيها الصّبّار ليُزهر ويُثمر وجدت نفسها تُقيم مع باحثة أوروبيّة في علم الآثار جاءت إلى بلادنا في مهمّة "علميّة " وجها لوجه، ممّا أثار في داخلها وبعمق مسألة الهويّة بمختلف أبعادها (ص 128: فإذا البلاد أوسع من مدينة وإذا تضاريسها تروي تاريخا عريقا ضاربا في القِدم... واحتدّت بداخلي أزمة الهويّة) ووجدت نفسها تدافع بشراسة عن فلسطين في وجه تلميذ صرّح بأن قضيّة فلسطين تهمّ الفلسطينيين وحدهم وبأنّ مشاكل تونس أولى باهتمامنا. وقد أصابها ما أسمته (ص 157: داء النّفور من الجزء الأوروبي في المدينة وأضربت عن دخوله وبدأت تتسكّع في الأحياء العتيقة). فكانت مجسّدة لأزمة التّضارب بين الوعي بحركة التاريخ ودور المثقّف وبين إكراهات الواقع المحاصر بسلطة الحكم الفردي والسّجون التي تفتح أبوابها لابتلاع الشباب المناضل والتي ذكرتها المؤلّفة بأسماءها جميعا تقريبا (برج الرّومي - رجين معتوق - السّجن المدني - سجن المرناقيّة...) على لسان الشخصيّات كشواهد على ضريبة الاصطفاف ضدّ السّلطة التّي سدّدها أمثال أحمد (حبيب رجاء اليساري المعتدل الذي دفعه شرخُ الإحباط إلى الهجرة نحو فرنسا ليبني مستقبله الفرديّ بنجاح هناك دون أن يلتفت إلى ما يحصل للبلاد ولا لرجاء بعده) أو عادل ابن قفصة المناجم (زوج رجاء الذي حاول الّتخفيف من وطأة تخلّي أحمد عنها.. اليساري الذي تشبّث بالإيديولوجيا بقدر تشبّعه بها فدفع أسنانه وحياة شقيقه سامي تحت التّعذيب في السجن ثمنا لذلك) وفي مختلف هذه المتناقضات الجزئيّة والكلّيّة حشرت المؤلّفة رجاء لتقيّم من خلالها طبيعة تعامل الفكر اليساري مع الواقع التّونسي وكأنّها تسلّط الضّوء وبطريقتها الرّوائيّة علي أسباب فشله بشقّيه المعتدل والمتطرّف (ص 106 بين رجُلين خسرتُ حياتي كلّها رجُلِ مجنون سكنه الدّمار ورجُل راهن حتّى النّهاية على انقلاب الموازين. كِلاكما أحمق.... بين غبيّين وقفتُ غبيٍّ ظنّ نفسه مشطورا فقامر على الجانب المظلم لأنّه يعطيه وهم القوة، وغبيٍّ كلّف نفسه عناء تغيير العالم فصلبوه والحال أنّ الأرض كلّها كانت في متناوله ولكنّه بصق على الحلول السّهلة)
وبين هذه الوقائع والأزمات والانكسارات كانت شخصية رجاء في حدّ ذاتها بمثابة شاهد من الواقع الاجتماعي يرمز إلى البلاد التونسيّة في انهياراتها وانزلاقاتها واهتزازاتها.. في انشطارها وحيرتها بين الشمال والجنوب والمدينة والبحر والحبّ والسّياسة وأيضا في بحثها قُدُما عن البعث والخلاص وفجر جديد ليس خلوا من هويتها الرّوحانيّة (فجر يؤذّن فيه "عبد الباسط عبد الصّمد" ويزهر فيه الصّبّار ويثمر) وهذا ما تحيل عليه رمزيّة الإسم في حدّ ذاتها (رجاء) فضلا عن رمزيّة الأماكن التي اجتمعت في الرّواية بكلّ تفاصيلها وأسمائها كما هي في الواقع (قرطاج، المرسى، حي الخضراء، نوتر دام، لافاييت، دار الثقافة ابن رشيق ،البلماريوم، سوسة، قفصة مكثر...) بتنوّع مشاهدها ومعمارها وتضاريسها وشواهد تاريخها حتى لكأنّ أدوات السّرد تضع القارئ أمام جغرافيا تونس من وجهة نظر أدبيّة ليدركها بشكل مختلف.
روافد الواقع التّونسي في رواية " زهرة الصّبّار":
بما أنّ الرّواية هي عمل لغويّ بالأساس، يختار مبدعُها في العادة لغةَ مُنجَزه وفق رسالته الأدبيّة وما يتناسب مع مكوّنات السّرد فيها ووفق السّياق الثّقافي والاجتماعي الذي تنتمي إليه. واللّغة في هذه الرّواية جاءت لتتناسب مع انتماء المؤلّفة إلى سلك التعليم وإلى فئة مثقّفي اليسار التّونسي الذين استلهمت منهم شخصيات روايتها لذلك جعلتهم يتكلّمون عربيّة فصيحة تجمع بين البلاغة وسلاسة الإبلاغ في الغالب وكأنّها بذلك تعمل على تجذير عملها الأدبيّ في أديمه الحضاريّ، من جهة وتثبت من جهة ثانية أن لا تعارض بين اللّغة العربيّة حين نُجِيد استخدامَها وبين الكتابة الواقعيّة التي قد لا تستوجب أصلا استعمال اللّهجة العامّيّة. فأنشات عالمها الروائيّ وأفكارها ورؤاها التي ألبستها للشّخصيات المجسّدة لها من تلك اللّغة الفصحى الميسّرة في رقيّ وطعّمتها في بعض الوضعيات الانفعاليّة التي ألمّت بالشّخصيّات باللّهجة التّونسيّة المكحيّة ومختلف أبجدياتها حتى السّوقيّةمنها والدّخيلة (الفرنسيّة بالأساس). بل ونجدها وبشكل طريف وعلى غير المعتاد تعمد إلى وضع هامش لشرح مفردات اللّهجة المحكيّة كلّ حين والحال أنّ مثل هذه الهوامش توضع في العادة لشرح مفردات اللّغة الفصحى خاصّة إذا كانت من الحوشيّ. (ص 80: التكعرير: لوك الكلام / التجلطيم: القول الجارح / التكمبين: الدّسّ والإيقاع والكيد / البونية: قبضة اليد كناية عن منطق القوّة...) فإذا بنا أمام رافد واقعي يضع اللّغة الفصحى والمحكيّة كلتيهما على محكّ الاستعمال المتلازم المتكامل في المجتمع مخالفة لما يروّج له بعض الأدباء من أنّ كتابة الواقع تكون (أعمق وقعا ابلغ أداء إذا كانت بلغة عامّة النّاس). وهذا نهج أدبيّ اعتبره الأستاذ " محمود طرشونة " من قبيل (تطبيق وجهة النّظر التّجريبيّة) وكذلك هو موقف ثقافيّ ليس غريبا عن علياء التّابعي التي جعلت شخصية رجاء وهي تخاطب أحمد أوتسترجع محادثاتها مع عادل أو مع صديقتها هدى تضع (ص 70: التّوحيدي في مواجهة مع " مونتاني "، ثورة يولية 1952 في مواجهة ثورة أكتوبر 1917 ، وأشعار الشّابّي والبيروني في مواجهة اشعار " اليوت " و"ماوتسي تونغ " أغاني صليحة وعبد الحليم حافظ وأمّ كلثوم في مواجهة أغاني " ميريام ماكيبا " و" ليو فيري" ) وفي مواضع أخرى تضع (ص 146: مقولات ابن رشد والطّبري في مواجهة نظريات " فوكو " و" بارت " و" شتراوس") وكذلك مقولات النّفّري الطّاهر بن عاشور في مواجهة مقولات ماركس ولينين معلنة أنّها (ص 145: راجعت أخطاءها النّظريّة والعلميّة وأنّه يجب الآن الحفر في الواقع بعيدا عن مقولات ماركس ولينين وتقرير خروتشاف...) بذلك نقلت المؤلّفة جملة الرّوافد الثّقافيّة المتنوّعة تنوّعا ممتدّا عبر الزّمان (القديمة والمعاصرة) وعبر المكان (العربيّة التّونسيّة والأجنبيّة) التي تفاعلت في طبع شخصيّة التّونسيين عموما بشيء من الازدواجيّة الثّقافيّة حتى في طريقة عيشهم اليوميّة، والتي أثّرت حتما في تشكيلِ وعيِ المثقفين وفكرِهم وتبعا لذلك في قراءتِهم لواقِعِهم وتحديدِ مواقفهم إزاءَه بمن فيهم المؤلّفة التى وظّفت رصيدها المعرفيَّ والثقافيَّ في مُنجَزِها الرّوائيِّ توظيفا يسمح بإدراجه ضمن المنحى التّجريبي. هذا المنحى الذي يتّضح أكثر من خلال عملِها على استنطاقِ ما زخرت بِهِ فصولُ الرّواية من روافدَ ومرجعيات ومساءلتها بحثا عن مُمكِنات تصحيح المسار (ص 110: الآن عرفتَ وعليك تصحيحُ المسار) في الحياة والعمل وإعادة هيكلة اليسار ليستطع تجاوز فشله إذ كان (ص 120: تربة مهيّئة لنموّ الهزيمة) لذلك لم يخل الخطاب على امتداد فصول الرّواية من طرح الأسئلة المستفزّة والمُحفّزة منها ما تعلّق بقيم المجتمع (ص 61: هل تعنينا عُذريّة الرّحم أم عُذريّة القلب؟) ومنها ما تعلّق بقيَم الوجود (ص 62: فلتبحث معي عن المعنى... المعنى؟؟ وهل وجدته انت؟؟) وكذلك (ص 113: هل يلومني على استقلاليتي أم ألومه على رزمة المسلّمات والبديهيات التي يحملها فوق ظهره؟) ومنها ما تعلّق بالابستيمولوجيا أيضا (ص 146: أنا أجهل نفسي، فكيف أعرف غيري؟) وكذلك ( ص 92: لماذا نحنّ إلى الخطإ من جديد ولا نتعلّم شيئا ولا نفهم أنّنا بلا مجد حقيقيّ؟؟) أسئلة رغم أنّها تبدو عامّة إلّا أنّها تخلّلت تفاصيل الواقع في الرّواية لتحمل المتلقّي على التوقّف عن (التّربيت المنافق على كتف التّاريخ المزيّف التّوقّف عند جلد الذّات) ولتَحمِله على التّفكير في الحلول والبدائل..
هكذا جاءت الرّواية مرتبطة بسياقها التّاريخي الجغرافي كما جاءت ايضا مرتبطة بسياقها الحضاريّ قائمة على رؤيا إبداعيّة لا تروم التّسجيل بقدر ما تروم المراجعة والتّحليل من أجل التّمكّن من النّقد الذّاتي نقدا بنّاءً وتصحيح المسار كما صرخت المؤلّفة على لسان رجاء (ص 62: والانبعاث من جديد مثل طائر الفينيق ينبعث من رماده).
خاتمة:
بدا الواقع بشواهده وروافده في هذه الرّواية (وروايات أخرى متزامنة معها) محمولا وحاملا في آن واحد. فهو محمول كمشاهد وأحداث وشخصيّات ومحطّات تاريخيّة... مثّلت المادّة التي أنشئ منها الخطاب الرّوائي. وهو حامل لجملة الرّموز والمواقف التي جسّدت الرّؤيا الإبداعيّة بل الإيديولوجيّة لعلياء التّابعي كشاهدة على خيبة امل وطنية في مرحلة من تاريخ تونس، وكشاهدة أيضا على مرحلة أدبيّة كانت وراء بلوغ الرّوائيّة تونس مستوى يّعتدّبه به.
حتّى لكأنها وهي تكتب زهرة الصّبّار على هذا المنحى التّجريبي، كانت تكتب العالم الدّاخلي للمثقفين من جيلها بما في ذلك عالمها الدّاخليّ بِلُغتِها وثقافتِها ومواقفها ومشاعرها الشّخصيّةِ. فلم تجعل روايتَها بمثابةِ سجلّ للوضع السّياسيّ والإجتماعي في تونس ولا بمثابة سجلّ لليسار التّونسي وفهرسةِ مكتبته فقط ، بقدر ما جعلتها واعزا للمراجعة والنّقد الذّاتي مدفوعة " برجاء " وقف النّزيف المترتّب عن الصّراع بين السّلطة والمعارضة وبين قوى اليمين وقوى اليسار، والذّهاب نحو تضميد الجراح برؤيا جديدة قوامها أنّ الوطن بجميع أرجائه برّه وبحره أريافِه ومدنِه يبقى وطن الجميع مهما اختلف أبناؤه وتقطّعت بهم السّبل ، كي لا يظلّوا على مَرّ التّاريخ يتحسّرون (ص 147 على حياة ذهبت قبل أن تُعطي ثمار الهزّات المُرّة، قبل أن يُزهر الصّبّار...).
***
بقلم: كوثر بلعابي
.......................
المصادر:
1 - رواية " زهرة الصّبّار" لعلياء التّابعي عن دار الجنوب للنّشر - تونس - ضمن سلسلة عيون المعاصرة
2 - رواية " مراتيج " لعروسية النّالوتي عن دار الجنوب للنّشر - تونس - ضمن سلسلة عيون المعاصرة
المراجع:
1 - كتاب " طرائق تحليل القصّة " للصادق قسومة عن دار الجنوب ضمن سلسلة مفاتيح
2 - كتاب " مباحث في الأدب التّونسي المعاصر" لمحمود طرشونة " عن المطابع الموحّدة بالشرقيّة - تونس - 1989
3 - كتاب " عروسيّة النّالوتي المهاجرة إلى أعماق الذّات" منشورات منتدى الفكر التّنويري التّونسي ضمن سلسلة أعلام الثّقافة التّونسيّة..
4 - مقال" الهوية في الرّواية النّسائيّة التّونسيّة: زهرة الصّبّار لعلياء التّابعي مثالا " مجلّة الحياة الثقافيّة العدد 213 الصّادر في ماي 2010.