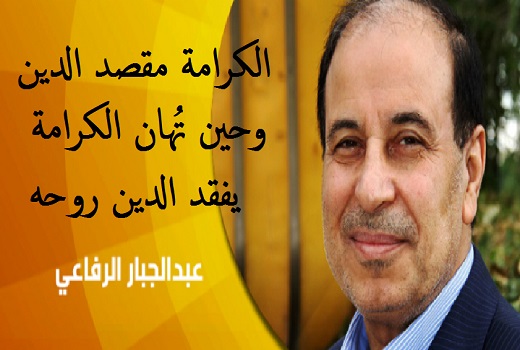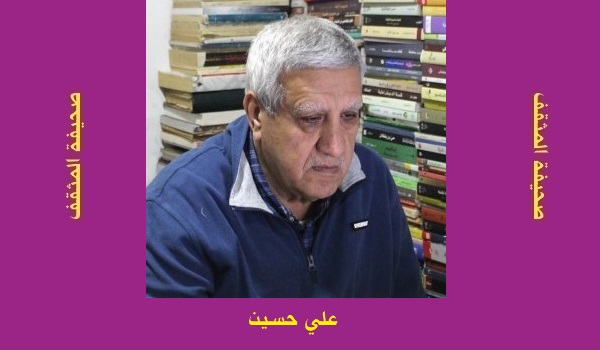قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: الشذرة النقدية

قراءة هيرمينوطيقية تأويلية وأسلوبيّة ورمزية وسيميائية في قصيدة: «رَسائِلُ مَقْصُوفَةٌ» للنّاشِدَةِ: نبيلة الوزّاني
تبدو هذه القصيدة وكأنها صندوقُ بريد أزرق يُرسِلُ مناخه بين عوالم: عالمُ التِّقنيةِ الباردة (الميجابايت) وعالمُ البحرِ الوجدانيّ، فتنبثق من هذا التلاصقُ مفارقةٌ تلتقطها النصوصُ الحديثة: تلاقُحُ الرقميّ مع العتيق، والحَفْرُ في الذاكرةِ برمْلٍ يَبتلعه الريح. وسأحاول في ما يلي تفكيكَ النصّ بطبقاتٍ متعدّدة — هيرمينوطيقا، أسلوب، رمز، سيمياء، نفسيّ-دينيّ — لنسبر ما تحت جلد الشعر من نبضٍ وتوتّرٍ ودلالة.
1. العنوان والانتقال الهيرمينوطيقي:
«رَسائِلُ مَقْصُوفَةٌ» — في الترجمة الأولية للمعنى، العنوانُ يعلنُ حالةَ انقِطاعٍ: رسائلُ مقصوفة قدْ قُطِعَت، أو قصائدُ مقصوفة بمعنى مُحذوفة السطر الأخير. هيرمينوطيقياً، العنوان يحيل إلى قصْرٍ في التواصل؛ هو إعلان إصابةٍ في آلية البثّ بين المرسل والمستقبل. بهذا تضع الشاعرةُ القارئَ في انتظار تفسيرٍ مزدوج: هل القَصْفُ لغويّ أم وظيفيّ أم وجوديّ؟ الإجابة تتوزّع عبر النصّ: كلّها معًا.
2. الموضوع المركزي والدلالات الرمزية:
ثيمةُ الغياب والاتصال المقطوع تتكرر كنبْضةٍ مركزية: البريد الأزرق، الميغا بايت، التغطية، البحر، الرمل، الريح، المجذاف.
البريد الأزرق / الميغابايت → رمز الحداثة والتقنية، لكنه هنا مقيَّدٌ، معطّل: تقنيةٌ لا تُتيح اللقاء، هي وسيلة اتصالٍ تُعطَّل بفعل غياب "التغطية". رمزٌ للزمن المعاصر حيث تتكاثر الوسائط لكنّها قد تعجز عن التلاقي الحقيقي.
البحر → الترميز الكلاسيكي لللاشعور والعمق، مصدر الطوفان والنبذ. البحر يلفظُ ويبتلع، هو قِدْرُ الحريق النفسي ومساحة التوهان.
الرمل والريح → الذاكرةُ التي تُمحى، الكتابةُ التي يُطوِيها الزمن.
المجذاف/الجيب/الرسائل → عناصرُ فعلية تشير إلى فاعلية ذاتٍ صغيرةٍ تحاولُ الإبحار في بحرٍ واسعٍ، لكنها عاجزة.
بهذه المعادلة الرمزية تتشكل رؤيةٌ تقول: التكنولوجيا لا تغنينا عن العمق؛ والحبُّ في زمنِ الاتصالات قد يُصبِح تجربةً منقطعةً تتأرجح بين حضورٍ افتراضيّ وغيابٍ حقيقيّ.
3. البنية الأسلوبية واللغة والوزن:
القصيدة تنتمي إلى النثر الشعري/القصيدة العمودية المتمردة؛ لا تقف على قافيةٍ منتظمةٍ ولا وزنٍ تقليدي ظاهر. الخصائص الأسلوبية اللافتة:
التقطيع والكسور: شواهد مثل: "/تَبْنِيهِ لِلمَجْهولِ / وَتَطرَحُهُ مِن جَدوَلِ الأَعمَالِ/" — استعمال شرطاتٍ وشرط مائل (/) يخلق وقفًا استعاديًا، ويكسر التدفق، مضيئًا حالة الانقطاع والتقطع التي يعبر عنها الموضوع نفسه.
-التكرار والتوازي: تكرار كلمة «الرَّسائِلُ» في مطلع المقطع المحوري يعطي النصّ إيقاعًا أنشوديًا وقداسةً للمرسل؛ التوازي في الصور (موجةٍ وموحةٍ") يعزّز حالة التردّد.
-الصوتيّة والوزن الداخلي: هناك فنية في الاستعانة بالصوامت المتشابهة (تكرار الراء، الميم) التي توفّر موسيقى داخلية؛ وفي المقابل استعمال مفردات معاصرة (الميجابايت) يخلق صدامًا لغويًا مقصودًا يقرّب النصّ من واقعنا الرقمي.
-الخطاب الشِعريّ المتعدّد: النص ينتقل بين المخاطب/المخاطَب (أنتَ)، والراوية المتكلّمة (أنا)، وسردٍ تأمّليّ؛ هذا التعدد يفتح فضاءً حواريًا باختصارٍ باختزال.
-ملاحظات لغوية ونحوية وصياغية:
عبارة «المَيْجابَايْتْ»: من الأفضل لفظها/كتابتها بالعربية المعتمدة: «الميغابايت» أو «الميجابايت»، لتجنّب تشتيت القارئ.
في البيت: «تَبْنِيهِ لِلمَجْهولِ وَتَطرَحُهُ مِن جَدوَلِ الأَعمَالِ/» — تركيب «تبنيه للمجهول» يحتاج وضوحًا نحويًا: هل تبنيه لتصبح مجهولًا أم تبنيه متجهاً نحو المجهول؟ قد تكون هنا دلالةٌ على تغريب الفعل وسلبه، لكن جملةً أنضج لغويًا قد تُسهل التأويل.
السطر «أَفْتقِدُني/ أَفتَقدُكَ /» — هناك احتمال خطأ مطبعي: «أَفْتقِدُني» قراءةٌ مشتتة؛ الأصح في سياق المخاطبة: «أَفتقدُني؟ / أَفتقدُكَ؟» أو «أَفتقِدُني / أَفتقِدُكَ» (مع ضبط السؤال أو النفي). هذه الازدواجية قد تكون مقصودة لإثارة لُبسٍ بين السؤال والإقرار، لكنها أيضًا تضع قارئًا لغويًا أمام انقطاعٍ في الدلالة إن لم تُفسّر طبقيًا.
استخدام محسناتٍ بلاغيةٍ مثل الاستعارات المجازية (الرسائل كمجذاف) ناجح ويعطي النصّ بُعدًا تشبيهيًا صالحًا للتوسّع.
4. البُنى النفسية والدينية:
الهواجس النفسية في القصيدة تتبدّى في مشهدَي التوقّ والحرمان: المتكلِّمةُ شاعرةٌ تكتبُ رسائلَها في جيبها، تبتلعها الخيبة، وتذوبُ في خاتمة السطر. قراءة نفسية (فرويدية/يونغية) تكشف:
طابعُ النوستالجيا والمرثية: الحُبُّ هنا مأخوذٌ كبُنية فقدٍ تُشبه الاكْتئابَ أو الحزنَ الطويل الأمد؛ «صدرُكَ عاهةٌ مُزمِنةٌ» يصف حالةً نفسيةً كسجيّة.
الهو/الأنا/الأنا الأعلى: الذات الشاعرة تودّ الاتصال، والآخر «أنت» مُصوّر كذاتٍ تبني الحُبّ للمجهول، أي أنها تُشيِّئ الحُبّ إلى غايةٍ خارجيةٍ لا تعودُ إلى الذات. هذا يشي بوصفٍ إلازمُركزيّ للعلاقة: الآخرُ يبني لغير المتكلّمة، فيتحوّل الحبُّ إلى مشروعٍ مُغترب.
-البعد الديني/الوجودي: عبارة «تُنادمُني الوَحشَةُ» و«أَحْتسِي الخَيبةَ بِدمْعِ الحِبْرِ» تحملُ نوعًا من التشبيه الطقسي: الكتابة كطقس تطهير، الحبر كدم. هنا تلتقي الإيحاءات الصوفية (الكتابة بوصفها ممارسة تعبّدية) مع رؤيةٍ وجوديةٍ ترى في الكتابة انتفاضةً ضد سنوات الصمت.
5. السيمياء: العلامة والدالّ والمدلول
من منظور بنيّاتي-سيميائي، كلُّ عنصرٍ في النصّ يعملُ كدالٍّ على مقابلٍ مدلولي:
البريد الأزرق (دال) → العزلة في زمن الاتصالات (مدلول).
الميغا بايت (دال) → سرعة/بطء المعلومات، وفي القصيدة «الحبر مُقيَّد في بطء الميجابايت» يصنع مفارقةً ساخرة: الحبر، رمز التدوين القديم، مقيد ببطء الرقمي؛ دالٌّ على أن أدوات العبور الحديثة لا تضمن السرعة الحقيقية للالتقاء الشعوري.
الرمل/الريح (دالان) → محو الذاكرة/تفكيك الهوية.
بهذه القراءة تفقد العلامات استقلالها وتتحول إلى منظومة تشير إلى أزمة اتصال أعمق: أزمةُ التمثّلِ الذاتيّ والوجوديّ في عصرٍ يَعِجُّ بالوسائلِ ولا يَبْلُغُ المعنى.
6. المرجعيات الأدبية والفكرية الممكن استحضارها:
غائبٌ عن النص لكن مفيدٌ للمقارنة: محمود درويش في مشروعه عن الغياب والكتابة، إذ يتحول الغياب إلى فعل ومكان.
١ - هايدغر (وجود-نحو-الموت): قد نستعير فكرته لفهم الطابع الوجوديّ للقصيدة في مواجهة الفناء والفراغ.
٢ - باختين (المنثور الحواري): القصيدة كفضاءٍ متعدد الأصوات.
٣ - رولوخ/ريكو: عن السرد والهوية، فالرسائل هنا تشكل سردًا مشتتًا لهوية الراوية.
٤ - سيجموند فرويد/كارل يونغ: لقراءة مظاهر الحزن والشكوى والرموز البحرية كأيقونات للشخصيّة اللاوعية.
على الصعيد العربي: مقارباتٌ مع نجيب محفوظ أو أنساق الطابع الصوفي في الشعر المغربي (تصوّف ابن عربي في ذهابه للوحشة والذات) قد تضفي بعداً تراثيّاً.
7. أخطاء نقدية أو فرص للتقوية:
-تصحيح لغويّ بسيط: توحيد لفظة «الميجابايت» وإعادة ترتيب بعض التركيبات النحوية لتجنّب اللبس (مثالًا: «أَفْتقِدُني»).
-توطيد وحدة نصية: بعض الصور قوية لكنها تبدو متفرّقة. يمكن للمؤلفة أن تُعزّز خيطًا محوريًّا واحدًا (مثلاً: الرسائل كمَيَدانٍ أساسي) وتطوّره خطًا سرديًا متصلاً ليزداد الأثر الدرامي.
-التوسّع في الإيقاع: إدماج عباراتٍ قصيرةٍ وطويلةٍ بنيةٍ إيقاعيةٍ واضحةٍ قد يربط المشهدَ النفسيَّ بزمنٍ شعريٍّ أكثر تماسُكًا.
8. الخاتمة: قراءة تكاملية:
تقف قصيدةُ نبيلة الوزّاني هذه على مفترق الحداثة والعمق، بين البريد الأزرق وصدورٍ «عاهةٌ مُزمِنةٌ». هي قصيدةُ انتظارٍ تكتبُ عن الانقطاعِ كما لو أنه شكلٌ مُؤسَّسٌ من الوجود؛ لذا لا تكتفي بالشكوى بل تحوّل الكتابةَ—حتى لو كانت «مَقْصُوفَة»—إلى فَعلِ مقاومتها. عمليًا، النصّ ناجح في خلق مشهدٍ بصريّ-سمعيّ قوي، وفي استدعاء رموزٍ تعبر عن مأزق عصرنا: وفرةُ وسائل الاتصال مع فقرِ اللقاء الحقيقي. نقديًّا، يحتاج النصّ إلى ضبطٍ لغويٍّ ونحويٍّ طفيف، وإلى توحيد خيطٍ دراميٍّ يؤدي إلى ذروةٍ شعريّةٍ أقوى.
محاولة لمتابعة بحثية أو تقديمية:
1. مقالة نقدية: «الرسائل في زمن الشبكات: غياب الاتصال في شعر نبيلة الوزّاني»، تضمّ مقارنةً مع قصائد درويش ونزار قبّاني حول الغياب.
2. دراسة مطوّلة: فصل في كتاب عن «التقنية والهوية في الشعر العربي المعاصر» يستخدم هذه القصيدة نموذجًا.
3. نصّ منقّح: اقتراح تعديلات لغوية نحوية لإزالة اللبس في خواصّ مثل «أَفْتقِدُني».
إنّ الشعر هنا يظلُّ «رسالة مقصوفة» بحقّ: رسالةُ إنسانٍ في زمنٍ قطعتْهُ الوسائطُ دون أن تُسدّ فراغَه. والقراءةُ الهيرمينوطيقيةُ تُعيدُ لهذه الرسالةِ أفقَ الفهمِ وتمنحها صوتًا يوصِلها من جيبٍ إلى قلبٍ، حتى لو أعادته الريحُ إلى الرمل.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين.
.....................
رَسائِلُ مَقْصُوفَةٌ
فِي بَريدِكَ الأَزْرقِ
الحِبرُ مُقيَّدٌ في بُطءِ
المَيْجابَايْتْ
فَكيْفَ لِرسائِلِي
أَن تُصافِحَكَ
وَأنْتَ خَارجَ التَّغطِيةِ؟
*
صَدرُكَ
عَاهةٌ مُزمِنةٌ
كُلّما نَضجَ الحُبُّ في قَلبِكَ
تَبْنِيهِ لِلمَجْهولِ
وَتَطرَحُهُ مِن جَدوَلِ الأَعمَالِ/
*
تَعلَقُ بَينَ مَوجَةٍ وَموْجةٍ
تَشيبُ بِمِلحِ التِّيهِ
وَيَلفُظُكَ البَحرُ
تَكتُبُ وَجْهَكَ على الرَّملِ
فَيَطْويكَ الرّيحُ في جَيبِهِ /
*
الرَّسائِلُ لا زَوارِقَ لها
الحُبُّ لا شِراعَ لَهُ
وَحدَهُ الحُلْمُ
يَنكَمشُ دَاخلَ حُلمِهِ
*
الرَّسائِلُ قَلبِي
بَينَ المَدِّ وَالجَزرِ
وَأنا مُجرّدُ مِجذَافٍ
يُخاتِلُ عَجزَهُ
*
في جَيبِي حِكايَةٌ
عنْ قَصيدةِ حُبٍّ
مَضْرُوبَةٍ
وَحدَها الرّسائِلُ تَعودُ
دُونَ عُنوانِكَ
*
أَفْتقِدُني/
أَفتَقدُكَ /
لا خَطْوَ إِلّا الضَّياعُ
أَنا العَائِدةُ دُونَكَ
تُنادمُني الوَحشَةُ
أَحْتسِي الخَيبةَ بِدمْعِ الحِبْرِ
وأَذُوبُ
في خَاتِمةِ السَّطرْ ..
***
نبيلة الوزّاني / المغرب