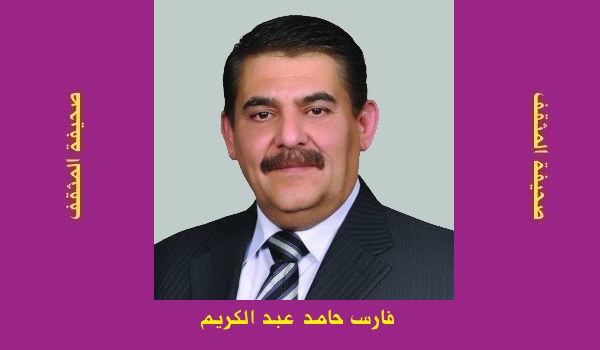قراءات نقدية
زينب احمد البياتي: جدلية العنوان والنص في مجموعة "أبجد حسن هوز" القصصية

لحسن مطلك.. مقاربة نقدية
يعد العنوان ذا اهمية قصوى للمتن ، لكونه مكثفاً له ومختزلاً للدلالة الأساسية التي تقوم عليها فالمتن يأخذ منه (شحنته التي تبقيه صالحاً للقراءة بكل أشكالها المواجهة والفاحصة) (1)؛ لذا لم يعد العنوان مجرد زائدة لغوية يأتي في أقصى أهميته لأجل التسمية فقط، بل تعداه إلى اختزال النص وتكثفيه، وبهذا عُدّ أخر عتبات المبدع التي يشتغل عليها وأولى عتبات القارئ التي يتمعن فيها، ويذكر (لوي هويك) الذي قدم تعريفاً أكثر شمولية جاعلاً إياه (مجموعة العلامات اللسانية، من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعيينه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف)(2)، وهو بهذا لخص المفهوم الحديث المتمركز حول العنوان، فهو علامة لغوية لسانية يعيين النص ويسميه ويشير إلى محتواه باختزاله، فضلاً عن الاهتمام بطريقة الصياغة اللغوية له بحيث يكون جاذباً لاهتمام الجمهور القارئ له.
ويعدّ العنوان مرتكزاً دلالياً يتكون من بنية لغوية لها مستواه السطحي الذي يعمل على (الحفاظ على اهتمام القارئ عن طريق تأمين كمية كافية من الإعلام) (3)، فيتخذ بذلك (دور المصيدة التي ينصبها الكاتب لاصطياد القارئ) (4) ومستواه العميق الذي (يولد النص باعتباره خطاباً سطحياً عبر عن مجموعة من عمليات التحويل كالتوسيع، والزيادة والاضافة والاستبدال، والحذف والتغيير والترتيب، وتمطيط الفكرة وقلبها إيجازاً، أو حذفاً) (5)، وبرز هذا المعنى للعنوان في النقد الحديث، وفي المناهج النقدية الحديثة بالتحديد كنظريات القراءة، وجماليات التلقي، وسيمائيات النص، و ظهرت علاقة العنوان في المنهجين الأخيرين بشكل أخص، فتوطدت علاقته بالسيميائية لكونه عد (نظاماً سيمائياً ذا أبعاد دلالية، وأخرى رمزية، تغري الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة كشف شيفراتها الرامزة) (6).
علاقة العنوان بالمتن.
يأتي العنوان بمثابة الرأس من الجسد الرأس الذي بواسطته يفقه الإنسان ما حوله، ويستدل على الموجودات؛ لذا فالعنوان هو مفتاح للدخول إلى عالم النص، فضلاً عن كونه علامة له، لكونه لا يخرج عن نظام اللغة المكون من العلامات، فهو علامة تدل على النص الذي تتقدمه، أو توحي به تحليلها واستكشاف بنيتها الدلالية، وقد تبدو العلاقة بين العنوان والمتن ترتيبية كأن يأتي الأول ثم الثاني وبالعكس، ولكنها في الحقيقة سببية أكثر من كونها ترتيبية لأن وجود العنوان يعني وجود المعنون، ووجود الأخير يفترض وجود العنوان(7).
وفي قضية علاقة العنوان بالمتن توصلنا إلى أن هناك ثلاثة أنماط من العلاقة بينهم(8):-
أولاً - العلاقة الامتدادية: توليد النص من العنوان: وفي هذه العلاقة ينطلق النص من خلال العنوان وبموجب ذلك يمكن تشبيهه بالبيضة الكونية المختزنة بقوة دلالية قصوى سرعان ما تنفجر بفعل عوامل مختلفة، فيتشكل النص من ذلك السدم، أو الغبار، أو مخلفات أخرى، وهكذا تبدو العلاقة بين العنوان والنص فهي أشبه بالانفجار الكوني الأعظم الذي تولد عنه العالم من نقطة مضغوطة بكثافة لانهائية من حيث إن الثاني على غرار الأول كان متكثفاً في ذرة دلالية توسعت وامتدت من خلال الانفجار الكتابي الكبير ليتولد النص ويتشكل من ثم مداره ومجاله الاستراتيجي في المنظومة الثقافية، ثم أن هذا التولد يكون ممتداً في الفراغ كما الكون إلى ما لانهاية، فهو لا يكف عن التضخم والتوسع عبر السيرورة التاريخية في الز - مكان، إذ لا تنفك الشروحات والتفسيرات والتأويلات تنهض حول النص الفعلي، نستنتج مما سبق أن العنوان في هذه العلاقة يسبق النص من خلال الوضع، والنص يأتي تبعاً لما تضمنه العنوان من أمور.
ثانياً - العلاقة الارتدادية: من النص إلى العنوان: - ويتسم العنوان هنا بتبعيته للنص أي يتأخر عن النص بنائياً وزمانياً ؛ لذلك تعكس هذه العلاقة سيناريو آخر لبرتوكولات النص والعنوان على الصعيد البنائي، فهي تؤسس في حركتها أتجاهاً معاكساً لعلاقة الأولى ومخالفاً لها، حيث اتجاه التحرك يشير من الامتداد إلى الارتداد، فيؤدي إلى تقلص مادة النص وانضغاطه في بنية تركيبية ذات دلالة قصوى، ومن الممكن من أجل الفهم أكثر تمثيل هذا النوع من العلاقة بين العنوان والمتن (بالانسحاق الكبير) الذي هو من ضمن الاحتمالات الممكنة لانبثاق العالم الكوني ؛ إذ يتقلص كل الفضاء والمادة ليشكلا مفردة الأمر الذي يؤدي إلى تكثف النص وانضغاطه داخل بنية أصغر بكثير منه، والحجة التي تنطلق منها هذه القراءة تتمثل في إن المؤلف الذي انتهى من إنتاج النص لابد له وتحت ضغوط التسمية أن يكثف النص في اسم / عنوان يُفترض به أن يُعبر عن دلالات النص بمجراته واتساعاته وخرائطه فيحاول من خلال المطابقة بين العنوان والنص أن يختزل نصه في لفظة أو تركيب، أو جملة و يدرس مدى التوافق الذي حصل بين الكم الواقع من المعاني واليسير من اللفظ.
ثالثاً- العلاقة التجاورية / المجال الجذبوي:- امتازت العلاقتان الامتدادية والارتدادية بتفسير جزء من الروابط البنيوية بين العنوان والنص، أو بين النص والعنوان على مستوى إنتاج العمل الأدبي 6 دون الإشارة الى الفصل بينهما بجزء معين، فأتت علاقة ثالثة سميت بالتجاورية لتنهض بعمليات فك الارتباط بين النص الصغير والكبير (العنوان والنص) ليستقل كل منهما عن الآخر مشيداً اختلافهما المعرفي والاحتفاظ في الوقت ذاته بعلاقات حسن الجوار بينهما، وبذلك تغدو التجاورية شكلاً الضيافة العنوان في ضيافة النص، والنص في ضيافة العنوان دون نسيان الاختلاف الذي يسكن بنية كل من أشكال منهما، فالعنوان إذا بموجب هذه العلاقة بتجاوره مع النص يهب استقلالية الوجود المعرفي، وهذا يعني بكل بساطة النظر إليه كونه كائناً لغوياً مكتملاً، له كينونته ذات الطابع التفاعلي الانفكاكي في علاقته بالنص، فهو كون نصي يجاور كوناً نصياً أكبر وأوسع، ومن ثم يمثل العنوان علامة كاملة كما يمثل العمل هو الآخر علامة كاملة أخرى، ويأتي التأثير الذي تمارسه العلامتان كعلامة حملية لتشكل المجال التفاعلي، فكل منها يولد مجالاً جذبوياً يمنع ابتلاع أحدهما الآخر، ويُبقي على استقلاليته، وفي الوقت نفسه تأثيرهما بالطاقة الدلالية أو الجاذبية التي يبثها أو يمارسها كل نص في الآخر دون فقدان التخوم والحدود الفاصلة.
فجاء عنوان المجموعة القصصية (أبجد حسن هوز) ليعمل بوظيفة تلخيصية مختزلة المضمون المتن الداخلي للمجموعة، فقد لخص تجارب الكاتب مع الحياة والكتابة التي ضمنت في أغلب قصص هذه المجموعة، وقد رأينا ضرورة اتباع أسلوب الدراسة ذاته لدلالة العنوان للقصة في دراسة علاقتها مع المتن الداخلي للقصص الأخرى في المجموعة ؛ لأن العنوان بكلماته الثلاثة لخص كل ما احتوته هذه القصص، فنرى كلمة (أبجد) التي تمثل الحروف الأولى لأبجديات الكتابة، أما مجيئها بهذه الصيغة فهو حتماً دال على تشوش واضح لدى الكاتب، لأنه حاول في هذه الكلمة أن يضعنا أمام الصورة التي وجد نفسه فيها والمتمثلة به وهو أمام مجموعة من الحروف التي لا يعلم ماذا يصنع بها والحالة التي اعترته وهو يشعر بالعجز، أمامها وعلاقة هذه الدلالة تتوضح مع متن قصة (الاكتظاظ) التي جسدت رحلة الشروع في أمر جديد بدايته مليء بالتشوش الذي ساد حياته في تلك المرحلة المتمثلة بالتخلي عن الحلم بتأثير من (عض على شفتيه مندهشاً وهو يعود إلى أبيه الذي القاه نحو القاع: لقد ضاع كل شيء كالدراسة والمستقبل) (9)، ثم سيطرة التشويش والاكتظاظ على صورة ذهنه إلى ماذا يتوجه وما السبيل الذي سيخوضه بعد فقدان الطموح والدافع في الاستمرار (ابتسم لأنه وجد نفسه حيال شيء يفعله بإرادته، أو هكذا خيل إليه، أخذ يتفحص المكان ببصر زائغ كمن فقد شيئاً، بحث في جيوبه فوجد الورقة والقلم الذي أعتاد أن يحملهما معه كتب بخط مرتجف ينم عن جرأة كاذبة في القرار: إنه ليس فراراً..لا أحد مسؤول.. ليعش أبي بهدوء) (10).
ثم تأتي كلمة (حسن) التي دلت في متنها إلى كونها تتحدث عنه، وهي في علاقتها مع المتن الداخلي للمجموعة تشير إلى الشيء ذاته ؛ فهي تدل على أن أبجدية الكاتب في الكتابة بدأت من داخل الذات الكاتبة (أنما أنا أصل ينطق عن نفسه) (11)، فهو يتحدث عن القضايا الموجودة في القصص من خلال وجهة نظره البحتة، ففي قصة) ولدان وبنت حلوة نراه يتحدث عن نظرته الذاتية إلى ما يجب أن تكون عليه المرأة التي يحب (متوحشة فعلاً، بشعر جاف منثور وعينين نسريتين، وقد رفض على شيء من الشك ما يعلمه المصيفون للمرأة: النعومة والرقة، ويلبسونها جلد الأنثى ويقنعونها بقناع الشهوة والتوسل) (12)، وهو هنا يشير الى ذاته المريدة لشكل خاص للمرأة التي تمثل ذاتها دون أن تتأطر داخل الصندوق الذي بناه لها المجتمع من الزام بصفات الرقة والنعومة المبالغ فيها، والذي يجلب لها الضعف والتشويش على ركائز القوة لديها، فضلاً عن هذا نرى الكاتب يسترسل في القصة بذكر نظرته الفلسفية عن الحب القائم بين الرجل والمرأة والسبب الداعي لانجذاب كلاً منهما للآخر، وهو التكاثر، أو الجنس لكنه هذبها في التعبير (ليس الحب - يا حلوتي، سوى استجابة للتخلص من قيح ما الأغاني والدبكات والدسائس وطريقة المشي والكلام إلا لأجل التكاثر) (13)، فعملية الدراسة العلمية لكيفية تيسير المجتمع للمرأة في طريق معين من السلوك من أجل إيقاع الرجل عن طريق إثارة شهوته قادته إلى استنتاج ماهية الحب بطريقة فكرية علمية بعيدة عن الأفكار المعتادة عليها، التي تتسم بانها مليئة بالعاطفة والمشاعر الجياشة، فالمرأة التي تعتمد على رقتها ونعومتها وجسدها كأسلوب لأنثى في إيقاع الرجل في شباك الحب ؛ فلابد إذاً لهذا الأخير أن يكون معناه نابعا من نظرة مختلفة يملأ الجسد، مجردة عن المفهوم المعروف عنه.
فضلاً عن ذلك رأينا الكاتب يُضّمن متونه نظرته لتجربة الكتابة الفنية، وكيف سببت لديه اكتظاظاً ذهنياً أكبر مما كان عليه في البداية بأن جعلته حائراً بين اتخاذ النظم طريقاً في الكتابة لكي يُعرف أو السرد الأمر الذي سبب لديه في مرحلة معينة صراعاً نفسياً فهو يبدو في قصة الاكتظاظ باحثاً عن الرؤية الواضحة له (تلفت حوله باحثاً عن مكان يكون واضحاً لأحد يجد فيه وصيته خطا ثلاث خطوات نحو الجرف الرملي، تحسس فيه أكثر الأماكن صلابة، الصق الورقة فإنهار شيء من لنفسه كتابة الشعر أولاً لأنه أحب هذا الفن، غير أن صعوبة الكتابة فيه، الرمل) (14)، وقد رجح جعلته يتخذ القرار بالتوقف عنه (إذ كلما التجأت إلى الكتابة تكون حالتي مؤسفة، أتقبل سطوة كلماتي بصدر ضيق وكأني أحمل طن رصاص حين تسمعين ما كتبته في جدول ألمي اليومي تحصدين خيبة فأغمضت 4 فضلاً عن، خيبة رجل تحبينه وتقضين النهارات والليالي مفكرة به، إنك تعيشين على ذكر ابتسامة، أو أطار قصيدة.. أما أنا الحقيقي فجعبة للتعب.. في قلب الليل برمت بآلامي، وصرخت فيها أن تتوقف عيني ونمت) (15)، من هنا تأتي دلالة كلمة (هوز) التي أشارت بمعناه المعجمي كونها ثاني الكلمات الأبجدية إلى الموت (هوز الرجلُ: مات) (16)، وهي بذلك أسست لحقل دلالي خاص لنظرة حسن لصعوبة الكتابة المقرونة بالموت عنده ؛ فرأينا بعضاً من المقتطفات في المتون متعلقة بالكتابة يزامنها ذكره للموت معها فمرحلة تركه الشعر والتجائه إلى الكتابة السردية، ثم اختياره الرواية كمشروعه الكبير لم يكن يظن فيها أنها ستكون من الصعوبة الكبرى وستعود صورة الموت التي دلت على الرغبة في الاستسلام لتكون واضحة وقريبة أكثر من ذي قبل، بل وعليه أن يتحمل تلك الرغبة المميتة ليكون كاتباً (من هنا بدأ فصل جديد، هو بدء ونهاية: حيث تنتهي أشياء تبدأ أشياء أخرى.. ظهرت للرجل الغاطس صورة للموت أدرك أنها صورة مشابهة لحياته كلها.. لقد عرف الرجل الذي صار الماء فوقه بارتفاع قامة أو أكثر، طعم الموت الحقيقي ولونه.. ورأى أنه سيكون كاتباً.. ولكن بعد أن يموت.. أني أموت الآن) (17).
***
م. م زينب احمد محمد البياتي
العراق / جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية
...............................
(1) ينظر: علم العنونة (دراسة تطبيقية): عبد القادر رحيم، دار التكوين، ط۱، دمشق، ۲۰۱۰م: ۸۲.
(2) تخطيط النص الشعري: حمد محمود الدوخي:۳۹.
(3) مناورات شعرية: محمد عبد المطلب: دار الشروق، القاهرة، ط1، ۱۹۹6،: ۷۷.
(4) اللغائب (دراسة في مقامة الحريري): عبد الفتاح كليطو، دار توبقال، ط1، الدار البيضاء، ۱۹۹۷م: ۲۷.
(5) سيموطيقا العنوان: جميل حمداوي:
(6) م.ن.
(7) سيمياء العنوان: خالد حسين حسين، مجلة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، مج ۲۱ / العدد ٣/٤ سنة ۲۰۰٥.
(8) ينظر: في نظرية العنوان مخاسرة تأويلية في شؤون العلبة النصية: خالد حسين حسين، دار التكوين، ط 1، د.ت: 44 – 45.
(9)الأعمال القصصية: حسن مطلك: ٩٥.
(10) م. ن : ٩٠.
(11) م. ن: 82.
(12) م. ن: 133.
(13) م. ن: 135.
(14) الأعمال القصصية: ٩٢.
(15) م. ن: 82 – 87.
(16)المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية: ٩٩٩.
(17)الأعمال القصصية: ٢٦-9٢.