قراءات نقدية
طارق الحلفي: في هزيع البرج يحتاط الحمام (3)
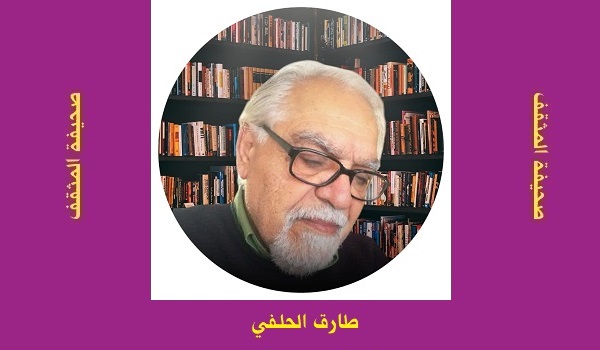
كنت قد كتبت في المدخل الى هذه القصيدة المثيرة وفي الفقرة الأخيرة.. باننا "سنبحر مع الشاعر جمال مصطفى في قراءة "بانوراميته" ... بالتفصيل..". واليوم نبدأ بالمقاطع من (11ـ 20)..
"حين تكون القصيدة مفتوحة كأفق وملمومة كقطرة ماء"، القسم الثالث: "في هزيع البرج تحتاط الطيور.."
دهشةُ الصعود ومكرُ الارتفاع
(11)
"البُرجُ أعْرَقُ مِنكِ بابِلْ
البُرجُ أحلامُ الأوائِلْ
في لَجْمِ غطْرسةِ البُغاةِ الآلِههْ
مَنْ يَحْسبونَ الأرضَ سَلَّةَ فاكِههْ
والناسَ تَحْتَهُمو عبيدا
......................
البُرجُ فاجأَهُمْ صعودا"
عراقة البرج:
يتوهّج هذا النص الشعري بإشراقات فلسفية وإنسانية تتجاوز الظاهر لتغوص في أعماق الدلالة والرؤية. فالشاعر، وهو يقارن بين البرج وبابل، يجعل من البرج كياناً يتسامى على المدينة نفسها، إذ يقول: "البُرجُ أعْرَقُ مِنكِ بابِلْ"، فيلفت انتباهنا إلى أن العمارة ليست حجارة صماء، بل تجسيدٌ للأحلام، وإرادةٌ للمقاومة، وتاريخٌ يتجاوز من بناه أو حكمه.
ثم تأتي العبارة "البُرجُ أحلامُ الأوائِلْ" لترسّخ أن البنيان ليس مجرد صرح مادي، بل هو تجلٍّ لروح الأجيال، صدى لتطلعات الإنسان الذي يسعى لكبح جماح الطغيان، في "لَجْمِ غطْرسةِ البُغاةِ الآلِهَهْ"، حيث يستحضر الشاعر الطغاة الذين نصّبوا أنفسهم آلهة، مستبدين بالناس، معتبرين الأرض مجرد "سَلَّةَ فاكِههْ"، ينهبونها، بينما البشر في نظرهم "عبيدا". هنا، يفضح النص ذهنية المستبدّ، الذي يرى العالم متاعاً، والناس أدواتٍ لا شركاء في الوجود.
لكن البرج، وهو رمز للإرادة الإنسانية، يخرج عن السيطرة، يفاجئ الطغاة "صعودا"، في انقلاب على منطقهم القمعي، كأن الأحجار ذاتها تتمرّد، وكأن الأحلام، مهما خُنِقَت، تصرّ على العلوّ والخلود، شاهدةً على عظمة الإنسان أمام هشاشة الطغيان.
هذا النص يفتح أبواب التأمل العميق في علاقة الإنسان بالسلطة والتاريخ.. مما يجعل القارئ يتساءل عن مصير الإنسان في تحدي الطغاة ومواجهة قوى الاستبداد..
"البرجُ.. بين الخرافة والتجلي"
(12)
"في البدءِ كان البرجُ محمولاً
على رُخِّ الخُرافةْ
حتى أناخَ بأرضِ بابلْ
أخَذَتُهُ مِنهُ قصيدتي
كالهودجِ الحَلَزونِ تحملُهُ زرافةْ
وبهِ تَطوفُ على المدائِنْ"
البرج والقصيدة:
يغوص هذا المقطع الشعري في جدلية الخرافة والواقع، فيكشف بأسلوب رمزي كيف تتحول الأسطورة إلى حقيقة ملموسة، وكيف تتجلى العمارة كفكرة عابرة للزمن. يستهل الشاعر بقوله: "في البدءِ كان البرجُ محمولاً / على رُخِّ الخُرافةْ"، حيث يستدعي طائر الرُخّ الأسطوري، ذاك الكائن الخرافي الجبار، ليسلط به الشاعر الضوء على دور الخرافات والأساطير في بناء المعتقدات والتصورات الإنسانية، من خلال الاشارة إلى أن البرج بدأ كحلم مستحيل، كمحض أسطورة تتناقلها الألسن. لكنه سرعان ما يرسو في "أرضِ بابلْ"، لينتقل من فضاء الخيال إلى أرض الواقع، وكأن الشاعر يوثّق رحلة الفكرة من الوهم إلى التجسيد.
غير أن اللافت هنا هو التدخل الشعري، حيث يقول: "أخَذَتُهُ مِنهُ قصيدتي"، فيجعل من الشعر قوة قادرة على امتلاك المعمار، وكأن الكلمات ليست مجرد وصف، بل إعادة خلق للواقع.. انها القوة التحويلية للكلمة والشعر التي تظهر.. وكأن القصيدة تحتضن البرج وتحمِل معانيه وتاريخه..
تتجلى عبقرية النص في إضفاء بعد جمالي جديد على البرج، فبدلاً من أن يكون حجراً صامتاً، يصبح كائناً متحركاً في صورة "الهودجِ الحَلَزونِ تحملُهُ زرافةْ"، في مشهد يمزج الغرائبية بالسلاسة، ويمنح البرج طابعاً حيًّا، متنقلاً، غير مستقر.. بمعنى آخر.. يشير إلى انفتاح المعاني وتجوالها في آفاق متعددة، لتجعل القارئ يتفاعل مع المضمون الإبداعي، مما يثري الفكر ويغذي الروح، ويدعو إلى التأمل في معاني الوجود والحضارة..
ثم تأتي الذروة في قوله: "وبهِ تَطوفُ على المدائِنْ"، في إشارة إلى انتشار الأفكار، إلى أن العمارة ليست مجرد بناء جامد، بل إرثٌ حضاري يتجاوز المكان، كأنها رسالةٌ متنقلة تحملها الأزمنة والشعوب.. وان ببطئ
" سفرٌ في سماوات بابل"
(13)
"في البُرْجِ بُرْجٌ لِلْطيورِ
مَعاً تَطيرُ لِكيْ تُطَرِّزَ في الصباحِ
سماءَ بابِلْ"
بُرْجٌ الطيور:
هذا المقطع الشعري يعكس جماليات اللغة العربية وعمق المعاني التي تحملها، حيث يُعبّر عن الأمل والانطلاق في فضاء جديد.. انه يُشرّع نافذة على رؤية تتجاوز المادي إلى الرمزي، حيث لا يكتفي الشاعر بالنظر إلى البرج كصرح معماري، بل يكتشف في داخله "بُرْجٌ لِلْطيورِ"، في إشارة إلى أن كل بناء يحمل في جوهره بعدًا آخر، أكثر شفافية وحرية. فالبرج هنا ليس مجرد كيان حجري، بل فضاء للحياة، للحركة، وللتحليق، مما يضفي عليه طابعًا إنسانيًا وروحيًا يتجاوز صرامة المعمار إلى انفتاح الرؤية.
ثم تأتي الصورة البديعة "مَعاً تَطيرُ لِكيْ تُطَرِّزَ في الصباحِ / سماءَ بابِلْ.. لحظة الانتعاش والإبداع، التي من خلالها يرسم الشاعر لوحةً حيةً للطيران الجماعي للطيور، لكنه لا يكتفي بوصف الحركة، بل يضفي عليها بُعدًا إبداعيًا عبر فعل "تُطَرِّزَ"، وكأن الطيور تغزل خيوط الصباح على قماش السماء، في استعارة تحتفي بالجمال الخالص.
هذه الصورة تحيل إلى الفكرة الفلسفية العميقة بأن المعمار ليس مجرد بناء صاعد نحو الأعلى، بل هو امتدادٌ لما حوله، يندمج مع الطبيعة، يتفاعل مع الضوء والهواء والحياة. كما أن وجود الطيور يرمز إلى الحرية، في مقابل ما قد يمثله البرج من سطوة الإنسان على المكان، مما يخلق جدلية بين الثبات والحركة.. بين الجثوم والتحليق.. بين السلطة والانعتاق، بين الحجر والكائن الحي، في توازن شعري بديع بين الفكرة والصورة.
"حيثُ تتكلم الغابة"
(14)
"هِيَ حُجْرَةُ الشامانِ
فارِغةٌ تَماماً
لَو دَخَلْتَ تَصيرُ غابَةْ
هِيَ حُجْرَةُ الشامانِ
فيها قد تُفَقِّهُكَ الأيائِلُ بالتَخاطُرِ
فِقْهَ إبْكاءِ السَحابَةْ"
حُجْرَةُ الشامانِ:
الشاعر يفتح أبواب الإدراك على فضاء يتجاوز المألوف فيغوص في عوالم الغموض والروحانية، حيث تتحول „حُجْرَةُ الشامانِ“، التي تبدو فارغةً تمامًا، إلى كونٍ آخر يعجّ بالحياة.. يتسع لتحولات مدهشة. الشاعر يوظف المفارقة بين "الفراغ" و"الامتلاء"، فالغرفة التي تبدو خاوية تتحوّل بمجرد الدخول إليها إلى „غابَةْ“، في دلالة على أن الوعي، لا المادة، هو الذي يمنح الأشياء حقيقتها.. قد تمثل الحجرة هنا العقل الباطن، أو الروح، فيما تشير الغابة إلى رمزية الطبيعة والحياة.
ثم تأتي الصورة المدهشة في قوله: „فيها قد تُفَقِّهُكَ الأيائِلُ بالتَخاطُرِ“، إذ يجعل من الأيائل معلمين روحيين، ينقلون الحكمة عبر التخاطر، في استدعاءٍ لرمزية الحيوان في الموروث الشاماني، حيث تُعدّ الكائنات جزءًا من نسيج الكون الروحي، قادرة على الإيحاء والتعليم. لكن الدرس هنا ليس مألوفًا، إنه „فِقْهَ إبْكاءِ السَحابَةْ“، وهو تعبير مدهش يكثّف فكرة الحكمة المتجاوزة، حيث يصبح الفقه – وهو عادةً مجال العقل والاستنباط – مرتبطًا بقدرة غامضة على استدرار المطر، وكأن المعرفة هنا ليست فقط إدراكًا، بل تماهٍ مع الطبيعة.. عن اتصال حميمي، او انصهارٌ في إيقاع الكون.. لالتقاط مشاعر الكون نفسه..
في هذا المقطع، يخلق الشاعر توليفةً بين الفلسفة والروحانية والشعر، إذ يجعل من الغرفة فضاءً للتحوّل، ومن الطبيعة نصًا يُقرأ دون كلمات، ليؤكد أن المعنى لا يُلقى جاهزًا، بل يُكتشف عبر التجربة والانفتاح على أسرار الوجود.
هذا النص لا يقدم إجابات مباشرة، بل يخلق جوًّا من الغموض والرهبة، مستدعيًا القارئ للتأمل في أعماق ذاته والعالم من حوله.
"إشراقة الصديق.. نارٌ تُضيء البرج“
(15)
"في باب مانعةِ الصواعقِ
عَنْهُ في اللوح الكتابِ إشارةٌ:
أنْ سوفَ يَجترحُ الصديقُ …...
إنارةَ البُرْجِ المُعَلّى
لَمْ يذكروا مَن كانَ ذيّاكَ الصديقُ
لَربّما خوفاً عليهِ كأنّهُ
قد كانَ (تِسْلا)"
العلم والصداقة:
يتجلى في هذا المقطع الشعري إبداع شاعر متمكن من نسج خيوطًا دلالية متشابكة وذات أبعاد فكرية وتاريخية مشحونة بالدلالات، حيث يستدعي الشاعر ثنائية النبوءة والتجاهل، العبقرية والنسيان، الحقيقة والتغييب. فالشاعر لم يكتفِ بتقديم صورة بصرية، بل غاص في أعماق المعاني، واستنطق الرموز، ليقدم لنا لوحة فنية متكاملة، تتجاوز حدود النص الشعري إلى آفاق أرحب من الفكر والفلسفة.
يتميز المقطع بصياغة لغوية رصينة، وكلمات مختارة بعناية، تعكس عمق تفكير الشاعر.
في البداية، يضعنا أمام مشهد غامض عند "باب مانعةِ الصواعقِ"، وهي صورة توحي بالحماية والمنع، لكنها في ذات الوقت تستبطن الإشارة إلى قوة هائلة مخبأة، وكأننا أمام مدخل إلى سرّ منسيّ.. وقد تحمل في طياتها إشارة إلى الحماية والإيمان، وأن هناك قوة أعلى تحمي الإنسان..
ثم تأتي الإشارة إلى "اللوح الكتابِ"، وهو استدعاء ديني يرمز إلى الأزلية والثبات، حيث تُكتب الأقدار والمعارف العظمى، لكن المفارقة تكمن في أن هذا اللوح، رغم احتوائه على النبوءة، لم يُصرّح باسم "الصديق" الذي "يجترحُ إنارةَ البُرْجِ المُعَلّى"، أي أنه سيشعل النور في القمم، في استدعاء رمزي لعصر الاكتشافات والاختراعات، وللروح التي تحاول اختراق الظلام بالمعرفة.
غير أن الغموض يزداد، إذ يتساءل الشاعر: "لَمْ يذكروا مَن كانَ ذيّاكَ الصديقُ"، ليشير إلى تهميش المتفرّدين في التاريخ، قبل أن يفاجئنا بالخاتمة: "لَربّما خوفاً عليهِ كأنّهُ قد كانَ (تِسْلا)". وهنا تتجلى عبقرية النص، حيث يستدعي نيكولا تسلا، المخترع الذي أحدث ثورة في الكهرباء لكنه تعرض للتهميش، في إشارة إلى أن العباقرة غالبًا ما يُحاربون أو يُنسون، رغم أنهم هم من يضيئون العالم.
بهذا، ينسج النص رؤية فلسفية حول علاقة السلطة بالمعرفة، حيث يُخشى على المبدعين أو يُحجب ذكرهم، وكأن النور الذي يشعلونه ليس مجرد طاقة، بل فعل تمرّد يهدد المألوف ويكشف المستور.
وهْمُ السلطة وبريقُ الزوال
(16)
"هي حُجْرَةُ التيجانِ
تَدْخُلُها بِقِيراطَيْنِ مِن ذَهَبٍ
دقائِقَ
كامبِراطورٍ، كَقَيْصَرَ أو كَكِسرى أو كَسلْطانٍ
كما مَلِكِ المُلوكْ
العرشُ فيها، الصولَجانُ، الخاتَمُ الطُغْراءُ
وحْدَكَ ها هنا الآنَ المُتَوَجُّ
بَيْنَ مَن قد تَوَّجوكْ"
غرفة التيجان:
يتناول هذا المقطع الشعري بنية السلطة ورمزية التتويج، ليكشف هشاشة العروش التي تبدو متألقة في ظاهرها لكنها محكومة بزمنٍ لا يرحم.
الشاعر يبدأ بمشهد يوحي بالفخامة الملوكية: "هي حُجْرَةُ التيجانِ"، حيث تُستدعى رمزية المُلك، لا بوصفه منصبًا ثابتًا، بل كطَقس عابر، إذ أن الدخول إليها لا يكون إلا بثمن، "بِقِيراطَيْنِ مِن ذَهَبٍ"،"، تُبرز قيمة الثروة والمكانة التي تصحب الدخول إلى عالم الملوك.. وهو ثمن رمزي، يوحي بأن المجد يُشترى لحظيًا، لكنه غير دائم، مجرد، وقتًا محدودًا.. دقائق معدودة من السيادة، كحكمٍ على حافة الفناء.
ثم ينتقل النص إلى تشبيه الحاكم المتوّج بأساطين السلطة عبر التاريخ: " كامبِراطورٍ، كَقَيْصَرَ أو كَكِسرى أو كَسلْطانٍ / كما مَلِكِ المُلوكْ "في استدعاءٍ لمختلف أنظمة الحكم، لو تتناوب الحضارات على قمة الهرم.. وكأن الشاعر يؤكد أن التاج واحد وإن تبدّلت الرؤوس التي تحمله. كذلك لا يمثل "الصولَجانُ، الخاتَمُ الطُغْراءُ"، الا رموزًا تتجسد فيها الإرادة والقوة.. غير أن المفارقة تتجلى في أن هذا التتويج، رغم طقوسه المهيبة، ليس إلا لحظة عابرة، إذ يقول: "وحْدَكَ ها هنا الآنَ المُتَوَجُّ / بَيْنَ مَن قد تَوَّجوكْ"، فالمشهد بأسره ليس سوى مسرح للآخرين، أولئك الذين صنعوا هذا المجد الزائف.
بهذا، يكشف النصّ بمهارة أدبية كيف أن السلطة لا تمنح صاحبها خلودًا، بل تجعل منه دمية في يد التاريخ، لحظة مجد تذوب في نهر الزمن، وتاجًا يُثقل الرأس أكثر مما يُتوّجه.
صراعٌ أبديّ ودورةٌ لا تنتهي
(17)
في حجرةِ الشطرنجِ يَمتَدُّ السِجالُ إلى الشروقْ
والفائزونَ يُكَرَّمونَ
بأنْ يزوروا حُجْرةَ الأسرارِ ما فوقَ الغيومِ
ليَسألوا: أنّى وكيفَ متى وأين؟
.................
في الصُبْحِ سادِنُ حُجْرةِ الشطْرنجِ
يَشْطفها بِخُرطومِ المياهِ مِن الدماءِ
ويُوقِظُ الصَرْعى مِن الجيْشيْنِ
يُوقِفُهُمْ على ذاتِ المَرَبَّعِ مِن جديدْ"
حُجرة الشطرنج:
يتخذ هذا المقطع الشعري من حجرة الشطرنج فضاءً رمزياً للصراع الوجودي، حيث تمتد المعركة "إلى الشروق"، في إشارة إلى أن المواجهة ليست لحظةً عابرة، بل امتدادٌ مستمر يتجاوز حدود الزمن، وكأن الحياة ذاتها لعبةٌ شطرنجية لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. غير أن اللافت هنا هو تكريم الفائزين، لا بمنحهم جوائز مادية، بل بإعطائهم فرصة "أنْ يزوروا حُجْرةَ الأسرارِ ما فوقَ الغيومِ"، وهو مشهد يتجاوز البعد الأرضي ليأخذنا إلى أفقٍ ميتافيزيقي، حيث تتاح لهم معرفة الأسرار الكبرى، لكن دون إجابات حاسمة، إذ تبقى الأسئلة مفتوحة: "أنّى وكيفَ متى وأين؟"، في إشارة إلى أن حتى النصر لا يهبُ اليقين.
ثم تأتي الذروة الصادمة مع الصبح، حين يدخل "سادنُ حُجْرةِ الشطرنجِ"، فيتجلى دوره كمُنظّمٍ للعبة الأبدية، إذ "يَشْطفها بِخُرطومِ المياهِ مِن الدماءِ"، مما يحوّل المشهد إلى استعارة للحروب التي تُخاض مرارًا، حيث تُمحى آثار الدم لكن المعركة تستأنف، ويتحوّل القتلى إلى بيادق جديدة: "ويُوقِظُ الصَرْعى مِن الجيْشيْنِ / يُوقِفُهُمْ على ذاتِ المَرَبَّعِ مِن جديدْ"، مما يعكس عبثية الصراع، حيث لا نهاية للمعركة، بل مجرد إعادة تدوير للجنود، وكأن التاريخ ذاته رقعة شطرنج تُعاد صياغتها بنفس القواعد، مهما تغيّرت الوجوه.
بهذا، يصوغ الشاعر رؤيةً فلسفية للقدر الإنساني، حيث تظل الحروب دائرة، والأسئلة قائمة، فيما يظل اللاعبون مجرد بيادق في رقعةٍ لا تبوح بكل أسرارها.
وقد يصور هذا المقطع الشعري كفضاء رمزي يعبر عن صراع الشاعر الداخلي في عملية كتابة القصيدة، وكأن القصيدة نفسها جولة شطرنج يسعى فيها للوصول إلى عمق المعنى، والولوج إلى "حُجرة الأسرار ما فوق الغيوم"، رمز الإلهام والمعرفة العليا.
فالسِجالُ يبدأ ممتدًا "... إلى الشروق".. انها رحلة الشاعر الليلة بحثاً عن الكلمات والمعاني والصور الشعرية، التي قد تستمر حتى بزوغ الفجر، حيث تتوهج لحظة الإبداع بانتصار الفكرة، فتُكرَّم القصيدة بحصولها على لمحة من الأسرار. بهذا التكريم يسمح للشاعر أن يسأل الأسئلة الكبرى "أنّى وكيفَ متى وأين؟"؛ استكشاف متسلسل لكل شيء غامض، بحثًا عن الحقيقة.
في "الصُبْحِ"، يعود السادن/ الشاعر، ليطهّر وينظف مسوداته من الكلمات والابيات والمقاطع التي اسقطها من القصيدة.. والتي كانت ضحايا الالغاء والتبديل.. إيذانًا بجولة جديدة.. مراجعة للعمل وتوكيدًا لنتائجه في تأثيث قصيدته.. خلال المراجعة يعود/ يوقظ الشاعر لـ (كل) ما كتب وما شطب "يُوقِظُ الصَرْعى مِن الجيْشيْنِ"، لتعود إلى مكانها "على ذاتِ المَرَبَّعِ"، أي للبت في الخيارات.. كدلالةً على تكرار دورة الصراع الإبداعي. او في إشارة إلى أن الصراع مع الإبداع لا ينتهي؛ فبعد كل قصيدة تبدأ معركة جديدة بحثًا مفردة او صورة او عن نص آخر.
الموتُ الذي لا يموت
(18)
"في حُجْرةِ الحُجُراتِ
نعْشٌ
في النهارِ يطوفُ مرفوعاً بِذاتِهْ
...............
في حُجْرةِ الحُجُراتِ
نعْشٌ
يَختفي ليْلاً فلا يبقى هناكَ سوى بَناته"
النعش وبناته
يستحضر الشاعر مشهدًا غامضًا يتجاوز دلالاته المباشرة، لينسج رؤية فلسفية عن الموت والخلود، الحضور والغياب، والتناقض الذي يحكم دورة الحياة.. فهو يقدم تماهياً عميقاً بين رمزية "بنات نعش" وأبعاد الحياة والموت، حيث تتجلى صورة الكون في هيئة نعشٍ يطوف في النهار شامخًا، رمزًا للوجود الإنساني في مواجهة الزمن وعبوره المستمر.
النص يبدأ بصياغةٍ مدهشة: "في حُجْرةِ الحُجُراتِ / نعْشٌ"، مما يخلق صورة ذات أبعاد متعددة، فـ "حُجرة الحُجرات" توحي بعمقٍ سرّي، كأننا أمام جوهر الأشياء ومخبأ الأسرار، حيث يكمن النعش، لكنه ليس جمادًا هامدًا، بل يتحرك في وضح النهار: "يطوفُ مرفوعاً بِذاتِهْ"، مما يبعث شعورًا بالغرابة والرهبة، وكأن الموت نفسه لا يخضع لقوانين الطبيعة، بل يظل حاضرًا متجولًا بين الأحياء، منتصبًا بذاته، لا يحتاج لمن يحمله، بل كأنه كائنٌ له استقلاليته وقدرته على الحركة.
لكن في الليل، يتحوّل المشهد تمامًا: "يَختفي ليْلاً فلا يبقى هناكَ سوى بَناتهْ"، في صورة تتسم بالغموض الميتافيزيقي، إذ أن اختفاء النعش يوحي بأن الموت ليس نهاية، بل هو أصلٌ يُخلف وراءه أثرًا، يتمثل في "بناته"، واللواتي قد يرمزن إلى التركة التي يتركها الراحل، سواء كانت أفكاره، موروثه، أو تأثيره المستمر في الوجود. وهي أيضًا إشارة أسطورية للكوكبة التي تبقى مرئية لتشهد على غياب مَن رحلوا..
انها رؤية فلسفية مذهلة: الموت ليس فناءً مطلقًا، بل حضورٌ متكرر، يتجلى نهارًا كواقعٍ لا يمكن تجاهله، ويذوب ليلاً تاركًا خلفه امتداداته، كأن الغياب ذاته نوعٌ من الحضور، وكأن "النعش" ليس فقط تابوتًا، بل هو فكرةٌ لا تموت.
الصراع بين السحر والعلم
(19)
في بابِ (هاروتٌ وماروتٌ) مِن اللوحِ الكتابْ
قالا لِقرْميدو: سنجعلُ فوقَ بُرْجِكَ
غيْمةً في صيْفِ بابلَ
تُنعشُ البرْجَ العظيمَ وتَغْسلُهْ
لكِنَّ قرْميدو تَوَجّسَ:
عنْدنا تِسْلا، كذلكَ عندنا الشامانُ
يَجْتَرِحانِ ما شِئْنا بِلا سِحْرٍ،
بِأيْدينا نُصُمِّمُ ما نُريدُ ونَجْعَلُهْ ...........
بين هاروت وماروت
يمزج هذا المقطع بين الأسطورة والتاريخ والعلم، ليخلق فضاءً تأويليًا واسعًا يعكس جدلية القوة، بين الغيبي والإنساني، وبين السحر والعقل، وبين التقاليد والحداثة.
يبدأ النص بإحالة دينية إلى قصة "هاروت وماروت"، وهما الملكان اللذان ورد ذكرهما في القرآن بصفتهما معلّمين للسحر، مما يمنح المشهد بعدًا ميثولوجيًا غامضًا. في هذا السياق، يقف "قرْميدو"، الذي يبدو وكأنه رمزٌ للمعمار أو للحضارة التي تبني مجدها بيدها، أمام وعدٍ قادمٍ من قوى عليا: "سنجعلُ فوقَ بُرْجِكَ / غيْمةً في صيْفِ بابلَ / تُنعشُ البرْجَ العظيمَ وتَغْسلُهْ"، وهي صورة شعرية تنطوي على دلالات التطهير والتجديد والخلود، فالماء هنا ليس مجرد فيض سماوي، بل امتدادٌ للرحمة، ولإرادةٍ تسعى لصيانة البنيان وحمايته من الزمن..
لكن المفارقة تنشأ من موقف "قرْميدو"، الذي "تَوَجّسَ"، فهو لا يرى في هذه الهبة الإلهية ضرورة، بل يستعيض عنها بالمعرفة البشرية: "عندنا تِسْلا، كذلكَ عندنا الشامانُ"، في استدعاء عبقري لشخصية نيكولا تسلا، رمز الحداثة والكهرباء، والشامان، الذي يمثل الحكمة الروحية المستندة إلى الحدس والعرافة.
يؤكد قرميدو استقلالية الإنسان عن القوى الغيبية بقوله: "بِأيْدينا نُصُمِّمُ ما نُريدُ ونَجْعَلُهْ"، وهو تعبير عن لحظة تاريخية فارقة، حيث يقف الإنسان في مواجهة الميثولوجيا، ليؤكد أنه قادرٌ على اجتراح المعجزات بلا حاجةٍ إلى السحر.
النص يطرح جدلية فلسفية عميقة حول الصراع بين الإيمان بالقدرات الغيبية والاعتماد على الذات، ليترك القارئ أمام تساؤل مفتوح: هل نحن بحاجة إلى معجزة، أم أن معجزتنا تكمن في وعينا ومعرفتنا وإرادتنا؟
الزمن كذاكرةٍ أسطورية
(20)
الطابقُ العشرونَ مُتْحَفُ (سوفَ كانَ) وفيهِ: أجنحةٌ
لِجبرائيلَ، ألواحُ الزمرّدِ، نَعْلُ آدمَ، مشطُ حواءَ، البراقُ،
وفُلْكُ نوحٍ، صُورُ إسْرافيلَ، والرُخُّ الذي عَبَرَ البِحارَ
مُحَلِّقاً بالسندبادِ، فَرائِصُ الأسرار تَرتعدُ ارتعاداً في
ضميرِ الغيبِ قُرْبَ عمامةِ الخَضِرِ، الدفوفُ تَزُفُّ بَدراً مِثْلَ
فاكهةٍ يُقَطِّعُهُ بِخِنْجَرِهِ إلهُ المَدِّ سْكْراناً لِيأكُلَهُ أهِلَّهْ
في (سَوفَ كانْ):
حَجَرُ الفَلاسِفةِ، الهِيولى، والبَهيموثُ المُحَنّطُ،
واهتزازُ ضفيرةِ الزمَنِ المُولِّهُ والمُوَلَّهْ"
متحف "سوفَ كان":
يستدعي الشاعر شخوصًا وأساطيرَ ورموزًا دينيةً وتاريخيةً لتشكل نسيجًا من التأملات حول الزمن، والذاكرة، والخيال البشري.. انها رحلةً ساحرةً في الزمن. فالعنوان المستتر "سوفَ كان" يجسد تناقضًا زمنيًا عميقًا، إذ يجمع بين المستقبل والماضي في تركيبٍ واحد، وكأنه يشير إلى أن الماضي ليس ثابتًا، بل هو امتدادٌ متحولٌ في الزمن، يتجدد بتأويلاتنا له.
ان افتتاحية " الطابقُ العشرونَ مُتْحَفُ (سوفَ كانَ)"، تشي بأننا أمام فضاءٍ رمزيٍّ معلّق بين الأرض والسماء، حيث تترابط العناصر الميثولوجية والدينية والأسطورية داخل متحفٍ يعرض إرث البشرية الروحي والمعرفي. ففيه "أجنحةٌ لِجبرائيلَ، ألواحُ الزمرّدِ، نَعْلُ آدمَ، مشطُ حواءَ، البراقُ"، حيث يتجاور المقدس مع الحلمي، والتاريخي مع الخرافي، في انسجامٍ يذكرنا بموسوعات المعرفة القديمة، التي لم تكن تفصل بين الدين والأسطورة والعلم.
في هذا المتحف أيضًا، "الرُخُّ الذي عَبَرَ البِحارَ مُحَلِّقاً بالسندبادِ"، في استدعاءٍ للخيال السردي العربي، حيث تندمج الأسطورة بالحكاية، ويتحول الزمن إلى كيانٍ عضوي ينبض داخل الذاكرة الجماعية.
أما المشهد الأكثر غرابةً فيأتي مع "الدفوفُ تَزُفُّ بَدراً مِثْلَ فاكهةٍ يُقَطِّعُهُ بِخِنْجَرِهِ إلهُ المَدِّ سْكْراناً لِيأكُلَهُ أهِلَّهْ"، حيث تتجلى رمزية القمر، الذي يتعرض للذبح كفريسةٍ للزمن، وكأن الشاعر يرمز إلى الفناء والتحوّل المستمر للأشياء، متمثلًا بالقمر في سيرورته من البزوغ حتى التمام.. ومن الاكتمال حتى المحاق.. ليعاود دورته..
ويُختتم المقطع بإشاراتٍ أكثر عمقًا: "حَجَرُ الفَلاسِفةِ، الهِيولى، والبَهيموثُ المُحَنّطُ، واهتزازُ ضفيرةِ الزمَنِ"، حيث يتحول الزمن إلى ضفيرةٍ حية، تهتز بين أيدي المبدعين والعلماء والفلاسفة، في تصويرٍ مدهشٍ للزمن ككيانٍ ديناميكي، لا كخطٍ جامدٍ في الماضي.
بهذا، يقيم النص احتفاليةً معرفيةً وزمنيةً، حيث يصبح الماضي مشروعًا مستقبليًا، والحكايات القديمة ليست محض ذكريات، بل طاقةٌ متجددةٌ تُعيد تشكيل وعينا بالعالم.
***
طارق الحلفي
......................
* رابط القصيدة //
https://www.almothaqaf.com/nesos/971491
* رابط المدخل //
https://www.almothaqaf.com/readings-5/979452
* رابط القسم الاول //
https://www.almothaqaf.org/readings-5/979564
* رابط القسم الثاني //







