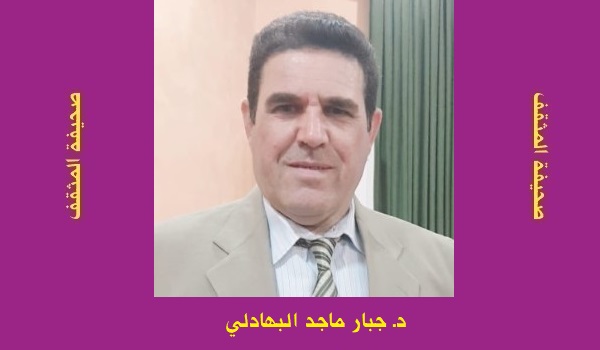قراءات نقدية
طارق الحلفي: شجرتان باسقتان في صحراء المألوف
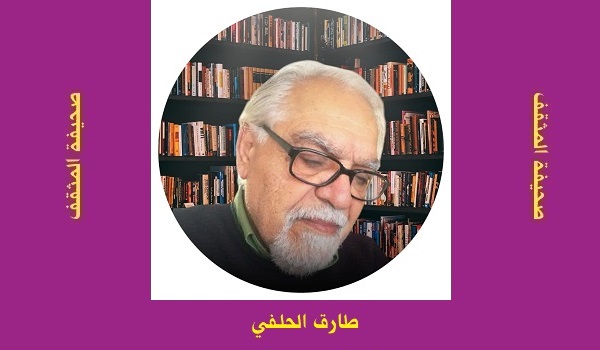
في رحاب الشعر المعاصر، تقف هاتان القصيدتان شامختين كشجرتين باسقتين في صحراء المألوف، تتحديان المتلقي بلغة مكثفة وصور متراكبة تستعصي على التأويل السطحي. إنهما نصان يتوشحان برداء الرمز، وينسجان خيوط المعنى في نسيج متشابك من الدلالات المتعددة.
أولاً: قصيدة "غموض" - جدلية الذات والكون
تفتتح القصيدة الأولى بمشهد سريالي حيث تستعير الريح صفة إنسانية في محاولة "غرف العطش" من النهر، في مفارقة تقلب الموازين الطبيعية، فالريح - التي لا تعطش - تغترف من النهر عطش الشاعر، وكأن الطبيعة باتت وعاءً لعواطف الإنسان وانفعالاته:
"أن أرادتْ الريح أن تغرفَ من النهرِ عطشي"
هذه الاستعارة المركبة تؤسس لرؤيا شعرية تتجاوز حدود المنطق، وتطرح سؤال العلاقة بين الذات الإنسانية والظواهر الكونية. فالشاعر يجعل من الريح كائناً قادراً على فهم معاناته والتعاطف معها، بل والتدخل لتخفيفها.
ثم تتصاعد حدة التشخيص في المقطع التالي:
"أو تذرف ببطءٍ دموعا ليأسي"
حيث تصبح الريح قادرة على البكاء نيابة عن الذات الشاعرة، في حالة من التماهي الكامل بين الإنساني والطبيعي. هذا الامتزاج بين الذات والموضوع يشكل أحد السمات الجوهرية للقصيدة، ويعكس اتجاهاً صوفياً يتجلى في فكرة وحدة الوجود.
ينتقل النص بعد ذلك إلى صورة "أصابع النذور" في علاقتها بالمتكلم، وهي صورة غامضة تحيل إلى فكرة العهود المقدسة التي التزم بها الشاعر:
"أتتْ إليّ.. لأعرف أصابع نذوري"
وتتوالى الصور الشعرية لتجسد فكرة التعالق بين الروح والطين، بين السماوي والأرضي:
"هي الروح ملتصقة بالطينِ / تطفئُ خوفي"
وهنا تتجلى ثنائية أخرى مركزية في القصيدة، هي ثنائية الخوف والأمان، حيث تصبح العودة إلى الأرض (الطين) ملاذاً روحياً يقي من الخوف الوجودي.
تنعطف القصيدة بعد ذلك نحو مفارقة أخرى تقوم على قلب المتوقع:
"إني وجدتُ في الحُمّى ما يشفيني / وفي آثامي وديعة ما يسلّيني"
فالحمى - وهي حالة مرضية - تتحول إلى مصدر للشفاء، والآثام - وهي انحراف عن المسار الأخلاقي - تصبح منبعاً للتسلية والسكينة. هذا الانقلاب الدلالي يعكس روح تمرد تتخطى المألوف وتسعى لتأسيس منظومة قيمية بديلة.
تختتم القصيدة بإعلان صريح عن حالة الغموض العامة التي أشار إليها العنوان:
"غامض كل شيء / الاّ قلعة التنين."
إنها خاتمة صادمة تترك المتلقي أمام لغز جديد، فما هي "قلعة التنين" هذه التي تمثل الوضوح الوحيد وسط ضبابية المشهد العام؟ ربما هي رمز للسلطة، أو للخوف المتجسد، أو لمركز القوة الذي يفرض هيمنته على المشهد الإنساني.
ثانياً: قصيدة "وصول المعنى" - مسرح الصراع الرمزي
تنطلق القصيدة الثانية من لوحة تشكيلية تتكون من عناصر متباينة متناثرة، كأنها مشاهد متقطعة من فيلم سريالي:
"أوزّة وحيدة / ثمة غربان هزيلة / مخالبٌ جائعة تتربّص بالأحلام"
تبدأ المشهدية بصورة الأوزة الوحيدة، رمز الضعف والانفراد، ثم الغربان الهزيلة التي تنتمي في مخيال الثقافة إلى عوالم الشؤم والموت، ثم المخالب الجائعة التي تستهدف لا الجسد بل الأحلام - وهنا تتجلى استعارة بليغة تجسد فكرة تهديد عوالم الحلم والتخييل.
يتصاعد المشهد الدرامي بصورتي النار والنمر:
"نيران تضيءُ أشجارا مثمرة / نمر يسقط في رماد."
إنها صور متناقضة تجمع بين الإضاءة والسقوط، بين النار المستعرة والرماد المتبقي منها، في جدلية الفناء والتجدد.
ينتقل النص بعد ذلك إلى مستوى ميتا شعري، حيث يتأمل في العلاقة بين الدال والمدلول:
"حين يزعم الحرف بأن اسما قد أنكر معناه"
وهنا نكتشف أن عنوان القصيدة "وصول المعنى" يحمل مفارقة، فالمعنى لا يصل بشكل مباشر بل عبر مسارات ملتوية من الإنكار والتحول. الحرف يزعم، والاسم ينكر، في حالة من الانفصال بين اللغة وما تحيل إليه.
تختتم القصيدة بعبارة مكثفة تبدو كخلاصة فلسفية:
"وصولا لظلمة صادقة."
فالظلمة - رغم دلالاتها السلبية المعتادة - توصف بالصدق، في انقلاب دلالي آخر يشبه ما رأيناه في القصيدة الأولى. وكأن الحقيقة لا توجد في النور والوضوح، بل في الظلام والغموض، في مقاربة تذكرنا بالمنهج السلبي في التصوف، حيث يوصف الله بما ليس هو، لا بما هو.
المقاربة الجمالية والأسلوبية:
تتميز القصيدتان بسمات أسلوبية مشتركة أبرزها:
* الاقتصاد اللغوي: حيث تتسم اللغة بالتكثيف الشديد والاختزال، فتقول الكثير بالقليل من المفردات.
* المفارقة: وهي تقنية بارزة في النصين، تقوم على الجمع بين المتناقضات ومنح الأشياء صفات نقيضها (الحمى تشفي، الآثام تسلي، الظلمة صادقة).
* السريالية: حيث تتوالى الصور في تداعٍ حر يتجاوز منطق السببية، فتتجاور عناصر متباعدة في الواقع (الريح تغرف العطش، النمر يسقط في الرماد).
* الشخصنة: منح الأشياء والظواهر الطبيعية صفات إنسانية (الريح تغرف وتذرف، الحرف يزعم، الاسم ينكر).
* الرمزية: استخدام عناصر رمزية موحية (التنين، الأوزة، الغربان) بدلالات مفتوحة على تأويلات متعددة.
تقف هاتان القصيدتان عند تخوم الشعر الصافي، متحررتين من أعباء السرد والخطابة، ساعيتين لخلق تجربة جمالية تغوص في أعماق الذات والوجود. إنهما تنتميان إلى تيار الشعر الرؤيوي الذي يتجاوز المباشرة والسطحية، ويسعى لتفجير طاقات اللغة الكامنة.
القصيدتان تتحديان المتلقي وتدعوانه للمشاركة في إنتاج المعنى، فالغموض فيهما ليس عيباً بل فضيلة، والإبهام ليس قصورًا بل غنى دلاليًا. إنهما تعكسان وعياً شعريًا متقدمًا يؤمن بأن مهمة الشعر ليست تقديم أجوبة جاهزة، بل طرح أسئلة جديدة تفتح آفاق التأمل والتفكير.
**
طارق الحلفي
.................
الرابط