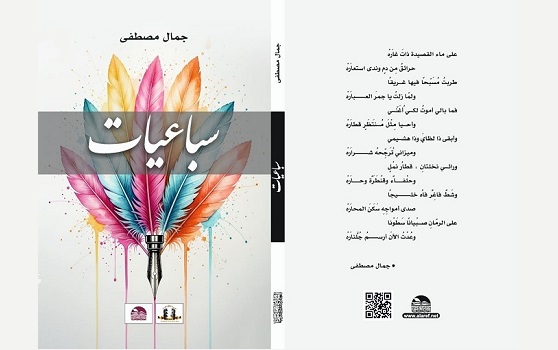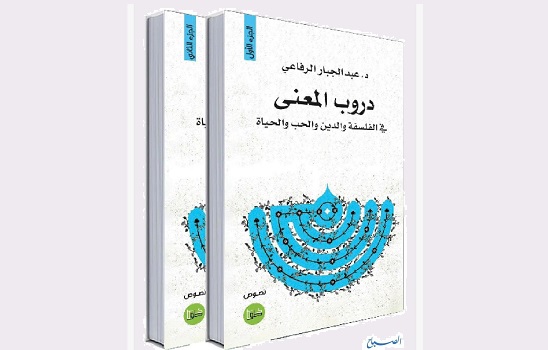قضايا
محمد حبش: إجماع أهل المدينة.. هل أسس الإمام مالك لفكرة البرلمان الوطني؟

أرجو ألا توضع هذه المقالة في سياق ما تعودناه من رواية الإعجاز والعجائبيات، وأن فقهاء الإسلام الأوائل تفوقوا منذ أربعة عشر قرناً على دوركهايم وسارتر ومونتسكيو وغيرهم من فلاسفة السياسة العالميين، بل هي مقاربة لوعي فقيه عاش في القرن الثامن الميلادي وقدم قراءة متفوقة سبقت عصره بعدة قرون.
إنها جملة مقاربات مدهشة في وعي هذا الإمام الجميل، تركت لدي انطباعاً بوعي متقدم في إدارة المجتمع والدولة، لم تنل حظها من الدراسة والاعتبار.
وبعيداً عن الصورة التبجيلية التي نرويها للإمام مالك عليه سلام الله، في هيبته ووقاره وتقديسه لحروف الرواية وأسانيدها، وهي الأدوات التي كان يستخدمها رضي الله عنه في طريقته التربوية والتعليمية، فإن هناك جانباً من الوعي السياسي التشريعي تفرد به الإمام مالك.
والفكرة المقصودة هنا هي قوله بإجماع أهل المدينة، فقد انفرد الإمام مالك بتأصيل بالقول بذلك في مواجهة الإجماع الشامل الذي ذهب إليه الفقهاء.
ومن المعلوم أن الإمام مالك كان يرى إجماع أهل المدينة مقدماً على السنة إذا رواها الآحاد، وفي كتابه الموطأ وردت عبارة: النص صحيح وليس عليه العمل أكثر من سبع عشرة مرة في كتاب الموطأ.
والقول بإجماع أهل المدينة يقتضي في الوعي السائد أن ما ذهب إليه أهل المدينة هو الأقرب لروح الشريعة، حيث المدينة هي مرقد الرسول وذكرها مسطور في القرآن وفضلها معلوم في السنن، وكذلك فهي المفضلة عقلاً نظراً لما كانت المدينة تعنيه من مخزون الحكمة والنبوة وميراث الرسالة، حيث أبناء الأنصار الذين دعا لهم رسول الله بالخيرية.
من وجهة نظري فإن تعليل إجماع أهل المدينة بفضائل المدينة ومآثرها، فيه ظلم لفقه هذا الإمام الجليل ووعيه، واختزال لوعي تشريعي عميق، في مسألة عجائبية ترتبط بالمكان والزمان وليس بالوعي التشريعي.
قناعتي ان الإمام مالك قصد بإجماع أهل المدينة التأصيل للفقه المحلي، والدعوة إلى إصدار تشريعات متعددة تتناسب مع كل بيئة وجغرافيا.
إنه ليس مجداً لأي دستور ولا تشريع أن يكون صالحاً لكل زمان ومكان، إن الأمكنة تختلف والأزمنة تختلف، والحوادث لا تتناهي وما يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، وعلينا أن نقدم الفتاوى لكل بلد على وفق ما يراه فقهاؤه وعلماؤه وخبراؤه، وليس هناك وصفة عجائبية تصلح لكل زمان ومكان، وستعزز هذه الفكرة المواقف الآتية للإمام مالك:
الأول: القصة المشهورة عن لقائه بأبي جعفر المنصور، فقد وصف الرواة جميعاً هذا اللقاء الكبير، والدهشة التي أصابت أبا جعفر من علم مالك وفقه مالك، وقد سحر الخليفة العباسي الكبير بحفظ مالك وعلمه، وطلب إليه كتابه الموطأ ليفرضه على الأمصار، وقال: يا أبا عبد الله دعني أجعل العلم علماً واحداً، إنني أُريد أن أنسخ من كتابك هذا نسخاً، ثم أكتب إلى الآفاق فأحملَهم على كتاب "الموطأ"، حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه، فلا يفتى إلا بما فيه! فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم.
لقد كانت فرصة نادرة يعرضها عليه أبو الدولة العباسية والمؤسس الحقيقي وجد الخلفاء القادمين لخمسة قرون تالية، ووفق اقتراح الخليفة فإنه سيكون للمسلمين في كل مكان في العالم كتاب الله وموطأ مالك، ويا لها فرصة من ذهب يتمناها كل باحث وفقيه، حيث ستحمل الخلافة نفسها مسؤولي نشر علمه في الناس!..
ولكن الإمام مالك تأمل قليلاً في كلام الخليفة ثم قال بدون تحفظ: كلا يا أمير المؤمنين! إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار وقد حدث كل بما سمع، واتبعهم الناس، وقد رأى كل فريق أن قد اتبع متبعاً!
وفي رواية أخرى قال مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وإنّ ردَّهم عما قد اعتقدوا شديد، فَدع الناسَ وما هم عليه، وما اختاره أهلُ كل بلد لأنفسهم، فقال أبو جعفر: لعمري لو طاوعتَني على ذلك لأمرتُ به.
وقد أعجب الإمام أحمد بموقف مالك وقال: هكذا ينبغي أن يصنع كل من نال من سلطانه إقبالًا عليه من أكابر أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولا يشتغل بالتعصب، وإعداء السلطان على من خالف اجتهادُه اجتهادَه.
الثاني: صدور الكتاب عن شورى وإجماع في أهل المدينة وليس عن رأي فردي، قال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فَقِيهًا مِنْ فقهاء المدينة فكلهم وَاطَأَنِي عَلَيْهِ فَسَمَّيْتُهُ الْمُوَطَّأَ.
الثالث: دعوته أهل كل مصر للاجتهاد فيما يخصهم ويعنيهم، وهو ما أوضحه بدقة لأبي جعفر المنصور بقوله: إن لأهل هذه البلاد قولًا ولأهل المدينة قولًا ولأهل العراق قولًا ولأهل الشام قولا!.
ويبدو أن أبا جعفر كان سيء الظن بأهل العراق فقال لمالك: أما أهل العراق فلست اقبل منهم صرفًا ولا عدلًا، وإنما العلم علم أهل المدينة فضع للناس العلم!
ومرة أخرى كان جواب الإمام مالك الرفض والتنبيه أن الفقه في العراق للعراق وفي الشام للشام وفي الحجاز للحجاز، وقال بصراحة يا أمير المؤمنين إن أهل العراق لا يرضون علمنا، ولا يرون في علمهم رأينا، فقال أبو جعفر إذن يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط !!
ولكن هذا العرض الاستبدادي المستفز كان دليلاً آخر للإمام مالك أن يرفض الفكرة برمتها، ويجدد دعوته لدعم الفقه المحلي وفق حاجات كل بلد وظروفه.
ويبدو أن الأمر تكرر بعد ذلك في عهد الخليفة المهدي ابن المنصور الذي طلب الأمر بصيغة أخرى حيث أراد كتاباً جامعاً لسائر بلاد الخلافة، وأرسل لمالك في طلب لك، فكان جواب الامام مالك: أما هذا الصقع يعني الحجاز، فقد كفيته وأما الشام ففيه الأوزاعي وأما أهل العراق
الرابع: موقف الإمام مالك من فتاوى الأمصار، فقد كان يفتي في كل شاردة في المدينة، حتى قيل أيفتى ومالك في المدينة؟، ولكنه كان يعتذر عن أسئلة أهل الأمصار، وكان يرى ان فقهاء كل مصر أولى بمسائل قومهم، وفي القصة الشهيرة أن وفداً من العراق جاءه في أربعين مسألة فأفتى بأربع وسكت عن ست وثلاثين!
الخامس: دعوته لاحترام اجتهاد العلماء والفقهاء في قضايا أقاليمهم، واحترام ما وصلوا إليه بغض النظر عن موافقته لهم أو مخالفتهم، وفي عبارة تكررت عند أبي نعيم أن مالكاً قال للمنصور: إن الصحابة تفرقوا في الأمصار ونشروا علمهم واختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلٌ بما اجتهد فيه مصيب!
وقال القاضي أبو بكر: إن مذهب مالك أن كل مجتهد مصيب، واستدل على ذلك بأن المهدي أمره أن يجمع مذهبه في كتاب يحمل الناس عليه، فقال له مالك رحمه الله: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلاد، وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم، فاترك الناس وما هم عليه"، فلولا أن مالكًا رأى أن كل مجتهد مصيب؛ لما جاز أن يقرهم على ما هو خطأ عنده، وبه قالت المعتزلة من البغداديين، وقد روي عن أبي حنيفة الأمران جميعًا، وكذلك فقد روي الأمران جميعًا عن أبي الحسن الأشعري، وقال المعتزلة البصريون: كل مجتهد مصيب.
السادس: اشتهر عن الإمام مالك أنه كان لا يحب الأرأيتية، وهم الذين يسألون افتراَضاً لمسائل لم تقع، فيقولون: أرأيت لو وقع؟ أرأيت لو كان؟ فكان مالك يقول دعوها لعالم زمانها، وفي الواقع فإن هذه العبارة على اشتهارها عن مالك لم ترد بنصها في أي كتاب معتمد، وقد رويتها لك وأتحفظ على إسنادها، ولعل من يقرؤ هذا يسعفنا بسند عنها، وإلا فهي في حكم المشافهات والله أعلم
وبعد فقد لا تبدو هذه المواقف الستة كافية للجواب على سؤال المقالة، ولكنها بكل تأكيد تصب في غايتها، ويمكننا دون تحفظ القول بأن الإمام مالك كان واعياً بجملة أمور:
- استحالة فرض قانون واحد على كل أمصار المسلمين، بل يجب اعتبار الاجتهاد المحلي، وأهل مكة أدرى بشعابها.
- دعوته الواضحة للاكتفاء بإجماع أهل المدينة مصدراً تشريعياً لأهل الحجاز، فيما استمر في دعوته لأهل كل مصر أن يجتهدوا في مصالح الناس، وصولاً إلى إجماع أهل الشام للشام وإجماع أهل العراق للعراق، ، وهكذا في كل مصر.
- رفضه القاطع لفرض الرأي عبر السلطة مهما رآه صواباً
- رفضه القاطع لاستغلال السلطة لإعداء الناس بعضهم على بعض
- دعوته الواضحة لإنتاج فقه مناسب لكل بلد على يد فقهاء البلد أنفسهم
بالطبع ليست هذه الإشارات كافية لتقديم نظرية متكاملة عن وعي الإمام مالك بالبرلمان الوطني، ولكنها تأسيس لبحث علمي جاد، يستند إلى منزلة هذا الإمام الكبير للوعي بالحاجة إلى كتابة فقه وقانون لكل بلد في إطاره الوطني والتوقف عن طرح وصفات جاهزة لكل زمان وكل مكان.
***
د. محمد حبش