قضايا
ثامر عباس: الوطنية (الظرفية) في المجتمعات المأزومة
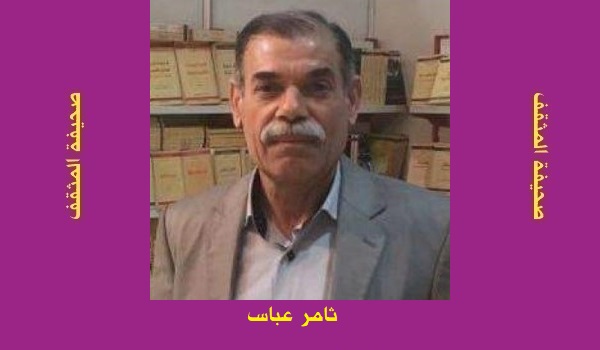
حين يجري الحديث عن المجتمعات (المأزومة) غالبا"ما تتداعى الى أذهاننا مجموعة من الخصائص والصفات التي يمكن إيجازها بالمؤشرات والمعطيات التالية ؛ توترات سياسية مستديمة، وانقسامات اجتماعية متقادمة، واحتقانات نفسية متراكمة، وتصدعات قيمية متفاقمة. بحيث قد يتساءل البعض: كيف يكون بمقدور هكذا مجتمعات مقطعة الأوصال ومعطلة الآمال وطافحة بالأهوال، استمرار بقائها على لائحة الوجود الإنساني والحضاري لحد الآن ؟!. لا بل والأنكى من ذلك أنها تطالب بقية الشعوب والمجتمعات الأخرى التي قطعت شوطا"بعيدا"في مضامير التطور والرقي، أن تنظر إليها وتتعامل معها بمنظار التكافؤ والنديّة !.
ولكن ما علاقة ما أسميه بالوطنية (الظرفية) بالمجتمع الذي ننعته ب(المأزوم) ؟، وهل يمكن وسم المشاعر (الوطنية) بالطابع (الظرفي) العابر وتجريدها من صفات (الديمومة) و(الاستمرار)، بصرف النظر عن طبيعة المجتمع الذي نتحدث عنه أو نقصده، ودون اعتبار لما تنطوي عليه تلك المشاعر من خصائص وما قد تزامن أو تحايث من سياقات ؟!. الحقيقة أن هناك تلازم عضوي يتعذر فصم عراه بين طبيعة (الأزمة) القائمة ومعدلات تفاقمها داخل المجتمع المعني من جهة، وبين مستوى جنوح المشاعر الوطنية صوب الخاصية (الظرفية) العابرة من جهة أخرى. أي بمعنى انه كلما أوغلت الأزمة في تطاولها الزماني وتجذّرها المكاني وتعمقها الإنساني، كلما أسهمت في الخمود التدريجي لجذوة المشاعر والحدّ من وهج العواطف التي تشدّ الإنسان بموطنه، للحدّ الذي يمكن مقارنته واستخلاص نتيجته عبر ملاحظة مستويات الصعود والهبوط لمؤشر (الولاء) لمراحل ما قبل الأزمة وما بعدها.
فعلى صعيد مرحلة (ما قبل) الأزمة حين يكون المجتمع في حالة من الاستقرار السياسي والتطور الاجتماعي، نجد ان مؤشر (الولاء) الوطني لدى الإنسان (المواطن) يبلغ مستويات (مرتفعة) من تأجج المشاعر وطغيان العواطف، على خلفية انغماره بأحاسيس الانتماء الاجتماعي، والاطمئنان الاقتصادي، والتشارك السياسي، والتفاعل الثقافي. أما على صعيد مرحلة (ما بعد) الأزمة، فإن الأمور تأخذ منحى دراماتيكي مختلف تماما"، بحيث تنقلب المسلمات والقناعات والتواضعات السابقة رأسا"على عقب، وذلك جراء عمليات التآكل والاندثار المستمر التي تفعّلها ديناميات الأزمة، ليس فقط داخل بنى الوعي الاجتماعي والسيكولوجي التي كانت في حالة من الثبات والاستقرار النسبي فحسب، بل وكذلك داخل شبكات الروابط والصلات والعلاقات التي كانت حتى ذلك الوقت، تسهّل وتديم عمليات التفاعل والتواصل بين الجماعات والمكونات.
ولأجل إيجاد معادل (واقعي) لهذا الاستنتاج (النظري) الذي خلصنا إليه، فإن ترشيح تجربة المجتمع العراقي كحالة معاشة لإظهار الكيفية التي يتعاطى من خلالها الأفراد والجماعات مع قضايا (الهوية الوطنية)، وما يفترض أنها تستتبعه من مشاعر وعواطف تتعلق ب(الولاء) لها من عدمه يبدو خيارا" معقولا"ومقبولا"، من حيث كونه يتيح للباحث فرص الملاحظة المباشرة للتحولات – صعودا"أوهبوطا"- التي تتعرض لها تلك الانفعالات السيكولوجية المضطربة. لاسيما وان تجارب المجتمع العراقي مع (الأزمات) هي الأكثر تواترا"والأشدّ تعقيدا"، إذا ما قورنت بتجارب بقية المجتمعات الأخرى التي وان كانت – ربما - تعاني من ذات الظاهرة، إلاّ أنها لا تسبب لها هذا الكم الهائل من المشاكل المتفاقمة والإشكاليات المستعصية مثلما تسببه للمجتمع العراقي من عواقب وتداعيات، لا تقتصر فقط على إعاقة تكوين (الشخصية الاجتماعية) التي تشكل ركن أساسي من أركان الاستقرار والتطور الاجتماعي فحسب، وإنما تساهم في إثارة النعرات والعصبيات بكل أشكالها وألوانها أبضا".
ولعل من أسباب شيوع هذه الحالة / الظاهرة (الوطنية الظرفية) بين مكونات المجتمع المأزوم، كون هذه الأخيرة لم تحظى بنظام سياسي يحرص على تكريس مفهوم (الوطن) وترسيخ أهمية الوعي ب(الوطنية)، بعيدا"عن نوازع الانتماءات الانثروبولوجية ودوافع الولاءات الإيديولوجية التي تتشظى إليها تلك المكونات، وإنما على العكس من ذلك راهنت تلك الأنظمة بمختلف عناوينها على توظيف تلك الانقسامات واستثمارات تلك الانشطارات، بما يعزز بقائها في السلطة ويضمن استمرار هيمنتها على المجتمع. لا بل أنها عمدت في الكثير من الحالات الى (شخصنة) كل ما يتعلق بمفاهيم (الوطن) و(الوطنية) الى حدّ التماهي، بحيث أصبح شعاراها الدائم هو (الوطن / الوطنية – القائد / الزعيم) دون اعتبار لما تنطوي عليه المماهاة من عواقب سياسية واجتماعية وثقافية. وهو الأمر الذي جرد تلك المفاهيم السيادية من دلالاتها الرمزية والاعتبارية والقيمية، بعد أن استحالت في الوعي الفردي والسيكولوجيا الاجتماعية الى مجرد ألفاظ (شكلية) وعبارات (جوفاء) تلوكها الألسن وتصدح بها الحناجر بمناسبة وغير مناسبة.
وعلى هذا الأساس، لم يعد (المواطن) يستحضر في وعيه مفهوم (الوطنية) إلاّ في المناسبات الرسمية، أو اللقاءات الدبلوماسية، أو الحوارات الأكاديمية، أو المنافكات الإيديولوجية، التي عادة ما تكون عابرة (ظرفية) سرعان ما ينطفئ بريقها ويتلاشى وهجها بانتهاء فترة المناسبة أو اللقاء أو الحوار أو المجادلة. أما ما يترتب على ذلك المفهوم من اعتبارات والتزامات وأخلاقيات وعلاقات، فهي نادرا"ما تخطر على بال الأطراف المعنية إلاّ بالقدر الذي ترى فيه وسيلة من وسائل المزايدة بين هذا المكون أو ذاك، وأسلوب من أساليب المفاضلة بين هذه الجماعة أو تلك ليس ألاّ.
والجدير بالملاحظة ان (فيض) المشاعر الوطنية أو (جدبها) في مثل هذا النمط من الجماعات / المجتمعات المأزومة، غالبا"ما يظهر لدى أولئك الذين يكابدون ظروف (الهجرة) القاسية في المجتمعات الأخرى التي اختاروا اللجوء إليها والاستيطان فيها لأسباب ودوافع مختلفة، أكثر مما يظهر لدى أقرانهم ممن تكيفوا مع ظروف أوطانهم وأوضاع مجتمعاتهم. ذلك لأن مستويات الإحساس بالغربة ومعدلات الشعور بالضياع لدى عناصر الصنف (الأول) تبدو أعلى مما هي عليه الحال بالنسبة لعناصر الصنف (الثاني)، خصوصا"بالنسبة للأجيال الأولى من المهجرين الذين تعرضوا لصدمات الاختلاف في القيم والرؤى والتباين في العلاقات والسلوكيات. خلافا"لأبنائهم وأحفادهم من الأجيال التالية الذين لم يعانوا أو يكابدوا – بذات القدر - وطأة تلك الصدمات والصعوبات، وبالتالي خفت أو اضمحلت لديهم مشاعر الانتماء للوطن أو الولاء للوطنية، التي كان آبائهم وأجدادهم يحرصون على التمسك بها والتعويل عليها
ولكن المفارقة، في هذا الإطار، هي ان (الحمية) الوطنية التي كانت تبديها عناصر الجيل الأول في مجتمعات الغربة، لا يلبث (الوهن) و(التراخي) أن يتسلل إليها ويطغى عليها حالما تطأ أقدام تلك العناصر أرض (الوطن) والانخراط في أمور المجتمع، سواء لأغراض تتعلق بالعمل التجاري والاستثماري، أو للقيام بالزيارات الدورية للأهل والأقارب، أو لاتخاذ قرار العودة النهائية والاستيطان مجددا". لا بل ربما تتجه بوصلة الحمية (الوطنية) بالاتجاه المعاكس، بحيث يتحول زخم المشاعر من حالة (الفتور) الى حالة (النفور)، لاسيما بعد أن يجد (العائد) ان واقعه الوطني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، ليس فقط لم يبرح طبيعته المتخلفة والمزرية فحسب، وإنما تردى أكثر الى مهاوي الانحطاط الحضاري والبربرية الإنسانية.
***
ثامر عباس







