قضايا
حيدر عبد السادة: الثورة الرابعة ونهاية الإبداع
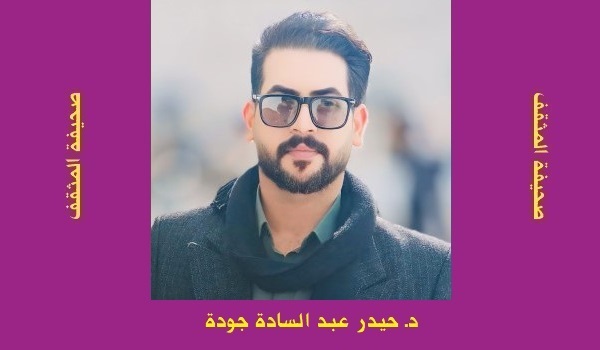
في غابر الأزمان، وعلى مدى التاريخ البعيد، لم تكن أمام الإنسان فرصة التعافي من صفعةٍ سابقةٍ قد وُجّهت له، إلا وتلقى صفعةً أخرى قد أثقلته وأردته أسفل سافلين، وهكذا عاش الإنسان على سطح هذه المعمورة، فبعدما تباهى بمركزية ما يسكنه، خيّل له مركزيته بالنسبة للعام، إلى أن جاء (كوبرنيكوس) الذي أعلن مركزية الشمس ودوران الأرض حول الأولى، فأفقد الأمر مركزية الإنسان تبعاً لانهيار مركزية الأرض التي يسكنها. فدار الإنسان حول نفسه ليعلن المكانة المثلى بين أنواعه، فتسيّد على الكائنات المجاورة، وتزعم المشهد المُعاش باعتباره الأكثر حظاً بين الأنواع، إلى أن جاء (داروين)، فقوض في كتابه الشهير (أصل الأنواع)، نظرية الخلق المنفصل، ونادى باستمرارية الخلق وصولاً إلى الحلقة الأخيرة وهي الإنسان، وبذلك وحّدت النشأة الأولى في الخلق، من وجهة نظر علمية، علائق الإنسان مع سائر المخلوقات، بعدّه جزءاً لا يتجزأ عن سائر المخلوقات الأخرى، فانتهت بذلك حقبة التسيّد على الكون بذريعة الخلق الفريد.
فتفرد الإنسان يتبجح من جديدٍ تحت غائلة (الإنسان حيوان عاقل)، فبدأت رحلة الاستعلاء تعود مرة أخرى لتُفرّد الإنسان على سائر ما خُلق تحت ذريعة الوعي، إلى أن جاء الأمر بالطبيب النمساوي (سجموند فرويد) ليعلن الضربة القاضية على الإنسان بالإعلاء من راية الغريزة على حساب العقل، ورجاحة اللاوعي على حساب الوعي الذي تبارك الإنسان في تقديمه كميزة على حساب غيره من الكائنات. وبذلك توازن العيش بالتسليم بمكانة الإنسان الطبيعية مع العالم ومع غيره ومع نفسه.
مع ما تقدم، فإن ما أسلفنا القول فيه، لا يخرج عن إطار اعادة خلق التوازن بين الإنسان وما يحيط به، والعيش المشترك تحت وصايا التواضع والواقعية، واعتناق المسؤولية الأخلاقية إزاء الكون والطبيعة. فمما لا شكّ فيه، أنّ الإنسان لو كان مفتقراً إلى هذه الثورات المعروفة، لطغى في الأرض وعلا فيها فساداً، مستبيحاً ومتمرّداً على معالم الطبيعة وما يحيط به، ولتسيّد على بقية الكائنات بعدّه الأصل الأصيل في دائرة الوجود. لذلك نقول بأهمية ما تعرّض له الإنسان من صفعاتٍ قد أوغلت في داخله معالم العيش المشترك، سواء مع الطبيعة أو مع بقية الكائنات الموجودة على سطح البسيطة.
من هنا نفهم آلية الاشتغال الحقيقي للفلسفة في القرن التاسع عشر، فلا شكَّ في إنّ السمة البارزة فيها تتمثل في الكيفية التي من خلالها مصادرة المباحث الميتافيزيقية المتعالية، والعمل على استبدال مفارقتها بما يخدم الإنسان والعالم الذي يعيش به، لذلك وُلدت الاتجاهات والمذاهب الفلسفية المعاصرة، الماركسية، الوجودية، البراغماتية وغيرها... وكلها بالأساس تهدف إلى اعادة توظيف مكانة الإنسان في العالم، وعلاقته مع التاريخ والطبيعة والآخر. لكن سرعان ما خفتت هذه الشعلة المتوهجة بميلاد التطور التقني، فقد أصبحت ثنائية الإنسان/العالم، تحلُّ محل الأنا/الآخر، إلى أن وصل الأمر بميلاد ما يُعرف بـ(الذكاء الاصطناعي)، وهي الثورة التي أعلنت بميلادها نهاية الإنسان وموت إبداعه، وقد اجتازت في أثرها جميع الثورات سالفة الذكر، لأنها لا تريد أن تعيد الإنسان إلى مكانته الطبيعية وتحديد مسؤولياته اتجاه ما يُحيط به، بل تريد به الذهاب إلى فجوةٍ من ككهف أفلاطون، ليكتفي بالنظر إلى الرسومات المشوهة على ذلك الجدار الزائف، المحجوب عن الحقيقة، بحقيقة النور المحجوب بوساطة الـ(GPT).
لا مكان اليوم لأيِّ مهمةٍ للإنسان، فقد أفرغت الثورة الأخيرة من الإنسان إبداعه وعبقريته وقدرته على التفكير، وهنا نشهد نهاية عصر الإنتاج، وبداية لعصرٍ جديدٍ يُنعتُ بـ(عصر الاستهلاك الالكتروني)، لأن الثورة الأخيرة ستؤسس لميلاد مجتمع ناصت متلقٍ لما يفرزه الذكاء من صورٍ وأفكارٍ وآراء، دون الحاجة إلى قدرة الإنسان في الابداع وممارسة إدلاء الرأي، فانتهت بذلك علاقة الذات السائلة والأخرى المجيبة، لانّ لا قدرة على الاجابة عن شيء، حيث لا وجود لمصدرٍ داخليِ يعتمد عليه الإنسان في صقل مهاراته للإجابة عن شيء يُسئل عنه، سيبقى الإنسان سائلاً دون إجابة بشرية، لأن هنالك من تكفّل عناء التحضير لإجابات مصبوبة في قوالب جاهزة، سيأخذ بها الإنسان من دون فحصٍ أو دراية.
ولا معنى اليوم لوجود آلة التفكير الإنساني، ولا معنى للإبداع والعبقرية، ولا معنى للمهنةِ أصلاً، فانتهى عصر الفن وانتهت مهنة الرسام، فتستطيع أن تخبر الذكاء بشيءٍ فيرسمه من دون جهدٍ أو قيد، ولا مكان للشعراء والمفكرين، فقد ناب عنهم الذكاء بسرد ما يودُّ المستمع سماعه، فأعقد الأشياء باتت أيسرها، فقد كانت الحقيقية في الفكر والمعرفة محجوبة وراء مئات الكتب والمجلات، وكان الباحث قد يمكث شهوراً متتالية في البحث عن مُشكل معرفي، فيعيش في بطون الكتب لليالٍ وأيام، بغية النقد والتحليل والتركيب وإعادة بنينة الأفكار وصقلها في قوالب الحقيقة الملائمة، أما اليوم فلا اعتماد على ما كُتب، وليس للباحثين أيُّ صلةٍ بالكتب وما كتبه الفلاسفة والمفكرين، فلك أن تمسك هاتفاً ذكياً، وتدخل في موقعٍ أذكى، فتكتب مثلاً: (ما الوجود؟)، ليقترح عليك الذكاء عشرات من الإجابات الجاهزة، وهذه العملية وإن اختصرت المسافات، إلا أنها ستبقى مفتقدة إلى الجهد الذي من شأنه أن يصنع باحثاً حقيقياً، فما الاعتماد على الذكاء إلّا إيذاناً بميلاد الغباء.
***
د. حيدر عبد السادة جودة







