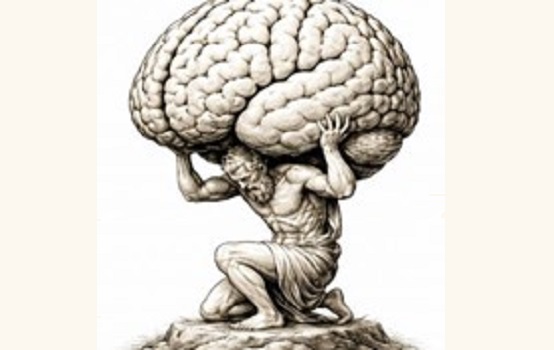قضايا
عبد الله الفيفي: أصحاب الكهف المعاصرون!

(قراءة في بِنية العقليَّة الاتِّباعيَّة)
ناقشنا في المساق السابق تلك المماحكات التي يثيرها بعض المحدثين حول ما وردَ في (سُورة الكهف: الآية ٨٦): «حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. قُلْنَا: يَا ذَا القَرْنَيْنِ، إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا.» فيقولون: كيف وجدَ الشمس؟ وكيف تغيب الشمس في عَين؟ وكيف وجدَ عندها قومًا؟ وقد قال (ذو القُروح): إنَّهم إنَّما يحصرون دلالات الألفاظ والتراكيب في ما يريدون. وإنَّ ذلك يذكِّرنا- للمفارقة أو للموافقة- بما وردَ في «صُورة الكهف»، لدَى (أفلاطون)، في الكتاب السابع من «الجمهوريَّة الفاضلة»، الذي ضربَه مثلًا في أنَّ الإنسان يظلُّ في سُبات الغفلة، عَدُوًّا لما يجهل، وما يجهل أكثر ممَّا يعلم، بل لعلَّ ما يراه حقائق أو يظنُّه لا يعدو خيالات وأوهامًا. بما في ذلك ذهن أفلاطون نفسه، الذي كان ما يزال غارقًا في كهف الأساطير القديمة؛ حتى إنَّه- على جلال قَدره العقلي والفلسفي- لم يكن قد تخطَّى عقليَّة الجاهليَّة، كما عهدناها عند العَرَب أيضًا، المعتقدة في ألوهيَّة الشمس (اللَّات)(1)؛ لما لحظوه من دَورها العظيم في الحياة. قلتُ له:
- لا غرو؛ إذ يبدو أنَّ الإنسان عمومًا قابِلٌ للتأسطر والأسطرة ونزف الأساطير في العالمين، إنْ بتصديقٍ أو بتلفيق، وفي كلِّ زمانٍ ومكان، وليس بالضرورة أن يكون من الغارقين في كهف الأساطير القديمة، كـ(أفلاطون).
ـ ويكفي لإدراك ذلك أن تطَّلع على كتابَي (أنيس منصور، -2011) «العظيمين»: «الذين هبطوا من السماء»، و«الذين عادوا إلى السماء»، ونحوهما من منشوراته الغفيرة، على سبيل النموذج. تلك المنشورات المتناثرة على الأرصفة وفي المكتبات، ولطالما عبثتْ بأذهان الشباب العَرَبي، خلال السبعينيَّات والثمانينيَّات من القرن الماضي، وَفق ملهاةٍ تخديريَّةٍ غير بريئة، باسم الثقافة والفلسفة والآداب والمعارف والفنون، على الطريقة العَرَبيَّة المسيَّسة المعهودة، غير المعنيَّة بإنتاج شيءٍ، سِوَى الجهل والضياع والعَدَميَّة. وحينما تطَّلع على مثل ذاك النتاج، غير العِلمي ولا المعرفي ولا العقلاني، ستترحَّم على أساطير الأوَّلين المتواضعة قياسًا إلى أساطير القرن العشرين! قد تُماري في أنَّه تفتَّق ذهن الرَّجُل عن ذلك كلِّه لأنَّه كان يكتب حافيَ القدمين، مرتديًا بجامته، عند الساعة الرابعة فجرًا، كعادته في الكتابة. أو ربما قلتَ: إنَّه كان لا ينام من اللَّيل أو النهار إلَّا قليلًا جدًّا، كما عُرِف عنه. أو لعلَّك تزعم أنَّ مشروعه الحقيقي الكبير إنَّما كان- وهو الموصوف بالمفكِّر والفيلسوف والمثقَّف الذي لا يُشَقُّ له غبار- أنْ يُعِيْد مجد الأساطير المِصْريَّة القديمة إلى جانب الأساطير الإسرائيليَّة القديمة والحديثة في وعاءٍ واحد، ليس فيه شركاء متشاكسون. ولا سيما بعد تجلِّياته عَقِبَ معاهدة (كامب ديفيد)، وما حظيتْ به من سيولة صاحبنا المتناهية ضمن أوانيها المستطرقة، وبكلِّ ما أوتي من مواهبه المذكورة، التي كانت محطَّ إعجاب الصهاينة بصفةٍ خاصَّة، بشهادة الكاتب الصهيوني الإسرائيلي (عاموس إيلون، -2009)، الصحفي والمؤلِّف والمؤرِّخ، الذي لا يُشَقُّ له غبار، هو الآخَر.
- لكن عاموسوه هذا كان من الداعمين لإقامة دولة فلسطينيَّة مستقلَّة، الداعين إلى أن تكون على أراضي ما قبل 1967.
- يا حبيبي! يعني كما بات ينادي العَرَب اليوم! هل أضاف: «وعاصمتها القُدس الشرقيَّة»؟! وكأنَّ القُدس الغربيَّة والشماليَّة والجنوبيَّة وغيرها قد باتت حلالًا زلالًا للمحتل! مع أنَّها كلَّها أراضٍ محتلَّة أصلًا، ولكن العَرَبيَّ بات يرضَى من الهزيمة بالخَيَّاب بن هيَّاب!
- لا أعلم هل أضاف هذا القيد المعاصر: «وعاصمتها القُدس الشرقيَّة»، لكن، للاحتياط، ربما!
- هؤلاء الداعمون والداعون هم الأخطر!
- لماذا؟
- لأنهم يدعمون بذلك تصفية القضيَّة الفلسطينيَّة، داعين إلى خنق أهلها في حدودٍ محدودة من أرضهم:
جوَّعوا أطفالَنا خمسين عامًا،
ورَمَوا في آخِر الصَّومِ إلينا بَصَلَةْ...
تَركوا عُلبةَ سردينٍ بأيدينا تُسَمَّى (غَزَّةً)...
عَظمةً يابسةً تُدْعَى (أريحا)..
فُندقًا يُدعَى (فلسطينَ)،
بلا سَقفٍ ولا أعمدةٍ،
تركونا جسدًا دونَ عِظامٍ،
ويدًا دونَ أصابعْ!
كما قال (نزار بن قبَّاني).
- لنعُد إلى أصحاب الكهف المعاصرين، ولنُسَمِّ الأشياء بمسمَّياتها!
- كيف «نُسَمِّي الأشياء بمسمَّياتها»؟!
- لم أفهم مُرادك!
- ولا أنا! هل من مترجم في الأُمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي؟!
- والحل؟
ـ الحلُّ أن تفرِّق بين الأسماء والمُسمَّيات!
ـ هكذا نسمع العبارة «نسمي الأشياء بمسمياتها»!
ـ بأيَّة لُغة هذه؟
ـ لُغةٌ يُسمُّونها اللُّغة العَرَبيَّة!
- هذه لم تعُد لا عَرَبيَّة ولا أعجميَّة! الصواب: «نسمي الأشياء بأسمائها»! لأن المُسَمَّى هو المُسَمَّى، أي الشيء نفسه، والاسم هو اسمه. وحين يصل المرء إلى عدم التفريق بين الاسم والمُسَمَّى، فقُل على لُغته السلام. «وعَلَّم آدمَ الأسماءَ كُلَّها»، ولم يقل «المُسمَّيات كُلَّها»، أي علَّمه أسماء الأشياء «المسمَّيات» بتلك الأسماء.
ـ طيِّب، ولا تزعل، ولنُسَمِّ الأشياء بأسمائها!
ـ هكذا نتفاهم! بالعودة إلى أصابع أصحاب الكهف المعاصرين، فإنهم لا يعانون معاناة أصحاب الكهف الأفلاطوني فحسب، بل يعانون الأيديولوجيَّات أيضًا، التي هي أشد ظلاميَّة من ظلام الكهوف؛ تحملهم حملًا على المغالطات، وعلى الانتقائيَّة، وعلى التدليس أحيانًا. فـ«وَجَدَ»، لديهم لا تعني إلَّا أَلْفَى ولَقِي حقيقة. لا تعني: رأَى، ظنَّ، وقعَ في وجدانه، إلى غير ذلك، من أفعال القلوب. والحرف «في»، في عبارة «في عَين»، لا تعني لديهم إلَّا الظرفيَّة، لا الحاليَّة. والضمير في كلمة «عندها» يعود لديهم إلى الشمس قطعًا. على حين أنَّ النصَّ ليس بقطعيِّ الدلالة على ما فهموا، بل هو محتملٌ لقراءات أُخَر. منها مثلًا: «حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، [رآها] تَغْرُبُ [فِي صورة عَيْنٍ حَمِئَةٍ]، وَوَجَدَ [عِندَئذٍ] قَوْمًا...». فأمَّا «وَجَدَ» بمعنى «رأَى»، فكثيرٌ في كلام العَرَب. قال الشاعر الجاهلي (بشامة بن الغدير):
وَجَدْتُ أَبِي فِيهِمْ وجَدِّي، كِلَاهُما ::: يُطـاعُ ويُؤْتَـى أَمْرُهُ وهْوَ مُحْـتَبِـي
وأمَّا «في» بمعنى: «في حال» أو «في صورة»، فقد جاء في «القرآن»، في مثل الآية: «فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، فِي صَرَّةٍ، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: عَجُوزٌ عَقِيمٌ.»
ـ غير أنَّ (القبَّانجي) يدندن تكرارًا، مثلما يفعل (زكريا بطرس)، على الحروف المقطعة في «القرآن»، متسائلًا ما معناها؟ لسان حاله: إذا كان الله أعلم بمُراده منها، فما وجه مخاطبتنا بما لا نفهم؟
ـ الحقُّ أنَّ المفسِّرين قديمًا وحديثًا قد خاضوا في ذلك خوضًا كبيرًا. ولعلَّ أقرب الآراء وأرجحها، في رأيي، أنها إشارات إلى أنَّ «القرآن» إنَّما هو نصٌّ مؤلَّفٌ من تلك الحروف، وأنَّ تلك هي معجزته، وذلك هو تحدِّيه. وهذا كمَنْ يلقِّن أطفالًا حروف الهجاء، قبل أن يلقِّنهم الكلمات، فالجُمل ثمَّ الأساليب. ولهذا ليس بمصادفةٍ أن تجد «القرآن» قد استعمل قرابة 50% من الحروف العَرَبيَّة في تلك المقاطع الرمزيَّة، موزَّعةً من أوَّل حرف في الحروف الهجائيَّة العَرَبيَّة إلى آخر حرف: (أ، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ي)، تُوظَّف في مستهلِّ أكثر السُّوَر الطِّوال. إنَّها إشارات إلى مادة المعجزة الأساس، وهي: الحرف، واللُّغة، التي مادَّتها الأوَّليَّة تلك الأصوات، لا سِواها. ونحن لو تأمَّلنا في (سُورة مريم)، على سبيل الشاهد، التي تستهلُّ بـ«كاف، هاء، ياء، عين، صاد»، للحظنا أنَّ الحكاية الأُولى التي تَرِد فيها، بعد هذه الرموز، هي حكاية (زكريَّا)، وأنَّ اسمه نفسه يتضمَّن حرفَين من تلك الحروف، ثمَّ يَرِد بعده اسم (هارون)، فـ(مريم)، فـ(عيسى)، فـ(إبراهيم)، المميَّز في الآيات بأنه كان (صِدِّيقًا نَبِيًّا). أفلا ترى هنا أن الكاف إشارة إلى: زكريا، والهاء إلى: هارون، والياء إلى: مريم، والعَين إلى: عيسى، والصاد إلى: الصِّدِّيق النَّبي: إبراهيم. واللافت أنَّ هذه الأسماء قد وردت في السُّورة بالترتيب نفسه الذي وردت به تلك الحروف، اللَّهم إلَّا أنَّ ذِكر مريم (أخت هارون) قد جاء قبل اسم هارون. ويُستثنى من هذه السلسلة النبويَّة اسم (يحيى بن زكريَّا)؛ لأنه ليس من أبطال قِصَّة زكريَّا. هذا اجتهاد، نضربه مثلًا، وليس صحيحًا بالضرورة في كلِّ حال، بَيْدَ أنه يومئ إلى مغزى تلك الحروف، وأنَّها لم تأت بلا معنى يفقهه السامعون من العَرَب ويلحظه المتأمِّلون. وإنَّها لَقائلةٌ لهم أيضًا: إنَّ هذا الكتاب، الذي يتحدَّى فصحاءكم وبلغاءكم، إنَّما هو مؤلَّف من هذه الأصوات اللُّغويَّة اليسيرة التي تعرفونها. وقد جاءت إشارةٌ جليَّةُ الدلالة على هذا المعنى في مستهل (سُورة قاف): «ق، والقرآن ذي الذِّكر...». قائلةً: فائتوا بمثله إنْ كنتم قادرين. حتى إنَّها لتَصدُق في هذا الشأن مقولة (طه حسين): إنَّ في العَرَبيَّة ثلاثة أنواع من النصوص: شِعرًا، ونثرًا، وقرآنًا.(2)
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
.............................
(1) عبدتْ القبائلُ العَرَبيَّة الشمس، وتَكنَّوا بعبادتها، كـ(عبد شمس)، كما عبدوا أصنامها، وتكنَّوا بعبادتها، كـ(عبداللَّات). وبقيتْ بعض آثار ذلك اللُّغويَّة والاجتماعيَّة معروفة في الأوساط الشعبيَّة إلى العصر الحديث. وليس هذا من اكتشافات الدراسات الحديثة أو تأويلاتها الشِّعريَّة، كما قد يزعم بعض الغافلين عن تراث العَرَب، بل قُل: بعض الصُّمِّ عن نصوصه العُمْي عن شواهده. وإنَّما جاء الإسلام، في ما جاء، ثورةً على عبادة الشمس والقمر. وقد نصَّ «القرآن» على ذلك، لا في الإشارة إلى العَرَب الأقدمين- كـ(سبأ)، الذين أشير إلى عبادتهم الشمس- فحسب، بل في الإشارة أيضًا إلى معاصري الرسول من العَرَب الوثنيِّين، الذين ما انفكُّوا يسجدون للشمس والقمر ورموزهما المتعدِّدة في الطبيعة. (يُنظَر كتابي: مفاتيح القصيدة الجاهليَّة: نحو رؤية نقديَّة جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا، (الأردن: عالم الكتب الحديث، 2014)، 91- 94).
(2) يُنظَر: (1953)، من حديث الشِّعر والنثر، (مصر: دار المعارف)، 25.