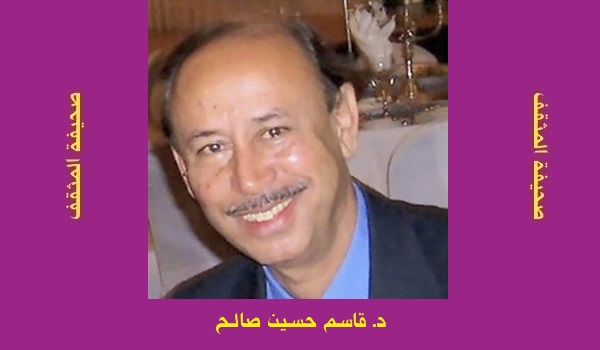أقلام فكرية
أسعد عبد الرزاق: الأخلاق الممكنة.. قراءة مقاربة لعناصر المرونة الفقهية

مدخل: ما الذي يكسب الفعل الأخلاقي قيمته؟
هنا فروض متعددة:
1- الانسجام مع المبدأ الأخلاقي وتجسيده الكامل، وهنا الفعل الأخلاقي يستمد قيمته العليا من مدى تطابقه مع المبدأ الأخلاقي المجرّد، بحيث يكون تجسيدًا حيًّا وكاملاً لذلك المبدأ، وهذا قريب من الاتجاه الكانطي في الأخلاق، إذ تُقاس القيمة الأخلاقية بالفعل من خلال التزامه بالواجب والمبدأ الكلي، لا بنتائجه.
2- تحقيق أكبر قدر من النفع للآخرين، وهنا الفعل الأخلاقي يكتسب قيمته القصوى عندما يحقق منفعة واسعة أو عميقة للآخرين، ويؤدي إلى نتائج ملموسة في تحسين حياتهم، وهذا قريب من الاتجاه النفعي الذي يرى أن معيار القيمة الأخلاقية هو حجم المنفعة أو السعادة الناتجة.
3- تجاوز صراع النفس والانتصار على الرغبات، وهنا الفعل الأخلاقي يبلغ ذروة قيمته عندما يكون ثمرة انتصار الإنسان على ميول أو رغبات تخالف المبدأ، خصوصًا إذا كان الصراع الداخلي شديدًا، وهذا قريب من الاتجاه الديني أو العرفاني الذي يربط الأخلاق بصفاء النفس والمجاهدة الروحية، إذ القيمة مرتبطة بعمق التجربة الداخلية.
4- الاعتراف الاجتماعي وتعزيز الثقة والقيم المشتركة، وهنا الفعل الأخلاقي يكتسب قدرًا عاليًا من قيمته عندما يلقى اعترافًا وتقديرًا من المجتمع أو الجماعة التي ينتمي إليها الفاعل، وهذا قريب من الاتجاه الاجتماعي في الأخلاق الذي يرى أن المعايير الأخلاقية تتشكل من خلال التوافق الجمعي، وأن القيمة تنشأ من الدور الذي يلعبه الفعل الجمعي العقلائي في تشكيل المنظومة الأخلاقية.
ولا أريد هنا أن أشرع في التحليل لهذه المداخل الأربعة، أو أن أرجح أحدا منها، لكن الذي يهم أن نفهم هذه المداخل، ونجعلها في مساحة الاعتبار، ومنطلقات تتشكل من خلالها تصوراتنا حول الفعل الأخلاقي، ليتم بعد ذلك الشروع في تصور الأخلاق الممكنة، التي تبحث في حيز متأخر، عن حيز المداخل الاربعة سالفة الذكر.
ما الأخلاق الممكنة؟
وعند الحديث عن (الأخلاق)، فإن الدلالة قد تنصرف إلى معانٍ متعدّدة: (القيم ومبادئها)، و(ما يندرج تحت تلك القيم من معايير)، ثم (الأفعال والتطبيقات العملية التي تجسّدها)، وفي هذا السياق، فإن ما نعنيه بالأخلاق الممكنة هو الأخلاق بوصفها أفعالاً تعبّر عن قيمها العليا ومبادئها المؤسِّسة، ويبدو أننا نستخدم مصطلح (الممكن) هنا في مقابل (الممتنع) و(المثالي) معًا، في نحوٍ من التوسّع أو التجوّز المعرفي.
الأخلاق الممكنة قد تُفهم، في إطار تصوري واسع، بوصفها نقيضًا للأخلاق المستحيلة أو الممتنعة، أو بوصفها بديلاً عن الأخلاق المثالية التي تتجاوز القدرة الواقعية للفرد والمجتمع، وبعيدًا عن التحديدات الفلسفية الصارمة، فإننا نتناول هنا مفهوم الأخلاق الممكنة ضمن أفق معرفي–ثقافي عام، لا في مستوى التخصص الفلسفي الدقيق.
وتنشأ الإشكالية عند طرح سؤال حول مدى إمكان تمثّل القيم الأخلاقية في الأفعال تمثّلاً تامًّا يُجلّي المبدأ والقيمة معًا:
هل يمكن للفعل الأخلاقي أن يُطابق المبدأ الأخلاقي أو القيمة العليا بصورة ثابتة ومطلقة؟
أم أن ثمة تباينًا في مستوى اتصاف الفعل بالمبدأ والقيمة تبعًا لظروف الفعل وفاعله؟
المشكلة الأخرى تكمن في أن الفكر الأخلاقي، عبر تاريخه، انشغل أساسًا بتحديد أسباب ودوافع اتصاف الفعل بصفة أخلاقية أو نفيها عنه، وتباينت المدارس الأخلاقية في بيان مناشئ تلك الصفة وشروطها ومقوماتها، وهذا التباين يُلقي بظلاله على وعي الفرد بسقف القيم والمبادئ التي يسعى إلى تمثلها في أفعاله، ويجعل الاستجابة الأخلاقية محكومة بمدى اتساع أو تضييق ذلك السقف، كما أن المجتمعات، في الغالب، تتأثر بهذه المحددات النظرية فتنعكس على سلوكها الجمعي ومعاييرها العملية.
(الأخلاق الممكنة) تعبير أقصد به للإشارة إلى النطاق الواقعي والمتحقق من المبادئ الأخلاقية التي يمكن للإنسان أو المجتمع الالتزام بها في ظل ظروفه وإمكاناته الفعلية، مقابل (الأخلاق في سقفها الأعلى) التي تمثل سقف القيم المطلوب، حتى لو كان تطبيقها كاملاً غير ممكن في الواقع.
وهنا يمكن تقرير أن تطبيق الأخلاق ليست منفصلا عن الظروف الاجتماعية، والقدرات البشرية، والموارد المتاحة، بل يُبنى على ما يمكن إنجازه فعلاً، مع الاحتفاظ بمثُل أعلى كمرجع وقدوة.
ويمكن افتراض بعض العناصر التي تحدد مستوى (إمكان الأخلاق) أو (الأخلاق الممكنة)، من خلال:
1. الواقعية الأخلاقية: الأخذ بعين الاعتبار حدود الإنسان الفردية والجماعية.
2. التدرج: الانتقال من الممكن إلى الممكن الأعلى بدل القفز مباشرة إلى المثال الكامل.
3. التوازن بين المبدأ والمصلحة: من خلال محاولة الجمع بين القيم العليا ومقتضيات الحياة الواقعية.
4. البعد الإنساني: من خلال جعل الخطاب الأخلاقي قابلا للتطبيق وليست مجرد تنظير.
جدلية العلاقة بين مرونة الفقه والاخلاق الممكنة
حاجة الفقه إلى الأخلاق، حاجة تفرضها طبيعة الفقه الذي يمس الحياة، والواقع العملي للإنسان، والفقه من دون الأخلاق، سوف يكون فقها جامدا جافا، لذلك، تمثل المنظومة الأخلاقية أحد أهم منطلقات وروافد التفكير الفقهي، فإذا كنا نتحدث بعيدا، عن مصادر التشريع، وأصول الفقه، فإن الأخلاق تمثل أرضية في (لا وعي) الفقيه، تبث في تفكيره عمق القيم الأخلاقية العليا التي نادى بها التشريع، وتجعلها أحد موجهّات تفكيره، ومن جهة أخرى تستفيد منظومة الأخلاق، من الفقه، من خلال أدوات الإجتهاد، ومرونة التفكير، وتيسر الوسائل التي تنظم أفعال الإنسان من خلال قواعد محددة وواضحة الملامح.
إذن في الخطاب الديني تتداخل المنظومات الفكرية، العقدية والاخلاقية والفقهية، ويمكن للفقه الاسلامي من خلال أدواته الاجتهادية أن يؤثر ويتفاعل جدليا مع الخطاب الأخلاقي، فتأثير التفكير الفقهي في فكرة (الأخلاق الممكنة) ممكن جدا، لأن الفقه بطبيعته يشتغل على الممكن والمقدور لا على المثال المجرد، فهو يربط التكليف بحدود الاستطاعة، ويراعي الظروف الواقعية للإنسان والمجتمع، ويمكن تصور ذلك من خلال الفروض الآتية:
1. تحديد سقف الواجب الأخلاقي بقدرة المكلف، والفقه أيضا لا يفرض تكليفًا فوق الطاقة، وهذا يجلعنا نتصور أن الفعل الأخلاقي يتحقق في إطار الإمكان الواقعي، فللو كان الوفاء بوعد أو التزام مالي يؤدي إلى ضرر بالغ أو عجز، يجيز الفقه تخفيف الحكم أو إسقاطه، وهذا يسوّغ فهم تطبيق الأخلاق ضمن الممكن.
2. مبدأ التدرج والتيسير، على فرض اقراره فقهيا، فكثير من الفقهاء يقرون التدرج في الأحكام؛ وهو مبدأ يجعل الأخلاق قابلة للتطبيق في سياق اجتماعي زمني متغير، فتشريع تحريم الخمر في الإسلام تم على مراحل، وهو ما يسوّغ أن الأخلاق الممكنة تتضمن عنصر التدرج في استيعاب الفعل الاجتماعي للقيمة الأخلاقية.
3. فقه الأولويات، الفقه يوجّه المكلف لاختيار الأهم عند تعارض المصالح أو القيم، ويحدد أولويات كثيرة في ميدان فقه النظم والتدبير، وهذا النمط من التفكير يتيح إنتاج أخلاق عملية مرنة وليست مثالية جامدة، فلو تعارض الصدق في موقف ما مع إنقاذ حياة إنسان بريء، يقدم الفقه حفظ النفس على التصريح بالحقيقة، وهذا يترجم (الممكن الأخلاقي) في الواقع.
4. الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الفقهية في أدنى مستويات مشروعيتها والعمل بها، تقارب ضرورة تعديل الخطاب الأخلاقي وفق الضرورة، فتتحول الأخلاق من نموذج صارم إلى نموذج مرن يتكيف مع الظروف الاستثنائية.
يمثل الإنسان في كلا المنظومتين الفقهية والأخلاقية، محورا رئيسا وهاما، تدور حوله النظريات والفرضيات بما يحقق نفعه وصلاحه، وبالنظر إلى محدودية قدرة الإنسان وفعله وطاقته، فإن كلا المنظومتين تراعيان حدود قدرة الإنسان على تحقيق مقاصد القيم الأخلاقية والقيم الدينية على حد سواء.
إن التمايز بين الحكم الفقهي والحكم الأخلاقي يكشف عن طبقات متعددة في تقييم الأفعال الإنسانية؛ فينطلق الفقه من معايير الضبط الشرعي لتحديد دائرة المباح والممنوع، ونجد أن بعض الأفعال وإن كانت جائزة فقهيًا، تظل أدنى من المستوى الأخلاقي الأمثل الذي تسعى القيم الإنسانية والدينية إلى تحقيقه، ومن هنا يمكن تصور مساحة (الأخلاق الممكنة)، بوصفها حيزًا سلوكيًا وسطًا؛ لا يخرق أحكام الشرع، ولا يبلغ المثل الأخلاقية العليا في الوقت نفسه، مما يتيح للمجتمع التعامل الواقعي مع تعقيدات الحياة دون الانفصال عن مرجعيته القيمية.
إن الأهمية اليوم لهذا الموضوع تكمن في ضرورة أن يعي الخطاب الديني هذا الجانب من الأخلاق الذي يتسم بمحاكاة واقعية لمحدودية الفعل البشري على تطبيق الأخلاق بنحو تام وكامل، وهذا ما يستدعي أيضا، أن نبدي بعض التقارب بين الأخلاق وآليات تطبيقها، من جهة، والفقه الإسلامي وأدواته المرنة، التي تستجيب لنسبية قدرة الإنسان على أداء التكاليف، فضلا عن مرونة الاستجابة لظروف الزمان والمكان.
***
د. أسعد عبد الرزاق الاسدي