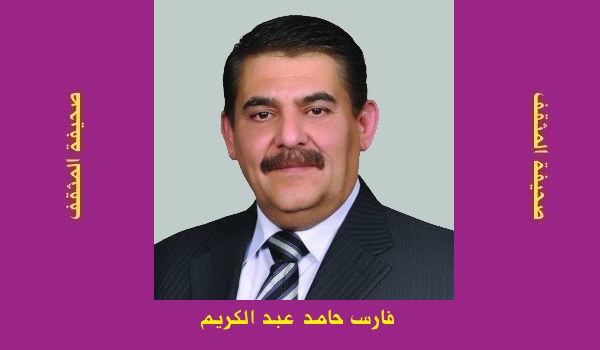قضايا
غالب المسعودي: النص المطرود في السرديات التاريخية

عندما يُستبعد نصٌ من السردية التاريخية أو الأدبية المقبولة، فإن هذا الاستبعاد غالبًا ما يكون نتيجة لعملية نقدية متعددة الاسباب يمكن أن تكون مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعدم وضوح النص، لغة النص غامضة جدًا، استخدم مصطلحات غير واضحا تقدم أحداثًا غير مترابطة، مما يجعل تفسيرها صعب للغاية وغير مُجدٍ .النص الذي لا يمكن دعمه بأي أدلة سواء كانت نصوصًا أخرى من نفس الحقبة أو أدلة أركيولوجية، يُنظر إليه بعين الشك خصوصا إذا كان النص يتعارض بشكل مباشر مع نصوص تاريخية أو أثرية أخرى موثوقة، إن هذا التناقض يُعد سببًا قويًا لاستبعاده، بعض النصوص. كما قد تُرفض بسبب خصائصها الكتابية غير المألوفة، مثل الأسلوب، أو عدم وجود بنية سردية منطقية، أو حتى شكل المخطوطة نفسها. المنهج العقلي يربط بين الكاتب والنص والسياق في منظومة متكاملة، النص الذي يبتعد عن سياق كاتبه، أو يُظهر عدم اتساق داخليًا، أو يتناقض مع أدلة أخرى، يكون من الصعب إدراجه ضمن السرديات المقبولة، ويعتبر استبعاده التاريخي دليلاً منطقيًا على وجود خلل أو عدم وضوح في النص الأصلي نفسه.
أمثلة على النصوص المطرودة تاريخيًا
الكتب المقدسة المحذوفة
الإنجيل الغنوصي، مثل إنجيل توما، الذي يعتبر نصًا غنوصيًا لم يتم تضمينه في الكتاب المقدس الرسمي. الإنجيل الغنوصي، مثل إنجيل توما
الأناجيل الغنوصية هي مجموعة من الكتابات التي ظهرت في القرون الأولى للمسيحية، وتتميز بتركيزها على المعرفة الروحية الباطنية ("غنوص") كوسيلة للخلاص. تختلف هذه الأناجيل عن الأناجيل القانونية في العهد الجديد
الفلسفة اليونانية
أعمال هيراقليطس، بعض النصوص التي كانت تُعتبر مهمة في الفلسفة لكنها فقدت أو لم تُحفظ بشكل جيد. هيراقليطس (حوالي 535 - 475 قبل الميلاد) كان فيلسوفًا يونانيًا قبل سقراط من أفسس في آسيا الصغرى. يُعرف بأسلوبه الغامض وكتاباته التي يغلب عليها طابع الحزن، ولهذا لُقب بالفيلسوف الباكي.
الأدب العربي
قصائد الجاهلية، هناك العديد من القصائد التي فقدت أو لم تُدوّن، مما يجعل من الصعب إعادة بناء الأدب الجاهلي بالكامل. أسباب فقدان الشعر الجاهلي
الرواية الشفوية: اعتمد الأدب الجاهلي بشكل كبير على الرواية الشفوية، حيث كان الشعراء يتناقلون القصائد والأخبار شفهيًا. هذا العرضة للتحريف والنسيان بمرور الوقت.
عدم التدوين المبكر: لم يبدأ تدوين الشعر الجاهلي إلا في فترة لاحقة، أي في العصر الإسلامي. هذا أدى إلى ضياع الكثير من الأشعار التي لم يتم تدوينها.
الظروف الاجتماعية والسياسية: الحروب والصراعات القبلية، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت مع ظهور الإسلام، ساهمت في فقدان بعض الأشعار.
انتقاء المدونات: عندما بدأ التدوين، كان يتم انتقاء الأشعار التي تُدوّن بناءً على معايير معينة، مثل الجودة أو الشهرة أو الفائدة اللغوية، هذا أدى إلى إهمال بعض الأشعار الأخرى.
التاريخ الإسلامي
مثل "تاريخ الطبري"، حيث توجد نصوص لم تُحفظ أو تم تحريفها عبر الزمن. تعتبر كتب التاريخ الإسلامي المبكر، مثل "تاريخ الرسل والملوك" للطبري، من أهم المصادر لفهم التاريخ الإسلامي، ولكنها لا تخلو من المشاكل المتعلقة بفقدان النصوص أو تحريفها عبر الزمن.
الأساطير
نصوص من الأساطير النوردية مثل بعض الملاحم التي فقدت أجزاء منها عبر الزمن، تعتبر الأساطير النوردية غنية بالقصص والملاحم التي تعود إلى العصور القديمة. إليك بعض النصوص الشهيرة والتي يُعتقد أن أجزاءً منها قد فقدت عبر الزمن:
إيدا الشعرية
إيدا النثرية أخرى قد تكون ضاعت
هذه النصوص تعكس كيف يمكن أن تتأثر المعلومات عبر الزمن، مما يؤدي إلى فقدان أو تحريف أجزاء منها.
النصوص واعادة الترميم
لا يعتبر هذا الأمر إعادة ترميم للنص بالمعنى الحرفي، ولا ينبغي أن يكون انحيازًا لتوجه جديد في التقييم. بل هو أقرب إلى إعادة قراءة نقدية أو تحقيق تاريخي. ترميم النص من ناحية متحفيه تعني التركيز على اعادةً إصلاح الأجزاء التالفة من المخطوطات أو استكمال الكلمات المفقودة لجعله قابلًا للقراءة. أما العملية المقصودة هنا، فهي تهدف إلى فهم سبب استبعاد النص تاريخيًا وتحليل أسباب عدم وضوحه من خلال السياق التاريخي والثقافي. هذا النوع من البحث هو جوهر النقد التاريخي، الذي يعيد النظر في النصوص المرفوضة أو المهمشة، إن فكرة أن النصوص قد تُرفض تاريخيًا بسبب تعارضها مع السلطة السياسية أو المرجعية الدينية السائدة، وهي فرضية مشروعة جدًا في البحث التاريخي. في هذه الحالات، لا يكون رفض النص بسبب عيوب داخلية (مثل التناقض أو عدم الوضوح) بل لأسباب خارجية مرتبطة بـ الأيديولوجيا السائدة، قد يتم تهميش نص لأنه يقدم وجهة نظر مخالفة للتيارات الفكرية أو العقائدية المهيمنة في عصره، المصالح السياسية يمكن أن تستبعد النصوص التي تنتقد الحكام أو النخبة الحاكمة، أو التي تدعو إلى تغييرات تهدد استقرار النظام السياسي، الخوف من التشويه، قد يُرفض النص ليس لأنه خاطئ، بل لأنه يمكن أن يُساء فهمه أو استخدامه بشكل يضر بالسلطة، الهدف من هذه المراجعة النقدية ليس تبرئة النص المرفوض، بل هو فهم تاريخي أعمق للسبب وراء رفضه. المنهج العلمي يتطلب من الباحث أن يكون موضوعيًا قدر الإمكان، وأن يميز بين عيوب النص الحقيقية (مثل التناقضات الداخلية) وبين الأسباب الخارجية التي أدت إلى إقصائه. هذا التمييز يساعد على إعادة بناء صورة أكثر دقة للماضي، وربما يكشف عن نصوص مهمة تم تجاهلها لأسباب غير علمية، خصوصا عندما لا تتوفر أدلة أركيولوجية لتأريخ نصٍ ما، يعتمد المنهج على مجموعة من الأدوات النقدية الداخلية التي تركز على النص نفسه وسياقه اللغوي والتاريخي.
النقد الداخلي
هو فحص دقيق لمحتوى النص لتحديد مدى صدقه واتساقه. يتم ذلك من خلال تحليل المفاهيم والمصطلحات، يتم فحص المفردات والمفاهيم المستخدمة في النص ومقارنتها بما هو معروف من نصوص أخرى من نفس الفترة أو الفترات المجاورة. مثلاً، استخدام مصطلحات حديثة في نص يُفترض أنه قديم يعد دليلاً قوياً على عدم أصالته، فحص المنطق الداخلي يبحث عن التناقضات في السرد أو الأفكار. هل الأحداث مترابطة منطقيًا؟ هل تتوافق الأوصاف مع الوقائع المعروفة عن تلك الفترة؟ النقد الخارجي يهدف إلى التحقق من مصدر النص وتاريخه من خلال الأدلة الخارجية المتاحة، حتى لو لم تكن أثرية. فحص السياق التاريخي للكاتب ومحاولة تحديد هوية الكاتب ومعرفة تفاصيل حياته وخلفيته الاجتماعية والثقافية. هل كان الكاتب معاصرًا للأحداث التي يصفها؟ هل كان لديه دافع لتزييف المعلومات؟ يتم مقارنة النص بالنصوص المعاصرة له أو التي تتحدث عن نفس الحقبة. هل هناك تشابه في الأسلوب أو الأفكار؟ هل يوجد إشارات إلى نفس الأحداث أو الشخصيات في نصوص موثوقة؟ هذا يساعد على وضع النص في إطاره الزمني الصحيح، التحليل اللغوي يركز على اللغة نفسها كأداة تأريخ. فلكل فترة تاريخية خصائص لغوية مميزة تتغير قواعد اللغة مع الزمن، لذا يمكن لمقارنة تراكيب الجمل وصيغ الكلمات أن يساعد في تحديد تاريخ تقريبي للنص، دراسة شكل الحروف والخط المستخدم، وهو ما يعرف بـ “علم الكتابة القديمة" أو "الباليوغرافيا". فكل فترة زمنية كان لها أسلوب خط مختلف، مزيج من هذه الأدوات التحليلية والنقدية التي تستخدم النص نفسه كـ “أثر" يُدرس، وتُقارن بأدلة نصية أخرى، مما يسمح للباحث بوضعه في سياقه التاريخي الأكثر ترجيحًا حتى في غياب الأدلة الأثرية المادية. في حالة عدم توفر نصوص موازية (سابقة أو لاحقة) للمقارنة، يصبح تأريخ النص تحديًا كبيرًا، لكنه ليس مستحيلاً. في هذه الحالة، يتحول التركيز بشكل كامل إلى تحليل النص ذاته وسياقه العام، معتمدين على منهج النقد اللغوي والتاريخي الداخلي، في حالة وجود تناقضات كبيرة بين سياق النص الأصلي والنصوص اللاحقة، لا يمكن اعتبار النص الأصلي "مشروعًا" ببساطة، بل يجب أن يخضع لدراسة نقدية دقيقة لفهم أسباب هذا التناقض. هذا التناقض ليس بالضرورة دليلاً على أن النص الأصلي غير صحيح، بل يمكن أن يكون مؤشرًا على عدة احتمالات مهمة في منهج البحث التاريخي، قد يكون النص الأصلي يعكس حقيقة تاريخية أو سياقًا اجتماعيًا لم يعد موجودًا في زمن كتابة النصوص اللاحقة. على سبيل المثال، قد يصف نص قديم نظامًا سياسيًا تغير لاحقًا، فتأتي النصوص التالية لتصف النظام الجديد، مما يُحدث تناقضًا ظاهريًا قد يكون النص الأصلي يعبر عن مرحلة سابقة من تطور فكري أو ديني، بينما تعكس النصوص اللاحقة تطورًا أو تغييرًا في تلك الأفكار. هذا يحدث كثيرًا في النصوص المقدسة أو الفلسفية، حيث يتم تعديل أو إعادة تفسير الأفكار الأصلية مع مرور الوقت، قد تكون النصوص اللاحقة قد خضعت لتعديل أو إعادة صياغة لتناسب مصالح السلطة السياسية أو الأيديولوجية السائدة. في هذه الحالة، يمكن أن يكون النص الأصلي هو الأكثر صدقًا، بينما النصوص اللاحقة هي نتاج لتغيير متعمد، قد يكون النص الأصلي نفسه يحتوي على أخطاء تاريخية أو يكون مزيفًا، مما يجعله يتناقض مع النصوص الموثوقة التي جاءت بعده.
الابداع في النصوص اللاحقة
تدعي بعض النصوص اللاحقة أن فيها إبداعًا أعلى من النص الأصلي، لذا يجب على الباحث أن يتعامل مع هذا الادعاء بحذر شديد، وألا يأخذه على أنه حقيقة مطلقة. فادعاء التفوق ليس دليلًا على صحته، بل هو جزء من النص اللاحق نفسه، يجب تحليله وفهم دوافعه في هذه الحالة، يتحول الاهتمام من مجرد مقارنة الجودة الفنية إلى دراسة السياق الأيديولوجي والفكري الذي دفع كتاب النصوص اللاحقة إلى الإدلاء بهذا الادعاء، يمكن أن يكون الادعاء بالتفوق الفني في النصوص اللاحقة نابعًا من عدة أسباب، لا علاقة لها بالضرورة بالجودة الفنية الفعلية للنص الأصلي، قد يكون الهدف من النص اللاحق هو إثبات أن له سلطة جديدة أو أنه يمثل مرحلة أعلى من الحقيقة أو الفهم. في هذه الحالة، يكون التقليل من شأن النص الأصلي أو وصفه بأنه "أقل تطورًا" وسيلة لترسيخ مكانة النص الجديد قد يكون المعيار الفني الذي يقيس به كتاب النصوص اللاحقة "التطور" يختلف كليًا عن المعايير التي كانت سائدة عند كتابة النص الأصلي. على سبيل المثال، قد يعتبر نص متأخر أن الوضوح والواقعية هي ذروة الفن، بينما كان النص الأصلي يركز على الرمزية والغموض، يكون هذا الادعاء محاولة لقطع الصلة مع التراث القديم وتأسيس هوية فنية أو فكرية مستقلة. هذا يحدث عادةً في فترات التجديد أو الانفصال عن التقليد القديم.
***
غالب المسعودي