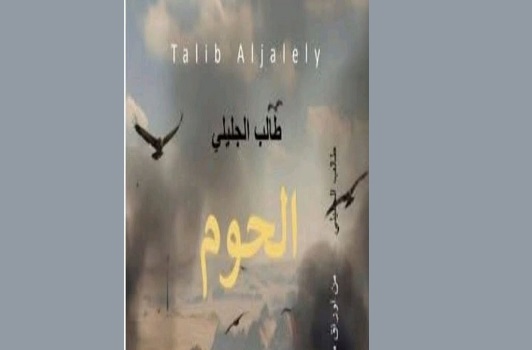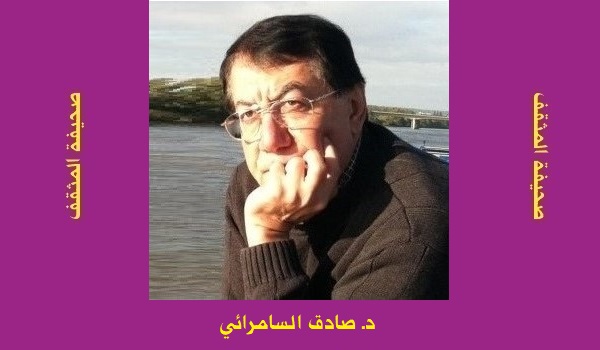قضايا
علي عمرون: اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

من أجل عولمة عادلة
(ليس في الليل نجوم، وأنْ لا شيءَ سوى خفافيشَ وأبوامٍ والقمر المجنون؟)... فريدريك نيتشه
يبدو اليوم ان سخرية نيتشه ونقده للطبيعة البشرية ورؤيتَه المرعبة للمستقبل قبيل بداية القرن العشرين قد أضحت واقعا ملموسا بداية من الحرب العالمية الأولى والثانية ووصولا الى المجازر الجماعية في غزة وارتفاع معدّلات الفقر العالمي مما يستلزم كما يقول جوناثان غلوڤر النظرَ بقوةٍ ووضوح إلى بعض الوحوش التي بداخلنا، والنظرَ في طرق ووسائل حبسها وترويضها لاسيما في عصرنا هذا الذي يشهد يتما سياسيا وثقافيا.
وعلى الرغم من انه يتم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام. وتذكير الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007 الى الحاجة إلى بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا وحث جميع الجهود لمكافحة البطالة والاستبعاد الاجتماعي والفقر الا ان هناك فجوة بين ما هو مأمول وما هو واقع بالفعل. مما يدفعنا الى ترديد قول (بورك):" أن العدالةَ ليست مسألةَ تفكير على الإطلاق؛ بل مسألة أن تكونَ لدى المرء حساسيةٌ مناسبة وأنفٌ صحيح يشتَمُّ به الظلم" ولا نجافي الصواب إذا افترضنا أنَّ الباريسيين ما كانوا ليقتحموا الباستيّ وغاندي ما كان ليواجهَ الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، ومارتن لوثر كينغ ما كان ليكافحَ سيادةَ العرق الأبيض في ‘أرض الأحرار ووطن الشجعان، وثوار الجزائر الاحرار ما كان لهم ان يقفوا في وجه فرنسا الاستعمارية لولا إحساسهم بالمظالم الواضحة التي يمكن رفعُها. لم يكونوا يحاولون التوصلَ إلى عالمٍ من العدالة الكاملة (حتى لو كان هناك اتفاق حول ما سيكون هذا العالَم)، لكنهم أرادوا أن يرفعوا المظالم الواضحة بالقدر الذي يستطيعون. وبهذا المعنى أيضا يمكن فهم القول المأثور لعمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا " فهي صرخة كل عادل اوليس العدل أساس الملك.
الفلسفة الكلاسيكية ومشكلة العدالة الاجتماعية بين التفاوت والمساواة
تعتبر الثورة من منظور الفكر الفلسفي محاولة لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا ، إنها رفض لكل أشكال الظلم والاستبداد، والبشرية حاولت منذ القديم من خلال الثورات المختلفة التحرر من قيود الطغيان والظلم في محاولة لبناء مجتمع مدني متحضر على أسس العدالة الاجتماعية باعتبار ان العدل قيمة أخلاقية سامية، وهو من اعم الفضائل الأخلاقية التي اهتم بها الفلاسفة ورجال الدين والقانون وهي يعني لغويا الاستقامة والمساواة ونقيضه الظلم وقد عرفه الجرجاني بقوله « العدل هو الامر المتوسط فلا افراط ولا تفريط » ولكن هل يعني هذا ان كل تفاوت ظلم وكل مساواة عادلة؟
هناك من الفلاسفة ورجال الفكر والعلم من رأى بأن العدالة الاجتماعية يكمن شرطها في إحترام التفاوت بين الناس وقصدوا بذلك التفاوت في التركيبة العضوية والقدرات العقلية والأدوار الاجتماعية حيث ان هناك تفاوت بين الناس في قدراتهم ومختلف مجالات الحياة ،و التفاوت نوعان: التفاوت الطبيعي، وهو راجع لفروق فردية بين الناس في قدراتهم العقلية؛ مثل الذكي، والضعيف عقليا، القوي الذاكرة، وضعيف الذاكرة ومواهبهم الجسمية: القوي جسديا، والضعيف بدنيا . والتفاوت الاجتماعي: وهو راجع لفروق بين الناس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الرئيس والمرؤوس، العالم والجاهل، رب العمل والعامل، تعود هذه الأطروحة إلى "أفلاطون" الذي حاول رسم معالم المجتمع العادل من خلال فكرة التفاوت الطبقي واعتبر المجتمع العادل هو الذي يحكمه الفلاسفة فالفلاسفة أولاً ثم الجنود وأخيرا طبقة العبيد، وقال في كتابه [الجمهورية]{يتحقق العدل في المجتمع عندما تقوم كل طبقة بالأدوار المنوطة بها والمتناسبة مع مواهبها} ومثل ذلك كمثل قوى النفس فالقوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على القوة الغضبية والشهوانية. وفي العصر الحديث نظر الجراح الفرنسي "ألكسيس كاريل" إلى العدالة الاجتماعية من منظور علمي حيث رأى أن النظام الطبيعي مبني على فكرة الطبقات البيولوجية وهي ضرورية لخلق توازن غذائي وتوازن بيئي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يحترم التفاوت قال في كتابه[الإنسان ذلك المجهول] {في الأصل ولد الرقيق رقيقا والسادة سادة حقا واليوم يجب ألا يبقى الضعفاء صناعيا في مراكز الثروة والقوة . . . لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية}وحجته ان هذا النظام يسمح لأصحاب المواهب من الارتقاء في السلّم الاجتماعي سواء الذين يمتلكون القدرات البدنية أو العقلية، وهذه الأفكار سرعان ما تجسدت عند أصحاب النزعة الليبرالية حيث أن المجتمع الرأسمالي يتكون من ثلاث طبقات (طبقة تملك وسائل الإنتاج ويوكلون استعمالها للأجراء، وطبقة تستخدم هذه الوسائل بنفسها، وطبقة الأجراء) وفي تفسير ذلك قال "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم]{المصلحة العامة متضمنة في المصلحة العامة والتنافس شرط العدالة الاجتماعية} واستقراء التاريخ يؤكد أن كثيرا من الشعوب قامت على فكرة الطبقية مثل الشعب اليهودي الذي يعتقد أنه شعب الله المختار وعندهم لا يعقل أن يتساوى اليهودي في الحقوق مع بقية البشر أما في الفلسفة المعاصرة، فقد أكد الفيلسوف الألماني نيتشه بأن التفاوت قائم بين الناس، حيث قسم المجتمع إلى طبقتين، وهما طبقة الأسياد وطبقة العبيد، وللأسياد الملكية والحكم للعبيد واجب الطاعة والاحترام وخدمة الأسياد.
وفي المقابل هناك من اكد على أن العدل يكمن جوهره في احترام مبدأ المساواة بين الناس وشعارهم أن المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية وبهذا المعنى يصبح كل تفاوت ظلم وكل مساواة عادلة ويبرر أصحاب هذه الاطروحة موقفهم بجملة من الحجج منها أن الأفراد بحكم ميلادهم تجمعهم قواسم مشتركة كالحواس والعقل والقدرة على التعلم وهذا ما اكد عليه الخطيب الروماني "شيشرون": الناس سواء وليس شيئا أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان، لنا جميعا عقل ولنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلّم} وفي الفكر الإسلامي رأى "محمد اليعقوبي " في كتابه [الوجيز في الفلسفة] أن مفهوم الفلسفة مصدره الشريعة الإسلامية لأن الجميع يتساوى في الأصل والمصير، "قال تعالى" {يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} ومن الذين رفضوا التفاوت ودافعوا عن المساواة الفيلسوف "برودون" الذي رأى أن مصدر الحقوق هو الجهد وليس التفاوت الوراثي فقال: {هناك على ضرورية لا مفرّ منها في التفاوت الجسمي والعقلي بين الناس فلا يمكن للمجتمع ولا للضمير الحدّ منها، لكن من أين لهذا التفاوت المحتوم أن يتحوّل إلى عنوان النبل بالنسبة للبعض والدناءة للبعض الآخر}. هذه الأفكار تجسّدت عند أصحاب المذهب الاشتراكي من خلال التركيز على فكرة [المساواة الاجتماعية] التي هي أساس العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "فلاديمير لينين" من برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي {الاشتراكية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامة لوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين أفراد المجتمع}
والواقع ان السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يشترط تحديد أسباب الظلم من أجل رسم معالم العدل وهذه حقيقة تحدّث عنها "أرسطو" قائلا {تنجم الخصومات عندما لا يحصلون أنا متساوون على حصص متساوية أو يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية} من هذا المنطلق لا بد من الاعتماد على[معيار تكافؤ الفرص] وكذا [الاستحقاق والمكافأة] وفق شروط اقتصادية حيث توزع الثروات بين الناس (العدل في التوزيع) وشروط قانونية وفيها تُسنّ قوانين تضمن السكينة والأمن للجميع وهذا ما أكد عليه المفكر زكي نجيب محمود عندما قال انه ينبغي ان يكون لكل مجال من مجالات الحياة أساسه ففي مجال القانون والقضاء لابد من احترام مبدأ المساواة اما في مجال التعليم والمناصب لابد للعدل ان يكون مبصرا ويميز بين من يستحق ومن لا يستحق .
من الإحساس بالظلم الى بناء مؤسسات عادلة
في كتابه فكرة العدالة أشار امارتيا سن أشار الى انه قد حاول الذين كتبوا في العدالة، على مدى مئات السنين، في مختلف أرجاء العالم، تقديمَ أساسٍ فكري للانتقال من الإحساس العام بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيقِ له، ومن ثم إلى تحليل طرق إعلاء العدل. ولتقاليد التفكير في العدل والظلم تاريخٌ طويل – ومدهش – في العالم أجمع، يمكن أن نقتبسَ منه آثاراً مضيئة للتفكير في العدالة ومنها نظرية العقد الاجتماعي ويدور ‘العقد الاجتماعي، الافتراضي، المُفتَرَض أنه يُختار [بالاتفاق]، كما هو معروف حول بديلٍ مثالي للفوضى لولاه لسادت هذه المجتمع، ولَمَّا كانت أبرزُ العقود الاجتماعية التي نوقشت تتعلق باختيار المؤسسات. فقد كانت النتيجة النهائية أنْ ظهرت نظرياتٌ في العدالة تُعنى في المقام الأول بالتحديد المافوقي لمؤسساتٍ مثالية.
وبعكس المؤسسية المافوقية، يتخذ عددٌ من منظّري عصر التنوير الآخرين مقارباتٍ نسبيةً متنوعةً تُعنى بالواقع الاجتماعي (الناتج عن المؤسسات الفعلية، والسلوك الفعلي، وغيرِ ذلك من مؤثرات). يمكن أن نجدَ أشكالاً مختلفة للفكر المقارن، مثلاً، في أعمال آدم سميث، والمركيز دو كوندورسيه، وجيريمي بنتام، وماري وولستونكرافت، وكارل ماركس، وجون ستيوارت ميل، بين عددٍ من قادة الفكر التجديدي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبالرغم من أن هؤلاء الكتَّاب، بآرائهم المختلفة جداً لمتطلبات العدالة، اقترحوا طرقاً متباينةً كلَ التباين في مقارناتهم الاجتماعية، يمكن القول، بقليلٍ من المبالغة، إنهم كانوا كلهم يقارنون مجتمعاتٍ موجودةً أصلاً أو يمكن أن تنبثقَ عملياً، بدل الاقتصار على التحليل في بحثهم المافوقي عن المجتمع العادل تماماً.
بدعوى هوبس – وراولز – أننا نحتاج إلى دولةٍ ذات سيادة لتطبيق مبادئ العدالة من خلال اختيار مجموعةٍ مثالية من المؤسسات: وهذا انعكاسٌ مباشر لأخذ مسائل العدالة في إطار المؤسسية المافوقية. وسوف تتطلب العدالةُ العالميةُ الكاملة، من خلال مجموعةٍ من المؤسسات العادلة تماماً، إنْ أمكنَ إيجادُ هكذا شيء، حتماً دولةً عالمية ذاتَ سيادة، وفي غياب مثل هذه الدولة، تبدو مسائلُ العدالة العالمية للمافوقيين غيرَ واردة.
العدالة كإنصاف
من توماس هوبس في القرن السابع عشر، ثم من جون لوك وجان-جاك روسو وعمانويل كانط، بين آخرين. كانت المقاربة العقد-اجتماعية هي المهيمنة في الفلسفة السياسية المعاصرة، لاسيما منذ أن طَلَعَ جون راولز بمقالته الرائدة (‘العدالة بصفتها إنصافاً،،Justice as Fairness،) سنة 1958 التي سبقت كلمتَه النهائية في تلك المقاربة في كتابه الكلاسيكي نظرية في العدالة .
عمل جون راولز على طرح سؤال العدالة الاجتماعية لاسيما في كتابه A Theory of Justice الصادر عام 1971 والذي تُرجم إلى اثنتي عشرة لغة. وفي نظره لكي يكون الشيء عادلاً، لا يمكن استغلال أي شخص أو إجباره على الخضوع للمطالبات التي تبدو غير شرعية. مبادئ العدالة من وجهة نظره ، مبادئ عامة وعالمية ،. لكن بمرور الوقت، استخدمها نقاد النظرية فقط كمعيار لدراسة وقياس المجتمعات الديمقراطية، قائلين إن المجتمعات ذات الهيكل الديمقراطي فقط هي التي يمكن قياسها من خلال هذه المبادئ. لبناء مجتمع عادل يعرّف رولز العدالة في المقام الأول على أنها العدالة الإجرائية لم يرغب رولز في أن تُفهم نظريته على أنها دليل عملي للإصلاح، بل كغذاء للفكر حول مبادئ مثل هذا الإصلاح.
تساءل في كتابه العدالة كإنصاف: عندما ننظر الى المجتمع الديمقراطي نظرة تعتبره نظاما منصفا من التعاون الاجتماعي بين مواطنين معتبرين أحرارا وتساوين نسال ما المبادئ التي تلائمه اكثر من سواها؟ ويقتضي هذا التساؤل التفكير في تطبيق العدالة الاجتماعية بطريقة عملية وهذا الامر مشروط بتقاطع وتوافق المؤسسات السياسية مع المؤسسات الاجتماعية وكيف تجتمع وتتناسق وتتكامل انطلاقا من منظومة أخلاقية ،صحيح ان السلطة السياسية هي دائما سلطة اكراهية الا انها سلطة مواطنين يفرضونها على انفسهم مواطنين احرارا ومتساوين وقد أشار الى ذلك جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي قائلا : " ان القابضين على السلطة التنفيذية ليسوا اسياد الشعب بل هم موظفوه او خدامه ..ان الشعب يقدر ان يعينهم وان يقيلهم كما يشاء " وهكذا المجتمع الحسن التنظيم هو المجتمع الذي ينظمه وبكفاءة مفهوم سياسي للعدالة وذلك بوجود قضاء مستقل وتحديد قانوني للملكية وبناء الاسرة للوصول الى العدالة الأخلاقية من خلال قوتين أخلاقتين هما الشعور بالعدالة كالتزام والزام أخلاقي والقدرة على الارتقاء الى الخيرية وهنا يظهر البيان الأولي لمبادئ راولز للعدالة كما يلي:
المبدأ الأول: لكل فرد الحق في الحصول على أعلى الحريات المتوافقة مع نفس الحريات مثل الآخرين. معنى المبدأ الأول هو أن الحرية الأساسية كحق عالمي يجب أن يتمتع بها الجميع ويمكنهم استخدامها على قدم المساواة. يسبق مبدأ الحرية (المبدأ الأول) مبدأ المساواة (المبدأ الثاني) ، وهذا هو الحال دائمًا. لذلك إذا كان لمبدأ الحرية أن يتغير، فلن تقيد الحرية إلا الحرية. هذا يعني أنه، على سبيل المثال، إذا كان هناك تعارض بين حريتين، فسيتم النظر في الحرية التي ستفيد العدد الأكبر من الناس. تنبع هذه الأسبقية من سببين: أ) حكمة الناس الذين اختاروا هذين المبدأين كمعيارين لعدالة البنية الاجتماعية ومحتواها ، وب) مبدأ الترتيب الأبجدي والأولوية
المبدأ الثاني : يجب تنظيم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة: أ) بشكل معقول يعود بالفائدة على الجميع. ب) تعتمد على الوظائف والوظائف التي يمكن للجميع الوصول إليها ويستخدم جون راولز في نظريته للعدالة هذين المعيارين لقياس عدالة أو عدم عدالة مؤسسات المجتمع المختلفة مثل النظام السياسي ، والهيكل الاقتصادي ، والدساتير ، ونظام التعليم ، وملكية الموارد الاقتصادية ووسائل الإنتاج ، والقضاء والمؤسسات الأخرى تعتبر المجتمع مهمًا وأساسيًا.
ولتمكين المواطنين من التطور بما فيه الكفاية وترسيخ البعد الأخلاقي للعدالة لابد من تحديد المنافع الأولية التي يحتاجها ويطلبها الأشخاص باعتبارهم أحرارا ومتساوين هنا تظهر الحاجة الى التمييز بين أنواع خمسة من المنافع[6]:
01- الحقوق والحريات الأساسية: حرية التفكير وحرية الضمير وغيرها للتطور الكافي عبر مؤسسات ديمقراطية
02- حرية الحركة وحرية اختيار الوظيفة من بين فرص متنوعة تسمح بالنضال لغيات مختلفة وفق مبدأ تكافؤ الفرص
03- إمكانية الارتقاء وبلوغ مراكز السلطة والمسؤولية والتمتع بقوى وامتيازات هذه الوظائف
04- المدخول والثروة كوسائل لبلوغ هذه الأهداف
05- الأسس الاجتماعية لاحترام الذات.
لا يمكن الفصل بين حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ستحتفل منظمة العمل الدولية بهذه المناسبة هذا العام بسلسلة من خمسة فعاليات ستعقد في المدن الكبرى حول العالم. ستجمع الأحداث متحدثين رفيعي المستوى من جميع أنحاء عالم العمل لمناقشة كيفية وضع العدالة الاجتماعية في صميم جداول أعمال السياسات الدولية والوطنية والإقليمية. حيث أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "تنحرف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المترسّخة في حقوق الإنسان، عن مسارها. كما أنّ معدّلات الفقر العالمي ارتفعت لأول مرة منذ أكثر من عقدَيْن. إلاّ إنّ الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان يسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية والعوائق الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة والعدالة والاستدامة، من خلال منح الأولوية للاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
إن تعزيز التحول العادل نحو مستقبل مستدام يعني التأكد من أن توجهنا نحو اقتصادات منخفضة الكربون يعود نفعا للجميع، وبخاصة الفئات الأشد ضعفًا. ويتطلب ذلك نهجًا شاملاً يدمج الاستدامة البيئية مع العدالة الاجتماعية، ويضمن حصول العمال والسكان الأصليين والمجتمعات المهمشة على الدعم الذي يحتاجون إليه ببرامج إعادة التدريب، وإيجاد فرص العمل، وإتاحة تدابير حماية اجتماعية قوية. وبعبارة أخرى، يجب أن تسير جهود إزالة الكربون والتحول الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع السياسات التي تحارب الفقر وتحد من التفاوت وتفتح الفرص للجميع. وفقًا لتورك، "يضمن الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن تسترشد نماذج الأعمال والسياسات الاقتصادية بمعايير حقوق الإنسان، كما يتيح مزيجًا متكاملًا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية الموجهّة نحو البعثات، تنهض بكل هدف وغاية من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك على وجه التحديد إنهاء التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات العرقية والإثنية واللغوية."
وأضاف تورك أنّ الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان يساهم أيضًا في تعزيز التوزيع العادل للموارد، ما يخفّف بدوره من عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها. وقال: "إن اقتصاد حقوق الإنسان هو اقتصاد يرسّخ الأهداف والأساليب الأساسية لحقوق الإنسان في كل سياسة وعملية صنع قرار، بما في ذلك ما يتعلّق بالضرائب والاستثمار وجميع قضايا تخصيص الموارد في الميزانيات الحكومية."
***
علي عمرون – تخصص فلسفة