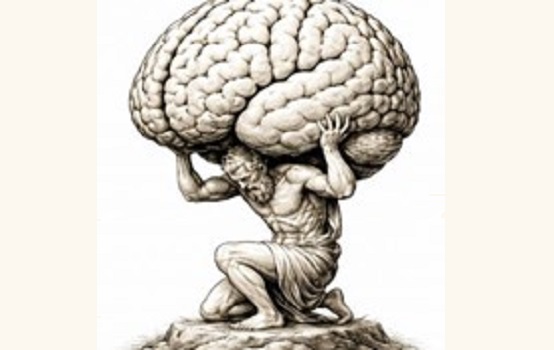قضايا
معمر بن علي التوبي: فلسفةُ العيدِ بين المقاصد والمتغيرات

يُقْبِلُ عيدُ الأضحى في عامه هذا والمجتمعات العربية -بشكل خاص- ترزح تحت وطأة الحرب والظلم والإجرام مثل الذي نشهده منذ عدة شهور في غزة الفلسطينية والسودان، ولا نعرف أيَّ طعمٍ سيتذوقُ أهلُ هذه المناطق مع عيدٍ يفترض أنّه يحمل في طياته السعادة والفرح وفقا لأبجديات العيد وفلسفته، ولا نملك حقَ دفع الجميع إلى محاكاة السعادة واصطناعها في ظل ظروف لا تلامس كرامة الإنسان ولا تحمي حياته وأساسياتها، إلا أننا بدافع من إدراكنا لفلسفة العيد ومقاصده العميقة نسعى إلى مقاومة هذه الظروف وبشاعتها، وهذا ما يمكن أن يصنع امتزاجا بين الفرح الذي يجسّده العيدُ في النفوس وبين الأسى الجاثم على صدور المظلومين الواقعين تحت وطأة الحروب وقسوتها، وشهدنا مثل هذا الامتزاج في عيد الفطر المنصرم في وجوه أهل غزة وإن كان ما يصلنا عبر الشاشات والأخبار لا يعكس واقعا مطلقا بل يفتح نافذةً ترينا شيئا يسيرا من الواقع. بعيدا عن الحروب ومآسيها، كذلك يأتي العيد في زمن الطفرة الرقمية التي أحدثت تغييرات في بعض ملامح العيد ومقاصده خصوصا في الزوايا الاجتماعية، وهذا ما سنعدّه أيضا متغيرات تقتحم ممارستنا الاجتماعية والمجتمعية في الأعياد.
لا أريد التحدث في هذا المضمار المتعلق بالعيد وفلسفته من منطلقات الرأي الآخر عبر كشف ما يقوله الباحثون والمهتمون بالشأن الديني والثقافي والفلسفي والاجتماعي، بل أتناول حديثا ينطلق من منطلقات ذاتية تعكس الرأي الشخصي لأستوضح بواسطتها ما يمكن أن يكون في دائرة الظن اليقيني -من حيث نسبيته الذاتية-. تؤكد مداركنا الواعية بأن للعيد فلسفته الخاصة من منطلقات المقاصد الكثيرة التي تفيض منه سواء الدينية "التعبديّة" أو الاجتماعية أو النفسية، ويتكيّف إدراكنا هذا من منطق العادة التي يمكن أن نقول أنها من مفرزات جيناتنا الوراثية التي جُبلت غريزةً على توظيف السعادة الجمعية التي تتفق على حصولها وممارستها الأديانُ أو الثقافاتُ، وعيدنا في الإسلام له جذوره التعبديّة التي تنطلق من مبادئ التقرّب إلى الله، ولهذا نجد أن ما يميّز عيد الأضحى اقترانه بموسم الحج الذي يجسّد الاجتماع الإنساني الكبير حيث تنتفي كل أشكال التباينات الإنسانية المتعلقة بالمال والمناصب والمستويات الاجتماعية؛ فالجميع سواسية يؤدون شعائر الحج وفق فلسفة تتبنى أعلى معايير الأخلاق وضوابطها، وتتجلى صورة الحجاج بملابس إحرامهم البيضاء؛ فترسّخ معنى أن تكون فردا سويا يقصد القرب من الله ويمارس شعائر الحج التي تعبّر عن الانسجام الجماعي ونظامه، وبمجرد أن تنقضي هذه الأركان تفيض القلوب رغبةً في نيل الثواب والقبول؛ فينعكس السرور في قلب الحاج بعد إتمامه لهذا الفرض العظيم، وينعكس معه السرور في قلب كل مسلم يعيش لحظات هذه الأيام المباركة في كل بقاع الأرض، وتُترجمُ هذه المشاعرُ إلى ممارسات تعكس سعادة الإنسان، وهذا ما يأتي في صورة العيد ومقاصده الاجتماعية وقبلها النفسية التي تجد لها متنفّسا من ضوضاء الحياة ومشكلاتها؛ فنجد مظاهر البهجة في أشكالها المتنوعة التي وإن تباينت بين مجتمع ومجتمع آخر إلا أنها تحمل المقاصد نفسها التي تحاول أن تسلكَ بالنفسِ مرتبةَ الطهارةِ والسلام والسكينة حيثُ يكون للألفة المجتمعية تحقُّقٌ، ولجبر الخواطر والرحمة والإحسان نصيبٌ خاصٌّ لا يشعر فيه الفقير بالضعف، ولا يملك الغني فيه شعورا بالمنّة والكلفة؛ فالجميع يسعى إلى تحقيق مقاصد العيد، وهنا تتضح ملامح الفلسفة الأخلاقية الصُلبة المرتبطة بالإيمان.
في ظل وجود هذه المقاصد -التي لا نملك بدًا إلا بإقرارها وممارستها- نقبع أحيانا تحت تأثير الظروف المحيطة التي تحيل بيننا وبين تحقيق هذه المقاصد والتفاعل مع حيثياتها، ولا أجد أقسى من ظروف الحرب الإجرامية التي يشنّها الكيان الصهيوني على أهل غزة وما تحمله من مشاهدَ تسيل من هَوْلِها الدموع حزنًا وألمًا، وهنا نرى ظرفية المتغيرات التي تحاول أن تخترقَ جزئيات العيد وتزعزعَ مقاصده السامية، ونرى مدى التأثير الذي يمكن أن تلحقه هذه المتغيرات بالجانب النفسي الذي يعكس قدرة الإنسان على تجاوز كل ما يحيط به من ظروف قاسية، ويتفاعل مع مظاهر العيد بما يملكه من مشاعر دفينة تتعلق بالعيد وفلسفته العميقه، والتوازن بين وقع الألم وظرفية الفرح أمرٌ يصعب تحقيقه في غالب الأحيان، ونتذكر في هذا المعرض ما فاضت به قريحة المتنبي الذي حاول أن يجد للعيد ملاذًا يفرُّ به من ظروفٍ يعيشها، إلا أن للظروف غلبةً أحالت بينه وبين تحقق مقاصد العيد؛ فعبّر عن ذلك بقوله: عيدٌ بأيَّة حال عدتَ يا عيدُ … بما مضى أم بأمرٍ فيكَ تجديدُ. تظل هناك محطة في العيد وفلسفته -حتى وإن ضاقت بظروف الحياة- تُؤْثرُ بقاءَ الأملِ الذي يأتي في صوره المناسبة، وفي ظروف الحرب الغاشمة يأتي في صورة النصر القريب الذي باتت معالمه واضحة تُنْبي بقيام دولة فلسطينية مستقلة وهزيمة للكيان الصهيوني الذي لم يجدْ له قبولًا في العالم أجمع.
وفي زاوية أخرى، لا يمكن أن نرى العيد بمظاهر ثابتة لا متغيرة؛ فثقافة العيد تأخذ شكلها وفقا لمستجدات الزمان وتطوراته، ونحن في عصر رقمي -تتدافع فيه طفرات التقنيات الذكية بأنواعها المختلفة- من الممكن أن نتوجس خوفا من فقداننا لبعض ما نظنه ثقافة ثابتة للعيد غير قابلة للتغير؛ فأسلوب تفاعلاتنا الاجتماعية والمجتمعية في ظل أدوات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تأخذنا إلى اتخاذ صور أخرى لهذا التفاعل تتقلص فيه مظاهر الاجتماع واللقاءات والزيارات؛ فنعوّضها بالتواصل الرقمي الذي يفقدنا شيئا من قيمة العيد ومبتغاه -وإن واكب متغيرات العصر ومستجداته الرقمية-، إلا أن هذه الممارسات المستجدة تُكسب أفراد المجتمعات تأقلما مع واقع جديد -يستهجن البعض حدوثه-، ومع مرور الزمن يتحول إلى أسلوب حياة يعتاد الناس تقبّله، وهذا ديدن المخاضات التي تسبق دخول ثقافة جديدة لتحل محل ثقافة قديمة، وهنا لا نملك حق مقاومة حدوث هذه المتغيرات حال أنها لا تمس قيم المجتمعات العليا وأحدها القيم التي تتعلق بمقاصد العيد، وحينها لابد من الدفع بالوعي الذي يهدف إلى حماية المقاصد دون الإفراط في مقاومة المتغيرات، ولكن عبر منهجية التوازن.
***
د. معمر بن علي التوبي
أكاديمي وباحث عُماني