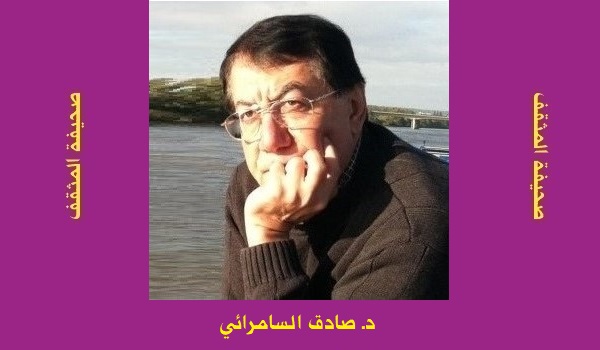قضايا
صالح الطائي: الإسقاط السيكولوجي الفقهي وثورة الدين

بسبب حالة الفوضى التي تعم وجودنا الإسلامي، أرى أن الباحثين الجادين المحايدين والعلماء المتخصصين يجب أن ينتقدوا ويفككوا ويدرسوا الإشكاليات المتعددة، ويقترحوا النتائج، وأن يضعوا ما يرونه صائبا من الحلول المستخلصة عن طريق البحث العلمي الرصين أمام الملأ دفاعا عن الإسلام ومن خلاله دفاعا عن الإنسان؛ فكلاهما صار لونه باهتا بسبب كثرة المماحكات الداخلية والخارجية، وعلى الإسلام المعاصر بجميع نسخه والمسلمين ألا يتطيروا من النقد البناء، لأننا على يقين تام أن موت الفكر النقدي العلمي المحايد الحر يُعدُّ من أكثر الأسباب التي تدفع البلدان والحضارات والأديان إلى التخلف أو الجمود والتأخر عن اللحاق بركب التحضر، وهي العوامل التي تتيح للانحياز المذهبي والطائفي قدرة التحكم في علاقات الفرق مع بعضها، وتدفعها للخوف من الآخر، والشعور بأنه منافس خطير وليس شريكا في الوجود وأخا في الإنسانية.
إذ لا ينكر أننا نعيش اليوم أزمة فكرية تحولت إلى إشكالية صعبة جعلت اللاهوت الديني/ السياسي، وأقصد به لاهوت الطوائف والمذاهب والفرق والجماعات والولاءات الفرعية التي ولدت بتأثير سياسي بحت هي الحاكم المتحكم بمصائر ديننا وحياة شعوبنا، في وقت يستنتج العاقل فيه أننا كمسلمين وديننا معنا بكل فرقه وطوائفه يمر بأخطر مرحلة تاريخية بعد أن وضَعَنا أعداؤنا شاخصا للتصويب، ولا ينتظر الرامي سوى اعتدال درجة الريح وتوافقها معه لكي يصوب علينا ويصيبنا في مقتل، بمعنى أننا نقف اليوم بعين الخطر، وهو خطر حقيقي يختلف عن جميع تلك المخاطر التي مرت بنا من قبل، وإذا لم نستعد رباطة جأشنا، ونعيد النظر بحساباتنا، ونبدأ بإعادة تقييم مسلماتنا العقدية الموروثة لغرض تنقيتها من كثير من الدرن الذي تلبَّسها تاريخيا ومرحلياً لأسباب قد لا يكون من بينها ولو سببا دينيا حقيقيا واحدا، فمن المؤكد أننا سنخسر الكثير، وربما نخسر كل شيء، وإذا كنا نحن الخاسرين، فسيخسر العالم معنا معناه وقيمته وإنسانيته، فنحمل وزرنا ووزر من تسببنا في خسارته يوم نقف أمام الله تعالى، ولا نملك عذرا نقدمه في دفاعنا عن أنفسنا.
ومن نافلة القول التذكير بأن ما حدث من قبل وما يحدث الآن كان تقصيرا، وأن هذا التقصير كان ممنهجا منذ ساعات ولادته الأولى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استثناء أحد من مغبة ما حصل، إذ لا زالت مدارسنا الفقهية ومذاهبنا وفرقنا منذ ساعات تأسيسها الأولى ولحد الآن تضع الأحكام الفقهية لتكون بالضد من الآخر، وتلقي اللوم على بعضها لتبرئ نفسها، رغم أنها جميعها اشتركت في جريمة تفريق الأمة، سواء عن قصد وتعمد، أو نتيجة التحيز الفرقي، أو جهلا، أو طيبة، أو تعبدا، وكل فرقة منها تدعي بأنها الكاملة والناجية؛ والعيب في غيرها، وهذا كله يقع ضمن إطار ما يعرف بالإسقاط السيكولوجي، وهو أن ينسب الإنسان ما به من عيوب إلى الآخرين، لكي يخفف من الضغط النفسي للمشاعر الحادة التي تسببها عوامل الإحساس بالنقص. وحتى من لم يمارس هذه اللعبة منهم، وأنَفَ أن ينحاز لأحد، نجده قد ترك الإيمان بثلاثة أرباع دينه، وأعتنق دين نظرية المؤامرة التي جعلته يشك حتى في نفسه، حتى لو كان على يقين تام أنها تعرقل إمكانيات العقل في الوصول إلى مراحل التفكير العلمي المثمر المنتج الجاد.
وبين هذا وذاك جاء كم الفتاوى المرعب ليلقي أكداسا من الوهم والتشتت والحيرة على عاتق المسلم البسيط الذي أجهد نفسه في ملاحقة مخرجات تلك الفتاوى المتشابكة دون أن يتمكن من استيعابها، بسبب كثرة تفرعاتها وتنوع آرائها وتعارض مناهجها، فالوقت الذي صرف على استنباط تلك القواعد والأحكام وكتابتها والتثقيف على مضامينها وترسيخها في الأذهان، لم يشغل العلماء وحدهم في أمور ثانوية، ويلهيهم عن متابعة الجوهر فحسب، بل حرم الأمة فرصة توظيف ذلك الوقت الثمين إيجابا، والإفادة من المعطيات المتحصلة من أجل التقدم والتحضر والتمدن أيضا، بدل أن تبقى الأمة مشتتة تحت رايات ـ يخيل إليَّ ـ أنها تحولت من رايات علم وإيمان إلى رايات يحمل صواريها جنود مهيؤون لخوض نزالات مميتة مع أبناء عمومتهم وإخوتهم ورفاق دربهم الإنساني بسبب التنافس لا أكثر.
والذي يدفعني مجبرا لمناقشة هكذا مواضيع جدالية مأزومة قد يراها بعضهم فجة، هو قول نيتشه: "يبدو لي أيضا أن الكلمة الأكثر فجاجة، والرسالة الأكثر خشونة، تظل أكثر فضلا وأكثر شرفا من الصمت. فأولئك الذين يركنون إلى الصمت هم الذين يفتقرون دوما إلى اللياقة وسماحة القلب". أقول هذا لأني أشعر بكمية حزن مهول حينما أسمع داخل البلد الواحد وربما داخل المدينة الواحدة أنماطا مختلفة من صور الأذان على سبيل المثال، بدل تلك الصورة البهية التي تدل على أنه صوت السماء وهبه الله تعالى للأرض، لكي تطمئن به النفوس التي تتهيأ للوقوف بين يدي الله تعالى ليعمها الاطمئنان والأمن والسلام.
وفي سعينا البسيط هذا نحاول التوصل إلى السر الذي جعل المسلمين يختلفون في هذه الشعيرة (الأذان) إلى درجة التشظي وصعوبة الالتقاء، لتكون اللبنة الأولى في مشروع الإصلاح المأمول، عسى أن نتمكن من تشخيص أثر خلافهم المستمر على وحدة الأمة وتقارب رؤاها. فنحن لا نقف اليوم أمام أعداء مؤدلجين للإسلام فحسب، بل نقف أمام ثقافة راسخة الجذور؛ لا تعترف بالرب الخالق، يتم الترويج لها على قدم وساق، نعم هي ليست بالفكرة الحديثة ولكن عمل بعض الفلاسفة الملحدين عليها حولها إلى مشروع ثقافي معاصر هدام يثابر على تغيير القناعات ويثبط الهمم، وكان فيورباخ أحد أشهر من عمل على هذا المشروع، ويمكن تلخيص رؤيته بأنه اعتقد "أن الله هو نتيجة لتجريد الإنسان من سمات الطبيعة البشرية فيه، فقد حاول البشر تحقيق مثلهم العليا، وصفات الكمال فيهم، ونظرا لعدم تحققها كاملة في كائنات بشرية محددة، ورغبة في تجسيد هذه المثل، خلقَ البشرُ اللهَ". فالله على رأي فيورباخ من صنائع البشر، وهذا مخالف لجميع الأديان السماوية والأديان الأخرى، وحتى للحضارات الإنسانية، وقد ترك أثره على الثقافة المسيحية بشكل مباشر، فغير الأعم الأغلب من قناعاتها العقائدية، ونجح في التأثير على بعض كبير المسلمين؛ الذين لا زالت أعدادهم تتزايد، وترك تأثيرا بدرجة أقل كثيرا على اليهود الذين ينمازون بقدرتهم على التمسك بموروثهم لا تدينا بل تعصبا قوميا.
المهم أن هذه الثقافة لا زالت تنمو وتتطور في الواقع الإسلامي لأنها وجدت بيئة صالحة أمدتها الفتاوى الكيدية بعوامل الرعاية، وأعتقد أنها ستضع الإسلام في المستقبل القريب أمام امتحان عسير إذا لم نتهيأ منذ الآن للتصدي لها من خلال تقليص جزئياتنا التعبدية والتركيز على القواعد الأساسية، وأهمها وحدة المسلمين في كل مكان، تلك الوحدة التي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا ما تخلينا عن ثقافة "الاختلاف رحمة"، هذه الثقافة سيئة الصيت، وأسسنا لثقافة "وحدة الكلمة رحمة". وهذه مسؤولية الجميع بلا استثناء، فكلنا مسؤولون وسنُسأل ولن تنفعنا أعذارنا، فلطالما تعللنا بأننا لم نكن في المكان المناسب، لكي نُظهر قدراتنا، ولطالما كانت هذه حججا نسوقها لنداري بها عجزنا وفشلنا، فالرجل الناجح برأيي هو من يشعر أنه تماما حيث يفترض أن يكون، وأن ما يقوم به، أو ينوي القيام به ليس أمرا تافها، بل هو جزء مهم جدا من مهمات تغيير العالم نحو الأفضل.
لقد منحنا الله تعالى طاقة كبيرة، وأوكل إلينا مهمة التصرف بها في فعل الخير أو فعل الشر، وأعطانا عقلا يميز أفعال تلك الطاقة لنمايز بين حسنها من قبيحها، وترك لنا حرية الاختيار، وعليه يجب أن تدرك أن هناك فرقا كبيراً بين أن توظف طاقتك للتدمير أو توظفها للتدبير والتعمير، ومن لا يميز بين الاثنين هو والحيوان الأبكم سواء. أما الذين يقفون بوجه حركة الإصلاح فمصيرهم الخذلان، لأنهم يحاولون الوقوف بوجه ثورية الدين، فالدين ثورة، وكل رسالة دينية تتخلى عن ثوريتها تفقد قيمتها، ومن يسهم في ضياع روح الثورة في الدين من أبنائه هم أعداؤه الحقيقيون، ويجب التصدي لهم بالعقل والمنطق والكلمة الطيبة قبل العدو ظاهر العداء، وأنا هنا لا أدعو للعنف، وإنما أعمل من أجل تصحيح الانحراف ونبذ العنف، وتعديل الميلان بالحكمة والعقل والمنطق والعلم، عسى أن يعود الذين ابتعدوا عن الأصل إلى الطريق القويم، ومن يرفض منهم الانصياع نتعاون لإصلاحه، لأن بقاء هؤلاء يجرد الأديان من ثوريتها، وفقدان الأديان لثوريتها يفقد الحياة قيمتها، ولا يمكن للدين أن يمارس الثورة إلا من خلال تجديد العقل الفقهي وإخراجه من مرحلة الإطلاق المنغلق المحاط بقدسنة سجن الموروث، ليؤمن عن قناعة ويقين أن الكثير من الأحكام، وكل ما يتعلق بها يخضع شئنا ذلك أم أبيناه إلى الظروف المحيطة، وأقصد بها الظروف الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وحتى سنن العادات والسلوك الفردي والجمعي، وبالتالي يخضع لكل التبدلات التي تقع.
وأعود وأذِّر بأن مخرجات الواقع الإسلامي المعاصر مجتمعيا وجغرافيا وسياسيا وضعت الدين في مرحلة حرجة وسطى بين القمة والعلياء؛ والسفح المتعرج المظلم، فإما أن يجد من يدفعه ليسقط في ظلمات التيه الأبدي، أو أن يشمر العقلاء المخلصون عن أياديهم ويشحذوا عقولهم لإحداث ثورة تصحيح ديني، تجعل للدين وهجا ينير درب الإنسانية المعذبة؛ التي ستشعر هي الأخرى بأنها جزء من هذا التغيير.
***
الدكتور صالح الطائي