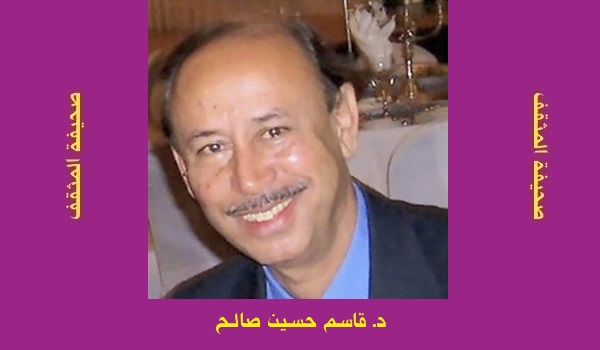آراء
مصطفى غلمان: ما بعد الحقيقة وما بعد الاستعمار

فلسطين في عيون ديفيد هيرست
رحيل الإعلامي والكاتب البريطاني الحر ديفيد هيرست في اليوم ذاته الذي اعترفت فيه الحكومة البريطانية بدولة فلسطين (أي ال22 من شتنبر 2025) ليس مجرد مصادفة زمنية، بل لحظة مشبعة بالدلالات التاريخية. فهنا تتقاطع ذاكرة الاستعمار البريطاني (من وعد بلفور إلى سياسات ما بعد الانتداب) مع تحولات الرأي العام الأوروبي في القرن الحادي والعشرين. ومن منظور سوسيولوجي، يمكن قراءة الحدث كجزء من مسارٍ أوسع يشهد انكسار السرديات الإمبريالية أمام ضغط الحركات الحقوقية الأوروبية وفقدان الخطاب الصهيوني لهيمنته المطلقة داخل الإعلام الغربي.
يمثل هيرست نموذجًا نادرًا للمثقف الأوروبي الذي تجاوز منطق “التعاطف الإنساني” إلى التضامن النقدي. فقد تشكّل وعيه في مدارس النخبة البريطانية، لكنه انجذب إلى الشرق الأوسط عبر تجربة بيروت الستينيات، حيث التقى بفلسطين كقضية تحرر كونية لا كملف “نزاع حدود”.
هذا التحول يجعله، في المخيال العربي، شبيهًا بأسماء كبرى مثل إدوارد سعيد أو جون بيرغر، جسرًا حضاريًا يربط الغرب النقدي بالشرق المقاوم، ويعيد طرح سؤال: لماذا تحتاج القضايا العربية دائمًا إلى “شهود غربيين” لتنال شرعية أخلاقية في المحافل الدولية؟
اعتمد هيرست على أرشفة دقيقة ووثائق أصلية، ما يمنح أعماله طابع المؤرخ لا الصحافي فحسب. في كتاب "البندقية وغصن الزيتون"، لا يكتفي بالسرد بل يفكك البنية الاستعمارية للصهيونية، رابطًا بين الاقتصاد السياسي للعنف وتاريخ الهجرة الاستيطانية. هذا النهج يتيح قراءة نصوصه في إطار مدرسة الحوليات الفرنسية (Annales) التي تمزج الاقتصاد والاجتماع والسياسة لفهم الظواهر التاريخية.
لم يكن هيرست يكتب في فراغ. فقد دخل في جدالات علنية مع مفكرين وصحافيين صهاينة وليبراليين غربيين كانوا يرون في المشروع الصهيوني ضرورة تاريخية أو “تعويضًا أخلاقيًا” عن الهولوكوست.
ففي مقالاته عن حرب العراق 2003، ناقش محللين من تيار “المحافظين الجدد” الأميركيين، كاشفًا عن التحالف بين اللوبي الصهيوني والمجمع الصناعي العسكري.
وفي حواراته أيضا مع بعض الأصوات العربية الناقدة لاتفاق أوسلو، أبدى تحفظًا على “إدارة الفشل الفلسطيني” من الداخل، مبرزًا أنه ينقد إسرائيل بلا مواربة، لكنه لا يعفي القيادات العربية من مسؤولياتها.
يمكن تناول هيرست في ضوء فلسفة العدالة العالمية كما بلورها جون رولز أو منظّرو “العدالة الكونية”، إذ تجسّد كتاباته قناعة بأن الحق الفلسطيني ليس مسألة تفاوض سياسي بل قيمة أخلاقية مطلقة. كما يحضر في أعماله أثر الفلسفة الوجودية في تشديده على المسؤولية الفردية للكاتب: أن يكتب الحقيقة حتى لو خالف قومه ودولته.
رغم الإجماع العربي على مناصرته، برزت أصوات اعتبرت أن هيرست، كابن للمؤسسة البريطانية، ظلّ أسيرًا لرؤية ليبرالية إصلاحية لا تصل إلى تبني القطيعة الكاملة مع النظام الدولي الذي ينتج الاستعمار. آخرون رأوا أن رهانه على “يقظة الضمير الأوروبي” يتجاهل حقائق القوة الصلبة. هذه القراءات النقدية تفتح الباب لدراسة كيف يتحوّل المثقف الغربي الداعم لفلسطين إلى موضوع مساءلة عربية أيضًا.
إن الجمع بين المنهج التاريخي والتحليل السوسيوثقافي والفلسفي يجعل من سيرة هيرست مختبرًا لفهم علاقة الغرب بفلسطين:
ـ كيف تطورت مواقف الرأي العام الأوروبي من 1967 إلى 2025؟
ـ ما أثر حركات المقاطعة الأكاديمية والثقافية (BDS) على إعادة تشكيل هذه المواقف؟
ـ وكيف يمكن توظيف إرث هيرست في بلورة خطاب فلسطيني-عالمي جديد يتجاوز ثنائية “المستعمِر/المستعمَر” نحو شراكة إنسانية على قاعدة العدالة؟
***
د مصـطـفــى غَـــلمـان*