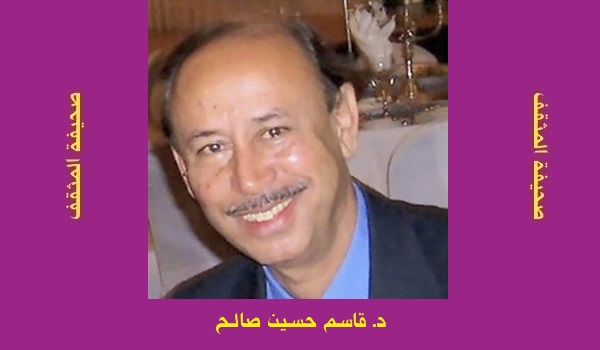آراء
عصمت نصّار: دروب الكذب وأشكاله وغرابيل الفلاسفة الناقدة (4)

إذا كان للفكر الغنوصي الأثر الأكبر على السياقات الأسطورية الأخلاقية المرغبة في الخير والصدق والمنفرة من الشر والكذب؛ فإننا سوف نحاول تفسير ذلك الترابط بين موطن النفس الأصلي قبل هبوطها من عالم المجرّدات من جهة، والعالم المحسوس والعقل البشري من جهة أخرى وذلك المتمثل في أن هناك قوة غيبية واحدة هي التي فطرت النفس الإنسانية وطبعتها بطابعها؛ فأصبحت النفس العاقلة الحالة في الجسد البشري تشتاق إلى ما كانت عليه في عالم الأخيار واللذائذ الروحيّة.
ولمَّا كان للثقافات السائدة في البيئات المختلفة أثر لا يمكن إغفاله على العقول والمشاعر والسلوك، فقد ساهمت تلك البيئات في تنمية ذلك العشق الفطري لعالم المُثل أو ساهمت في طمسه ومحوه بالتدريج من ذاكرة النفس العاقلة حتى أصبحت نفوس شيطانية في هيئات بشرية.
أمّا النفوس الراقية؛ فقد زاد تعلقها بعالم الربوبية والمُثل فأنتجت العقول الإنسانية حكايات وقصص وملاحم أسطوريّة تحمل ذكرياتها وتعكس أحلامها لتنمي في الأذهان عشقها لهذا العالم فترغبها في الصدق وترهبها من الكذب.
ولعلَّ هذا التفسير يتناسب مع الفكر الهندوسي الذي كان يعتقد وجود عالم للآلهة يرأسه (براهمان) الذي تدين إليه كل الموجودات بالانتماء وذلك بمقتضى القبس المقدّس الحي فيها، وهو المطبوع بطابع ذلك الاله المتفرد في وجوده غير أن الأنفس البشريّة انحرفت عن أصولها وتعلقت بالشهوات واللذات المادية فقام الحكماء (البراهمة) بتذكيرهم عن طريق الأساطير بأن هناك ثواب وعقاب للأنفس البشرية وهناك أيضًا دروب ونهوج للتوبة والخلاص من ذلك الدنس يبدأ بالتراتيل الصادقة لأعلان التوبة ثم الرياضات الروحيّة العازفة تمامًا عن الكذب أو عشق المادة أو الاعتداء على إحدى الموجودات التي تحوي قبسًا ربوبيًا حتى يتم الخلاص من عجلة الميلاد (وقانون الكارما وتناسخ الأرواح)؛ حيث ترتفع النفوس الراقية إلى عالم الربوبية (والنرفانا والاستنارة عند بوذا وتلاميذه أي السعادة الأبديّة)؛ وذلك نظير صدقها وإخلاصها في العبادة في حين تستنسخ النفوس الشريرة وتحل في أبدان موجودات أدنى (حيوانات شرسة أو حشرات مؤذية أو حيات سامّة أو شياطين تحترق وتتعذب إلى ما لا نهاية) وذلك جزاءً عادلًا لما ارتكبته من شرور وعلى رأسها الكذب والخيانة والسير في ركاب الباطل والخداع.
وقد طور البوذيون والجينيون (أصحاب الديانة الجينية) ذلك النسيج الأسطوري فجعلوا الصدق مع الذات أولى خطوات النجاة والخلاص من عذابات الكارما والتناسخ، وربطوا بين الأفعال الخيّرة والسلوك القويم والوصول إلى النرفانا والسعادة الأبديّة وذلك بمقتضى ابتعادهم عن النفاق والخيانة والفحش والمراوغة والكيد والتلاعب بالعقول والإيقاع بين الناس وتزيف الحقائق، وغير ذلك من منتجات الكذب التي تنتمي للشرور الشيطانيّة.
وعلى مقربة من الفكر الهندوسي نجد الفكر الصيني والعقلانية الواقعية فعلى الرغم من عدم وجود أساطير في نسقهم التربوي تتحدث عن الفكر الغنوصي والعالم الغيبي إلا أنهم قد ابتدعوا (قانون الطاو) الذي يقضى بالجزاء من جنس العمل؛ فالصادق سوف يسعد بصدقه ويكافئ في حياته بانتصاره للحق ودفاعه عن العدالة في حين يعاني الأشرار من فرط القلق والخوف والارتياب في كل شيء فأذهانهم تكفر باليقين وتمضي شاكة في كل شيء لا تستطيع التمييز بين النافع أو الضار.
وقد صيغ النسيج الأسطوري في الفلسفة الطاوية على نحو يحبب الناس في الصدق ويحذرهم من دنس الكذب مثل كتاب (طاو تي تشينغ) وأسطورة (وووي) وثنائية (يين ويانغ) وأسطورة (زيران) وغيرها من الأساطير الحاوية للقيم التي يحبها ويكرهها الطاو فهو المبدأ الأول العادل الذي يسير الأقدار والمقادير.
فاذا كان الصدق يمثل التناغم للفطرة الإنسانية والانسجام الذاتي للسلوك البشري في النسيج الأسطوري الطاوي (وووي) الذي يؤدي إلى صلاح الكون؛ فإن الكذب يعد آلية الهدم وعلة كل الشرور والمُحرض الأول لجنوح الموجودات عن نظامها وجموحهم ونشاذهم عن التناغم الطاوي.
وقد طور كونفوشيوس ذلك النسيج الأسطوري وجعله أكثر عقلانيّة وواقعية يقوده الضمير الإنساني والعقول الراجحة التي تستطيع تهذيب السلوك البشري عن طريق الحوار والتربية والتعلم والتثقيف والتنوير الذي لا يخلو من وعد ووعيد المؤدب الغيور على العدالة والأخلاق الحاكمة للمجتمع كما يرد إلى كونفوشيوس القاعدة الذهبية للخُلق المستقيم ألا وهي أن الفضيلة وسط محمود بين رذيلتين كلاهما ممقوت ومكروه. فجعل الصدق على رأس كل الفضائل؛ لأنه صوت العقل وبصيرة الضمير. فالصدق يقبع في يمينه الإسراف في المدح والفناء في الحب وإخفاء النقائص رغم وجودها. ويقف على يسار الصدق الكذب والمداهنة والنفاق والخيانة وطمس الحقائق والوقائع لإضلال من يستجيبوا لغاوياته.
وعلى الرغم من عزوف كونفوشيوس عن الرؤى الأسطورية وتفضيله الحديث عن الضمير والعدالة والوسط الذهبي للأخلاق الفاضلة على الحكايات الأسطوريّة، فإن أحاديثه للشباب في محاوراته التثقيفية لم تخل من قصص الأبطال والحكماء والقادة مثل (هوانغ دي) وأساطير الخلق مثل (بانغو ونووا) بالإضافة إلى قصص أبطال مثل (دايو) الذين حكموا ضمائرهم وانقادوا إلى عقولهم وانضوا تحت مظلة الوسط الذهبي في سلوكهم واختياراتهم في تسيس أنفسهم من جهة، والعمل الجاد من أجل رفعة مجتمعهم من جهة أخرى.
أمّا سقراط فعلى الرغم من تعلقه بالفكر الغنوصي وحديث الكاهنة بيثيا (الجالسة في معبد أبولو في دلفي) التي أخبرته بأنه نبيُّ مرسل من عالم الربوبية والتوحيد الناطق بلسان الصدق والثائر على أباطيل الكاذبين والمتلاعبين بالعقول إلا أنه كان لا يبرح ترديده لمقولته الشهيرة (أعرف نفسك بنفسك) وكن صادقًا ولا تصغي لمن يصفوك بما ليس فيك؛ لأنهم يخدعونك وينافقونك بأكاذيبهم وجعل هذا القول هو بداية حملته على الكذابين وفاتحة رسالته لترغيب الناس في الحكمة الصادقة والعقل المنزَّه عن المنافع والنفس النقية الكارهة لكل ألوان الرذائل وأشكالها وأفعالها.
ورغم مغالاته في تقبيح الكذب، وإن كان مقصده مغاير لطبيعته؛ فإنه قد خالف هذا المبدأ الذي اشترطه على نفسه في واقعتين أولهما : خضوعه وانصياعه لحكم قضاته مع تيقنه من كذبهم، وأن جل ادعاءاتهم يفوح منها روائح الإفك والتآمر والكراهية والحسد وثانيهما: أنه أوصى تلاميذه قبيل تجرعه للسم أن يوفوا نذرًا عليه قد وهبه لمعبود مدينته وذلك رغم تأكده من ضلال وفساد هذا المعتقد.
وتبدو عبقرية سقراط في أثر شذراته وحكمه التي انصهرت في أفكار تلاميذه وجعلت منه أنموذجًا حيًا تضرب به الأمثال على ضرورة صدق الأنا مع ذاتها باعتبار هذا المبدأ أقوى الآليات لمدافعة الكذب ونقض أباطيله.
أمّا أفلاطون فقد ربط بين خداع الحواس والكذب من جهة والضلالات التي تطمس الحقائق تحت ستار الأوهام من جهة أخري وذلك في أسطورته الشهيرة (الكهف) تلك التي جعل فيها الصدق تاجً للعقول التي تطمح لإدراك الحقائق. وتأكيده على أن مثال المُثل والخير الأعلى الذي يوصف بالكمال والجلال والجمال يضع على رأس الفضائل التي تطوف من حوله فضيلة الصدق الذي يمكن النفس البشرية من إدراك مثال العدالة والعشق الأسمى، ويطهر النفس من كل الشهوات الحسية التي تحول بينها وبين الجنس الذهبي الذي لا يدانيه شيء ولا يستطيع الكذب الاقتراب من ذهنه أو لسانه أو مشاعره.
ولا يؤخذ على أفلاطون البحث عن موطن الجمال والخير بين مواقع القبح ومواطن الشر ولاسيما إذا كان ذلك الشر (عرضاً لا يصيب جوهر الأشياء بعطب) بل يمنع المخاطر ويزيل الأزمات في أمور محدودة.
ولعل أرسطو عندما جعل الصداقة أرفع وأنبل المشاعر التي تعمل على ترقية الأنفس البشرية؛ فإنه قد أراد بذلك التأكيد على أن حركة الأشياء لا تستطيع أن تنحرف بعشقها إلى شيء آخر - دون رغبة منها إذا أرادت الحياة المستقيمة - سوى الإله الصادق دومًا لأنه مجرد عن المادة فهو صورة خالصة لا يعنى إلا بالمجردات وهو الفاعل الحقيقي غير المنفعل والمحرك الأول لهذا العالم دون أن يتحرك ولا تغريه اللذائذ المادية فيسقط من سموه ومكانته العالية.
ولعلّ هذا التصور للعقل الربوبي هو الذي جعله يبيح الإفراط في عشق وإجلال وإكبار من يستحق هذه المبالغات التي تعادل الإفراط في قدح الكذب بكل أشكاله الضارة الفاسدة ولعل هذا التصور نقيض (الهيولى التي تحول بنيتها العاجزة عن بلوغ الوجود الحقيقي شأن الكذب) و(صورة خالصة يمثلها الإله، ومادة قح تمثلها الهيولى)
وللحديث بقيّة عن تلك الغرابيل التي صنعها حكماء الشرق وفلاسفة اليونان لتخليص الموروث الثقافي من الأوهام الكاذبة؛ معولين في ذلك على التصورات العقلية التي نسبوها إلى المعرفة الربوبية في النسيج الأسطوري تارة أو سبيل الرشاد والاستقامة والاستنارة في طلب القيم الضامنة للأمن والسعادة الأرضية والعدالة والمساواة تارة أخرى .. تلك التي تنمي عواطف الألفة والمحبّة بين الناس بمعزل عن الصراعات والأحقاد التي تولدها الأوهام التي يخترعها الكذب. وسوف نكشف كذلك عن مدى دقة ومتانة وقوة تلك الغرابيل (حريرية ناعمة أو معدنية ذات ثقوب حادة تحول بين النافع والفاسد غير المرغوب فيه) خلال عملية تنقية وتطهير الأذهان والمشاعر؛ بل والحواس أيضًا من أقنعة الكذب ومكائده وحيله التي كان يخطط لها الشيطان لإضلال الأنفس البشرية.
***
بقلم: د. عصمت نصّار