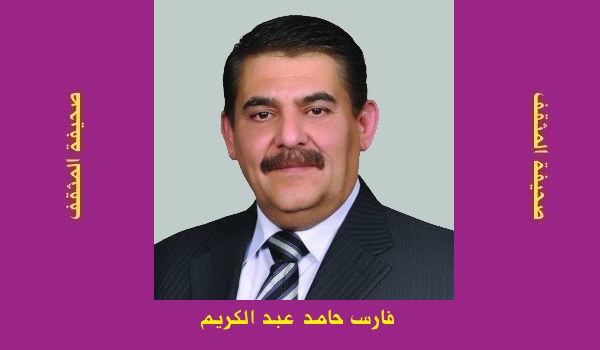أقلام فكرية
حمزة مولخنيف: مفهوم الحقيقة بين الواقعية الجديدة والبنائية الرقمية

الحقيقة منذ نشأة الفلسفة، لم تكن مجرد انعكاس للواقع أو مطابقة بين الفكر والموضوع، بل هي فضاء للعلاقة المعقدة بين الإنسان والعالم، حيث يتقاطع الوجود بالمعنى، والإدراك بالتجربة، والوعي بالموضوعية. لقد تناولها الفلاسفة الكلاسيكيون، من أفلاطون وأرسطو إلى ديكارت وكانط، باعتبارها محورا لإشكالية المعرفة وحدودها، بين ما هو مستقل عن وعينا وما هو مشروط بالخطاب والتأويل. ومع التحولات المعرفية المعاصرة، وخصوصا في العصر الرقمي، اتخذت الحقيقة أبعادا جديدة، إذ لم تعد المعرفة نتاجا للفكر الفردي فحسب، بل أصبحت محكومة بالوسائط التقنية والخوارزميات وتدفقات البيانات، بحيث يُعاد إنتاج الواقع نفسه باستمرار. ويتكشف التوتر الفلسفي بين الواقعية الجديدة التي تؤكد استقلالية الواقع وموضوعيته، والبنائية الرقمية التي ترى في التقنية والوسائط الرقمية عاملا نشطا في إنتاج الحقيقة. دراسة هذا التوتر تصبح بذلك مسألة مركزية لفهم أفق المعرفة والإدراك البشري في العصر المعاصر.
لم تكن الحقيقة في أي طور من أطوار الفكر الإنساني معطى بسيطا ولا مفهوما مستقرا، بل ظلت على الدوام موضع شدٍّ وجذب بين ما هو قائم في الخارج وما يُنشئه العقل في الداخل، بين الواقعة كما هي، والصورة كما تُدرك، وبين الوجود كما يُعطى، والمعنى كما يُصاغ. منذ أفلاطون حين جعل الحقيقة مقيمة في عالم المثل، مرورا بأرسطو الذي أنزلها إلى مطابقة الفكر للشيء، وصولا إلى ديكارت الذي ربطها باليقين، وكانط الذي أعاد تشكيلها في أفق الشروط القبلية للمعرفة، ظل سؤال الحقيقة يتخذ أشكالا متعددة، لكنه لم يفقد قط مركزيته في البناء الفلسفي للإنسان والعالم.
وقد عبّر هايدغر عن هذا التوتر الجوهري حين أعاد تعريف الحقيقة بوصفها انكشافا لا مجرد تطابق، معتبرا أن الحقيقة حدث وجودي قبل أن تكون حكما منطقيا. أما نيتشه فقد ذهب أبعد حين وصف الحقائق بأنها “أوهام نسينا أنها كذلك”، مشيرا إلى الطابع الإنشائي للمعرفة، وإلى أن ما نسميه حقيقة ليس سوى ترسيب تاريخي للسلطة واللغة والعادة. وفي السياق ذاته، رأى فوكو أن الحقيقة ليست خارج أنظمة الخطاب، بل تُنتج داخل شبكات السلطة والمعرفة، حيث تصبح كل حقيقة مشروطة بسياقها المؤسساتي والتاريخي.
غير أن التحولات الرقمية الراهنة قد دفعت هذا السؤال إلى تخوم جديدة، إذ لم يعد النزاع يدور فقط بين الواقعية والذاتية أو بين الموضوعية والبنائية، بل انتقل إلى مستوى أعمق، حيث أصبحت الحقيقة نفسها عرضة لإعادة التشكيل عبر الوسائط والخوارزميات والمنصات والذكاء الاصطناعي. لقد دخلنا طورا لم تعد فيه الحقيقة تُكتشف فحسب، بل تُصنّع وتُضخّم وتُجزّأ وتُعاد برمجتها.
وهنا برز ما يُسمى بالواقعية الجديدة، بوصفها محاولة فلسفية لاستعادة مرجعية العالم الخارجي بعد عقود من هيمنة النسبية والتفكيك والبنائية الراديكالية. فقد دعا مفكرون معاصرون إلى ضرورة الاعتراف باستقلال الواقع عن تمثلاتنا، معتبرين أن الإفراط في تأويل الحقيقة بوصفها بناءً لغويا أو اجتماعيا قد أفضى إلى نوع من العدمية المعرفية. يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الأشياء توجد بمعزل عن وعينا بها، وأن للوقائع مقاومة عنيدة لكل محاولات الاختزال الخطابي.
ويذهب موريس فيراري إلى أن الواقعية الجديدة ليست ارتدادا ساذجا إلى الموضوعية الكلاسيكية، بل هي نقد مزدوج: نقد للنزعة المثالية التي تذيب الواقع في الوعي، ونقد للبنائية المتطرفة التي تحوّل الحقيقة إلى مجرد اتفاق اجتماعي. فالعالم بحسب هذا التصور ليس نصا مفتوحا بلا ضفاف، بل له بنية ومقاومة وكثافة أنطولوجية لا يمكن تجاهلها.
غير أن هذا المسعى الواقعي يصطدم مباشرة بالبنية الرقمية للعالم المعاصر، حيث لم يعد الواقع يُعاش مباشرة، بل يُوسّط عبر الشاشات، ويُعاد إنتاجه بواسطة البيانات، وتُعاد صياغته عبر الخوارزميات. هنا تبرز البنائية الرقمية بوصفها أفقا جديدا لإنتاج الحقيقة، حيث تصبح الوقائع رهينة نماذج حسابية، وتتحول التجربة الإنسانية إلى تدفقات معلوماتية، ويغدو الإدراك نفسه مبرمجا ضمن أنظمة ذكية تتعلم من سلوك المستخدمين وتعيد توجيهه.
لقد تنبّه بودريار مبكرا إلى هذا التحول حين تحدث عن “فرط الواقع”، حيث تختفي الحدود بين الحقيقي والمصطنع، ويحلّ المحاكي محل المرجع، وتصبح الصور أكثر حضورا من الأشياء. وفي العالم الرقمي لا تُقدَّم الحقيقة بوصفها ما هو كائن، بل بوصفها ما هو قابل للمشاركة وما يحظى بالانتشار، وما ينسجم مع منطق المنصة. وهنا يتحقق ما سماه بول فيريليو “تسارع الواقع”، حيث تفقد الأحداث عمقها الزمني، وتتحول إلى ومضات آنية بلا سياق.
إن البنائية الرقمية لا تكتفي بإعادة تمثيل الواقع، بل تعيد تشكيل شروط إمكان ظهوره. فالمعرفة لم تعد تُنتج في المختبرات الأكاديمية وحدها، بل داخل شبكات التواصل ومحركات البحث وأنظمة التوصية حيث تُفلتر المعلومات وتُرتب الأولويات وتُصاغ الاهتمامات وفق منطق تجاري وتقني خفي. وبذلك تنتقل الحقيقة من كونها نتيجة بحث عقلاني إلى كونها مخرَجا خوارزميا.
وقد أشار هابرماس إلى خطورة هذا التحول، محذرا من تآكل الفضاء التداولي العقلاني، حيث تُستبدل الحجة بالانتشار، والنقاش بالإعجاب، والمعنى بالإحصاء. أما حنة أرندت فقد ربطت بين انهيار الحقيقة الواقعية وصعود أنماط جديدة من التلاعب الجماهيري، معتبرة أن فقدان المعايير المشتركة للواقع يفتح الباب أمام أشكال مستحدثة من الاستبداد الرمزي.
في هذا الأفق الملتبس، تبدو الواقعية الجديدة كنداء أخلاقي بقدر ما هي موقف معرفي، إذ تسعى إلى إعادة الاعتبار لفكرة أن هناك عالما لا يخضع بالكامل لأهوائنا، وأن الحقيقة ليست ملكا للخوارزميات ولا رهينة للرغبات الجماعية. لكنها في المقابل، تصطدم بقوة البنائية الرقمية التي تُعيد تعريف الوجود نفسه بوصفه قابلا للترميز، والمعنى بوصفه قابلا للحوسبة والتجربة بوصفها بيانات.
إن التوتر بين هذين الأفقين لا يمكن حسمه بسهولة، لأنه يعكس انقساما أعمق في تصور الإنسان لذاته ولمكانه في العالم. فالواقعية الجديدة تراهن على استعادة الثقة في الواقع، بينما تراهن البنائية الرقمية على إعادة هندسة الواقع ذاته. وبين الرهانين يتشكل وعي معاصر ممزق بين الحنين إلى الحقيقة الصلبة والانخراط في سيولة المعنى.
وقد عبّر غادامير عن هذا الإشكال حين أكد أن الفهم ليس امتلاكا للحقيقة بل مشاركة فيها، وأن الحقيقة تنكشف داخل أفق تاريخي متحرك. غير أن الرقمنة تدفع هذا الأفق إلى أقصى درجات السيولة، حيث يصبح كل فهم مؤقتا، وكل معنى قابلا للتعديل، وكل يقين عرضة للتحديث.
إننا بإزاء لحظة فلسفية حرجة، تتطلب إعادة التفكير في مفهوم الحقيقة لا بوصفه قضية نظرية فحسب، بل بوصفه رهانا وجوديا وأخلاقيا. فالحقيقة اليوم ليست مجرد مطابقة بين الفكر والواقع، ولا مجرد بناء لغوي، بل هي مجال صراع بين أنماط مختلفة من العقلانية، بين الإنسان والخوارزمية وبين التجربة الحية والنموذج الحسابي.
غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في هذا السياق لا يتعلق فقط بتعارض الواقعية الجديدة مع البنائية الرقمية، بل بطبيعة التحول الذي أصاب مفهوم الحقيقة ذاته. فالحقيقة لم تعد تُفهم باعتبارها أفقا مشتركا تُبنى داخله المعارف، بل غدت موضوعا للتجزئة والتخصيص، بحيث أصبح لكل جماعة، بل لكل فرد، “حقيقته” الخاصة، المصاغة وفق تفضيلاته وخوارزميات تغذيته المعلوماتية. هنا يتحقق ما وصفه ليبوفيتسكي بعصر الفراغ القيمي، حيث تنحل المرجعيات الكبرى، ويُستبدل بها منطق اللذة الفورية والتلقي السريع.
لقد كان كانط يرى أن العقل لا يتلقى العالم كما هو، بل يصوغه عبر مقولاته القبلية، ومع ذلك ظل يؤمن بإمكان معرفة موضوعية ضمن حدود التجربة الممكنة. أما اليوم فإن هذه الحدود نفسها قد أُعيد رسمها بواسطة البنية الرقمية، حيث لم يعد العقل الفردي هو الوسيط الوحيد بين الإنسان والعالم، بل دخلت الخوارزميات طرفا ثالثا يشارك في تشكيل الإدراك وتوجيه الانتباه وصناعة الأولويات. وبذلك تنتقل الحقيقة من مجال الحكم النقدي إلى مجال الترتيب التقني.
ويذهب برونو لاتور إلى أن الحداثة قد أخفقت في الفصل بين الطبيعة والمجتمع وبين الواقع والخطاب، وأن ما نعيشه اليوم هو انكشاف لهذه الهجنة الأصلية. غير أن الرقمنة تضيف بعدا جديدا لهذا الالتباس، إذ لا تكتفي بإظهار الترابط بين الإنسان والتقنية، بل تجعل التقنية ذاتها فاعلا معرفيا، ينتج المعنى ويعيد توزيعه. وفي هذا السياق، تصبح الحقيقة نتيجة شبكة معقدة من الفاعلين البشريين وغير البشريين.
أما الواقعية الجديدة في مقابل ذلك، فتسعى إلى إعادة تثبيت فكرة أن للوقائع استقلالا نسبيا عن أنظمة التمثيل، وأن الزلازل تقع سواء صدّقناها أم لا، وأن الأوبئة تنتشر بمعزل عن تأويلاتنا، وأن العالم ليس محض سردية. لكن هذه الأطروحة تصطدم بواقع أن معظم ما نعرفه عن العالم اليوم يمر عبر وسائط رقمية، وأن التجربة المباشرة باتت استثناءً لا قاعدة.
وقد أشار تشارلز تايلور إلى أن الذات الحديثة تعيش داخل أطر تخيلية تشكل علاقتها بالواقع، وأن هذه الأطر لم تعد دينية أو ميتافيزيقية كما في السابق، بل إعلامية وتقنية. وهنا يتبدى عمق الأزمة: فالحقيقة لم تعد تُختبر في العالم، بل على الشاشة، ولم تعد تُقاس بالبرهان بل بعدد المشاهدات، ولم تعد تُستمد من الواقع، بل من تدفق البيانات.
ويحذر بيونغ تشول هان من أن الشفافية الرقمية، بدل أن تعزز الحقيقة تؤدي إلى تسطيحها، لأن كل ما يُعرض بلا حجب يفقد عمقه الرمزي، ويصبح مجرد معلومة قابلة للاستهلاك. فالحقيقة في نظره تحتاج إلى مسافة، إلى صمت، إلى تأمل، بينما الثقافة الرقمية تفرض حضورا دائما وضجيجا متواصلا.
إن البنائية الرقمية لا تنتج فقط معرفة جديدة، بل تعيد تشكيل الإنسان ذاته، إذ يتحول الفرد إلى ملف بيانات، وتُختزل هويته في أنماط سلوكية، ويُعاد تعريف حريته بوصفها اختيارا بين خيارات مسبقة البرمجة. وهنا تتحقق نبوءة هربرت ماركوز عن الإنسان ذي البعد الواحد، الذي يُدمج في النظام عبر الإشباع التقني، ويُحرم من القدرة النقدية.
وفي مقابل ذلك، تحاول الواقعية الجديدة أن تستعيد إمكانية النقد عبر إعادة الاعتبار للواقع بوصفه معيارا، لكن هذا المسعى يظل محدودا ما لم يُرفق بتحليل عميق للبنية الرقمية التي أعادت تشكيل شروط الإدراك. فليس كافيا أن نقول إن العالم موجود خارج وعينا، بل ينبغي أن نسأل: كيف يُقدَّم لنا هذا العالم؟ ومن يختار ما نراه؟ ومن يحدد ما يستحق الانتباه؟.
وقد شدد بول ريكور على أن الحقيقة لا تنفصل عن التأويل، وأن كل فهم هو إعادة كتابة للواقع داخل أفق لغوي وتاريخي. غير أن التأويل في العصر الرقمي لم يعد نشاطا هرمنيوطيقيا واعيا، بل صار عملية آلية تجري في الخلفية، حيث تقوم الأنظمة الذكية بتأويل بياناتنا نيابة عنا، وتستبق اختياراتنا، وتعيد توجيه مساراتنا.
إننا أمام انتقال خطير من العقل التأملي إلى العقل الحسابي، ومن الحقيقة بوصفها ثمرة حوار إلى الحقيقة بوصفها ناتج معالجة. وقد لاحظ إدغار موران أن التعقيد الإنساني لا يمكن اختزاله في نماذج رياضية، وأن أي محاولة لتبسيط العالم عبر الخوارزميات تنتهي بإفقاره معنويا.
وهنا يغدو الصراع بين الواقعية الجديدة والبنائية الرقمية صراعا على معنى الإنسان ذاته: هل هو كائن منفتح على حقيقة تتجاوزه، أم مجرد عقدة داخل شبكة بيانات؟ هل الحقيقة أفق يُطلب أم منتج يُسوّق؟ هل المعرفة تجربة وجودية أم خدمة رقمية؟.
لقد كتب أفلاطون في أسطورة الكهف عن أسرى يرون ظلال الأشياء ويحسبونها الحقيقة، غير أن كهف اليوم لم يعد حجريا بل رقميا تضيئه الشاشات بدل النار، وتتحكم في ظلاله خوارزميات غير مرئية. ومع ذلك يبقى السؤال الأفلاطوني حيا: كيف نخرج إلى النور؟.
إن الخروج لا يكون بالحنين إلى موضوعية مفقودة، ولا بالاستسلام لبنائية مطلقة، بل بإعادة تأسيس علاقة نقدية بالحقيقة، تعترف بواقعية العالم وبوساطة اللغة وبسلطة التقنية في آن واحد. علاقة تستلهم من كانط شجاعة التفكير، ومن هايدغر الإصغاء للوجود، ومن فوكو اليقظة تجاه السلطة، ومن غادامير الانفتاح على الحوار.
وبذلك يغدو مفهوم الحقيقة مجالا للتوتر الخلاق بين ما هو معطى وما هو مُنشأ، بين الواقع والبناء وبين الإنسان والآلة. توتر لا ينبغي حسمه لصالح طرف واحد، بل ينبغي الإقامة فيه بوصفه شرطا لإمكان الفكر في زمن الرقمنة.
ذلك أن الحقيقة في عمقها الفلسفي ليست مجرد قضية إبستيمولوجية، بل هي مسألة وجودية تتعلق بكيفية تموضع الإنسان في العالم. وقد عبّر كارل ياسبرز عن هذا البعد حين رأى أن الحقيقة لا تُمتلك، بل تُعاش داخل وضعيات حدّية تكشف هشاشة الكائن البشري، وتضعه أمام مسؤوليته الوجودية. غير أن الرقمنة تعمل على تحييد هذه الوضعيات، عبر تحويل التجربة إلى بيانات، والمعاناة إلى محتوى، والحدث إلى خبر عابر.
وهنا، يغدو الإنسان كائنا مُدارا، لا كائنا سائلا فقط، كما وصفه باومان، بل كائنا مُراقَبا عبر بنى غير مرئية، حيث تُختزل الذات في أنماط استهلاك، وتُعاد صياغة الرغبات وفق منطق السوق. وهنا يتقاطع تحليل فوكو للسلطة الحيوية مع واقع الخوارزميات، إذ لم تعد السلطة تمارس عبر القمع المباشر، بل عبر التوجيه الناعم وإدارة الاحتمالات وصناعة القناعات.
إن البنائية الرقمية لا تفرض رؤيتها للحقيقة بالقوة بل بالإغواء، عبر ما يسميه ديبور مجتمع الفرجة، حيث تتحول الحياة إلى عرض دائم، وتصبح الصورة بديلا عن الواقع، ويغدو الظهور أهم من الوجود. وفي هذا العالم لا تُقاس الحقيقة بمدى صدقها، بل بمدى قابليتها للانتشار، ولا تُختبر عبر البرهان بل عبر التفاعل.
ومن هنا تنشأ مفارقة عميقة، فبينما تزعم الرقمنة توسيع آفاق المعرفة، فإنها في الواقع تضيق أفق التفكير النقدي، لأن التدفق المستمر للمعلومات يمنع الترسّب، ويحول دون التأمل، ويُبقي الوعي في حالة استثارة دائمة. وقد لاحظ نيتشه أن كثرة المعارف قد تؤدي إلى ضمور الحكمة، وهو ما يتجلى اليوم في فائض البيانات وفقر المعنى.
أما الواقعية الجديدة فهي تحاول مقاومة هذا الانزلاق عبر إعادة تثبيت مفهوم المرجع، غير أنها تظل مهددة بالتحول إلى موقف دفاعي إذا لم تُدمج في مشروع نقدي شامل للتقنية. فالواقع لا يعود إلينا تلقائيا بمجرد الاعتراف بوجوده، بل يحتاج إلى وسائط معرفية جديدة قادرة على تحرير التجربة من أسر النمذجة الرقمية.
وقد أشار ميرلوبونتي إلى أن الجسد هو موقع الحقيقة الأول، وأن الإدراك متجذر في الخبرة الحسية المباشرة، لكن العالم الرقمي يفكك هذه العلاقة عبر إحلال التفاعل الافتراضي محل الحضور الفيزيائي، وبذلك يُفرغ الحقيقة من بعدها التجسيدي، ويحوّلها إلى مجرد تمثيل.
إن أخطر ما في البنائية الرقمية ليس إنكار الواقع، بل إعادة تعريفه على نحو وظيفي، بحيث يصبح ما لا يمكن ترميزه غير موجود. وهنا يتحقق ما سماه هوسرل أزمة العلوم الأوروبية، أي اختزال العالم المعيش في صيغ رياضية، وفقدان المعنى لصالح الدقة التقنية.
في المقابل تفتح الواقعية الجديدة أفقا لإعادة الاعتبار للعالم المعيش، لكنها تحتاج إلى أن تتجاوز النزعة الوصفية، لتؤسس أخلاقا للحقيقة، تُعيد للإنسان مسؤوليته المعرفية. فالحقيقة ليست فقط ما هو كائن، بل ما ينبغي أن يُصان، لأنها شرط إمكان العدالة، وركيزة كل تعاقد اجتماعي.
وقد شدد راولز على أن أي مجتمع عادل يفترض حدا أدنى من الاتفاق حول الوقائع، لكن هذا الاتفاق يتآكل في زمن الأخبار الزائفة والتلاعب الرقمي. وهنا تصبح الحقيقة سلعة سياسية، تُستخدم لتوجيه الرأي العام وإعادة هندسة الوعي الجمعي.
وفي الفكر العربي المعاصر، بدأت تتشكل محاولات خجولة لمساءلة هذا التحول، حيث يُنظر إلى الرقمنة بوصفها امتدادا لهيمنة معرفية جديدة، تعيد إنتاج التبعية الثقافية عبر أدوات تقنية. ويُطرح السؤال حول إمكانية تأسيس عقل نقدي عربي قادر على استيعاب التقنية دون الذوبان فيها، وعلى الدفاع عن الحقيقة دون الوقوع في دوغمائية.
إن استعادة الحقيقة لا تعني العودة إلى يقينيات ماضوية، بل بناء موقف تأويلي نقدي، يجمع بين الاعتراف بواقعية العالم والوعي بوساطة اللغة واليقظة تجاه سلطة التقنية. موقف يرفض اختزال الإنسان في بيانات والمعرفة في خوارزميات والمعنى في تفاعل.
إن إمكان التفكير في الحقيقة اليوم يمر حتما عبر تفكيك الثنائية الساذجة بين الواقعية والبنائية، لأن كلتا المقاربتين، إذا أُخذت على نحو أحادي، تنتهي إلى مأزق. الواقعية الجديدة حين تنغلق على فكرة الاستقلال الصلب للواقع، تخاطر بتجاهل الأبعاد الرمزية والتاريخية التي تشكل تجربتنا للعالم. والبنائية الرقمية حين تُطلق العنان لمنطق الإنشاء التقني، تُفرغ الحقيقة من بعدها المعياري، وتحوّلها إلى وظيفة ضمن نظام تداولي لا يعترف إلا بما هو قابل للقياس.
والحق أن الحقيقة لا تُختزل في كونها مرآة للواقع ولا في كونها بناءً اعتباطيا، بل هي علاقة معقّدة بين الذات والعالم تتوسطها اللغة، وتتشكل داخل التاريخ وتتأثر بالبنى التقنية. وقد عبّر غاستون باشلار عن هذا البعد العلاقي حين رأى أن الحقيقة العلمية نفسها ثمرة قطيعات إبستيمولوجية متتالية، وأن المعرفة تتقدم عبر تصحيح أخطائها. غير أن الرقمنة تُضعف هذا المسار التصحيحي، لأنها تسرّع التداول على حساب التمحيص، وتُراكم الآراء بدل أن تُعمّق الفهم.
إن ما نعيشه اليوم هو انتقال من الحقيقة بوصفها أفقا للتفكير إلى الحقيقة بوصفها مادة للاستهلاك. فالمعلومة تُستبدل بالحكمة والرأي بالمعرفة والظهور بالفهم. وهذا التحول لا يقتصر على المجال الإعلامي بل يمتد إلى الجامعة والسياسة والثقافة، حيث يُقاس النجاح بعدد المتابعين، لا بقوة الحجة وبمدى الانتشار لا بعمق التحليل.
وقد لاحظ بيير بورديو أن الرأسمال الرمزي يتحدد داخل حقول اجتماعية تحكمها علاقات القوة، لكن العالم الرقمي يعيد تشكيل هذه الحقول على نطاق كوني، حيث تُمنح الشرعية لمن يتقن لعبة الخوارزميات، لا لمن يمتلك رؤية نقدية. وهنا تتبدى أزمة المثقف الذي يجد نفسه مزاحا من فضاء التأثير، أو مُجبرا على التكيف مع منطق السوق الرقمي.
إن استعادة الحقيقة تقتضي إعادة بناء الذات النقدية، القادرة على مقاومة التلاعب المعلوماتي، وعلى ممارسة الشك المنهجي، وعلى إعادة وصل المعرفة بالتجربة. وقد شدد ديكارت على أن الحقيقة تبدأ من الشك، غير أن الشك اليوم يُستثمر لإنتاج الارتباك لا اليقين، ولتفكيك الثقة العامة لا لبناء معرفة راسخة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى أخلاق للحقيقة، تتجاوز المقاربات التقنية، وتعيد الاعتبار للقيم المعرفية مثل الصدق والدقة والمسؤولية. فالحقيقة ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي التزام وجودي. وقد رأى ليفيناس أن العلاقة بالآخر هي أساس كل معنى، وأن الحقيقة تنكشف في الاستجابة الأخلاقية قبل أن تتجلى في الحكم النظري. غير أن العالم الرقمي يضعف هذه العلاقة، عبر تحويل الآخر إلى صورة، والتفاعل إلى نقرة.
إن الواقعية الجديدة إذا أُعيد تأويلها في ضوء هذا الأفق الأخلاقي، يمكن أن تشكل ركيزة لمقاومة تسليع الحقيقة، شرط أن تنفتح على البعد الإنساني للمعرفة، وألا تختزل الواقع في معطى فيزيائي. والبنائية الرقمية إذا أُخضعت لنقد جذري، يمكن أن تتحول من أداة هيمنة إلى مجال إمكان، يسمح بإعادة توزيع المعرفة، شريطة تحريرها من منطق الربح والمراقبة.
وهنا يصبح سؤال الحقيقة سؤالا سياسيا بامتياز، لأنه يتعلق بمن يملك القدرة على تعريف الواقع. وقد نبّه كارل شميت إلى أن السيادة تظهر في لحظة الاستثناء، لكن السيادة الرقمية تظهر في التحكم في تدفق المعلومات. ومن يملك هذا التحكم يملك تشكيل الوعي الجمعي.
أما في السياق العربي فإن التحدي مضاعف، لأننا نواجه الرقمنة من موقع هش دون سيادة تقنية ودون مشروع معرفي مستقل. ولذلك فإن التفكير في الحقيقة يقتضي أيضا التفكير في الاستقلال المعرفي، وفي بناء مؤسسات بحثية قادرة على إنتاج المعرفة لا استهلاكها فقط.
إن الحقيقة ليست معطى جاهزا بل مهمة مستمرة. مهمة تتطلب شجاعة التفكير وعمق التأمل ومسؤولية الكلمة. وهي لا تُختزل في مطابقة أو بناء، بل تتجسد في السعي الدائم إلى فهم العالم دون الخضوع له، وإلى استخدام التقنية دون الارتهان إليها.
يتضح من خلال ما سبق وذكرنا، أن مفهوم الحقيقة يقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث تتنازعها نزعتان متعارضتان في الظاهر، متداخلتان في العمق، نزعة تسعى إلى استعادة صلابة الواقع عبر الواقعية الجديدة، ونزعة تعمل على إعادة تشكيل الواقع عبر البنائية الرقمية. وبين هذين القطبين يتشكل وعي معاصر مأزوم، يتأرجح بين الحنين إلى يقين مفقود والانخراط في سيولة لا ضفاف لها.
لقد أظهرت الواقعية الجديدة أهمية إعادة الاعتبار لاستقلال العالم عن تمثلاتنا، مؤكدة أن الحقيقة لا يمكن اختزالها في الخطاب أو الاتفاق الاجتماعي. غير أن هذا الموقف يظل قاصرا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار التحولات التقنية التي أعادت تشكيل شروط الإدراك والمعرفة. فالعالم لا يُعطى لنا اليوم مباشرة، بل يُفلتر ويُرتب ويُعاد إنتاجه عبر أنظمة رقمية تشارك في صنع الحقيقة ذاتها.
في المقابل كشفت البنائية الرقمية عن الطابع الإنشائي للمعرفة المعاصرة، لكنها دفعت هذا الاكتشاف إلى حدوده القصوى، حيث أصبحت الحقيقة قابلة للتلاعب، والمعنى رهين الخوارزميات، والذات مختزلة في بيانات. وهنا يتبدى خطر اختفاء البعد المعياري للحقيقة، وتحولها إلى وظيفة ضمن اقتصاد الانتباه.
إن تجاوز هذا المأزق يقتضي بناء تصور تركيبي للحقيقة، يعترف بواقعية العالم وبوساطة اللغة وبسلطة التقنية في آن واحد. تصور يجعل من الحقيقة علاقة دينامية بين الإنسان وواقعه، لا انعكاسا آليا ولا بناءً اعتباطيا. علاقة تقوم على النقد والحوار والمسؤولية الأخلاقية.
كما يقتضي هذا التجاوز إعادة تأسيس الذات العارفة، بوصفها فاعلا نقديا، لا مجرد مستهلك للمعلومات، وإحياء الفضاء التداولي العقلاني، حيث تُختبر الآراء بالحجج لا بالإعجابات، وتُبنى المعرفة بالتراكم لا بالتكرار.
وفي السياق العربي، تزداد هذه المهمة إلحاحا، لأن استعادة الحقيقة تتقاطع مع معركة أوسع من أجل السيادة المعرفية والتحرر من التبعية الرقمية، وبناء مشروع ثقافي قادر على استيعاب التقنية دون فقدان المعنى.
إن الحقيقة في عصر الواقعية الجديدة والبنائية الرقمية ليست نهاية الطريق بل بدايته. إنها أفق مفتوح للتفكير ودعوة دائمة إلى اليقظة، ومسؤولية مشتركة في زمن تتكاثر فيه الصور وتقل فيه البصائر. وهي قبل كل شيء، فعل مقاومة ضد الاختزال وضد النسيان وضد تحويل الإنسان إلى رقم في معادلة كبرى لا روح لها.
***
د. حمزة مولخنيف