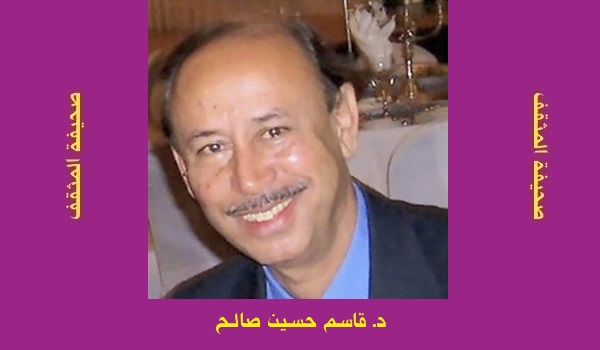قراءات نقدية
حميد بن خيبش: عبد الله راجع.. جسد مُحاصَر بالكتابة

تحددت ملامح الحركة الشعرية في السبعينات وسماتها الأساسية من خلال ثلاثة عناصر، سرى مفعولها في المتن الشعري لأزيد من عقد من الزمان، ويمكن القول أن الصدى لازال مستمرا حتى الآن:
يتثمل العنصر الأول في عمق التجديد الذي أحدثه جيل السبعينات بشكل يختلف جذريا عن النتاج الشعري لدى الأجيال السابقة.
وأما العنصر الثاني فيتعلق بصياغة مفاهيم نظرية ومقولات في النقد الأدبي، سرت بدهشة من خلال المتابعات النقدية والمطارحات التي كان رواده يتداولونها حول مسائل وقضايا فكرية ونقدية. ورغم ما قيل عن تعالي هذه المقولات، وطموحها الزائد في مقابل الإمكانية الإبداعية المطروحة، إلا أنها أسهمت بشكل مثير في بث روح بالغة الحماس في الحياة الثقافية آنذاك.
ويتجلى العنصر الثالث في تنوع الأشكال الإجرائية المستقلة التي أتاحت لهذا الجيل أن يذيع نتاجاته، ويحقق أقصى درجة من الإعلان عن عنصري الإبداع والنقد، ومنها الندوات، والمقاهي الثقافية، والصحف والمجلات التي ساعدت على طرح الأمر بشكل واسع(1).
إلى هذا الجيل المفعم بالتجريب والتجديد ينتسب الشاعر المغربي عبد الله راجع، أحد رواد القصيدة المغربية المعاصرة، وصوتها المفعم بالعمق والأصالة، والتوق لاجتراح رؤى وآفاق شعرية متجددة.
تفتقت قريحة شاعرنا ضمن سياق اجتماعي وسياسي مفعم بالصدام والرعب والإحباط، وتبخر أحلام بناها جيل الشباب بعد الفكاك من ربقة الاستعمار. أما على المستوى الفني فقد تشكلت حساسية شعرية اهتمت بالتجريب في بنية القصيدة المغربية، وخلق متخيل شعري يواكب التحول العميق الذي أحدثته نظيرتها المشرقية، وذلك بالانتقال من الشكل العمودي إلى التفعيلة، وتطويع اللغة والإيقاع، وتوظيف الموروث بشتى تجلياته المضيئة للتحرر من قوانين السائد والمألوف.
تشكلت الحروف الأولى لصوته المتميز من مزيج ضم شعراء النهضة، إلى جانب قمم الشعر الفرنسي كبودلير ورامبو ومالارميه وغيرهم. إلا أنه، وهو المؤمن بحتمية الوفاء لجذور القصيدة العربية، لم يُخف انكبابه المستمر على شعر أبي الطيب المتنبي، والتوغل في المتاهات الفنية التي أبدعها أبو تمام، والذي يصفه بالشاعر المهووس بالتغيير وإحداث خراب داخل هذا العالم.
ولأن الكتابة مسؤولية، ومعترك لا يليق إلا بمناضل متمرس بعتاده، فلابد من زمن يسبقها لينحت الشاعر أداته الفنية. صرّح في مقابلة مع الناقد جهاد فاضل قائلا:
" كان لابد أن أخلق مسارا شعريا يميزني لكي أتأكد من أنني فعلا أصبحت شاعرا. وقد اقتضى مني ذلك مرحلة من الزمن لا أعتقدها قصيرة هي في حدود العشر سنوات. ولكن عندما اقتنعت بأنني أستطيع أن أكتب كما ينبغي، أقدمت على تجربتي الأولى."(2)
في المسار الذي اختطه راجع لنفسه تحتفي الكتابة بالسرد والمجاز والإيقاع، واستدعاء نماذج تاريخية تجعل من المتن الشعري فضاء لمعالجة واقع القهر والانتكاس (عبد الكريم الخطابي، الحلاج، عبد الرحمن الأشعث...)، وتعكس قلق الشاعر المعاصر إزاء الإشكالات السياسية والاجتماعية، وواجب إدانتها لتحرير ذاته من قوانين السائد والموروث. ينسج شيئا من وجعه بخيوط ملحمة النضال التي قادها عبد الكريم الخطابي في جبال الريف المغربية متوعدا:
"لجبال الريف عيونٌ ترصد أمواج البحر المتوسطْ
كيف إذن حين افتضّت سفن الغزو شواطئ سبتهْ
وامتلأت برذاذ الدهشة والحزن عيون الأطفالْ
لم تصهل في منعرجات الريف خيول «الخطَّابي»
أو تتحرّك راياتك يا أنَوالْ؟
كي تكشفَ أوراق الغَبَشِ المتمدِّد شرْخًا يتقيّح في
ذاكرةِ الريف لعل غضون البحر الغاضبْ
تُفرزُ ثانيةً وجه الخطّابيْ إذ يقرأ فاتحة (الحركةِ)
والموت أمام الباب المسدودْ
فتموجُ الشطآن برائحة الزعتر والبارودْ؟"
(مكاشفات من دفتر الغربة)
الكتابة تحريض. ولأنها قدره فإن شاعرنا يعلن القصيدة عالما جديدا، يلوذ به من انهزموا على مستوى الحياة اليومية. وباللغة التي ظلت حتى زمن قريب أداة اتصال وتوصيل، سيسهم راجع في تغيير الواقع، أو نسفه إن لزم الأمر لإعادة تركيبه في صورة جميلة:
آت تسبقني لغة جُبت لأتقنها
أطراف المعمور
لغة تخرج من تيه الصمت
البارد، وتخرج من أعماق
الديجور
كي تملأ باسمك يا سيف الدولة
رمل الصحراء وأشجار الشام.
(أوراق متساقطة من ديوان أبي الطيب المتنبي)
الكتابة تمنع إزاء الفوضى، لذا تحفّظ شاعرنا على دعاوى التجاوز والاختراق التي تطال أدوات الشاعر الأساسية. إن هناك أصولا ينبغي أن تٌقدّس وفي مقدمتها اللغة. يجب التمييز بين اختراق التعبير المألوف وبين تحطيم الأصول؛ وهذه الدعوة إلى المشي بحذر وسط ركام الحداثة تتسق مع نحت قصيدة معاصرة، تهتم بتطوير الأصل بدل الاكتفاء بالخروج على مواضعات اللغة والموسيقى. كن قادرا على اختراق العالم واخترقه، يقول راجع، ولكن اخترقه بأداة طيعة، اخترقه بأداة سليمة!
الكتابة انكفاء، وهو مالم يمكن لشاعرنا الإفلات منه في فترة حالكة، خيم على وجدان شعرائها أثر نكسة 67، وكآبة العجز والحيرة ونهش الذات. بدا وكأن الجميع يواجهون قدرا سياسيا مفعما بالقهر والعنف، ويتوجب على الكلمة الحرة أن تتصدى له، وتنفعل إزاء الأحداث بروح مفعمة بالأمل والحلم:
"ولست جديرا بكل بلاد
يكون المرور إليها جواز سفر
جدير بكل بلاد جوازاتها أن
تحب القمر
وأن يملأ الكادحون بها المُدنا
لذلك أرحل عنكم وعني
فما وجدت نبضتي مستقرا
ولا جبهتي وطنا."
(جبهة تتغضن قبل الأوان)
والكتابة انهماك، لذا لم يكن شاعرنا ذاتا تحاور العالم فحسب، وإنما سعيا محموما لتأسيس قصيدة مغربية معاصرة، تضيء جغرافيا شبه منسية في قوائم الشعراء. لقد حاصر الكتابة وحاصرته ليستكمل بمسؤولية والتزام، ما بدأه جيل الستينات قبله، أمثال محمد السرغيني، وأحمد المجاطي، وعبد الكريم الطبال، ومحمد الخمار، ويفسح للخصوصية المغربية موطئ قلم في ديوان العرب:
"ها وردة أولى:
هي الأرض التي تحبو على
كتفي، تترك في القصيدة
لحمها
وأنا امتداد الحلم في الجسد
المحاصر بالكتابة
لاشيء ينقذني من الأرض
التي تمشي
سوى الأرض التي تأتي
وليس رحيل أحبابي سوى
مر سحابة."
(تروبادور)
***
حميد بن خيبش
.......................
1- شعبان يوسف: شعراء السبعينات. المجلس الأعلى للثقافة 2001.
2- جهاد فاضل: أسئلة الشعر. الدار العربية للكتاب