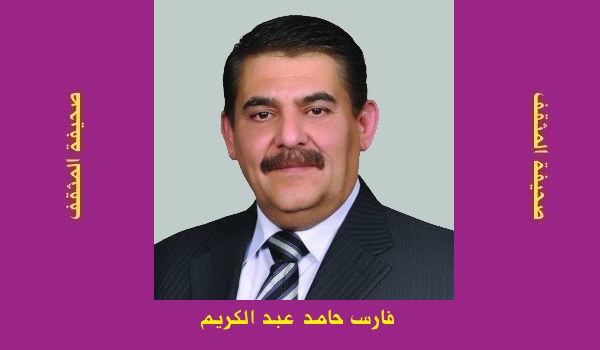قراءات نقدية
أمجد نجم الزيدي: فضاء الانكشاف والإنكار في المخيال العربي

نجد أنفسنا وفي نص (مكان للسباب) الذي نقله محمد المنسي قنديل ضمن كتابه "وقائع عربية" (دار الشروق، 2021)، إزاء سردية ذات طابع أسطوري تحاول عبر التخييل أن تفكك البنية العميقة للوعي العربي، وخاصة في لحظاته المؤسسة في زمن ما قبل الإسلام، لا من أجل استحضار مجد ماضٍ مزعوم، بل لكشف التصدعات الأولى في خطاب الفخر والأنساب والعصبيات التي صنعت تلك الهوية، يحمل هذا النص في طياته، رغم صيغته الحكائية البسيطة، بناءً ثقافياً معقداً يكشف عن التوتر الاجتماعي والقيمي، حيث يُختزل المجتمع في مكان طقسي مخصص للسباب، كأن الكلمة القذرة هي الأثر الباقي الوحيد في زمن انهارت فيه المعاني الكبرى.
ليس المكان الذي يدعى "صفي السباب" مجرد حيّز جغرافي، بل هو مساحة رمزية، تمثل التناقض العميق بين القداسة المكانية لمكة والممارسات الدنيئة التي تحدث على هامشها، هذا الانفصام بين الفضاء المقدس والممارسة المنحطة، يشي بأن الانحطاط ليس فعلاً عارضاً، بل مؤسساً في بنية الجماعة، فذكر الأنساب والمفاخرة والسباب ليست إلا تمثيلات لأوهام التفوق والامتياز، لكنها في حقيقتها لا تنفصل عن شهوة السلطة والعنف والتمركز الطبقي، أو كما يقول النص (يعلون بمفاخرهم على الآخرين للمرة الألف، ثم تأخذ كل جماعة في الطعن في نسب الأخرى وتبالغ في معايبها وهوانها على الناس).
يقدّم قنديل في هذا النص، قراءة معكوسة للسردية البطولية العربية التي لطالما مجّدت النسب والقبيلة، فبدلاً من أن تُصور تلك الأنساب بوصفها دليلاً على النبل، تتحول إلى أدوات للتهكم والطعن، بل ويكشف النص أيضاً عن أن الأنساب، التي يُفترض أن تكون حصناً للهُوية، تُستخدم كقنابل لفظية تُلقى في معركة لا تشبه معارك الفرسان، بل تشبه معارك الضواري في برية من الكراهية (ينزعون من على أجسادهم العباءات الثمينة ويقفون نصف عرايا، تستيقظ الضواري الرابضة في أعماقهم وتفرد مخالبها)، فيكشف هذا المشهد عن تَحَوُّل الجماعة من بشر إلى كائنات مفترسة بمجرد أن يُستفز الخطاب الهوياتي.
ثم تأتي المفارقة حين ينتقل النص من طبقة السادة إلى طبقة الموالي والعبيد، حيث يتحول فعل السباب إلى ممارسة أكثر عنفاً وتدميراً، فهؤلاء المهمشون، الذين لا يملكون إلا ألسنتهم وسيوفهم في حضرة سادتهم، يمارسون شكلاً من التعويض الرمزي عن تاريخ طويل من القهر، لكن لا تمنحهم الحكاية بطولة أخلاقية، فبدلاً من أن يكون فعلهم مقاومة للظلم، يصبح تماهياً مع خطاب التبعية ذاته، إذ يدافع كل عبد عن سيده ويشتم سادة الآخرين، كأنهم تماهوا مع موقعهم القيمي إلى حدّ تبني أدوات القامع (كل منهم يدافع عن سادته ويعيب سادة الآخرين، كانوا في العادة أكثر انفعالا من السادة، ينفسون من خلال السباب عن حنق أيام العبودية الطويلة).
وتمضي الحكاية لتغوص في طبقة أكثر هشاشة وجرحاً؛ وهي الجواري، إذ لا تخوض هؤلاء النساء المعركة من أجل الفخر أو الدفاع عن السادة، بل من أجل حكايات العذاب، من أجل جراح الجسد والروح التي لم تندمل، هنا يغدو السباب فعلاً وجودياً، ليس ضد الآخر، بل ضد العالم، ضد القدر، ضد الذكريات الموجعة (يتشاجرن حول نظرات الاحتقار وآهات الاحتضار والإحساس الدائم بالانكسار)، تكشف الحكاية عن الجانب الأكثر مأساوية في هذه الحفلة الجماعية للسباب، حيث تتحول الجروح الفردية إلى مادة صراخ جماعي لا يسمعه أحد.
يشارك الجميع في حفلة الانحطاط الجماعي التي يقيمها المكان الذي لم تبرحه الغربان، فلا أحد ينجو من الإدانة في هذه الحكاية (كانت تترقبهم جميعا في صمت حصيف، وتنتظر من يسقط منهم دون أن تبالي من السابب ومن المسبوب)، ليست تلك الغربان مجرد طيور، بل رموز لعقل محايد، يراقب دون أن يتورط، كأنها تمثل الحقيقة، أو الذاكرة التي لا تُخدع بالشعارات، ذاكرة صلبة لا تنحاز سوى لتوثيق ما يجري، تحفظ التفاصيل، وتعيدها للزمن كمرآة قاسية لا ترحم، وتذكّر بأن الخراب لا يُقاس بعدد الجثث فقط، بل بعدد المعاني التي تُهدر.
يقدم النص في النهاية قراءة فاحصة للثقافة العربية التأسيسية، بوصفها لحظة موغلة في الصراع والتفكك والنفاق، لحظة تكشف عن بنية عميقة من التواطؤ بين السلطة والعرف، إن «مكان السباب» هو استعارة كبرى، ليس للماضي فقط، بل للحاضر أيضاً، حين تُستبدل العدالة بالانتقام، والكلمة بالبذاءة، والتاريخ بالفضيحة، ويغدو الوعي الجمعي أسيراً لدائرة لا تنتهي من الإقصاء المتبادل وإعادة إنتاج العنف الرمزي.
ولعل الكتابة هنا ليست فعل حكيٍ ماضٍ، بل مرآة سوداء نُطل منها على وجوهنا كما هي، دون أقنعة، فهل نحن –بألسنتنا، بخطاباتنا، بتحزّباتنا– إلا امتداد لذلك السباب الأول؟ أليس التاريخ العربي، في أحد تجلياته، صراعاً دائماً على النسب والحق والكلمة، لكنه غالباً ما ينتهي إلى قذف الحصى والصراخ في العراء؟ (ويظل الصدى يردد بقايا كلماتهم القذرة حتى بعد انصرافهم)، في دلالة مريرة على أن اللغة، حين تُستنزف في السباب، تبقى كندبة لا تزول، كصدى يشوه المكان والزمن والذاكرة.
***
أمجد نجم الزيدي