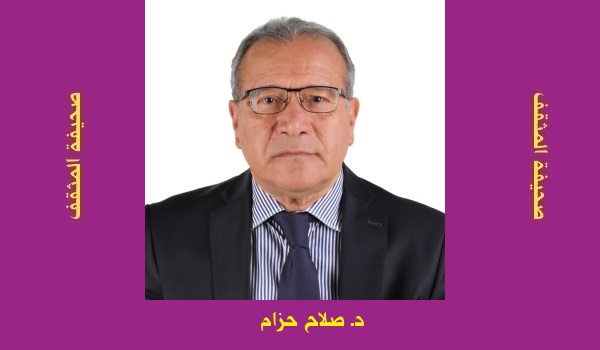قراءات نقدية
صباح بشير: "في بعض تجلّيات السّيرة الفلسطينيّة" للأديب محمود شقير

نافذة على الذّاكرة والهويّة
لقد شدّني كتاب "في بعض تجلّيات السّيرة الفلسطينيّة- قراءات" للأديب محمود شقير، فأفضت في دراسة نقديّة مطوّلة عنه، ضمّنتها في كتابي "نفحات من النّقد"، الّذي صدر حديثا عن نادي حيفا الثّقافيّ ودار الشّامل للنّشر والتّوزيع، وخلال مشاركتي في أمسية إشهار الكتاب في نادي حيفا الثّقافيّ بتاريخ (18.09.2025)، قمت بعرض مقتطفات منها، لكنّني هنا انشرها كاملة؛ لتكون متاحة بين أيدي القرّاء والمهتمّين.
السّيرة، نافذة على الرّوح والتّاريخ:
يجمِع النّقّاد على أنّ كتابة السّيرة، سواء كانت ذاتيّة أم غيريّة، تمثّل ركنا أساسيّا في صرح الأدب، فهي لا تقتصر على سرد الأحداث، بل تتجاوز ذلك؛ لتصبح شاهدا حيّا على التّاريخ والذّاكرة الجمعيّة، من خلالها تتجلّى التّحوّلات الاجتماعيّة والثّقافيّة، وتُسمَعُ أصوات قد لا يجد لها التّاريخ الرّسميّ مكانا، كاشفة عن دوافعها وصراعاتها، وتاركة القارئ يتأمّل في قضايا الوجود والهويّة والحبّ والفقد، فهي مرآة تعكس تجربة الإنسان بكلّ تعقيداتها، وتُسهِم في فهم الذّات والآخر، وتتيح فرصة للتعلّم من تجارب السّابقين وأخطائهم، وتقدّم نماذج للصّمود والمثابرة، معززةً بذلك التّفكير النّقديّ في مسارات الحياة.
كما تبرز السّيرة تداخل الأدب بالواقع، فعلى الرّغم ممّا يكتنفها من صياغات فنّيّة، إلّا أنّها تتغلغل في أحداث حقيقيّة، مُظهِرةً قدرة اللّغة على تشكيل الواقع وإعادة تفسيره، وهي وسيلة فعّالة للتّعبير عن الهويّة والخصوصيّة، ومقاومة أي ّمحاولة للطّمس أو التّهميش، لتؤكّد بذلك على ثراء التّجربة الإنسانيّة وتنوّعها.
يُعَدّ فيليب لوجون من أهمّ المنظّرين في مجال السّيرة الذّاتيّة، فأطروحته الأساسيّة تدور حول الميثاق الأوتوبيوغرافي، حيث يرى أنّ هناك عقدا ضمنيّا بين الكاتب والقارئ في السّيرة الذّاتيّة، يلتزم فيه الكاتب بتقديم سرد صادق وموثوق عن حياته، ويتوقّع القارئ هذا الصّدق.
لقد أيقن العديد من الدّارسين أمثال جيمس أولني، وجورج غوسدورف، وسيرج دوبروفسكي، وغيرهم، أنّ السّيرة هي إعادة تشكيل للأنا، تستند إلى معطيات الذّاكرة، وتتجلّى في كيفيّة تصوير الكاتب لذاته بأبعادها المتعدّدة.
في كتاب الأديب محمود شقير، "في بعض تجليّات السّيرة الفلسطينيّة- قراءات"، نجد هذا الفهم العميق يتجلّى في تحليلاته الواعية، حيث يُسلّط الضّوء على فرادة السّيرة الفلسطينيّة، وتشابكها مع الذّاكرة الجمعيّة وتاريخ النّضال؛ ليعيد صياغة الذّات في سياق يجمع بين الشّخصيّ والوطنيّ، مقدّما بذلك نموذجا فريدا، يزاوج بين الحكي الفرديّ ومآسي شعب بأكمله.
صدر هذا الكتاب عن نادي حيفا الثّقافيّ ودار الشّامل للنّشر والتّوزيع، وهو يقع في ثلاثمئة وتسع وأربعين صفحة من القطع الكبير، وهو رحلة آسرة وغوص عميق في لجج السّيرة الفلسطينيّة، تتجاوز حدود الوثيقة الصّمّاء؛ لتغدو منبرا شامخا للصّمود وبوتقة تتّقد بالإبداع، وشاهدا ساطعا على العلاقة الّتي لا تنفصم بين الإنسان والأرض.
"في بعض تجلّيات السّيرة الفلسطينيّة".. نافذة على الذّاكرة والوجدان:
يهدف هذا الكتاب التّوثيقيّ إلى تعزيز حضور السّيرة في حياة النّاس، فهو يبرز الأدب الفلسطينيّ كشاهدٍ حيّ على تحوّلات الزّمن، يروي قيَم التّفاؤل ويعكس أبعاد المأساة، ويؤكّد أنّ مدينة القدس، هي رمز متجذّر في الوجدان الفلسطينيّ، تظلّ نورا يُبصَرُ به الدّروب.
يقدّم تحليلا لباقةٍ من السِّيَر الذّاتيّة والغيّريّة واليوميّات والمراسلات لشخصيّات بارزة، متوغّلا ببراعة في هذه النّصوص، كاشفا كيف تتجلّى فيها مختلف منعطفات التّاريخ الفلسطينيّ المعاصر، بدءا من فجائع النّكبة والنّكسة، وصولا إلى أدقّ تفاصيل الحياة اليوميّة.
يتوقّف الكاتب عند الأعمال الّتي تناولت القدس، يحكي بعمقٍ وشغفٍ عن علاقته برموز ثقافيّة ووطنيّة وسياسيّة، ويتساءل في افتتاحيته بأسلوب بلاغيّ عميق عن مدى حاجتنا إلى كتب السّيرة، سواء كانت ذاتيّة أو غيّريّة، وإلى إبراز تجلّيات المكان الفلسطينيّ وسماته، مجيبا بقناعة أنّ هذه الحاجة ملحّة للغاية، لا سيما في ظلّ محاولات طمس تاريخنا، يرى أنّ السِّيَر الّتي يكتبها الفلسطينيون على اختلاف توجّهاتهم الفكريّة والسّياسيّة، تكتسب أهمّيّة بالغة، فهي تجسّد العلاقة الوثيقة بين الإنسان وأرضه، وتعزّز الانتماء الوطنيّ من خلال تفاصيل الحياة اليوميّة الّتي يصعب تجاهلها أو إنكارها.
يتناول الكتاب عدّة محاور رئيسية، منها: أهمّيّة السّيرة الذّاتيّة والغيريّة الفلسطينيّة، وسيرة الكاتب الذّاتيّة وعلاقته بالمكان.
يستعرض شقير تجربته الشّخصيّة مع كتابة السّيرة، موضّحا كيف أسهمت تجربته في المنفى وعودته إلى القدس في تشكيل رؤيته لأهمّيّة توثيق السّيرة، مشيرا إلى أنّ بعض كتب السّيرة، تناولت الرّسائل بشكل مباشر أو غير مباشر، مساهمةً بذلك في تحفيز الكتّاب والمثقّفين على تدوين تجاربهم. وعلى الرّغم من هذا الجهد، يقرّ الكاتب بتواضع، أنّه لم يُحِط بكلّ ما كُتِبَ في فنّ السّيرة الفلسطينيّة، داعيا إلى إثراء هذا المجال الحيويّ بمزيد من الكتابات الأصيلة، مشيرا إلى وجود أعمال متميّزة أخرى لم يتناولها، سواء كانت سِيرا ذاتيّة أو غيريّة لأدباء ومفكّرين، أو كتبا عن المكان الفلسطينيّ، أو مذكّرات.
هذا الإقرار يؤكّد أنّ الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من الكتابة عن السّيرة بشتّى تجليّاتها، وذلك لتعزيز الوعي بالهويّة والحفاظ على الذّاكرة الجماعيّة.
رحلة من المكان إلى الذّاكرة:
يستعرض شقير رحلته الأدبيّة والشّخصيّة الّتي شكّلت أساس كتاباته السِيَريّة. يبدأ سرده بالعودة إلى عام (1995م) حين اقترح عليه الشّاعر محمود درويش، أثناء إعادة إصدار مجلّة "الكرمل" في رام الله، أن يكتب نصّا عن مدينة القدس من منطلق كونه مواطنا مقدسيّا.
تطوّر هذا النّصّ ليصبح كتاب "ظلّ آخر للمدينة"، الّذي يروي سيرة القدس من منظور شقير الخاصّ، وعلاقته بالمدينة منذ طفولته، فيبرز ارتباطه الوثيق بالقدس، الّذي لم ينقطع عنها إلّا عندما تمّ إبعاده عام (1975م) إلى لبنان، حيث قضى ثمانية عشر عاما في المنفى قبل أن يعود إليها عام (1993م).
هذه التّجربة الحياتيّة شكّلت دافعا قويّا له ليؤمن بضرورة كتابة السِّيَر الذّاتيّة والغيريّة، وتسجيل العلاقة المتجذّرة بين الفلسطينيين ومكانهم. لم تقتصر تجربته في السّيرة على القدس وحدها، بل تجلّت علاقته بالمكان والزّمان في عدّة مؤلّفات، ففي كتاب "مدن فاتنة وهواء طائش"، تناول علاقته بالقدس ورام الله وثلاث عشرة مدينة أخرى حول العالم.
أمّا في "مرايا الغياب.. يوميّات الحزن والسّياسة"، فقد كتب فيه عن علاقته بشقيقته الرّاحلة أمينة، وبقادة سياسيين كبار مثل: سليمان النّجاب وبشير البرغوثي، والأديب الأردنيّ مؤنس الرزّاز.
كما أصدر "قالت لنا القدس" عام (2010م)، و"مديح لمرايا البلاد" عام (2012م)، وكلاهما يعكسان جوانب من حياته الشّخصيّة وعلاقته بالقدس، ويكشف عن ولعه بقراءة كتب السّيرة، سواء لكتّاب فلسطينيين أو عرب أو أجانب، مثل: معين بسيسو، رضوى عاشور، بابلو نيرودا، وذلك لما تحمله من صدق وتفاصيل شخصيّة، لكنّه يعرب عن عدم استساغته لأسلوب بعض الكتّاب الّذين يدخلون عنصر الخيال في سيَرِهم الذّاتيّة، مثل ربعي المدهون، مؤكّدا أنّ السّيرة الّتي يتخلّلها الخيال تتحوّل إلى سيرة روائيَّة أو رواية سيريَّة، كما هي الحال في رواية إبراهيم نصر الله "طفولتي حتّى الآن".
في هذا السّياق، يوضّح الكاتب أنّ رباعيّته الرّوائيّة الّتي حملت أسماء مثل: "فرس العائلة" و"مديح لنساء العائلة"، ليست سيرة ذاتيّة لعائلته بالمعنى الحرفيّ، بل هي أعمال روائيّة استفادت من بعض تجارب عائلته، لكنّها احتوت شخصيّات وتجارب متخيّلة.
السّيرة، وتعزيز حضورها:
لم يكتفِ شقير بكتابة سيرته الخاصّة، بل أسهم أيضا في إعداد كتب سيريّة مخصّصة للفتيات والفتيان عن مدن فلسطينيّة، كما أعدّ كتبا عن شخصيّات أدبيّة وفنّيّة بارزة، مثل الشّاعرة فدوى طوقان والأديب غسّان كنفاني، والفنّان إسماعيل شمّوط وزوجته الفنّانة تمام الأكحل، وتعمّق في توثيق حياة شخصيّات سياسيّة من خلال كتب اعتمدت على شهادات معارفهم، مثل: سليمان النّجاب، فائق ورّاد، غسّان حرب، فؤاد نصّار، ونعيم الأشهب. هذا الاهتمام، يؤّكد حرصه على تعزيز حضور فنّ السّيرة في الثّقافة العربيّة.
مع تقدّمه في العمر، رأى أنّ الشّيخوخة تتيح له كتابة سيرته الذّاتيّة بشكل مباشر وموسّع دون حرج، فبدأ بكتابة سيرة أدبيّة بعنوان "أنا والكتابة.. من ألف باء اللّغة إلى بحر الكلمات"، سرد فيها علاقته بالكتابة، وَتَوَّج هذه الرّحلة بكتابيّ سيرته الذّاتيّة: "تلك الأمكنة" و"تلك الأزمنة".
في "تلك الأمكنة" يصف تفاصيل حياته، مستخدما مقولة "أكتبُ لعلّ العالم يصبح أجمل، ولعلّ الشّر يكون أقل" (ص13)؛ كمنهج لحياته وكتاباته، مع حرصه الشّديد على الاستفادة من تقنيّات السّرد الرّوائيّ وتوخّي الصّدق في الكتابة وعدم المبالغة في مديح الذّات. أمّا في "تلك الأزمنة"، فقد استكمل ما لم يظهر من سيرته، متطلّعا إلى بلوغه الثّمانين، رافضا اليأس الّذي قد يصاحب هذا العمر، ومنحازا إلى الفرح والحياة.
يَختتمُ هذا القسم بالإشارة إلى كتاب سيرته الذّاتية القادم "هامش أخير"، الّذي يتناول علاقته النّاضجة بالكتابة، وتفاصيل حياته اليوميّة في زمن الشّيخوخة.
هذا الجزء من الكتاب يقدّم نافذة فريدة على الالتزام العميق بفنّ السّيرة كوسيلة لتوثيق تجربته الشّخصيّة، وأداة قويّة للحفاظ على الذّاكرة الجمعيّة وتعزيز الانتماء.
محمود درويش.. الغياب وإرث الإبداع:
يتناول الكاتب غياب الشّاعر محمود درويش، مسلّطا الضّوء على الأسباب الّتي أدّت إلى وفاته والأثر العميق لرحيله، عاكسا العلاقة الشّخصيّة العميقة الّتي كانت تربطه به، مبرزا مكانة درويش الأيقونيّة والأثر الشّامل لغيابه الّذي ترك فراغا هائلا لم يقتصر عليه شخصيّا، بل امتدّ ليشمل كلّ ما كان يحيط به من تفاصيل الحياة اليوميّة، وأنّ العزاء الوحيد في هذا الرّحيل يكمن في إرثه الإبداعيّ الخالد في الوجدان الفلسطينيّ والعربّي. يقول (ص18): " غاب محمود في لحظة قاسية مؤلمة، وليس ثمَّة من عزاء إلّا فيما تركه من إرث إبداعيّ مدهش خلَّاق". يكتب عن أوّل لقاء له بدرويش عام (1975م) في بيروت، لافتا إلى تزامن تاريخ ميلادهما (ص20): "ولدته أمّه في البروة/ عكّا بتاريخ 13 / 3 / 1941، وولدتني أمّي في القدس بتاريخ 15 / 3 / 1941، وعملنا معا في الاتّحاد العام للكتّاب والصّحافيّين الفلسطينيّين، حيث كان هو رئيسا للاتّحاد وكنت أنا عضوا في الأمانة العامّة، وعملنا معا في لجنة جوائز فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة، حيث كان هو رئيسا للّجنة وكنت أنا أمينا للسّرِّ فيها".
يشير إلى فرصة لقائهما الضّائعة في حيفا عام (1968م)، مفسّرا كيف أنّ أعمال درويش وسميح القاسم وتوفيق زيّاد وغيرهم من شعراء الدّاخل، شكّلت صدمة إيجابيّة للوعي العربيّ، بِشِعرِها المتمرّد الّذي يجسّد المقاومة والتّشبّث بالأرض والهويّة، ويوضّح كيف أنّ درويش بعد لقائهما في بيروت، كان قد قطع شوطا متقدّما في مسيرته الشّعريّة، الّتي صقلها وطوّرها لتصل إلى الذّروة، ما جعله من أبرز شعراء العصر، متمكّنا من التّعبير عن القضيّة برؤية تتجاوز المباشرة والتّنميط، متمرّدا على المفاهيم المتزمّتة الّتي سعت لحصره في إطار معيّن، فظلّ وفيّا لتجربته الشّعريّة، ومخلصا لقضيّته الفلسطينيّة بأبعادها المأساويّة والإنسانيّة.
شقير والقدس.. وشائج المكان والعودة:
يتناول هذا القسم العلاقة الوجدانيّة العميقة الّتي تربطه بمسقط رأسه القدس، مستعرضا رحلته بين المدن الفلسطينيّة والعالميّة، مبرزا أثر المكان في تشكيل تجربته الحياتيّة والأدبيّة، مقدّما صورة حيّة لرحلته الشّخصيّة والمهنيّة، وكيف تداخلت هذه الرّحلة مع عشقه للمدن الفلسطينيّة، خاصّة القدس التّي تمثّل جذوره وهويّته. يُفرِد مساحة خاصّة لمدينة رام الله الّتي يصف مكانتها في قلبه، ويتحدّث عن عمَّان، بيروت، تونس، القاهرة، دمشق، الدّار البيضاء، براغ، فيينّا، لندن، باريس، نيويورك، وأيوا الأمريكيّة الّتي شارك فيها عام (1998م) في برنامج الكتابة الدّوليّ، مع ثمانية عشر كاتبا وكاتبة من العالم، وكانت الكوريّة "هان كانغ" الّتي فازت بجائزة نوبل للآداب لعام (2024م) مشاركة معهم في ذلك البرنامج (ص25). وبعد عودته إلى القدس، بعد غياب قسريّ دام ثماني عشرة سنة، عمل محرّرا، ثمّ رئيس تحرير لصحيفة "الطَّليعة" المقدسيّة الأسبوعيّة، وانضمّ إلى وزارة الثّقافة لمدة عشر سنوات، متنقّلا يوميّا بين القدس ومقرّ الوزارة في رام الله. كانت تلك السّنوات حافلة بالأنشطة الثّقافيّة داخل البلاد وخارجها، مع مواظبته على كتابة القصص.
يقول: إنّ رام الله وبيت لحم، بعد القدس، هما مدينتان تتميّزان بالتّعايش المسيحيّ الإسلاميّ والانفتاح على الحياة العصريّة، مع وجود النّوادي والمقاهي المشتركة، ويعرب عن سعادته بزيارة مدن فلسطين وقراها، تلك الّتي ألهمته قصصه الأولى مثل "خبز الآخرين"، ثمّ يصف روتينه اليوميّ المفعم بالكتابة والقراءة المتنوّعة ومشاهدة الأفلام العالميّة، يعيش بتفاؤل وإقبال على الحياة، معلنا عن قناعته بالبقاء في الوطن وعدم السّفر، بعد أن زار أكثر من أربعين بلدا. أمّا القدس، فهي بالنّسبة له المدينة الأولى الّتي "أبهجته وعذّبته"، هي معلمته في التعدّديّة والتّسامح ومنها تَشكّل وعيه، وبعد الإبعاد المرير عاد إليها ليثبت جذوره فيها حتّى النّهاية. يقول (ص31): "لم تبهجني مدينة مثل القدس، ولم تعذِّبني مدينة مثلها".
يروي كيف كان يرتاد المكتبات في القدس ويترجم بعض القصص القصيرة، ويلقي الضّوء على حضور القضيّة في الرّواية العربيّة، مستشهدا بأعمال لروائيّين عرب، على رأسهم اللّبنانيّ الياس خوري، الّذي عكست رواياته "باب الشّمس" وثلاثيته "أولاد الغيتو" تفاصيل القضيّة ببراعة، ويشيد بالرّوائيّ الجزائريّ واسيني الأعرج وروايته "سوناتا لأشباح القدس"، والعراقيّ علي بدر وروايته "مصابيح أورشليم" الّتي اعتمدت على سيرة إدوارد سعيد لتفكيك رواية الآخر، ويضيف إليهم الأردنيّ إلياس فركوح في "غريق المرايا"، والعراقيّ زهير الجزائريّ في "المغارة والسّهل" الّتي تناولت المقاومة بعد نكسة (1967م)، ثمّ يعتذر عن أيّ تقصير في استعراض كلّ الأعمال الرّوائيّة، فهناك المزيد من الرّوايات المخلصة للدّفاع عن قضيّتنا وشعبنا.
تأثير "هيمنغواي" على محمود شقير.. أسلوب حياة:
يعبّر شقير عن إعجابه العميق بإرنست هيمنجواي منذ قراءاته الأولى في الثّانية والعشرين من عمره، فقد أسره أسلوبه السّهل الممتنع، وطريقته الماكرة في التّخفّي خلف النّص. هذا التّأثّر تزامن مع فترة ازدهار ثقافيّ في القدس خلال السّتينيات، حيث انخرط في مجلّة "الأفق الجديد" الّتي عرّفته بالأدب العالميّ المترجم.
أيضا، من خلال مجلّة الآداب اللّبنانيّة، تعرّف على الكثير من الكتب، يقول (ص35): "تعرَّفت جرَّاء ذلك إلى كتب هيمنجواي، جون شتاينبك، ألبير كامو، جان بول سارتر، أرسكين كالدويل، كولن ويلسون وآخرين". وتحوّل إعجابه بكتب هيمنغواي إلى شغف بالغ، ما دفعه لترجمة قصصه.
لم يتوقّف التّأثّر عند الأدب، بل امتدّ ليشمل حياته اليوميّة، فصار يرتاد المقاهي مع رفاقه، محاكاةً لهيمنغواي، حاملين الكتب دائما دلالة على التزامهم الثّقافيّ.
يذكر أنّ الحركة الثّقافيّة في القدس، تأثّرت بشدّة بعد النّكسة عام (1967م)، ممّا أدّى إلى الرّكود الثّقافيّ، فلم يتمكن من معاودة التّواصل مع كتب هيمنغواي إلّا بعد إبعاده من الوطن عام (1975م).
الكتابة للقدس والحياة:
تحت عنوان "نكتب للقدس وللحياة" (ص41)، يذكر أنّه رغم انشغالاته، لبّى دعوة لزيارة مركز يبوس الثّقافيّ بالقدس، حيث التقى مجموعة من الشّباب الموهوبين في دورة الكتابة الإبداعيّة، وقد أدرك الجهد المبذول في جمعهم لتنمية مواهبهم، والرّغبة العارمة لدى هؤلاء الشّباب في اكتشاف أسرار الكتابة وصقلها بالممارسة والقراءة الجادّة. استمع إلى نصوصهم، وتيقّن أنّهم يمتلكون مواهب واعدة، يمكنها أن تتطوّر لتُقدِّم للقدس والأدب كُتّابا قادرين على حمل رسالة الوطن والحقيقة والجمال. ويكتب عن يوميّات خليل السّكاكيني، واصفا إيّاها بالصّورة الحيويّة للقدس في النّصف الأوّل من القرن العشرين، أظهرت دوره كمربٍّ وأديب ومفكّر، حيث ساهم في تحديث التّعليم ونشر الوعي، وكان بيته مركزا ثقافيّا وملتقى للأدباء.
القدس في ذاكرة الأسرى:
في هذا القسم، يسلّط الضّوء على حضور القدس كرمز محوريّ في أدب السِّيَر الذّاتيّة واليوميّات الّتي كتبها الأسرى والأسيرات، مبرزا دور هذه الكتابات في توثيق تجربتهم ومعاناة المدينة، بحيث تتحوّل إلى فعل إبداعيّ، يؤكّد على التّمسّك بالحياة والأمل.
كما يصور في سيرته لحظات اعتقاله الأولى، وكيف تحوّل المكان (المسكوبيّة) من واحة تاريخيّة إلى بناية متجّهمة. يصف السّاعات الأولى من اعتقاله عام (1969م) واقتياده ليلا من بيته، فيكتب (ص69): "القدس تنام الآن في سكون الفجر، وستصحو بعد قليل من نومها، فتعرف أنّني لم أعد قادرا على التّجوال في شوارعها وأزقّتها، فتضيف إلى أحزانها المتراكمة حزنا جديدا. أسير صامتا، متهيّبا ممّا تبيّته لي الأيّام القادمة، ويسير الضّابط صامتا".
أيّام زمان.. مقدسيّون يروون الحكاية:
في هذا الفصل، يتحدّث شقير عن حوارات أجرتها الصّحافيّة ديما نادر دعنا مع أكثر من أربعين شخصيّة من نساء ورجال القدس.
تقدّم هذه الحوارات نافذة على منعطفات التّاريخ الفلسطينيّ المعاصر، بدءا من بوادر الوعي بخطر الاحتلال والثّورات المتتالية، وصولا إلى النّكبة والنّكسة، وما أعقبهما من انتفاضات وأحداث مفصليّة.
نجد شهادات حيّة وسِيَرا متكاملة، تبرز واقع القدس عبر حياة أهلها، وتلقي الضّوء على حياة الأشخاص من خلال المدينة. ثمّ يتطرّق للباحثة نسب أديب حسين، الّتي كتبت عن دور المتاحف في الصّراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، مبرزة أهمّيّتها في تثبيت الرّواية والهويّة الثّقافيّة الفلسطينيّة، خصوصا في القدس.
بانوراما من الذّكريات والإبداعات:
في هذا الجزء، يستعرض أعمالا ومذكّرات وإصدارات لعدد من الكتّاب، مقدّما بانوراما غنيّة تضيء جوانب متنوّعة من التّجربة الفلسطينيّة. يشير إلى أحلام بشارات الّتي كتبت عن المطبخ الفلسطينيّ، مستعرضة مزاياه ووجباته المتنوّعة، ما يعكس عمق الارتباط بالأرض والتّراث. ينتقل بعدها إلى الأديب أسعد الأسعد، ثمّ يقدّم أسماء أخرى مثل: أسماء عيسى سلامة، أسنات كامل إبراهيم، أيمن الشّرباتي، جمال زقّوت، حسام زهدي شاهين، حنان بكير، رشيد النّجّاب، د. صافي صافي، د. عدنان شقير، وطلعت الصّفدي.
يتناول بعد ذلك الأديب جميل السّلحوت، مستعرضا سيرته الذّاتيّة "أشواك البراري" و "من بين الصّخور"، يصفها بأنّها مشاهد موجزة ومتوالية، تتّسم بالتّشويق وسلاسة اللّغة، تتدفّق من ذاكرة يقظة قادرة على تسجيل أدقّ التّفاصيل من أزمنة مختلفة. كما يذكر السّلحوت في كتاباته لسيرة غيريّة، خصّ بها ابن عمّه وشقيقه داوود.
يتحدّث بعد ذلك عن كتاب المحامي فؤاد مفيد نقّارة رئيس نادي حيفا الثّقافيّ، "صيّاد.. سمكة وصنّارة"، فيكتب (ص158): "إنّ هذا الكتاب يضيف إلى علاقة الفلسطينيّين بالبحر أفقا جديدا، ويوسّع الفضاء الّذي تشغله الثّقافة الفلسطينيّة، بحيث ترتقي مكانة فلسطين بثقافتها الإنسانيّة المتنوّعة، وتتأكّد على نحو واضح حقيقتها الحضاريّة، العصيّة على المحو أو التّجاهل أو الطّمس أو الإلغاء".
ثمّ يشير إلى الكاتب كميل أبو حنيش الّذي يتّخذ من المقالة شكلا فنّيّا؛ ليمرّر من خلالها أفكاره ورؤاه، ويتطرّق إلى رواية الشّاعر ماجد أبو غوش "عتبة الجنون"، ويذكر كذلك إسهامات د. محمّد شحادة، والكاتب محمّد صبيح عن عمّه الدّكتور محمود صبيح الّذي "جدّ فوجد" (ص176).
أسماء في الذّاكرة:
يتناول شقير علاقته بأسماء بارزة في عالم الأدب والثّقافة، سواء عبر لقاءات شخصيّة جمعته بهم، أو من خلال معرفته بمسيرتهم، يركّز على تأثير هذه الشّخصيّات في مسيرته الفكريّة والإبداعيّة، ويقدّم رؤى حول المشهد الّذي نشأ فيه وتفاعل معه. يستهل هذا القسم بالحديث عن غسّان كنفاني الّذي التقاه في بيروت عام (1965م)، مركّزا على الأثر العميق الّذي تركه كنفاني في وعيه الأدبيّ والسّياسيّ. ومرّة أخرى، يتحدّث عن محمود درويش الذّي التقاه في بيروت عام (1975م)، مبرزا الكاريزما الطّاغية الّتي تمتّع بها، والّتي تشكّلت من جمال شعره، وقدرته على الإلقاء وثقافته الواسعة، ووعيه الفكريّ المتجذّر في نزعة علمانيّة تحترم العقل والإنسان. يكتب بعد ذلك عن عبد العزيز العطّي، تيسير العاروري، حسن مصطفى، راجح السّلفيتي، د. حنّا ميخائيل، خليل السَّكاكيني، حنّا فارس مخول، أحمد سعد، عزّت الغزّاوي، على الخليلي، محمّد أديب العامري، محمّد جوهر، زهدي شاهين، سلمان ناطور، شادية الأشهب، عاطف سعد، وغيرهم.
رسائل ومراسلات.. توثيق للتّواصل الإنسانيّ:
يستعرض شقير كتبا مختارة من أدب الرّسائل، مؤكّدا أنّ الرّسالة، هي شكل حيويّ للتّعبير والتّواصل الإنسانيّ، مستهلّا حديثه عن كتاب "رسائل كسرت القيد" لأسامة الأشقر، مبرزا فيض العذوبة والشّوق الّذي يغمر رسائله الموجّهة إلى حبيبته، يقول عن هذه الرّسائل(ص270): "تفيض عذوبة وشوقا، وتفيض حكمة وبُعد نظر حين يحاور من خلالها الحياة ومنطقها وتجليّاتها، وتمتلئ سخرية وتهكّما حين يتحدّث عن الأوضاع العربيّة المزرية".
يتطرّق لكتاب د. حسن عبد الله "كلمات على جدار اللّيل"، الّذي كُرِّس لدراسة رسائل الأسيرات والأسرى، وأثرها على حياتهم داخل السّجون.
ينتقل بعد ذلك إلى رسائل جميل السّلحوت وصباح بشير، فيكتب (ص275): "الرّسائل مكتوبة بلغة سلسة لا تعقيد فيها ولا غموض، فيها تشويق للقارئ بالنّظر إلى أنّها تأخذ من فنّ السِّيرة الذّاتيّة قسطا، ومن أدب الرّحلات قسطا آخر، ومن السَّرد الأدبيّ القسط الأوفر، وهي تحمل في طيّاتها دعوة صريحة إلى نبذ التّعصّب والتّزمّت والمغالاة في التّمسّك بالعادات البالية وبالتّقاليد الّتي لم تعد مناسبة للعصر الّذي نعيش فيه".
ثمّ يصل إلى رسائل سليمان النجَّاب (ص277)، الذّي حرص على إكثار المراسلات لوالديه وأشقّائه وشقيقاته، وحتّى للأطفال الصّغار في عائلته، وكان يهدف بذلك إلى طمأنة والديه على صحّته والاطمئنان عليهما.
يتناول بعد ذلك، رسائل عمر صبري كتمتو وروز شعبان، ويعود للحديث عن نسب أديب حسين و"مراسلات أبيها"، الّتي جمعت بين رسائل عجاج نويهض وأديب حسين، إلى جانب مراسلات بيان نويهض الحوت ونسب أديب حسين.
في رسالة مؤثّرة (ص285)، يعبّر شقير لحفيدته أصيل سلامة، النّازحة من رفح إلى خانيونس، عن شوقه لاستئناف تبادل الرّسائل الورقيّة الّتي تعطّلت بسبب الحصار، ويعدها باستقبال حافل في بيته بجبل المكبر وفي القدس.
أصداء وتأمّلات:
يُضَمِّن شقير مقالا بقلم الكاتبة سامية عيسى (ص289)، يسلّط الضّوء على كتابه "أكثر من حبّ" الّذي يجمع رسائله المتبادلة مع الرّوائيّة حزامة حبايب، حيث تشير عيسى إلى أنّ هذه المراسلات تتعمّق في هموم الحياة اليوميّة، وتكشف عن الصّعوبات الّتي تؤثّر في الطمّوحات الإبداعيّة، تقدّم نصوصا أدبيّة رفيعة المستوى، وتدفع القارئ إلى التّأثّر والتّأمّل في المشترك الإنسانيّ، مضيئة ما خفي في الذّوات ومبدّدة غموضها.
ثمّ يلحق مقالا بقلم صباح بشير (ص296)، تصف فيه شقير بـ "عميد الأدباء"، محتفية بنَيّله جائزة فلسطين العالميّة للآداب. تُبرِز المقالة تجذّر القدس في أعمال شقير كرمز للصّمود، وتشيد بأسلوبه في القصّة القصيرة، وقدرته على مزج الأجناس الأدبيّة، وتُختَتم بالتأكيد على أنّه "مدرسة أدبيّة" ملهمة.
نقرأ بعد ذلك رسالة مؤثّرة من قمر عبد الرّحمن، موجّهة إليه، تثني فيها على قدرته على تجاوز الأحزان بالكتابة، واعتبارها وسيلة لتساقط الألم وتخفيف الخسائر.
بعدها، نجد مقالا بقلم راسم المدهون (ص304) بعنوان: "حياة في القصص"، يشير فيه إلى قصّة شقير الشّهيرة "خبز الآخرين" كنموذج لقراءته الواعية؛ لواقع النّكبة وامتزاجها بالحياة اليوميّة، مبرزا تأثّره بتشيخوف. عقب ذلك، يُختَتم الكتاب بحوارين أُجريا مع الكاتب مؤخّرا.
الختام.. السّيرة نبض الوطن وذاكرته الخالدة:
في نهاية رحلتنا مع الأديب محمود شقير، يتجلّى لنا هذا العمل بوصفه مرآة صادقة لنُضجِ تجربة أدبيّة رفيعة، خاض غمارها ببراعة واقتدار، فكلماته المترعة بالعفويّة والصّدق، تنساب كجدول رقراق، ترسم ببراعة المدن والشّخوص والأحداث، محافظة على عتبة الصّدق والواقعيّة الّتي لا يساوم عليها.
كما يتّسع هذا العمل؛ ليمتدّ على رحاب الذّاكرة الفلسطينيّة، ناسجا صفحات تتضافر فيها متانة البحث وعذوبة السّرد، مقدّما إلينا بانوراما ثريّة من النّصوص الّتي تتحوّل بين يديه؛ لشهادات خالدة على صمود شعب وابداعه، وتأكيد لا يلين على ارتباطه العميق بالأرض والتّاريخ.
أمّا عن أسلوبه، فهو فصيح عذب مشوّق، يحمل القارئ في تيار من الأفكار والمشاعر، لا يطغى عليه الجانب الفكريّ المجرّد، ولا يبتعد عن رصانة المعرفة؛ بل يقدّم توليفة فريدة تلهم القارئ، تثري فكره وتعمّق وجدانه، هو السّهل الممتنع، كالنّهر الّذي تخفي مياهه الصّافية عمقًا لا تدركه العيون من أول نظرة، إنّه البناء المحكم المتماسك الّذي يبهرك بجماله، دون أن تحيط بسرّ صنعته.
يكمن سرّه في هذه الوداعة المتقنة، فكلماته تحافظ على رونقها، وتنساب كالنّسيم العذب؛ لتلامس القلب والفكر. هذا الأسلوب الفريد هو ما نلمسه في حروف أستاذنا الكبير محمود شقير، فسطوره تدعونا لنرى من خلالها عمق الوطن ونكبته، وعطر الأرض، دون أن يثقل علينا بتكلّف أو ادعاء.
إنّه يقدّم الحكمة والألم والحبّ في ثوب من السّلاسة، يعلّمنا أنّ أقوى الكلمات هي أبسطها، وأنّ أجمل المعاني هي أوضحها، وأنّ الأدب الحقيقيّ يتجلّى في قدرته على تحويل العاديّ إلى خارق، والمألوف إلى ملهم.
من هنا، يُعَدّ هذا العمل الأدبيّ والتّوثيقيّ المتكامل إضافة نوعيّة للمكتبة العربيّة، فهو يعزّز حضور السّيرة في الثّقافة الفلسطينيّة، ويؤكّد أنّ الذّاكرة درع لا ينكسر، يدعو إلى مواصلة الحياة، ويوثّق كلّ ما هو إنسانيّ في وجه التّحدّيات الجسام، ليظلّ الأدب شاهدا على الحقيقة، ودليلا ساطعا للأجيال القادمة.
***
صباح بشير