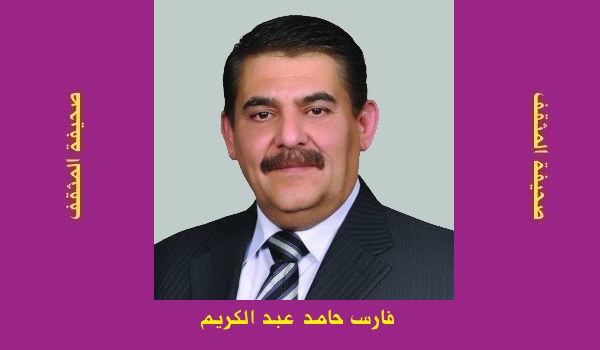قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية موسّعة قصيدة "عذراً، عذراً، لا أحبك"

لإنعام الحمداني.. حسب (النهج الهيرمينوطيقي- الأسلوبي- الرمزي- الجمالي- السيميائي مع غوص في البنى النفسية)
تُقْدِم الاستاذة إنعام الحمداني في قصيدتها هذه على فعل بلاغي ونفسي مزدوج: رفضٌ شخصيٌّ يبدو موجهًا إلى مخاطب حميم، وفي أيقونته تستدعي القصيدة أزمةَ الوجود العاطفي وتدوّيها في مساحة لغوية مُشيّدة من الصمت والنبذ والإيحاء. إن عنوانها التكراري «عذراً، عذراً، لا أحبك» يعلن منذ البداية عن موقفٍ تأبيديّ: لا هو اعتذار تهذّبِي فحسب، ولا هو تنكّر مباغت، بل هو توقّفُ حبٍّ وتحكّمٌ في نفسٍ لا تريد أن تُهان بمسرح التضحية.
- سنعالج النص في هذه الدراسة عبر منظوراتٍ متكاملة: هيرمينوطيقية تأويلية (فهم المقروئية ودوائر المعنى)، أسلوبية (دراسة اللغة والأدوات البلاغية)، رمزية وجمالية (الصور والدلالات الجمالية)، سيميائية (أنظمة العلامات والبُنى النصّية)، ونفسية (آليات الدفاع النفسي، الإحراق والتهديم والبناء مجدداً). كما سنقارب النص في علاقته مع التقاليد الشعرية العربية الحديثة، ومع مناهج النقد الغربي.
أولاً - مقاربة هيرمينوطيقية: دائرة الفهم والتأويل:
- من منظور هيرمينوطيقي: (جادامر، ريكور)، القصيدة ليست مجرد رسالة بل حلقة تركيب بين معطى النصّ وأفق القارئ. العنوان التكراري هو «مدخل هرمنوطيقي» يحدّد أفق التوقع: القارئ يستعدّ لفعل اعتذار لكنه يُفاجأ بالنفي النهائي. هذه المفارقة تُعدّل أفق القراءة: ما بدأ في صورة مخاطبة عاشقة/مخاطب يتحوّل إلى محاكمة للعلاقة ذاتها.
النص يشتغل على طبقتين زمنيتين: زمن السرد (الماضي/الليالي التي مرت) وزمن القرار (الحاضر: إعلان النفي). التداخل يؤسس لحركة تأويلية حيث يصبح الفعل الشعري أداءً كلامياً محمود الآثار: ليس فقط إخبارًا بأنّي لا أحبك، بل إلغاء لشرعية الارتباط وإعادة صياغة للذات المسرودة.
ريكور يذكر أن السرد يمتلك طاقة لإعادة ترتيب الذاكرة: هنا الشاعرة «ترمم حرفها»، أي أنها تعمل سردياً على إعادة بناء الذات عبر الصياغة الأدبية، ليست مجرد إفصاح عاطفي بل فعل وجودي/لغوي.
ثانياً - قراءة أسلوبية: لغةُ القطعِ والأساورُ والبناءُ الإيقاعيّ
1. الاقتصاد اللفظي والإفعالي:
القصيدة توظف اقتصادًا لغويًا واضحًا: جملٌ قصيرة، نفي مباشر، أفعال إنشائية ("لا أكتب لأحد يتربص": إنشائية تحمّل موقفاً). هذا الاقتصاد يقوى على تكرار الصور والعبارات (مثل "عذراً")، ما يمنح النص طاقةً إيقاعية شِعْرَيةً وانتظامًا درامياً.
2. الصور الاستعارية والمجازية:
«كل قصيدة تغتالني» - استعارة مركّبة: القصيدة بوصفها كائناً فاعلًا قادراُ على العنف تجاه الشاعرة نفسها؛ تحكي عن تنافرٍ بين فعل الكتابة وذات المؤلفة: الكتابة تؤلِمها وتغتالها وفي الوقت نفسه تُشكّل هويتها.
«جراحي تئن نازفة / تركتها هناك على قلبك شهيدة» - صياغة درامية تُحوّل الجرح الخاص إلى شاهد، والاعتراف بترك الجرح في قلب الآخر يشي بخبرة الرفض والقدح في الذاكرة المشتركة.
«أروض الليل بحكايات» - فعل ترويض يوحى بتحكم الشاعرة في سُمك الظلام، لكنها تقول "لم أمل سماعها" لأن الحكايات منقوشة "منك وإليك"؛ أي أنها حكايات تسير بين ذاتين لم تعدا تشاطران نفس اللغة.
3. الاستدلالات الصوتية والإيقاع الداخلي:
التكرار الافتتاحي للكلمة «عذراً» والضربات الصوتية الناعِدة (الهمسات الطويلة) تعطي النص طابع اعتذاري مصطنع يتفكك بسرع. وجود صور حسّية ("كوز عسلك") يقطع الرتابة ويعيد ملمساً مادّيّاً للعالم الخارجي، مقرّباً الحسية من التجربة العاطفية.
ثالثاً - الرمز والجمال: ثيمات الهوية، الكرامة، والكتابة كطقس
1. الكرامة- النفي:
النفي "لا أحبك" ليس فقط تحرراً عاطفياً؛ بل فعل ربّاني للحفاظ على الذات. هذا الموقف يُرجعنا إلى ثيمات أنثوية في الشعر الحديث: رفض التضحية الذاتية، المطالبة بحقّ الكلام والوجود. الشاعرة تقول: "لم أكن حبيبتك يوماً / لا أريد أن أنحر مثل الأضاحي" - مقارنة قوية بين التضحية الدينية/الطقسية والاحتفاظ بالذات.
2. الكتابة كطوق نجاة ومصدر ألم:
القصيدة تعرض الكتابة على أنها سيف ذو حدين: "كل قصيدة تغتالني" و"أصوّغ حرفي أساور" - الكتابة تُمزّق وتُزَيّن. إنها رثاء للذات في مواجهة اللغة: الحرف يعذب ويزيّن في آن. هذا التوتر يكشف جمالًا مزدوجًا: الأثر والجرح.
3. الزمن والذاكرة
الليالي المهجورة والصمت الهارب يتصلان بذاكرةٍ مضتْ وأدلة طريفة (أدلة طريدة لا أبالي). هنا الذاكرة ليست تقليدية بل تُروّض وتُصاغ، والشاعرة تتصرف كمؤرِّخة لجرحها.
رابعاً - سيميائية النص: نظام العلامات وبنية الدلالة:
باتباع روبرتيو مونو ونظريات اللغة السيميائية، يمكن قراءة النص كنظام من العلامات التي تتقاطع لتصنيع معنى متماسك:
١ - العلامة (المعنى/الدال): كلمات مثل "عذراً"، "قصيدة"، "جراح"، "صمت"، "جواد" تشكل دلالات متكررة.
٢ - القيم الاختلافية: "الصمت/الكلام"؛ "العودة/الرحيل"؛ "الحب/اللا حب"؛ هذه ثنائيات تشكّل هيكل النص.
٣ - الوحدة المرجعية: المخاطَب غير محدد، لكن البنية تشير إلى علاقة حميمية (عاطفية ـ اجتماعية). الغموض في تحديد المخاطب يوسّع النصّ ويمنحه ٤- :بعداً كلياً: يمكن أن يكون رجلاً، تجربة حب، المجتمع، أو حتى اللغة نفسها.
سيميائياً، النص يُستَجاب عنه عبر عملية تكوين المعنى: القارئ يُكمل الفراغات، ويعمل النصّ كلغزٍ تسلط عليه الشاعرة ضوءاً جزئياً؛ لذا يظلّ التأويل مفتوحاً.
خامساً - التحليل النفسي: آليات الدفاع، الظل، والهوية المختارة:
استنادًا إلى فرويد ويونغ وبعض مفاهيم النقد النفسي الحديث:
1. آليات الدفاع:
الإنكار والنفي: "لا أحبك" كإنكارٍ واعٍ لارتباط قد يهدد استقلالية الشاعرة.
- الإسقاط: تصوير الحبيب كفاعل يغتال أو يترك جروحاً - إسقاط للعنف الداخلي على الخارج.
- التسامي: تحويل ألم الفقد أو الخيبة إلى فعل إبداعي (الكتابة)، رغم كونها تدّعي أن الكتابة تغتالها؛ فيها بالتالي التناقض الذاتي للدّور المُسامي: الألم يولّد الفن، والفن يعيد تشكيل الألم.
2. مفهوم "الظل":
الآخر مُمَثّل في النص بصفات قاتلة (التربّص، التسبب بالجراح)؛ هذه الصور يمكن قراءتها كظل نابع من اللاوعي الجمعي للشاعرة، أي جزء مرفوض منها تسقطه على الآخر. إعلان الرفض عملية تكامل: الشاعرة تختار أن تُخرج ذلك الظل من علاقتها وتضعه أمامها معلناً.
3. الذات والهوية:
إعلان "لم أكن حبيبتك يومًا" هو فعل تأسيسي لهويةٍ جديدة: رفض تعريف الذات عبر علاقة معطّلة. هذه إعادة تأسيس نفسية ـ أخلاقية: الاحتفاظ بالذات، رفض الذبح الرمزي، وتصعيد الكرامة.
سادساً - البُنى التناصية والسياق الأدبي:
القصيدة تتقاطع مع تقاليد الشعر العربي الحديث التي تزخر بصوتٍ أنثوي يرفض التهميش (نجد إشارات لخطاب نازك الملائكة، فدوى طوقان، وأمينة سعد الله)، كما أنها تستثمر رمزيات الحداثة (الليل، الصمت، الجسد، الجواد كعلامة حركة وحُرية). كذلك يحضر في خلفية القراءة حديث النقاد عن الكتابة الأنثوية والرفض من منطلق الكرامة الذاتية (جمال الغيطاني، أدونيس في قراءاته للنص الحديث كتعبير عن الذات الجمعية ـ إنْ كان في سياق تفاوت).
سابعاً - قراءة تفكيكية مختصرة: خطاب الإمكان والتقييد:
من زاوية تفكيكية، النص يُظهر ثنائية "القول/العدم": الشاعرة تقول «لا» لكنها في قولها هذا تفتتح فضاءً من الكلام والتماثل الذاتي. هكذا يُصبح النفي فعلًا بلاغياً وإيجابياً: نفي حبٍ يؤدي إلى ولادة صياغة نقدية للذات واللغة. لذلك، النفي هنا هو لُغةُ تمكّن وليست مجرد قطع.
خاتمة: استنتاجات نقدية:
1. القصيدة فعل وجودي ولغة مقاومة: إعلان «لا أحبك» ليس تهويناً لليأس بل اعتماد لكرامة الذات والكتابة كحتواء وتجديد.
2. الكتابة مزدوجة الأداء: تُؤلِّم الشاعرة وتُهنِّئ نفسها—القصيدة تغتال ولكنها في الغالِب تُصون.
3. الأسلوب اقتصادٌ دراميُّ مؤثر: الاقتصاد اللفظي والتكرار والاستعارات المركبة يمنحان القصيدة كثافة عاطفية وتماسكًا بلاغياً.
4. المنظور النفسي يؤكّد التحوّل: نص الرفض هو نصّ الانتقال النفسي من موقف التضحية إلى موقف الحفاظ على الذات.
5. النص هيرمينوطيقيّاً مفتوح للتأويلات: غموض المخاطب وعمومية الأوصاف يوسّع دائرة القارئ ويمنح القصيدة طاقة تأويلية متعددة.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
..............................
عذرًا، عذرًا، لا أحبك
اسمي لا يشبه أسماء نسائك الأربعين.
ما زال قلبي يحتفظ ببيته،
لا تسكنه كلماتك الباردة.
لا أكتب لأحد يتربص بالحرف،
فكل قصيدة تغتالني،
وجراحي تئن نازفة،
تركتها هناك على قلبك شهيدة.
*
لو علمتم كم من الليالي،
ولى الصمت هاربًا،
ونسي جلبابه،
أدلة طريدة لا أبالي.
أروض الليل بحكايات،
لم أمل سماعها،
لأنها تقص منك وإليك،
مسهدة غافية،
عيون الآسى وعيون من يحب،
جليسة.
*
أغيب بعض الوقت لأرمم حرفي،
وأصوغه أساور تُزين عنوان القصيدة.
لم أكن حبيبتك يومًا،
لا أريد أن أنحر مثل الأضاحي.
كوز عسلك المصفى أبعد من سكر وماء.
لا تستفز صمتي،
هل جربت امتطاء صهوة جوادك،
وتركت العنان للريح كيفما شاءت،
وتقول: لربما يعود؟
*
أيظن الفراق صمتًا وجبروتًا،
سيعود؟
***
إنعام الحمداني