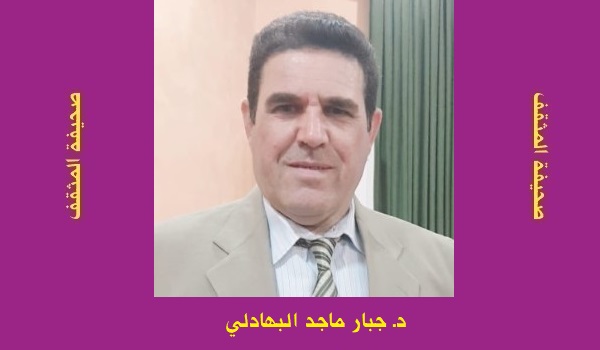قراءات نقدية
جبَّار ماجد البهادليّ: "خِيانَةُ النَّاطورِ".. جَدليَّةُ المُقدَّسِ والمُدَنَّسِ الواقِعي

دِراسَةٌ نَقديَّةٌ في سَرديَّاتِ الوَجع والمُفارَقةِ القِصصيَّةِ
تَقديـمٌ: لا شكَّ أنَّ اللُّغة التعبيرية للكاتب في جنس التسريد القصصي أو أي جنسٍ أدبي آخر على الرغم من كونها مهمَّةُ جدَّاً في صيانة معمارية النصِّ الأدبي وبلاغته الأُسلوبية من حيث بنية الشكل والمضمون والمُعجم، بيدَ أنَّها لم تكن كافية العمل ما لم تلك اللُّغة الفنيَّة قادرةً على أداء وظائفها البنائية والتركيبية، ومهيمنةً على موحياتها الدلاليَّة والمعنويَّة القريبة والبعيدة بإتقانٍ فريدٍ وعالٍ.
والتي من خلالها يجوس القارئ أو المتلقِّي أرض هذه السردية القصصية ويتمكَّن من جَني ثمار حراثتها وبذارها فكريَّاً ودلاليَّاً؛ ليعيش أجواء ومناخات تلك اللَّحظات الروحية الهاربة التي أنتجها مضمون النصِّ الأدبي على شكل حكاياتٍ وأفكارٍ وقصصٍ سرديةٍ مُتجدِّدةٍ ومتواليةٍ تركت آثارها النفسية المُذهلة وانطباعاتها الكليَّة الراسخة، وأظهرت إسقاطاتها الواقعية المُتراتبة على ذهنية القارئ الواعي، وهيمنت فنيَّاً وجمالياً على مَساقط ظلِّه الفكريَّة المُتعدِّدة، واستحوذت على مِساحاتٍ لونيةٍ واسعةٍ من لَدُنِ اهتماماته الذاتية والفكرية ووعيه بتجلِّيات الخطاب السردي الموجه إليه.
إنَّ هذه الفيوضات الّلُّغوية التي أفرزها جماليات القراءة الصحيحة وآليات التلقِّي المعرفي الحديث هي ما تشي به قصص مدوَّنة (خيانةُ الناَّطورِ) للكاتبِ والباحث والأديب والقاصِّ العراقي المثابر لطيف عبد سالم. والِّذي اتَّخذ من أفياء اللُّغة السرديَّة وظلالها المعرفية أداةً فنيةً طيِّعةً في التمكُّن من أدواته التعبيرية القصصية كمبدعٍ واعدٍ بالجمالِ أحكم قبضه الفنيَّة من خلالها على عناصر القصَّة الأساسية، وأركانها الفنيًّة المهمَّة، والتي تمثَّلت في (الشَّخصيَّات الفواعلية، والحِبكة التي هي سلسلة الأحداث الفعليَّة الثابتة والمُتحركة للصراع، ووحدتا البنية المكانيَّة والزمانيَّة الملتصقتان معاً، وعنصر الصراع، مركز الإثارة الحسيَّة والنفسيَّة الذي يولِّد التشويق القصصي والمتعة النفسيَّة).
أمَّا لُغةُ القَصِّ الحكائي وفاعليةُ الأُسلوب التعبيري اللَّذين هما من أدوات الكاتب الثانويَّة، فضلاً عن مجموعة الرموز والإيحاءات والدلالات والعلامات السِّيميائيَّة، ووجهات نظر الكاتب، وأدوار الشَّخصيَّات الرئيسة، والنهايات القصصيَّة، والتي عادةً ما تكون مُغلقةً أو مفتوحة أو موضوعيةً أو إدهاشيةً فجائيةً صَادمةً لأفقِ توقُّع القارئ بحسب مقال النصِّ ومقامه الثيمي، فإنَّ هذه العناصر جميعها تسهمُ إسهاماً كبيراً وفاعلاً ومكيناً في صُنع وتخليقِ الوحدة الموضوعية لآليات فاعلية الخطاب السردي القصصي.
وهي على الرغم من كونها تُشكلُ عناصرَ وأركاناً ثانويةً في العمل القصصي، بيدَ أنَّها في حقيقة الأمر لها أثرها الفنِّي الكبيرالفاعل في تعضيد البناء القصصي وتوحيد تكامله الفنِّي الصحيح.
العَتبةُ العُنوانيةُ لِلمدوَّنةِ القَصصيَّةِ:
تُمثِّل دالة العنوان في مقاربة حدِّه التعريفي القريب الموجز مفتاحَ مفاتيحِ الدخول (الماستر) إلى بوابة النصِّ الموازي السرديِّة، وتُعدُّ العنونة شاخصها المضيء الأوحد في توجيه بوصلة الدليل أو ومكنوناتها العميقة، وتَقفي آثارها ورموزها البعيدة؛ للكشفِ عن لُقاها الفكريَّة ومكامنها الجوهرية الثمينة. فلا يمكن أن يكون هناك نصٌّ موازٍ قائمٌ بذاته التعبيريَّة من غير أن تكونَ له بالمقابل عتبةٌ عنوانيةٌ قارةٌ تُفصح عن أثر مجاهيله ومرموزاته ومُوحياته الجماليَّة والفنيَّة القريبة منها والبعيدة.
وعلى وفق ما هو مثبتٌ من عتبة المدوَّنة العنوانية الرئيسة (خيانةُ النَاطورِ) يمكن أنْ نقول، لا خيانةٌ يمكنُ أنْ تَحدثَ على أرض فضاء الواقع ما لم يكنْ لها ناطورٌ مسؤولٌ عنها وعن فعلتها الحدثية الشائنة. ولا يصحُّ أبداً ،اْنْ نقولَ ناطوراً ما لم يكن ذلك الناطور مُؤتمناً بحقٍّ عن نطارته، والمحافظة على حقوق رعيته التي أُنيطت له مهمَّة حراسة بوابتها، وإلا فَلنُردِّدَ مُنشدينَ ما أباحَ به أبو تمَّام في توصيفه الرثائي: (كَذَا فَليَجلَّ الخَطبُ وَليَفدحِ الأمرُ فَليسَ لِعينٍ لَمْ يَفضْ مَاؤُها عُذرُ)
وحينَ نُجيل النظرَ مليَّاً في لوحة العنوان الرئيس والعام لمدوَّنة (خيانةُ الناطورِ)، لا بُدَّ وأنْ نستقرئ ونفهم بتدبرٍ واعٍ مضامينه الدلالية ونفكِّكَ شفراته اللُّغوية ومقصدياته المعنوية؛ لنقفَ بتؤدةٍ مُطمئنين عمن هو (الناطورُ) المعيَّن بهذا المعن الدلالي الظاهر والمُضمر الخَفيّ نسقياً وثقافَّياً؟ فلو ذهبنا إلى تجلِّيات المعنى الدلالي القريب لِدالةِ (النَّاطورُ) لاتضحَ لنا أنَّها تعني (الحارسَ) الذي ارتبط فعله الحركي والسكوني الثابت بمهمًّة النطارة اللَّيلية أو الحراسة المكانية التي صارت بعهدته أمنياً. فهوَ أقرب ما يكون شبيهاً بما يُسمَّى في لهجتنا المحليَّة (البَاصوَانِي)أو الحارس اللِّيلي.
في حين أنَّ موحيات المعنى اللُّغوي الدلالي البعيد لمفردة (النَّاطورِ) تعطينا أكثر من معنىً ودلالةٍ توصيفيةٍ دقيقةٍ وجديدةٍ، فالناطور وفقَ ذلك المعنى الآخر البعيد هُوَ العَينُ الحارسة الساهرة التي لا تنامُ، وهو حائط الصدِّ المحافظُ، وهو المسؤول عن حقوق الناس ورعايتها، وهو أيضاً الأمين والمؤتمن، والراعي لحقِّ رعيته، تذكيراً بحديث الرسول الأكرم (ص) القائل: (ألَا كُلكُم رَاعٍ وَكُلكُم مَسؤولٌ عَنْ رَعِيتِهِ). فالرجل راع لأُسرته، والقائد راعٍ لشعبه وأُمَّته، والمعلِّم راعٍ لطُلابه، والأديبُ المبدع راعٍ لأدبه وقرَّائِه، والطبيب راعٍ لمَرضَاه، والأمُّ أسريَّاً راعيةٌ لأبنائها وبناتها.
أمَّا معنى دالة (الخيانةُ)، فهي بالتأكيد الفعل الإنساني السلبي الشائن المَعيب مُطلقاً الذي ترفضه كُلُّ الأعراف والعادات الاجتماعية، ولا تقرُّه سُننُ الدين والشرائع السماويَّة والأرضيَّة المُوحدة. ولا يمكن أن تأتلف دلالة (الخيانةُ) وتتوحدن مع دلالة (الناطور)إنسانياً وفكريَّاً وأخلاقيَّاً وعرفيَّاً أبداً.
فالناطور، إذنْ كلمة لا يمكن أنْ يُختزَلُ معناها اللُّغوي ويختصُّ بمعنى دلالي واحدٍ فقط، أو يقصرها عليه ويُحيِّد عملَها الفعلي تعسفاً. نعم الناطور هو الحارس؛ ولكنَّه حارس من نوعٍ آخر، الحارسُ لأمرٍ مُهمٍّ ما جَللٍّ؛ لذلك يمكن أنْ نعده في مقاربات اللُّغة الحاكم والمسؤول والقائد والإمام والسادن والراهب والحِبرَ. وهو سفينة الصدق والنجاة، ومرفأُ بَرِّ الوصول، وشاطئ الأمن والأمان، وهو ميزان الحقِّ والعدل الذي لا يبخسُ أشياءَه، وهوَ المسؤول عن أشيائه في السراء والضراء، وفي السر والعَلنِ دوماً. فهذا هو المعنى الدلالي البعيد الذي أراده الكاتب (القاصُ) وتوخاه وتقنَعَ به أمام أنظار ومرأى قرَّائه في معماريَّة عنوانه العام لمجموعة (خِيانةُ النَّاطور).
وقد أشار الكاتب إلى تلك التوريات الدلالية، والانزياحات اللُّغوية المتعدَّدة الأصل لمعنى كلمة (الناطورُ) في مستهل توطئته الكتابية الموجزة لهذه التسمية العنوانية القريبة من حياة الناس في مدوُّنته (خيانةُ الناطورِ)، إذ أفصح قائلاً: " ُربَّما يَكونُ بَاعثَاً علَى تَحريكِ الفُضولِ لَدَى المُتلقِّي، ودَافعَاً إلَى السُّؤالِ عَنْ دِلالاتِهِ، فَضلَاً عَمَّنْ هُوَ المَعنِي بِهذَا المَعنَى؟" (خيانةُ الناطورِ، ص7). وختم الكاتب خلاصة ما أراد إيصاله بمجموعته القصصية هذه بالقول: "إذ إنَّ الإخلالَ بِأصولِ أيِّ مَسؤوليَّةٍ ومُخالفةَ قَواعدِها النَّاطقةَ يُعدُّ خِيانةً". (خِيانةُ الناطورِ، ص 9)، وقد تكون خيانة كبرى لا تُغتفرُ.
وعلى وفق تلك التعدُّدية المعنوية فإنَّ العتبة العنوانيةالرئيسة (خيانةُ الناطورِ)قد أدَّت جميع وظائفها العملية الأربع بإقناعٍ وتمكُنٍ. تلك الوظائف التي أكَّدها الناقد الفرنسي جيرار جينيت في كتاب عتباته العنوانية المتعدِّدة (مِنَ النّصِّ إلى المَناصِّ)،لأيِّ منتوجٍ، شعرياً أكان جنسه أمْ سرديَّاً نثرياً؟ ولابدَّ من الإشارة إلى أنَّ (خيانة الناطور) عتبةٌ لقصَّةٍ فرعيَّةٍ اُخيترتْ لتكونَ عنواناً عامَّاً للمُدونة. ويَحصل هذا الاختيارُ كثيراً من باب إطلاق الجزءِ على الكُلِّ لاعتباراتٍ فنيٍّة وجَماليَّةٍ وموضوعيةٍ.
أمَّا العنوانات الفرعية أو الثانوية لعتبات النصِّ الموازي لمدوَّنة (خيانةُ النّاطورِ)، فقد انمازت بلاغتها اللُّغوية بقصرها وجمال اقتصادها اللغوي المكثَّف تركيباً ودلالةً. وقد تناصفت من حيثُ عددها الكمي مع بعضها في بنائها التركيبي النحوي وتوازنت في توصيفها الأُسلوبي بين العنوانات الموضوعية المُباشرة، والَّتي مثَّلتها القصصُ الست: (مواءمةٌ، والمجهولُ، واستلابٌ، والمواجهةٌ، وصرخةٌ، والمَأزقُ)، ونظيراتها العنوانات الفنيَّة الأخرى التي تمثَّلت بالقصص الست: (وأدُ حُلمٍ، وخيانةُ النَاطورِ، وقلبٌ استوطنهُ الأملُ، وضَياعُ الذَاتِ، ونُتوءٌ فِي شَغافِ القلبِ، وجُرحٌ نازفٌ).
أمَّا عتبات نصِّ هذا الكتاب الأخرى فيقف في مقدمتها الإهداء الذي تصدَّرَ مُستهل مدوَّنته لهذا المجموعة القصصيَّة، وقد حرصَ الكاتب لطيف عبد سالم على أنْ يكون إهداؤه الشخصي جَمعياً عامَّاً لا ذاتياً ضيِّقاً فَصدَّره ُإلى أبناء الجامعة الإنسانية التي تُمثل الإنسان المُكابد الآخر من سَواد الناس المكافحينَ إذ قال: "إلَى النُّفوسِ الَّتي تَتوَارى بِأوجاعِها خَلفَ رُكامِ الأيَامِ". (خِيانةُ النَّاطورِ، ص 5).
تعدُّ مجموعة (خيانة الناطور) من المجاميع القصصيَّة القليلة النظائر من التي احتوت على عتبة توطئة تقديمية تُمهِّد الدخول إلى توضيح إشكاليات العنوان العامِ وتَحسمُ تداعياته الدلاليَّة الكثيرة، وتقف على تعدُّدِ آفاق مرجعياته الموضوعية، وأنساقه الثقافية العامَّة والخاصَّة والظاهرة الجليَّة والمُضمرَة الخفيَّة التي كشفت جوانبه الفنيَّة والجماليَّة. مُؤكِّداً في الوقت ذاته على قِول أبي الطيِّب المُتنبِّي في توصيفِ نواطيرَ مِصرَ التي تراوحت معانيها بين حراسِها (النَواطيرِ) وثعالبِها من اللُّصوص وبينَ سادتها وأشرافها: (نَامتْ نَواطيرُ مِصرَ عَنْ ثِعالبِهَا فَقدْ بَشمَنَ وَمَا تَفنَى العَناقيدُ).
تَأثيثُ المُدوَّنةِ القِصصيَّةِ موضوعيَّاً:
القارئ النابه الذي يتتبع بعين نقدية واعية متئدةٍ الهندسةَ المعماريَّةَ والفكريَّةَ لخريطة تأثيث
مدوَّنة (خيانةُ الناطورِ) القصصية، الصادرة بطبعتها الأولى عام 2020م عن مكتبة فضاءات للفنِّ والطباعة والنشر ببغداد، سيلفتُ نظره الفكري أنَّ هذه المجموعة على الرُّغم من صغر حجمها الكمي العددي البالغ اثنتي عشرة قصةً أو نصَّاً سرديَّاً، وبِمساحةٍ وَقيةٍ تَجاوزت الثمانين صفحةً ومن القطع الكتابي فوق المتوسط، فإنها انمازت بسعة كيفها النوعي والموضوعي والدلالي المكين الذي يمنحها درجة التميُّز والتفرُّد القرائي المحبَّب لدى القارئ العادي والقارئ الناقد الحاذق على الرغم من كونها المجموعة القصصية الأولى في سلسلة تعدُّد كتابات الكاتب لطيف سالم المتنوِّعة.
وقد تراوحت مِساحات هذه المجموعة القصصية النَّفسِيَّةِ بين القصص القصيرة والمتوسِّطة والطويلة نوعاً ما، والتي لا يشعر معها القارئ بأيِّ ضَجرٍ أو إملالٍ في قراءتها؛ كونها كٌتُبَتْ بلغةٍ تحشيدٍ سردية مكثفةٍ أنيقةٍ وماتعةٍ، واقتصاد لغويٍّ موجز واعٍ، وبمهارةٍ فنيةٍ احترافيةٍ سَلِسةِ الحَبكِ والسَّبكِ اللُّغوي والدلالي المعنوي بعيداً عن كلِّ أشكال التعقيد اللفظي والغموض المعنوي والإطالة والإطناب،ولا أثر للترهُّل فيها ذلك الذي لا يُحفزُّ القارئ إلَّا على التواصل معها دون الفكاك عنها.
لقد استنَدَ الكاتب والقاصُّ لطيف عبد سالم في تأثيث وبناء مدوَّنته القصصيَّة إلى مجموعةٍ ثرَّةٍ من الأنساق والمراجع الثَّقافيَّة، والموضوعات الفكريَّة اللَّافتة للذهنِ، والِّتي اختارها بعنايةٍ فائقةٍ واهتمامٍ كبيرٍ من تَمظهرات صراع الواقع الحياتي المجتمعي المَديني والرِّيفِي المَعيش لِهُويَّةِ الذات الفردية وعلاقتها الازدواجية الإنسانيَّة المُتوحدنة جِدَاً معَ الذات الأخرى الفرديَّة الجمعية المشتركة.
ومن أمثلة ذلك الصراع قصة (ضياعُ الذاتِ)التي يتحدَّث فيها عن بطلها القادم من أعماق الريف بحثاً عن فرصة عملٍ تُعوُّضهُ عن شعوره الذاتي بالضياع "فِي فَجرِ مُعتَم مُلَبَّدٍ بِالغُيومِ خَرجَ كَعادتِهِ بَاحثَاً عَنْ رِزقهِ. فَرَشَ إزارَ حَظهِ عَلَى رَصيفِ (مَسطَرِ العَمَّالةِ)،جَلسَ طَويلَاً،أَخذَ مِنهُ البَردُ مَأخذَاً، شَارَكَ بَعضَ العُمَّالِ فِي إشعالِ النَّارِ بَحثَاً عَنِ الشُّعُورِ بِالدفءِ، ظَلَّ يَترقَّبُ مِنْ دُونَ جَدوَى، أرهقَهُ الاِنتظارُ بَعدَ أنْ يَأسَ مِنَ الحُصولِ عَلَى فُرصةِ عَملٍ فِي ذَلكَ اليَومِ، أحسَّ بِحاجةٍ مَاسَّةٍ لِلراحةِ، فَلمْ يَجدْ مَكانَاً لِيستريحَ بِهِ أفضلَ مِنَ مُقهَى (العُمَّال) المُطلَّةِ عَلَى المَسْطَرِ". (خِيانةُ النَّاطور، ص 47).
وقد هَيمنتْ تجلِّيات صراع ثنائية المقدَّس والمدنَّس الواقعية السرديَّة بظلالها السحرية والجديدة على تشكَّلات بنية هذه المجموعة القصصية، وعلى إيقاع حمولاتها الفكرية ومخرجاتها الحدثية والموضوعية الفاعلة. والتي كانت تمثِّل مناطق إشعاعٍ بارزةٍ وفناراتٍ ضوئيةً لافتةً في الإبداع والابتداع الفنِّي لا يمكن تجاوزها في خانة الميتا سرد الحداثوي العراقي المُعصرن نوعاً وكمَّاً.
واعتمد القاص لطيف سالم كثيراً في مُعجمه السَّردي والقصصي على إشكاليات وأزمات الواقع العراقي الحداثوي على وجه الخصوص، وعلى وقع تداعياته الحياتية الساخنة. فكانت مواجعه وخيباته وانكساراته ونكوصاته التخاذلية المتكرِّرة تمثِّلُ بحقٍّ مظاهر ديستوبيا فوضى هذا الواقع الشرير والمدنَّس الحياتي لِهُويةُ الآخر في خطِّ علاقته الجدليَّة والإشكالية المباشرة وفي تشاكله التضادي والحدِّي مع يوتوبيا مدينة المقدَّس الإنساني الذي ينشد صفاتِ المحبَّة والفضيلة، ويسعى إلى الوئام في ظلٍّ مجتمع فاضلٍ يسوده السلام والأمان؛ لذلك كان النهج الواقعي نواة بيت حكايات المدونة السردية (خيانة الناطورٍ) التي منحها الكاتب جُلَّ اهتماماته ووضعها نَصبَ عينهِ السَّرديَّة:
"الحَربُ سَلبتنِي اِبنِي فِي مُقتَبِل عُمرِهِ، وَاليومَ أظنُّ أنَّ خُيُولَ المَوتِ تَزحفُ صَوبَ مَنْ سَلَبَتْ قُلوبَ العَائلةِ، وَأسَرتْ أرواحَهُم بِضحكاتِهَا وَبَراءةِ حَركَاتِهَا، وَقَلبِي لَمْ يُسعَدْ بِهَا بَعدَ. وَلَمْ يَقطعْ عَليهِ صَمتِهِ وَهوَ يَحتضنُهَا سِوَى صَوتِ كَابحِ السَّيَّارةِ، وَإِشعارِ صَاحبِهَا إيَّاهُ بُوصولِ المُستشفَى". (خِيانةُ الناطورِ، ص62، 63). هذا الفقدُ الحزين الظالم هو ما كشفت عنه قصَّة (نُتوءٌ فِي شِغافِ القَلبِ).
لم تكن أفكار الواقع وحكايات صراعه المتجدِّدة هي المُهيمن الثيمي الصوري الأوحد الذي فرض سطوته السرديَّة وفاعليته السحرية الحكائية على وحدات مجموعة (خيانةُ الناطورِ) الفكرية والموضوعية فحسب، وإنَّما كانت لتمظهرات التراث أو الموروث الشعبي العراقي والتاريخي الحديث الحصَّةُ الأهمُّ والأسمى في إنتاج هذه المدوَّنة. ومن نماذج التراث الشعبي العراقي الجيِّدة التي تصوُّر مشاهد الصراع القائم بين الإقطاع الجائر والفلَّاح المسالم قصة (استلابُ) الحقوق منه:
"لَمْ يَجدْ بُداً مِنْ اللُّجوءِ إلَى التَّوسُّلِ وَهوَ يُقسِمُ بِأغلظِ الأَيمَانِ بَينَ يَديهِ، أنَّهُ لَا يَقصدُ أيَّ شَيءٍ فِيهِ مَساسٌ بِمنزلَةِ الشَّيخِ أو سُركَالِهِ، إلَّا أنَّ مَا تَوَالَى مِنْ مَحاولاتهِ قَصَدَ اِستعطافَ السُّركالِ لَمْ تُجدِ نَفعَاً أمامَ قَسوتِهِ الَتيِ تُميِّزهُ عَنْ غَيرهِ، حَيثُ أعمَتْ نَشوةُ السُّلطةِ والشَّهوةِ فِي إذلالِ الرِّجالِ بَصيرتِه، لَمْ يَتوانَ عَنْ مُمارسةِ مَا عُرِفَ بِهِ مٍنْ عُنجهيةٍ، فَشرَعَ بإهانتهِ وَشتَمِهِ عَلَى مَرأى وَمَسمعٍ مِنْ جِيرانِهِ الَّذينَ أثارَهُم الفُضولُ وَدَفعَهُم لِلتَوافدِ، إلّى جَانبِ زَوجتِه الَّتي لَمْ تَبَسْ بِبِنتِ شَفةٍ، ثُمَّ أمَرَهُ بصوتٍ عَالٍ قَائِلَاً: - تَحرَّكْ أمَامِي.. تَحرَّكْ أمِامِي..-يَا كَلبُ..". (خِيانةُ النَاطورِ، ص 24، 25).
وقد أبدع الكاتب والقاص لطيف عبد سالم في تخليق وإنتاج لوحات التمثيل القصصي الحكائي والدرامي لشخصيات التراث العراقي الشعبي وإظهار رموزه الحاكمة والمحكومة بمختلف أشكاله ومسمياته الزمانية والمكانية وخاصةً في زمن حكم شيوخ سلطة الاستلاب القبلي الإقطاعي وسطوته القبلية الجائرة على الذات الإنسانية الفلاحية التي تمثل السواد الأعظم من عامَّة الناس.
وقد رسم الكاتب في خبايا مدوَّنته (خيانةُ الناطورٍ) -وفي تلافيف قصَّته بالذات (وأدُ حلمٍ) - رسم بحيادية واتقانٍ موضوعي صوراً وحشيةً حزينةً ومؤلمةً جدَّاً وعديدةً عن دكتاتورية وظلم واستبداد وتجاوزات ذلك الواقع الزمكاني الجائر والمهيمن للذات الإنسانية. وقد أسهمت مفاهيم ومصطلحات ذلك الواقع مثل، (السّركالُ والمَحفُوظُ والحَاشيَّة) كرموز وأصوات ناشزة وطاغية في تجسيد أدوار الشخصيَّات الرئيسة والثانوية وإظهارها بالصورة الإيموجية المرئية والحركية الدراميَّة البشعة التي تناسبها في تمثيل واتقانِ فاعلية واقعة الحدث الحكائية السردية التي جاء فصالها على قياسها:
"ذَاكرتُهُ الحُبلَى بِنشيجِ الأيامِ تَسرَحُ بِفضاءٍ فَسيحٍ، فِي غَمرةِ تَواردِ خَواطرهِ المَشحونةٍ بِصورِ ظُلمِ الإقطاعِ وَجَورِ جَحيمهِ، أغمضَ عَينيهِ طَمَعَاً فِي إغفاءَةٍ قَصيرةٍ، َاستَسلَمَ لِلنومِ سَريعَاً، اِلتبسَ عَليهِ الحُلُمُ بِغيرهِ بَعدَ أنْ أيقظتهُ رَفَسَةٌ مَسمومةٌ تَزَامَنَ فِعلُ وقُوعِهَا عَلَى خَاصرتِهِ مَعَ نَشازِ أصواتِ ثُلَّةٍ مِنَ الرِّجالِ: أيُّهذَا الشَّقيُّ..المَحَفُوظُ أَمَرَ بِجلائِكَ بَعيدَاً عَنِ القَريةِ!" (خِيانةُ النَاطورِ، ص 15).
لقد كان القاصُّ لطيف أميناً في نقل الأحداث الواقعية والغرائبية والمخيالية بقداستها ودناستها إلى القارئ، وجعله يتعاطف مع وقع تلك الأحداث ويتصوَّرها شكليَّاً وذهنياً، خاصةً وأنها تمثِّل مرحلةً مهمَّةً من مراحل تاريخ العراق السياسي والاجتماعي الحديث، وأحداثه الخفية التي تتستَّر الآيدلوجيا عليها بقناعها الدفين الذي لا يمكن فكُّ شفراته بسهولةٍ؛ الأمر الذي دفعه للوقوف عندها مليَّاً. فَفي ذات السياق يوثِّق القاصُّ للحياة الأُسريَّة في قصَّة (صرخةٌ) وصراع الزوجة الطاهرة النقية مع زوجها بمحاربة أشكال الرذيلة التي يمتهنا ويمارسها سلوكاً عدائياً دنيئاً بحقِّها الوجودي:
"اِستبعادَهُ مَحاولةَ لُجوءِ زَوجتهِ لِاعتمادِ خَيارَ التَّمرُّدِ، شَجعَهُ عَلَى المُضِي فِي غَيهِ، فَلَمْ يَكنْ فِي تَفكيرهِ مَا يُوحِي بِغيرِ مَا اِعتَادَ عَليهِ فِي كُلِّ يَومٍ، لَكنْ ألَمَ جُرحِهَا الغَائرِ فِي أيامِهَا، جَعلَهَا تُلَمْلِمُ بَقايَا إنسانِيتِهَا الضَائعةِ وَتَستعِدُّ لِدفعِ ثَمنِ دُخولِ مَعتَرَكِ رَفضِ خَيبتِهَا، فَلمْ تُعطِهِ ذَاتَ فَجرٍ فُرصةَ التَّلَذُذِ بِأذلالِهَا، إذْ اِعترتْهَا رَعشَةُ غَضَبٍ عِندَ عَودتِهِ إلَى مَنزلِهِ، سُرعانَ مَا أدخلتهَا فِي مُواجَهَةٍ مَعَ مَنْ طَحَنَ إنسانيتَهَا بِرَحَى غُرورِهِ". (خِيانةُ النَاطورِ، ص 56).
من هنا تُشكِّلُ مُهيمنات الواقع الحياتي ، وتجلِّيات الموروث الشعبي التراثي والثقافي المعرفي والإنطلوجي والسوسيو ثقافي للمجتمع العراقي نقطةَ الصراع المفصليَّة وبؤرة الأحداث الإشكالية الدائرة بين جدلية (المُقدَّسِ والمدَّنسِ)،والحياة والموت، والخير والشرِّ، والوجود واللَّاوجود أو العدم (أكون أو لا أكون) أشبهُ بما يجسده المشهد الهاملتي الكبير لشكسبير في رواية مسرحيته الشهيرة.
أكون مؤتمناً وراعياً مسؤولاً أو خائناً خذولاً غيرَ مسؤولٍ، فلَا أكون إلَّا عوناً ونصيراً للرَّعية لا مغتصباً لحقوق إنسانها، ولا أكون إلَّا أهلاً للعهد والوفاء، وليس نصيراً للذُّل والاستبداد والخيانة التي لا تغيب عنه الشمس ولا تُحجب بغربالِ الزمن القميء. وتأتي قصة (خيانةُ الناطورِ) التي اُختيرت إن تكونَ عنواناً عامَّاً للمجموعة القصصية في مقدَّمة هذا المقدَّس العلمي الذي تعرَّض لخيانة الانتهاك الدنيء في سرقة جهد باحثٍ أكاديمي رفيع من قبل سطوة الآخر الجاهل المسؤول:
"مَا الخَطبُ يَا صَديقِي؟ قاَلَهَا وَهَبَّ مُسرِعَا إلَّى صَديقهِ الَّذي لَمْ يُكلِّفُ نَفسَهُ الكَلامَ، إذْ سَلَّمَهُ رِسالةَ مَاجستيرٍ، وَهوَ يُشيرُ بِطرفِ إصبِعِهِ إلَى عُنوَانهِ، فُوجِئَ مِثلَ صَاحبِهِ بِالعنوانِ الَّذي كَلَّفَهُ اِختيارَهُ لِدراستِهِ قَبلِ سَنواتٍ أياماً ولياليَ طَويلةً، هَولَ الصَدمَةِ وَعُنفِهَا لَمْ يَفقدُهُ الشُّعورَ بِضرورةِ التَّيقنِ أكثرَ، بَدَأَ يَتَصَفَّحَ الكِتَابَ المَطبوعَ بِشكلٍ أنيقٍ، لَمِ يَجدْ شيئا قَدْ تَغيَّرَ مِنْ دِراستِهِ غَيرَ اِستبدالِ اِسمِ المَسؤولِ بِالباحثِ!". (خِيانةُ النَّاطورِ، ص 41، 42).
أُسلوبيةُ الكَاتبِ القَصصيَّةِ:
بوجهات نظرهِ التعدُّدية المتواضعة وبأسلوبيته الفنيَّة استنطق لطيف عبد سالم أصوت شخصياته ورموزه القصصيَّة الفاعلة على أرض الواقع وتمثيلها دراميَّاً، واستحضر بتلقائيةٍ عفويةٍ مُحنكةٍ ديمومةَ الصراع لفكري الإنساني الوجودي المجتمعي القائم بينها من خلال تَنامي سير فِعليَّاته الحدثية المرتبطة بالوحدات الزمانية والمكانية. واهتم بالتأكيد على تلاحم نسيج الوحدة الموضوعية للخطاب النصِّي وديمومتها الترابطية مع الوحدة العضوية الكبرى للخطاب السردي العام،والإمساك بتلابيب أذيالها في ترجمة الخطاب دون المساس بوحدة عناصره الأساسية أو الخروج عنها فنيَّاً.
وقد عمد الكاتب في أسلوبية فنِّه التعبيريَّة إلى أنْ تكون جميع نصوصه السردية الاثني عشر نصَّاً واقعيةً صرفةً تستمدُّ نسغها الروحي الجوهري، وتنفسَها الرِئَوِي النقيِّ، وتشكُّلَها الحكائي الفنِّي المتنامي من أرضية ومحيط الواقع الحالي، ومن تفاصيل الحياة اليومية المعيشية للإنسان، ومن مرجعيات التراث الحداثوي ومصادر ثقافته النوعية المؤثِّرة، ومن خزائن الموروث الشعبي العراقي التأصيلي الضارب في العمق الريفي والمديني أطناباً من عقود الزمن والتاريخ.
فتنوَّعت أفكار موضوعاته الكتابية التي خصَّ بها الإنسان الذي هو المعادل للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية. تلك التعدُّديَّة التي تمثَّل مناطق التبئير المُكثَّف في الوطن العراقي الكبير بمختلف اتجاهاته وطوائفه ومسمياته المذهبية والإثنية والوجودية. ولنقرأ في هذا الخصوص مشهداً ختامياً من قصة (المواجهةُ) التي يشعر فيها البطل في ظل التقاليد وثقل العادات والموروثات الاجتماعية بهزيمته النكراء وَوَهَنهِ وتخاذله الشخصي عن مواجهة قاتل أبيه عمداً:
"ذَاتَ يَومٍ أَسَرَّهُ أحدُهُم عَنْ بَعضِ جَوانبِ فَجيعتهِ قَائلَاً: - كُلُّ تَرْكَةِ وَالدِكَ هُوَ الصِّريفةُ الَّتي تَسكنها، أبوكَ شَيَّدَهَا بِالتَّرجِي وَالاستعطَافِ، وَلَا تَملُكُ مِنهَا سِوَى الطِّينِ. لَمْ يَكترِثْ لِمَا طَرَقَ سَمعَهُ وَلَمْ يَحدْ عَمَّا عَزَمَ عَليهِ، حَدَّثَ نَفسَهً قِائِلَاً: - قَدْ يِكونُ مُخادِعَاً كَمَا قَالتْ وَالدتِي[...] إذْ شَعرَ بِهزيمتِهِ وَهوَ يَتجرَّعُ رياحَ الخَيبةِ، حِينَ أقرَّ بِوهَنهِ أمامَ سَطوةِ قَاتلِ أبيهِ عَمدَاً، فَالنكدُ الَّذي أحرَقَ رُوحَهُ فِي المَاضِي، سَوفَ يُحرقُهَا بِلَا رَيبٍ فِي المُستقبلِ!". (خيانةُ الناطورِ، ص32، 33).
لقد كتب لطيف عبد سالم تسريداته القصصيَّة عن شخوصه ورموزه الصوتية بلغة الحضور أو الغياب للمواءمة بين الذات الأنويَّة والآخر، وللأحلام الموءودة والشعور بالاغتراب النفسي، ووثَّقَ للمصير الإنساني المجهول، ولثقافة استلاب الحاكم الجائر في بخس حقوق الناس. ورسمَ في الوقت نفسه لوحاتٍ قصصيةً رائعةَ الجمال ومدهشةً! للمواجهة بين طرفي الصراع المُختلفينِ، وشخَّصَ أنساقَ خيانةِ الناطورِ المؤتمن على حياة الناس من خلال سوداوية هذا الصراع الدامي بالوجع .
واتشحت بعض قصصه بالأمل الذي يستوطن القلوب المتألمة، وعن ضياعِ الذَّاتِ الإنسانية المُحطَّمة، وسماع صدى صرختها المدويَّة، وكَتبَ عن النتوءات العارضة التي تَصيب شِغاف القلب المَكلومةِ، وختمَ سرديَّاته الحكائية بما يَتعرَّض له الإنسان من مأزقٍ وظلمٍ لا فكاكَ عنه، وجروحٍ نازفةٍ لا بُدَّ منها كونه إنساناً مجتمعيَّاً تَحيق بمحيط تجربته الحياتية ما دام يعيش حيَّاً على أرض وبساط الواقع.
تقنيةُ الخَواتيمِ والبداياتِ القصصيَّةِ:
أمَّا بخصوص فنية التعبير الأسلوبية للبدايات والنهايات، كيف ابتدأت قصص الكاتب؟ وكيف انتهت في مجوعته (خيانةُ الناطورِ). فقد انتهى القاص لطيف عبد سالم في مركز اشتغالاته إلى أن تكون المقاربة التوافقية إحدى وسائله الأسلوبية للموازنة بين بداياته ونهاياته القصصيَّة تارةَ، وتارةً أخرى تكون أسلوبية الانزياح وانحرافاته البلاغية الجديدة سبيلاًموحِّداً لحسن تخلُّصاته الموضوعية النهائيَّة، وتارةً ثالثةً لا سبيل لخواتيمه السردية إلَّا المفارقة الإدهاشيَّة والفجائيَّة الصادمة التوقُّع.
لقد ارتأى الكاتب لطيف عبد سالم فكريَّاً أنْ تكون جميع مطالع مُقدِّماته أو مستهلات حكاياته القصصية مقدِّماتٍ افتتاحيةً خبريةً توصيفيةً لا إنشائيةً عن شخصياته الرئيسة، وحرص أنْ تكون مفاتيحُ تقديمِ لُغتها الطلليَّة لغةً زمانيةً ماتعةً وشائقةً مُحبَّبةً تستهوي قراءتُها المُتلقِّي وتجذبه نفسياً إلى الانجرار مع وقع حكايتها الموضوعية وجماليات موحيات توصيفها الرمزي المُتراتب نسقيَّاً. ولنقف متأملين كيف بدأ القاص لطيف مقدمة قصته التراثية (استلابٌ)؟وكيفَ يُخبرُ عن حركة بطلها زمانياً ومكانياً. "لَا يَعودُ إلَى مَنزلهِ إلَّا مَعَ غُروبِ الشَّمسِ، وَقَدْ غَدَا مِنْ فَرطِ تَعبِ النَّهارِ مَنهوكَ القِوَى، فَاعتَادَ أنْ يَنامَ مُبكِّرَاً فِي أغلبِ الأيامِ، وَيَستيقظَ مَعَ غَبشةِ الفَجرِ". (خِيانةُ النَّاطورِ، ص23).
وفي الوقت ذاته عكف القاصُّ جديَّاً على أن تكون هندسة نهاياته أو خواتيمه القصصية نهاياتٍ متنوعةً التخلُّص ومتعدِّدة الأفكار والرؤى ، وليست على شاكلةٍ أسلوبيةٍ نمطيةٍ واحدةٍ مملةٍ تأتي رتيبةً. وتأتي (النهايات الموضوعية)أولى خواتيم هذا التنوُّع وتمثِّله قصص خمس وهي: (المَجهولُ، والمُواجهةُ، وضَياعُ الذَّاتِ، وصَرخةٌ، وجُرحٌ نَازفٌ). التي تخبر نهايتها الموضوعية بحركة بطلها الرئيس، "ِانطلَقَ هَائِمَاً عَلَى وَجهِهِ وَهوَ يَحمِلُ جُرحَاً غَائِراً دَامياً مُؤلمَاً، أًبلغُ أثرَاً وَأعمقُ ألمَاً فيِ النَّفسِ مِمَّا تَركتهُ مَشارِطُ الأطبَاءِ مِنْ نُدُوبٍ فِي جِسمِهِ النَّحيلِ". (خِيانةُ النَاطورِ، ص 76).:
في حين يأتي النوع الثاني ما يُسمَّى نهاياتِ المُفارقةِ القَصديَّةِ الصَادمةِ بإثارتها، ويمثِّلُها أربع قصص هي: (مواءمةٌ، واستلابٌ، وخِيانةٌ الناطورٍ، وًنُتوءُ في شَغافِ القَلبِ). فلنقرأ ما تعرَّضَ له الباحث العلمي من إجحافٍ بحقِّ ملكيته العلمية التي اُغتصبتْ منه."بَدأَ بِتصفُحِ الكِتابِ المَطبوعِ بِشكلٍ أنيقٍ، لَمْ يًجدْ شًيئاً قَدْ تَغيَّرَ مِنَ دِراستِهِ غَيرَ اِستبدالِ اِسمِ المَسؤولِ بِالباحثِ". (خيانةُ الناطورِ، ص 42). أما في قصة (مواءمةٌ)، فلنستمع إلى ما قاله بطلها الأمّيُّ من مفارقة في خاتمتها المثيرة الأثر. "قَالتْ لَهُ والذُعرُ بَائنٌ فِي نَظراتِها: - كَيفَ تَكتُبُ رِسالةً، وأنتَ لَا تَقرأُ وَتَكتُبُ؟ أشارَ بِيدهِ قَائِلَا: -وَمَا الضَيرُ فِي ذَلكَ ؟ماَدامَ هُوَ أيضَاً لَا يُجيدُ الِقراءةَ والكِتاَبةُ!". (خِيانةُ النَّاطورِ، ص 12) .
ويأتي النوع الثالث وهو النهايات الفجائية المُدهشة، ويمثِّله القِصتانِ، (وأدُ حُلمٍ، والمَأزقُ)، "حَمَلَ القُرويُّ العَجوزَ عَلَى ظَهرِهِ وَسَارَ بِهَا صُحبةَ شُرطيٍّ فِي شَارعِ مَركزِ النَاحيةِ الرَّئيسِ الَّذي يَنتهِي عِندَ السُّوقِ المَسقوفِ، كَانَ فِي قَرارَةِ نَفسِهِ يَأملُ أنْ يَرَاهَا أحدٌ مِنْ عَائلتِهَا أو مِنْ مَعارِفهَا وَيُخَلِّصُهُ مِنْ عَناءِ حَملِها. طُوالَ الطَّريقِ، كُلَّما شَاهدَ القُرويُّ شَاخصَاً أمامَهُ، أوْ بِمُحاذاتهِ، أوْ قَريبَاً مِنهُ، صَرخَ بِه: -اِفتحِ الطَّريقَ ، تَنحَّى جَانبَاً، وَإلَّا سَتصبَحُ اِبنَهَا!". (خِيانةُ النَاطورِ، ص 70).
أمَّا النوع الرابع والأخير فهو ما يُسمَّى بالنهايات أو الخواتيم المفتوحة، ويمثِّلهُ تطبيقياً وإجرائيَّاً قصَّة (قَلبٌ استوطنهُ الأملُ)، وتشترك معها في هذا السياق قصَّة (ضَياعُ الذاتِ) التي ورد ذكرها مع قصص النهايات الموضوعية لخيانة الناطور."نَعَمٌ يَا بُنَيَ قَبلَ أنْ التحِفَ الثَرَى أحلمُ بِوطَنٍ أجملَ! استحوذَ الذِّهولُ عَلَى الفَتَى، تَسمَّرَ فِي مَكانهِ، بَاتَ يَشعرُ بِالألم فِي رَأسِهِ وَهوَ يَنظرُ مَبهوتَاً إلَى العَربَة المُتهالكَةِ، وَهيَ تَبتَعدُ عَنْ الزُقاقِ رُويداً رُويداً نَحوَ فَضاءٍ مَجهُولٍ". (خيانةُ النَاطورِ، ص345) .
فهذه التعدُّدية والتنوَّع النهائي في اختيار خواتيم القصص والحكايات دليل على وعي الكاتب وتمكُّنه من أدواته القصصيّة في اختيار وتوظيف النهايات التي تُناسب الشخصية الفواعلية التي قامت بتمثِّل الحدث السردي تمثيلاً حقيقيَّاً.فضلاً عن أنَّ التعددية تمنح النصَّ السردي قبولاً معرفياً وثقافياً إنسانياً مُحبَّباً في كسر أفق جدار الواقع الحياتي المألوف وتحطيم رِتِمِهِ الإيقاعي الثابت. وكما في هذا السياق،"أغلقت البَابَ، اِحتضنَتْ اِبنَهَا، اِمتدَّ بَصرَهَا إلَى الأفُق حيث شروق الشمس، ضحكت بكل جوارحها وهي تشعر بنسائم الصباح لأول مرة في حياتها. (خِيانةُ النَّاطورِ، ص 57).
بِنيةُ المَكانِ القِصصيَّةُ:
يعدُّ المكان وبنيته التعدديَّة من أكثر عناصر السرد القصصيَّة الأساسيَّة التصاقاً بالحدث واهتماماً به، وارتباطاً بحركة الفواعل (الشخصيات) وتنقلاتها السريعة. فالمكان يُجِّد بنية الحدث الفعلية ويمنحها صفة التَفرُّد والاستقلاليَّة وخاصَّية التغيُّر. وفي الوقت نفسه يُحدِّدُ المكان هُوية الشخصيات الفاعلة، ويؤكِّد صلة انتمائها الوجودي في العمل الأدبي أمام أنظار قارئه ومتلقيه الواعي.
لذلك فإنَّ المكان المُحدَّد بزمن معيَّنٍ ما، يكشف عن خبايا العمل السردي وعمق تلافيفه النسقية الظاهرة والمضمرة، ويُلقي بالضوء على أهمِّ مناطقه الجوهرية التي من خلالها يستمتع القارئ بمثاباته ويتواصل مع أحداثه إلى آخر منطقة من مناطقه الحدثية المتساوقة. فلا حدث يحدث من غير مكان يؤصِّله،ولا شخصيَّات يظهر تواصلها إلَّا مع البنية المكانية التي توثق معالمه التاريخية.
وتأتي أهمية المكان الزمكانية من أهمية الحدث، فلا يمكن أنْ نصف مكاناً بالأهمية والسمو ما لم يكن الصراع الحدثي كبيراً وأصيلاً ومضيئاً. لذلكَ فإنَّ المكان عند الكاتب لطيف عبد سالم يأخذ مكانته الدلالية الاعتبارية والفنيَّة الواسعة في وقع مصفوفاته القصصية لمجموعة (خيانة الناطور).
وقد يكون المكان عنده فضاءً فكريَّاً ذهنيَّاً ومعنويَّاً ليس له حيز أو فراغ أو حدود تحدَّه في فضاء النصِّ السردي. وهو المنظور القليل الذي يشغل تفكير شخصياته في مِساحة هذه المدونة ويَهبُها صفة التواصل الحواري والحكائي مع المتلقِّي. وهذا ما سيكشفه وعي القاري النابه الحاذق أو ألمعية (الناقد) في اشتغالات اشتباكه وتصدِّيه لبنية العمل القصصي السردي المكين. وأنَّ النماذج القصصية التي يمكن أنْ تكون المثال الأوفى الجيّد للبنية المكانية المعنوية الذهنية تكمن في القصص الثلاث الأتية: (قَلبٌ استوطنهٌ الأملُ)، و (نَتوءٌ في شِغافِ القَلبِ)، و (جَرحٌ نَازفٌ):
"اِختلطَ الألمُ بِالأملِ، فَاعتدنَا عَلَى الحُزنِ، حَتَّى أصبحَ جُزءاً مِنْ عَوالمِنَا، إلَّا أنَّ الحُلمَ لَا يَزالُ يَلهثُ مَا بَينَنَا. ذُهِلَ الفَتى، زَاتْ حَيرتُهُ، لَمْ يَعد قَادرَاً عَلَى إدراكِ مَا يَبطنُ الرَّجلُ فِي خَبايا أقوَالهِ، فَرجاهُ طَالباً تَوضيحَ مَقاصدِ عِباراتِهِ...". (خيانة الناطور، ص 45) فالألم والأمل والحزن مكانها القلب.
أمَّا الحيز الأكبر الثاني الذي شغلَ تفكير القاص لطيف عبد سالم، فهو البنية المكانية التي لها تمثيل ماديٌّ وجوديٌّ على سطح الأرض في الفضاء النَّصّي السَّردي. وهذا ما انمازت به بنية المكان التعددية في أغلب قصص المجموعة الاثنتي عشرة قصةً. لذلك وظَّف الكاتب مجموعة كبيرة من المثابات المكانية في طيَّات قصصه، بدأً من أصغر وحدةٍ مكانيةٍ إلى أكبر وحدةٍ مكانية تسمو بفاعلية الحدث السردي وتظهر تناميه الحثيث.
فجاءت اشتغالاته المكانية منصبَّةً بالدرجة الأولى على المثابات والأمكنة التي لها الأثر الكبير والفاعل في حياة الإنسان وفي ترسيخ وجوده الاجتماعي. فهذا الاهتمام الكبير بالتقانات المكانية دفعه إلى استحضار وذكر الكثير من الأمكنة التي وردت متجليةً في طيَّات قصصه، فوظف، (البيتَ والأسرةَ والدارَ والمَنزلَ والمُضيفَ والصِّريفةَ والطُولَةَ والشارعَ والزقاق والمَقهى ومجالسَ الخمرَ ومكانَ العملَ والمدينةَ والقريةَ والنَاحيةَ ومكاتبَ الكُتبِ بالمتنبِّي ومِراكزِ العملِ ومَراكزَ البُحوثِ العلميةِ ومَراكزَ الشُّرطةِ وسَطح الدَارِ وقَاعةَ الطَواري والمَشافيَ ومَتاجرَ بغدادَ التِّجاريةِ)،وغيرها من مقاربات تلك الأمكنة والمثابات والمعالم العمرانيةومجاوراتها اللغوية والدلالية في بيت مشغله:
"ارتَدَى ثِيابَهُ، تَأنَقَ وَتَعطَّرَ، هَمَّ بِالخُروجِ؛ لإمضاءِ لَيلتِهِ كَالعادةِ فِي اِرتيادِ مَجالسِ الخَمرِ، مَا إنْ وَضعَ يَدَهُ عَلَى مَقبضِ البَابِ، حَتَّى نَادتهُ زَوجتهُ بِنبرةٍ يَشوبُها الحُزنُ قَائِلةً: اِبنكَ يُعانِي مِنَ الحُمَى مُنذُ ثَلاثةِ أيامٍ! رَدَّ صَارِخاً: - ومَنْ أخبرَكَ أنَّني طَبيبٌ؟! أشاحَتْ وجَهَهَا دُونَهُ قَبلَ أنْ يُطلقَ ضِحكةً عَاليَةً وَيُغادرُ المَنزلَ". (خيانةُ النَاطورِ، ص 55). فَتمثُّلات المكانية واضحة في قصته (صرخةٌ).
والمكان عند لطيف عبد سالم لا يقف عند حدود المدينة المُتحضِّرة وزحام مثاباتها الضوئيَّة المُبهرة، فقد تجاوزت المكانية لديه حدود المَدى المكاني، فتوغل في وجعه السردي بقصصه وحكاياته إلى عالم الريف وإلى فضاء وحداته الزمكانية التي فضحت وكشفت الكثير من تجليات الصراع الوجودي والألم العراقي الذي تعرض له الإنسان ابن الريف ونواته الفواعلية.
وقد ظهرت آثار هذه المكانية الضاربة في العمق من خلال المفارقات القصصيَّة الصادمة السوداء التي عَبَّرت عنها شخصيات قصصه وأصواته الداعية إلى التحرر من العبودية ونبذل أشكال الذل وممارسات الاسترقاق البشري. والتي هي جزء كبير من آيدلوجيَّة الكاتب وفلسفته.
وقد عزفَ القاص لطيف عبد سالم سرديَّاً في أسلوبية لغة موسيقاه المُعجميَّة القصصيَّة على أوتار ذلك الوجع المرير الأسود فأطرب وأبكى، وأمات متلقيه وأحيا، ذلك الوجع الإنساني الكبير الذي كشفت عنه فضاءات قصصه الواقعية بوضوح تامٍ وتجرُّد ونكران ذاتٍ صوبَ القارئ اللبيب:
"رِحلتهُ الَّتِي بَدأهَا فَجرَاً وَهوَ يَنتقلُ مِنْ قَريةٍ إلَى قَريةٍ أُخرَى، لَمْ تُسفرْ عَنْ أيِّ نَتيجةٍ تَشفِي غَليلَهُ فَكَمَا كَانَ يَأملُ، الشَّمسُ فِي طَريقِهَا إلَى المَغيبِ وَقَدْ وَصلَ قَريةً نَائيةً، لَا مَعرفةَ لَهُ فِيهَا بِقريبٍ أو صديقٍ، وَلَا يَتذكَّرُ أنَّهُ زًارَهَا أو مَرَّ بِهَا فِي وَقتٍ سَابقٍ، تَوقَّفَ عَنِ السَّيرِ فِي أطرافِ المَدينةِ بِمُحاذَاةِ جَدولٍ صَغيرٍ، ارخَى قَدميهِ مِنَ السَّرجِ، نَزَلَ مِنَ عَلَى ظَهرِ فَرسِهِ؛ لِيَتركَ لَهَا فُرصةَ الحَصُولِ عَلَى حَاجتِهَا مِنَ المَاءِ". (خِيانةُ النَاطورِ، ص 17). هكذا ينتقل القاصُّ من مكان لأخر، من المدينة إلى القرية، ومن القرية إلى الريف الواسع الأمكنة وعوالم الطبيعة الثابتة والمتحركة.
إنَّ جدلية الخفاء والتجلي السردي لصراع المقدس والمدنس والمفارقة الإدهاشية الصادمة السوداء في ثنائيات المواجهة المحتدمة بين الخير والشر والحياة والموت والوجود والعدم التي استأثرت كثيراً باهتمام الكاتب وتخليقه الإبداعي والفني الإنتاجي تؤكد لنا بصدقٍ أنَّ تجربة القاصِّ والكاتب لطيف عبد سالم الإجرائية الثريَّة في مدونته القصصية (خِيانة ُالناطورِ) يمكن أنْ نعدَها إضافة نوعيةً ومعرفية نافعةً وماتعةً إلى مكتبة سرديات القصة العراقية القصيرة؛ كونها تلقى احترامَ ومقبوليةَ رِضَا القارئ واستحسانه الذوقي والمَعرفي في آليَّات القراءة وجمالياتِ التلقِّي.
***
د. جبَّار ماجد البهادليّ - ناقدٌ وكاتبٌ عِراقيّ