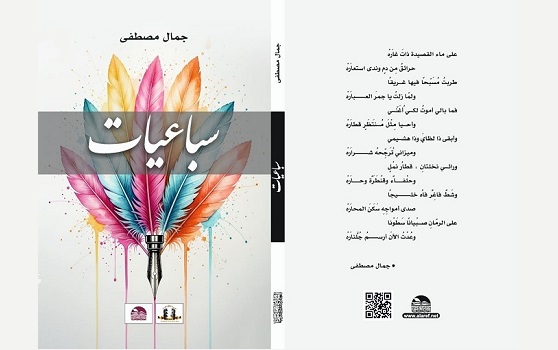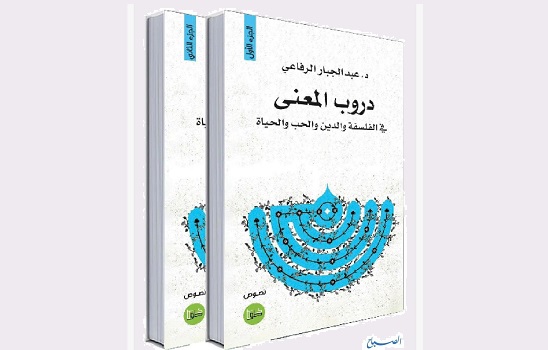قراءات نقدية
عدنان عويّد: دراسة نقديّة لقصيدة الشاعر "منير محمد خلف"

(إليها هاءً غيرَ قابلٍ للسكتِ) من ديوانه – ثورة الورد.
الشاعر "منير محمد خلف" من مواليد: الحسكة – سورية 1970· عضو اتحاد الكتاب العرب (عضو جمعية الشعر) يعمل مدرساً للغة العربيّة · صدر له المجموعات الشعرية التالية:
1. غبار على نوافذ الروح – دار الحصاد – دمشق.1995
2. سقوط آخر الأنهار - دمشق 1997.
3. لمن تأخذون البلاد؟ اتحاد الكتاب العرب 2000.
4. جنازة الإرث – اتحاد الكتاب العرب.2002
- نال عدداً من الجوائز الشعرية في سورية وخارجها من أبرزها:
1- جائزة سعاد الصباح في الكويت 1995.
2- جائزة المزرعة عن أفضل مجموعة شعرية في السويداء 2001.
3- جائزة طنجة في المغرب 2002.
4- جائزة أديب عباسي في الأردن 2004 وغيرها.
ينشر في الدوريات العربية والمحلية.
البنية الدلاليّة للنص:
دمشق في كل دلالاتها وزخمها وحضورها في الماضي والحاضر والمستقبل، التي عبر عنها الشاعر "منير الخلف" في هذه القصيدة، تظل عنده (روضةً من زخرفِ الأحلامِ)، شكلت حالة عشقٍ لروح هائمة في نور وظلال حضورها الأبدي، وفي نبض ياسمينها وزخرف أحلامها، التي لم يجد ذاته يوما إلا بين ياسمينها وعطره.
عيناكِ نبْضَا ياسمينِ الشَّامِ
يا روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ
هي عينا دمشق التي لم تعرف النوم عبر تاريخها، هي بوابة التاريخ، وجذوة المجد التي لم تنطفئ... هي سر الخلود وشعلة النور التي تضيء لأهلها ومن يعرف معنى الحلم والأمل عندما يغفو التاريخ.
دمشق التي أنهكها اليوم الجوع والقهر والحصار والموت وشهوة الدم، حتى خَفَتَ نور عينها ولم تعد تشع كي تضيء للمتعبين من أهلها طريق الخلاص... دمشق التي لم تعرف النوم عبر تاريخها، ها هي اليوم تكاد تغمض عينيها وتغفو من ظلم تتر ومغول العصر، حتى راح شعراؤها ومحبّوها يتمنون لها النوم والراحة والسكينة والخلاص من كل ما عانته، لعلها تصحو من جديد لتستعيد مجدها.
يخاطبها الشاعر "منير الخلف" وفي روحه وعقله ألف سؤال وسؤال:
عيناكِ.. لا أدري أأطرقُ مُتعباً
بابَ الفؤادِ بقبضتَي إحجامِ؟
عيناكِ عنقودَا كلامٍ صامتٍ
مَنْ ذا يُترجِمُ يقظتي لتنامي؟
هو يخاطب دمشق المكلومة في وجودها، يخاطب مشعل التاريخ.. ونبض قلبه وقلب كل عشاق الحريّة الذين أتعبهم ما أصابها من رزايا،، حيث لم يدرِ كيف الدخول إلى مجدها من جديد، وهو يرى الصمت وغياب البهجة في حضورها... وهذا ما يحزنه ويجعل القهر وعذاب الروح ينالا منه.. ويتساءل في داخله من ذا الذي يستطيع أن يفسر حبنا وأشواقنا لك يا دمشق، وكل أحلامنا ورغباتنا التي تأججت اليوم في مسامات وجودنا، تنتظر ارتياحك وعودة مجد التاريخ في عينيك؟.
ها هو الشاعر "منير" يدعوها أن تنام... أن ترتاح من قهرها على زند انتظاره وانتظار كلِ محبيها، لعلها تصحو من جديد. وهنا يحضرني شوق ولهفة الشاعر "سعيد عقل" لدمشق وهو يقول:
طالَتْ نَـوَىً وبَكَـى مِـن شَوْقِـهِ الوَتَـرُ
خُـذنِـي بِعَينَـيـكَ وَاهْـــرُبْ أيُّـهــا الـقَـمَـرُ
لم يَبقَ في الليلِ إلا الصّوتُ مُرتَعِشاً
إلا الـحَـمَــائِــمُ، إلا الــضَــائِــعُ الـــزَّهَــــرُ
كيف لا تصحو دمشق أيقونة التاريخ وهناك من يعشقها وهي من ألهم كل من عرفها سر البلاغة ونبض الحرف. يدعوها الشاعر "منير" بعد أن عاش هو آلامها أن تنام قائلاً:
نامي على زندِ انتظاري، إنَّهُ
وَشْمٌ على خدِّ البَلاغةِ نامي
ودعي مفاتيحَ اللّغاتِ على يَدِي
نعم... كيف لا تنهض دمشق من جديد... وهي الشآم التي لا يغيب حضورها رغم كل ما حاكه أعداء الإنسانيّة والجمال والحب ضدها... وهذا يعيدني ثانية لسعيد عقل وهو يخاطب دمشق:
(شَــآمُ يــا ابـنــةَ مـــاضٍ حـاضِــرٍ أبـــداً
كـأنّـكِ السَّـيـفُ مـجـدَ الـقـولِ يَخْتَـصِـرُ
حَـمَـلـتِ دُنـيــا عـلــى كـفَّـيـكِ فالتَـفَـتَـتْ
إلـيـكِ دُنـيـا، وأغـضَـى دُونَـــك الـقَــدَر).
يقول الشاعر "منير خلف" مخاطباً دمشق الروح والعشق والبهجة والحضور، ومحطة لعناق الروح والجسد بينها وبين محبيها ومغرميها:
سأجيءُ نحوَكِ شاعراً كَلِفَاً بِمَ
جَادَ العِنَاق بثروةِ الإلهامِ.
كيف لا يجيد شاعرنا ويعشق عناقها وهي الشآم التي عشقها كل شاعر عربي عرفها وعرف أهلها بطيبهم وحبهم.. ألم يقل "سعيد عقل" بها:
(شـــــآمُ أهــلـــوكِ أحـبــابــي، وَمَـوعِــدُنــا
أواخِــرُ الصَّـيـفِ، آنَ الـكَـرْمُ يُعتَـصَـرُ
نُـعَـتِّــقُ الـنـغَـمَـاتِ الـبــيــضَ نَـرشُـفُـهــا
يــومَ الأمَـاسِـي، لا خَـمــرٌ ولا سَـهَــرُ
شَــآمُ يــا ابـنــةَ مـــاضٍ حـاضِــرٍ أبـــداً
كـأنّـكِ السَّـيـفُ مـجـدَ الـقـولِ يَخْتَـصِـر).
البعد الجمالي في القصيدة:
يركز البعد الجمالي على تحليل وتقييم الجماليات في الأعمال الأدبيّة، وفهم كيفيّة استخدام العناصر الجماليّة مثل اللغة، الأسلوب، الصور، والرموز في النصوص الأدبيّة لإثارة المشاعر والتأثير في القارئ. وعلى هذا الأساس تأتي دراستنا للغة القصيدة أولاً.
لغة القصيدة:
لقد شكلت اللغة هنا آليّةً استراتيجية هامة في البناء الشعري للقصيدة، فهي كسفينة راحت تنقل الشاعر والمتلقي معاً إلى آفاق المجهول من أجل الكشف عن الرؤى الهاربة في المتاهات السريّة البعيدة، الأمر الذي يجعل المتلقي يذهب إلى تأويل ملفوظ القصيدة تأويلاً استعاريّاً، عندما يدرك غموض المعنى في لغة النص. (إليها هاءً غيرَ قابلٍ للسكتِ).. (عيناكِ عنقودَا كلامٍ صامتٍ)... (ودعي مفاتيحَ اللّغاتِ على يَدِي).. (مَنْ ذا يُترجِمُ يقظتي لتنامي؟). مع هذا الغموض في النص يفتح المتلقي بنية وآفاق القصيدة على كل ما تمثله معارفه عن دمشق التاريخ... فبوابة التاريخ وعمقه ومجده، هي بحر عميق في كنوز دلالات حضورها فتسهل للمتلقي أن يغرف من كنوز هذه الدلالات كل ما يستطيع عقله وعاطفته وحبه وشوقه لدمشق.
تمتاز لغة النص بسلاستها ونصوعها وسهولتها وفصاحتها. فالكلام الفصيح هو الظاهر البين الذي يستلذ السمع منه ويميل إليه. وما يميز لغة النص أيضاً، عذوبة (النسيب) في لغة القصيدة التي فرضها عشق الشاعر لدمشق، فهناك تهالك في الصبابة، وإفراط في الوجد واللوعة والرقة، وأخيراً جودة المعنى التي تأتي من "اتفاق المقال مع واقع الحال"، كما يقال... يخاطب الشاعر "منير الخلف" دمشق:
عيناكِ نبْضَا ياسمينِ الشَّامِ
يا روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ
عيناكِ.. لا أدري أأطرقُ مُتعباً
بابَ الفؤادِ بقبضتَي إحجامِ؟
عيناكِ عنقودَا كلامٍ صامتٍ
مَنْ ذا يُترجِمُ يقظتي لتنامي؟.
الرمز في القصيدة:
إن للرمز قبل كل شيء معنىً خفيّاً وايحاءً، يحاول الأديب عكس ما يدور في خلده عن طريق الرمز والقناع والأسطورة، وهو في الشعر العربي الحديث بشكل عام، يعتبر الوليد الشرعي لظروف القمع السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، فالأديب يصعب عليه أن يطلق أفكاره بحريّة تامة وبصورة مباشرة، لذلك يلجأ الى تقنية الرمز. وتزداد قيمة الرمز وأثره محل الأشياء بكونه تعبيراً لا شعوريّاً يتجاوز الواقع الى الايحاء به، فهو قد يبدأ من الواقع ولكن لا يرسم الواقع، بل يُردُّ الى الذات، وفيها ينهار عالم المادة وعلاقاتها الطبيعيّة لتقوم على انقاضها علاقات جديدة مشروطة بالرؤية الذاتيّة لمستخدم الرمز.
بيد أن الرمز في القصيدة عند الشاعر "منير خلف" جاء هنا ليعبر عن عمق تاريخ دمشق وتعدد سجاياها الجميلة، إن كان في طبيعتها أو طبيعة أهلها عبر التاريخ.
ففي عنوان القصيدة (إليها "هاءً" غيرَ قابلٍ للسكتِ)، يأتي حرف (الهاء) هنا، الحرف الأول لاسم حبيبة الشاعر، هذه الحبيبة التي تساوت في عشقه لها مع عشقه لدمشق... فالمرأة تظل في رمزيتها كـ"عشتار" الخصب والعطاء الذي لا ينضب، أو ك"فينوس" آلهة الجمال التي تحقق الدهشة، ودمشق كذلك.
كما يأتي (الياسمين) في القصيدة رمزاً يعبر عن جمالها وعطر ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فهي (روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ.)، كما وصفها الشاعر.
أما أن تكون دمشق عند الشاعر (مفاتيح اللغات)، فتعدد اللغات (رمز) يدل على عمق دمشق الحضاري، ومنها كانت أول أبجدية في التاريخ وعلى أرضها قامت حضارات، ومرت عليها شعوب عديدة تركت الكثير من مفردات لغاتها ممتزجة ومتعانقة مع لغتها العربيّة حتى اليوم.
لقد وظف الشاعر الرمز في القصيدة ببراعة عالية، يريد به إبراز قدراته الابداعيّة والجماليّة من جهة. إضافة لكونه يعني حالة باطنيّة معقّدة من أحوال النفس، وموقفا عاطفيّاً أو وجدانيّاً من جهة ثانية. وبوصفه أيضاً أكثر فاعليّةً وقدرةً على التعبير بدلالات واسعة مختلفة من جهة ثالثة.
الصور الشعريّة في القصيدة:
تظل الصور الشعريّة هي الوسيلة التي يستخدمها الشعراء لنقل الأفكار والمشاعر بطريقة ذهنيّة أو حسيّة ملموسة. كما تحتل الصورة أهميّهً كبيرةً في تشكيل البناء العام للعمل الأدبي، على اعتبار أن العمل الأدبي أو النص بعمومه، هو صورة، يقوم الكاتب أو الأديب في تجسيدها شعراً أو نثراً. ومن خلال استخدام الصور الشعريّة، يمكن للشاعر أن يخلق عوالم خياليّة غنيّة بالتفاصيل، مما يسمح للقراء بقراءة النص بشكل أعمق وأكثر تفاعليّة.
من هذا المنطلق المنهجي، اعتمد الشاعر "منير خلف" كثيراً على الصورة الذهنيّة والحسيّة معاً، ساعياً بخبرته وتراكم معرفته بدور الصورة وأهميتها فنيّاً وجماليّاً ومعرفيّاً، حيث قام بتشخيص تلك الصور الذهنيّة خاصة في النص، عبر اللغة ومحسناتها البديعيّة البلاغيّة من التشبيه والاستعارة والكناية. فصار للمعنى وجوداً آخر من جهة دلالة الألفاظ وجماليّة صياغتها، والتطابق بين الصورة والتجربة الشعريّة للشاعر، إضافة لتحقيق حيويتها وايحائيتها، والمتعة الفنيّة في ذاتها، بما تحويه من خيال بديع.
لقد جاءت القصيدة بمعظمها مشبعة بصور حسيّة وذهنيّة عالية التشكيل، لتشكل من كل هذه الصور المنفردة ومجتمعة، صورة كليّة لدمشق التي حركت كل أحاسيس الشاعر وكوامن وجدانه، وألهمته معنى الحياة والخلود والبوح:
(عيناكِ نبْضَا ياسمينِ الشَّامِ).. (يا روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ).. (أأطرق.. باب الفؤاد).. (عيناكِ عنقودَا كلامٍ صامتٍ).. (وَشْمٌ على خدِّ البَلاغةِ).. (مفاتيحَ اللّغاتِ)...
شعريّة المكان في القصيدة:
تظل العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة قديمة متجذرة في أعماق النفس البشريّة، وطبيعة هذه الوشيجة تشكلها تلك العلاقة الحميميّة بين البيئتين الطبيعيّة والاجتماعيّة اللتين ترعرع فيهما الإنسان، ونمت إدراكاته وأحاسيسه وتشكل هويته وإحساسه بذاته. فالشاعر الجاهلي تعلق بالطلل وبالرسوم الدارسة وأماكن الظعن، وانعكست أشجانه ورؤاه الشعريّة على تلك الأماكن، فكان يسافر إليها للذكرى والتذكر، ويقف حيالها حزيناً يذرف الدمع مدرارا ويستعيد لحظات الماضي بكل تفاصيله في لذّة وشجن وحرقة والتياع. ويركز الشاعر الحديث على موطنه ومسقط رأسه ثم يخرج من هذه الرؤية الضيقة وتتوسع نظرته لتشمل أماكن متعددة كالبيت والنهر والقرية والمدينة...إلخ. ولكن هناك علاقة أخرى أشد عمقاً تربط الإنسان بالمكان، وهي الوطن الذي يعبر عن انتماء الإنسان وارتباطه الحضاري بكل مفرداته من لغة وثقافة وآمال وألام وعيش مشترك، ففي هذا الانتماء الحضاري تبقى العلاقة وطيدة بين الذكريات والمكان، لتشكل جزءاً هاماً من تجربة الشاعر، فيبني علاقات مع جمادات المكان، ويعمل على أنسنتها، من خلال مخاطبتها ومحاورتها.. وهذا ما عبر عنه الشاعر "محمد خلف" في انتمائه لدمشق التي راح يبين لنا عبر كل تلك الصور الذهنيّة والحسيّة واللغة الشفافة التي جاءت في القصيدة، عن حبه وعشقه وانتمائه لها.. حيث يقول:
يا روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ
نامي على زندِ انتظاري...
ودعي مفاتيحَ اللّغاتِ على يَدِي
لأفكَّ شِفرةَ شوقيَ المتُنامي
سأجيئ نحوَكِ شاعراً كَلِفَاً بِمَ
جَادَ العِنَاق بثروةِ الإلهامِ
الموسيقى الخارجية والإيقاع الداخلي في النص الشعري:
تظل الموسيقي تلازم الخطاب الشعري، وهي جزء من القصيدة لا تنفصل عنها، لأنها تنشأ في داخلها، مراوحةً بين الحركات والسكنات، ولا تنفصل عن سياق المعنى، فينضبط ويرتبط بها.
إن مصدر الموسيقى في التشكيل الخارجي للقصيدة متعلق بالتفعيلة (الوزن) والقافية.
أما الإيقاع فهو ذلك التناغم الداخلي الحاصل من النبر أو الصوت الداخلي للنص الناجم عن الحالة النفسيّة والشعوريّة وحتى الحالة الفيزيولوجيّة للشاعر، التي تتطابق وتتناغم مع طبيعة كلمات القصيدة وحروفها وتراكيبها وصورها ونسيجها البلاغي من تشابيه واستعارة وكناية وجناس وطباق وغير ذلك. وبالتالي مدى قدرة الشاعر على تحقيق الانسجام والوحدة بين مكونات القصيدة كي يصدر عنها رتم موسيقي ينسجم مع بنيتها العامة.
مع شعر الحداثة (التفعيلة أو الشعر المنثور) تطور الإيقاع فانتقل من نظام الصوت المتشابه، والبنيات المتماثلة في الوحدات المتقابلة، ومن نظام الوزن الصارم في الشعر والقافيّة، إلى إيقاع جديد متحرر متسامح مع نفسه، ومن ثمة صار الصوت يؤدي دورا ًبالغ الأهميّة في التأثير على المتلقي بما يحمل من خصوصيات في التنغيم والنبر والجهر والهمس.
إن هذا التطور في الرتم الموسيقي سيجده المتلقي في قصيدة الشاعر: "منير الخلف" (إليها هاءً غيرَ قابلٍ للسكتِ). لقد استطاع الشاعر في هذه القصيدة القائمة في موسيقاها الخارجيّة على تفعيلة (متفاعل)، وغلبت على نهاية الشطر في بنية القصيدة حرف (الميم) بكل ما يحمل هذا الحرف من دفقات وجدانيّة تخاطب عاطفة المتلقي وحسه وشغاف قلبه ووجدانه. أما على مستوى الموسيقى الداخليّة، فقد جاءت دقة الشاعر في اختيار الألفاظ، ثم قدرته على الملاءمة بين ألفاظه وإيحاءاته الفكريّة، وقدرته التعبيريّة في اختيار الكلمات، ثم تحقيقه لحالة الانسجام بين الأصوات ودلالاتها، ساهم كل ذلك في تشكيل رتم موسيقي تعانق فيه نغم الموسيقي الخارجي الصادر عن الوزن والقافية مع الإيقاع الداخلي أو الموسيقى الداخليّة للنص، وبالتالي منح مكونات القصيدة التناغم والتوازي والتساوي بين أجزاء الكلام.
***
د. عدنان عويّد
كاتب وباحث وناقد من سوريا.
....................
(إليها هاءً غيرَ قابلٍ للسكتِ)
عيناكِ نبْضَا ياسمينِ الشَّامِ
يا روضةً من زُخْرُفِ الأحلامِ
عيناكِ.. لا أدري أأطرقُ مُتعباً
بابَ الفؤادِ بقبضتَي إحجامِ؟
عيناكِ عنقودَا كلامٍ صامتٍ
مَنْ ذا يُترجِمُ يقظتي لتنامي؟
نامي على زندِ انتظاري، إنَّهُ
وَشْمٌ على خدِّ البَلاغةِ نامي
ودعي مفاتيحَ اللّغاتِ على يَدِي
لأفكَّ شِفرةَ شوقيَ المتُنامي
سأجيئ نحوَكِ شاعراً كَلِفَاً بِمَ
جَادَ العِنَاق بثروةِ الإلهام