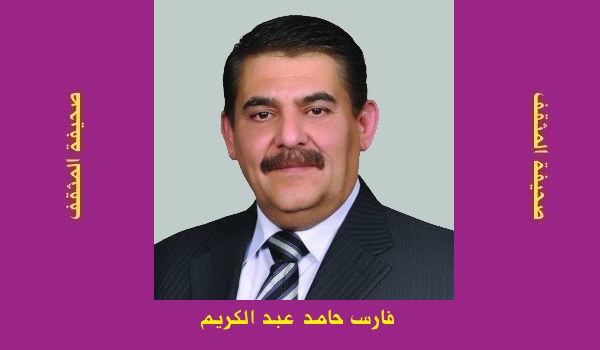قراءات نقدية
حياتك ليست قصة.. لماذا يعيقك التفكير السردي؟ / ترجمة محمد غنيم

بقلم: كارين سيميك
ترجمة: د. محمد عبد الحليم غنيم
***
قصصنا تساعدنا في فهم عالم فوضوي، لكنها قد تكون ضارة ومقيدة. هناك بديل تحرري.
***
السرديات موجودة في كل مكان، والحاجة إلى بنائها ومشاركتها تكاد تكون حتمية. كتب جان بول سارتر في روايته "الغثيان" (1938): "الإنسان دائمًا ما يكون راويًا للحكايات، يعيش محاطًا بقصصه وقصص الآخرين، ويرى كل ما يحدث له من خلالها؛ ويحاول أن يعيش حياته كما لو كان يروي قصة".
نحن نعتمد على السرديات لأنها تساعدنا على فهم العالم. إنها تجعل الحياة أكثر معنى. وفقًا لسارتر، لتحويل أبسط سلسلة من الأحداث إلى مغامرة، يكفي أن "تبدأ في سردها". ومع ذلك، فإن سرد القصة ليس مجرد فعل إبداعي قوي. بعض الفلاسفة يعتقدون أن السرديات أساسية لتجاربنا. يعتقد ألسدير ماكنتاير أننا لا يمكن أن نفهم أفعالنا وأفعال الآخرين إلا كجزء من حياة سردية. ويجادل بيتر غولدي بأن حياتنا نفسها "لها بنية سردية" – ولا يمكننا فهم مشاعرنا ومشاعر الآخرين إلا من خلال التفاعل مع هذه البنية. وهذا يشير إلى أن السرديات تلعب أدوارًا مركزية، وربما أساسية، في حياتنا. لكن كما يحذر سارتر في "الغثيان": "كل شيء يتغير عندما تروي عن الحياة".
في بعض الحالات، يمكن أن تعيقنا السرديات عن طريق تقييد تفكيرنا. وفي حالات أخرى، قد تقلل من قدرتنا على العيش بحرية. كما أنها تمنحنا الوهم بأن العالم منظم ومنطقي ويصعب تغييره، مما يقلل من تعقيد الحياة الحقيقي. قد تصبح حتى خطيرة عندما تقنعنا برؤية زائفة وضارة للعالم. ربما لا ينبغي أن نكون متحمسين جدًا للعيش كما لو كنا "نروي قصة". السؤال هو: ما الخيارات الأخرى المتاحة لدينا؟
تعمل السرديات على تنظيم تجاربنا من خلال ربطها في تسلسلات تمنح حياتنا معنى. القدرة على تشكيل هذه التسلسلات شيء نتعلمه في سن مبكرة جدًا. كما اكتشفت المربية كارول فوكس خلال بحثها في التسعينيات، فإن القصص تبدأ في تشكيلنا منذ الطفولة. وجدت فوكس أن القراءة للأطفال في المنزل تمنحهم معرفة ضمنية بالبنية اللغوية والسردية، والتي يدمجونها في قصصهم المنطوقة. وأظهر بحثها أن الأطفال في سن الثالثة يستخدمون القصص لتجربة اللغة أثناء محاولتهم فهم العالم. وكلما تقدمنا في العمر، استمررنا في اللعب – واستمر اعتمادنا على السرديات.
يمكن إعادة صياغة الأحداث العشوائية باعتبارها جزءًا من خطة كبرى
عندما نصبح بالغين، نتبنى أدوارًا مختلفة، مثل الصديق، الحبيب، الموظف، الوالد، المُعيل، وغير ذلك. الطريقة التي نفهم بها هذه الأدوار غالبًا ما تكون مؤطرة بسلوكيات متوقعة. على سبيل المثال، لدينا تصور سردي لما يعنيه "الصديق"، ونحكم على أنفسنا وعلى الآخرين بناءً على مدى توافقهم مع تلك القصة - أحيانًا بشكل إيجابي، وأحيانًا بشكل أقل.
فلماذا يُعد هذا مشكلة؟ إحدى القضايا هي التعقيد. رؤية نفسك كشخصية رئيسية في قصة يمكن أن تبسط الحياة بشكل مفرط. فكر في الطريقة التي يتحدث بها الناس عن "رحلتهم" في الحياة. من خلال هذه السردية، تصبح بعض الأحداث أكثر أهمية بينما يتم تجاهل أخرى، وقد يُعاد تأطير الأحداث العشوائية على أنها جزء من خطة عظيمة. ومع ذلك، فإن النظر إلى حياتنا بهذه الطريقة الضيقة يعيق قدرتنا على فهم السلوك المعقد للآخرين ولأنفسنا. على سبيل المثال، الطفل الذي يقبل السردية التي تصفه بأنه "مشاغب" قد يفسر سلوكه بشكل خاطئ على أنه سيئ، بدلاً من أن يكون تعبيرًا عن احتياجاته غير الملباة. يمكن أن تغيرنا القصص عن طريق حصرنا في طرق معينة من التصرف، التفكير، والشعور.
في السبعينيات، أدى الاعتراف بهذا القيد إلى ظهور العلاج السردي. بدلاً من رؤية الناس كغير منطقيين أو مفرطي العاطفة، ركز هذا النوع الجديد من العلاج النفسي على دور السرديات في حياة الشخص. وكما يوضح المعالج مارتن باين في كتابه العلاج السردي (2000)، فإن النهج يسمح بظهور "سرديات أكثر غنىً ومركبة من أوصاف متنوعة للتجربة". يمكن أن تكون السردية الجديدة قوية للغاية بالنسبة لشخص لا يدرك كيف أن قصصه الراسخة تخفي عنه طرقًا أخرى لفهم حياته.
القصص التي قد تحتاج إلى تغيير ليست فقط الكبيرة، بل أيضًا الصغيرة، مثل "النصوص" التي نعتمد عليها طوال حياتنا. يمكن أن تصبح هذه النصوص أنماطًا تفكيرية معتادة، تؤثر على تفسيرنا لأفراد العائلة، الأصدقاء أو الزملاء. وكما يُظهر العلاج السردي، يمكننا أن نخطئ في هذه النصوص، وقد نحتاج إلى مساعدة لتغييرها.
على الرغم من أن العلاج السردي قد يكون فعالًا، فإنه غير قادر على مساعدة الناس في فهم ما يُنشئ ويشكل سردياتهم. إنه يساعدهم فقط على الاختيار بين سرديات مختلفة أو بناء قصص جديدة عن أنفسهم والعالم. تبديل "نص" بآخر لا يساعد الشخص على رؤية مجموعة الخيارات الكاملة التي أمامه، بما في ذلك ما قد يعنيه رفض السردية تمامًا.
السردية التي يتبعها تمنحه فهمًا محدودًا لنفسه.
إمكانية رفض السردية يمكن العثور عليها في كتاب الوجود والعدم (1943) لجان بول سارتر، حيث يصف نادلًا في مقهى. وفقًا لسارتر، تبنى النادل سردية معينة تشكل هويته وتحدد كيف ينبغي أن يتصرف. الارتباط برؤية سردية للذات قد يؤدي إلى العيش فيما يسميه سارتر "سوء النية" - أي العيش دون وعي بالمسؤولية أو سيطرة على المصير الشخصي:
"كل سلوكه يبدو لنا كأنه لعبة. هو يركز على ربط حركاته وكأنها آليات، واحدة تضبط الأخرى؛ حتى حركاته وصوته يبدو أنها آليات؛ يمنح نفسه السرعة والحدة القاسية للأشياء. إنه يلعب، إنه يتسلى. ولكن ماذا يلعب؟ لا نحتاج إلى مراقبته طويلًا قبل أن نفسر ذلك: إنه يلعب دور النادل في مقهى. لا يوجد شيء يثير الدهشة في ذلك."
بعبارة أخرى، هو يلعب دور النادل بطريقة مماثلة لممثل على خشبة المسرح يتبع نصًا مكتوبًا. نتيجة لتجسيده لسردية النادل، يعيش بشكل غير أصيل لأنه لا يستطيع التصرف إلا بما يتناسب مع هذا الدور. السردية التي يتبعها تمنحه فهمًا محدودًا لنفسه، حيث تحدد أفعاله وتمنعه من امتلاك حياته. ولكن ماذا سيحدث لو رفض النادل تلك الهوية السردية؟ بالنسبة لسارتر، سيكون هذا خطوة نحو الذات الحقيقية، أو الوجود الأصيل – ما سماه "الوجود" – بدلًا من مجرد لعب دور.
إذًا، ماذا يعني رفض السردية؟ العيش بطريقة غير سردية يعني رفض هوية معينة، ورؤية الحياة والمعنى على أنهما مجموعة من الخيارات المفتوحة. بالنسبة للنادل، رفض هويته السردية يعني التصرف بطريقة تعكس خياراته وشعوره بالذات، وليس فقط القصة التي يحكيها عن نفسه.
لفهم ما يتضمنه رفض السردية، من المهم أن نتذكر أن السرديات لا توجد خارج عقول الناس. القصص التي نحكيها لأنفسنا ليست موجودة في العالم. إنها أدوات تساعدنا على التفاعل مع العالم. على الرغم من أنها ترتبط بالحقائق والأحداث الواقعية، إلا أنها ليست حقائق بحد ذاتها. في الواقع، هي ليست صحيحة ولا خاطئة. بدلًا من ذلك، تساعدنا القصص في فهم الأمور. إذًا، إذا رفضنا قوة السرديات في تنظيم الأحداث في حياتنا، كيف يمكننا تنظيم أفكارنا حول العالم بطرق أخرى؟
فكر في الطرق التي تنظم بها المنظورات التجارب بشكل مختلف. بعبارة "المنظور" لا أقصد مجرد "وجهة النظر". بل أشير إلى الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم من موقع أو توجه معين يوجه انتباهنا إلى جوانب معينة من التجربة، مثلما يسمح لنا "المنظور" البصري برؤية الألوان الزاهية بسهولة أكبر من الألوان الباهتة. المنظورات تتشكل من موقعنا في العالم، ومعتقداتنا، وقيمنا، وما نعتقد أنه مهم. كما تشرح الفيلسوفة إليزابيث كامب، فإن المنظور "يساعدنا في استخدام الأفكار التي لدينا: لإصدار أحكام سريعة بناءً على ما هو أكثر أهمية، لفهم الروابط البديهية، وللرد عاطفيًا، من بين أشياء أخرى". من خلال المنظور، تبرز بعض ميزات تجاربنا في أذهاننا بينما تتلاشى أخرى في الخلفية.
الشعر يلتقط طريقة معينة في الرؤية والشعور، وليس مجرد تسلسل للأحداث.
إذن، تحدد المنظورات السرديات التي نتبناها. بعبارة أخرى، تشكل معتقداتنا وقيمنا الأساسية الطريقة التي نرى بها الأشياء وما نعتبره مهمًا في تجاربنا. إنها منظوراتنا التي تولد سردياتنا. كما أن المنظورات تفسر سبب اختلاف سردياتنا بشكل جذري عن سرديات الآخرين، حتى عندما نعيش الأحداث نفسها. ولكن بمجرد أن نفهم هذه المنظورات، يمكننا أن نرى مدى مرونة سردياتنا. فليس للمنظورات بنية خطية أو مرتبة. لا يمكننا التفكير فيها كأنها تسلسلات للأحداث مثل القصص. في بعض النواحي، تُعبّر المنظورات بشكل أفضل عن طريق اللاخطية التي نجدها في الشعر.
فالقصائد، خاصة القصائد الغنائية، تعبر بطبيعتها عن المنظورات؛ حيث توحد الكلمات والصور والأفكار والمشاعر للتعبير عن القيمة. يلتقط الشعر طريقة معينة في الرؤية والشعور، وليس مجرد تسلسل للأحداث.
فكر في قصيدة "ثلاث عشرة طريقة للنظر إلى طائر أسود" (1917) للشاعر الأمريكي والاس ستيفنز. يركز كل مقطع من القصيدة على طريقة مختلفة للنظر إلى الطائر الأسود وعلاقته بالذات:
تجمدت الأضواء على نافذةٍ طويلة
زجاجها همجيّ وقاسٍ كالشتاء
ظل الطائر الأسود
يمرّ فوقها ذهابًا وإيابًا
والمزاج
يرسم في الظلّ
سببًا غامضًا، عصيًّا على الفهم
في قصيدة ستيفنز، يجمع بين التجارب دون أن يوضح كيف ترتبط ببعضها البعض – فهي متصلة فقط بمنظوره. وبالمثل، فإن فهم أنفسنا بطريقة غير خطية يعني رؤية كيفية ارتباطنا بعالم معقد وفوضوي في اللحظة الحالية. نجد في تلك اللحظة معنى دون الحاجة إلى نمط منظم.
وهكذا، بدلاً من مجرد تغيير سردياتنا، يجب أن نتعلم فهم المنظورات التي تشكلها. عندما نركز على قصصنا الخاصة، نعيش الحياة كما نعرفها بالفعل، ولكن من خلال تخفيف القبضة التي تمتلكها القصص على حياتنا – عبر التركيز على منظوراتنا ومنظورات الآخرين – يمكننا أن نبدأ في فتح أنفسنا أمام إمكانيات أخرى. يمكننا تبني توجهات جديدة، والعثور على معاني جديدة في أماكن غير متوقعة، بل ونتحرك نحو عدم القدرة على التنبؤ المثير الذي توفره المنظورات المشتركة.
كما حذر سارتر، كل شيء يتغير عندما تحكي قصة. تقيّد السرديات إمكاناتنا. على الرغم من أننا كائنات معقدة نعيش في كون فوضوي، فإن قصصنا تخلق الوهم بأن حياتنا منظمة ومنطقية ومكتملة.
ربما لن نتمكن أبدًا من الهروب الكامل من السرديات التي تحيط بنا، لكن يمكننا تعلم تغيير المنظورات التي تقف وراءها. وبهذا، نحن لسنا مقيدين بالقصص، بل بقدرتنا على فهم كيف تشكل معتقداتنا وقيمنا الطريقة التي ندرك بها العالم ونتفاعل معه. نحن لا نحتاج إلى سرديات أفضل؛ بل نحتاج إلى توسيع وصقل منظوراتنا.
***
........................
الكاتبة: كارين سيميك /Karen Simecek أستاذة مشاركة للفلسفة في جامعة وارويك بالمملكة المتحدة. وهي مؤلفة كتاب فلسفة الصوت الغنائي: القيمة المعرفية للشعر الغنائي (بلومزبري، 2023). تقول سيميك عن نفسها: تتمحور اهتماماتي البحثية حول فلسفة الشعر، والجماليات، والتفكير الأخلاقي، والعواطف. أعمل على قضايا تتعلق بقيمة التفاعل مع الشعر من حيث كيف يمكن أن يعزز هذا التجربة فهمنا لذاتنا ويساهم في إحساسنا بالتقدم الأخلاقي. تركيزي الحالي هو على القيمة المحتملة للشعر المؤدى، الذي أرتبطه بفكرة العاطفة المشتركة.
https://psyche.co/ideas/your-life-is-not-a-story-why-narrative-thinking-holds-you-back